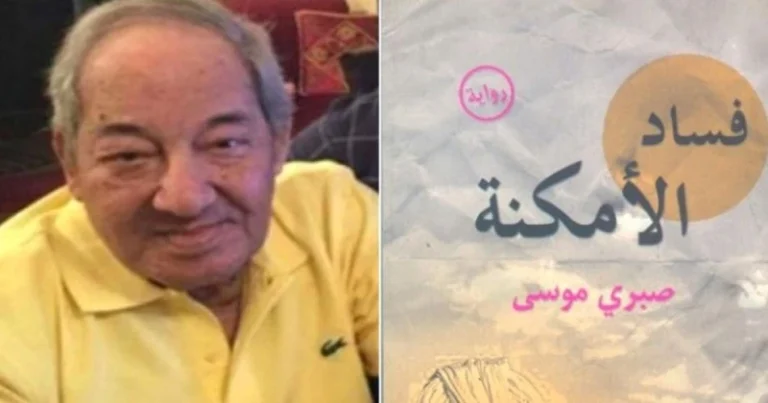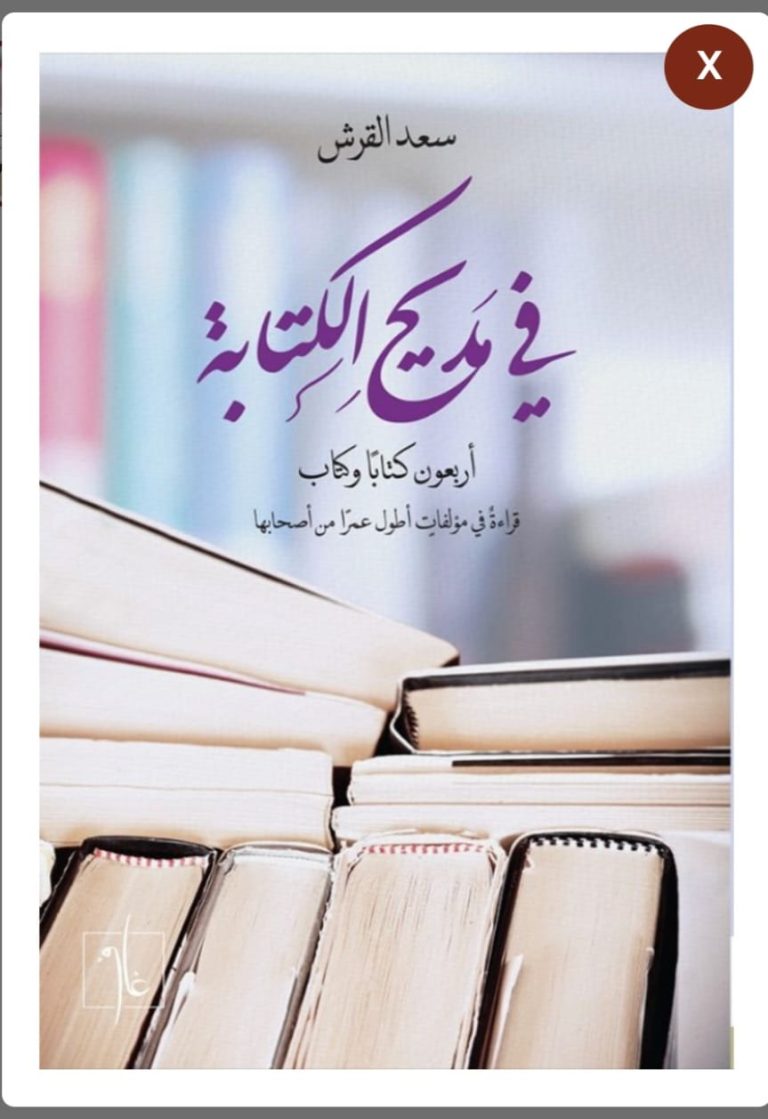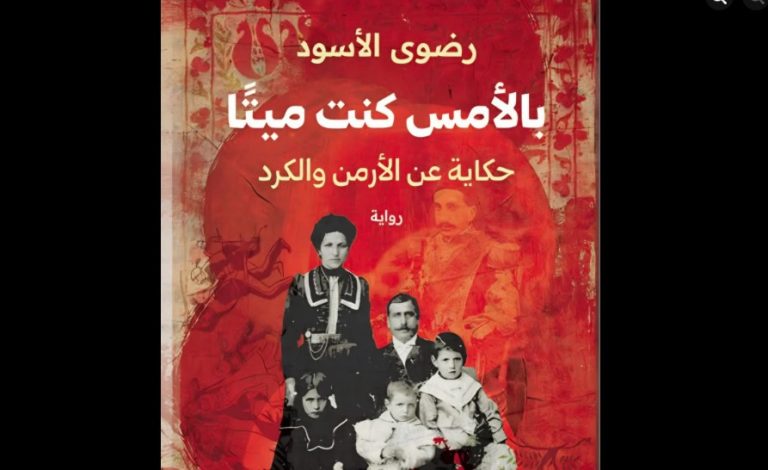شوقى عبد الحميد يحيى
بعد كل عمل للمبدع وحيد الطويلة، يتصور القارئ أن جعبته قد أفرغها كلها فى هذا العمل، ومع كل عمل جديد، يبدأ القارئ فى تصور ما يمكن أن يقدمه جديدا. وقد انصهرت كل أعماله داخل بوتقة المجتمع، الصغير، ثم الكبير، حتى باتت القناعة بأنه معجون بطين الأرض، مهموم بالإنسان، وما يؤثر فيه من عادات وتقاليد، وعلاقة كل ذلك بالهم العام، الذي تغطيه وتسيطر عليه “الهم السياسى”، وراء الرؤية التنويرية التى تبدو فى الظاهر.
حتى جاءت “سنوات النمش”[1] ليعلن لقارئه أن جعبته لم تخل بعد من حكايات الإنسان، وحكايات السياسة، فصهرهما معا، فى بوتقة لا تقبل الفصام، ولا الانفصال، فتأرجح الزمن، وغادر الخط المستقيم، فأصبح على القارئ، أن يجمع الأشلاء من بين الصفحات، ليتعرف على تاريخ مصر فى عهدها الذى انفصل عن الماضى، وأصبح كأنه الزيت فوق الماء. فقد سارت “سنوات النمش” كما لو أنها سيرة ذاتية، تعتمد على الحكى، ولكنه غير متصاعد، وتنضح منه لغة الذاتية، المحببة لدى القارئ، سعيا وراء كشف المستتر من الحياة، لكن الكاتب جعل المستتر هو الحياة العامة، والمسيرة التى بدأت من العام 1952، أما الظاهر على السطح، فهو الحياة الشخصية، وانعكاس الحياة العامة عليها. وإن كانت “سنوات النمش” تعيد للذاكرة رواية المنسى قنديل “انكسار الروح” والتى أفاض فيها الحديث عن وقائع 1967، وانتقل بعدها مباشرة إلى عملية الانفتاح الساداتى. فكذلك أفاضت “سنوات النمش” فى الحديث عن فترة عبد الناصر، إلا انه اكتفى بالإشارة الضمنية لما حدث فى 1967، والتى أنهت مرحلة عبد الناصر، حيث انتهت الرواية فأصبح على القارئ أن يبحث ما وراء السطور، ليستكمل المسيرة التى تعتبر كلها مرحلة واحد، وإن كان أحد شخوص الرواية، (المُتَنور) فى القرية، نادى بعمل حكومة ظل فى القرية، فقد صنع الطويلة من القرية البعيدة، غير محددة الملامح، إلا أنها تنغرس فى العمق المصرى، جعل فيها حكومة ظل. غير أنها ليست حكومة ظل بالمعنى السياسى، حيث تقف كمعارضة ومنتقدة للحكومة، ولكنها جاءت حكومة ظل بالمعنى الحرفي، بحيث أنها تمثل الوضع العام فى البلاد، وأن يصبح كل من فيها ممثلا لتلك التى فى النور، ليعكس عليها ما تفعله الحكومة المركزية. وإن كان قد نجح فى توصيف تلك المنطقة وما تعانيه من تخلف وفقر عام، حيث هى الطبقة التى استفادت بالدرجة الأولى من قرارات وقوانين سنتها الفترة الناصرية، ليكون كالفرشة التى شكلت القاعدة التى سعت إليها تلك المرحلة، وكانت أساسا بَنَتْ عليه تصورها للنهضة، وهو ما تطلب أن يفرش الكاتب، لذلك بوصف ناس تلك المنطقة، فالناس هم الأساس فى العملية، كاشفا عن كثير من السوءات التى يعانى منها أبناء الطبقة (التحتية) رغم ما قد يتوافر لديهم مما يجعلهم خارج تلك الطبقة، غير أن القيود التى فرضها المجتمع، وفرضها الموروث، هى ما يتحكم، فى الرجال خاصة، ويعانى منها النساء، مثل الحرمان من الميراث، لنه يذهب لمن هم خارج العائلة، مخبئين وراء هذا اسبب، كرههم لأن يعتلى نساءهم غريب، لأنه يعتبر كأنه إعتلاهم هم- ليعيد إلىالذاكرة رؤية السودانى الطيب صالح فى روايته “موسم الهجرة إلى الشمال” حيث رأى أن إعتلاءه للنساء ال،جليزن عوضا عن إحتلال الأنجليز لبلده- فكان حتما أن يظهر منهن من تثور على تلك التقاليد، فكان{الأمر يستحق التفكير، لكن لم يفكر أحد أن وجود امرأة في منتصف العشرينيات قد يقضّ مضجعه برغباتها، فلتذهب رغبتها إلى الجحيم، الرغبة للرجال، والنساء متاع بل إن المتاع أحيانًا أهم منهن. قانون، قانون الناس الذين يعتقدون فيه، لا يحكمون به فقط، هو بديهي تمامًا بالنسبة لهم، الرجال ثم الرجال ثم المتاع والنساء، شرعة مكتوبة في النفوس، وستسمع في عزاء امرأة إن أقاموا لها عزاء بسيطًا من أصله، ستسمع من النساء أنها عاشت بالأصول، لم تخرج من الباب من يوم زواجها ولا عتبته مرة حتى خرجت لقبرها… الجنس فقط من حق الرجال}.وهو ما يعكس التخلف الذى يعانيه ناس هذه المنطقة، فكان على الرواية أن تلعب دور التنوير الذى يخرج بمثل هذه (البؤر) إلى النور. لذلك كانت العمة “فريال” والتى كانت جميلة الوجه والقد، بعود مستوٍ، عود لدن بوجه مدهون بالزبدة طوال الوقت، امرأة حية شعنونة تحب الحياة، تزوجت ووقعت قرعتها في ابن عم حرامي، لم يكن عيبًا لكنه لم يكن لصًّا على المستوى المطلوب الذي تستطيع أن تتباهى بلصوصيته التي ترفع من قدر العائلة، بل كان “حرامي عِفش”، وطلقت منه، وترك لها بنتين، لكنها تحب الحياة. فقررت {أن تخوض المعركة، ترفع صوتها كأنما رأت داخلها وتقول: “خدي بختك من حجر أختك”. أكلت أذن أمي وأذن عمتي نميرة زوجة الشيخ حامد شيخ الجامع: قولي لزوجك عن ستر الولايا، كلكم تستحمون وأنا أتحمم على الفاضي، تستحمون بالصابون وأنا أتحمم بالطين }. ولما تأخر الزواج، تحدث الجسد نيابة عن اللسان، فار لبنها حتى أصبح بقعا على وجهها وكأنه “النمش” ليتدخل الكاتب ليحلل ويكشف عن رؤيته للظاهرة { لم يكن ذلك جديدًا فيما يبدو على العائلة، فالأيام تكرر نفسها، لا أستطيع أن أقضي بأن ذلك أحد الجينات، ربما يكون جينًا غير معروف في اللائحة، لكنه بالقطع نمش يسري في دم من يعيشون في المنطقة.. نمش لم يكن ابن اللحظة التي ولدت فيها، ولا ابن تلك الفترة فقط، كان واضحًا أنه قديم وأنه يتناسل في حياة الجميع، يسري مسرى الدم} ليلقى أول الأضواء الكاشفة عما يعنيه بالنمش، فهو ليس ذلك النمش الذى يُعَرفُه الأطباء، وإن كان يكشف عن الرؤية الضمنية التى يخبؤها الكاتب خلف السطور، وهو المشترك بين الرؤية العلمية، والرؤية المرادة فى الرواية، وهو التعرض للشمس، او المكشوف للسماء، وهو ما يشير بالفعل لتلك الجماعة من البشر، الذين يلتحفون بالمساء، ويتوسدون الأرض. وتستمر الرواية فى تبيان حال العمة “فريال” التى تكشف عن عمق المآساة التى تعيشها، الجوع، ليس الجوع المادى، ولكنه الجوع العاطفى، الجوع للحياة، بينما هى تعيش كألاموات فظهرت رائحة الشياط على ملابسها، وراحت تنام نصف النهار وكل الليل، وكأنها تهرب من الحياة، وتنام بشكل غريب، فكأنها تعرض بضاعتها، لكل من يريد الشراء. فإذا كانت العمة فريال، هى الصوت الرافض للمعيش، والثائرة على ما تعيشه، فكانت صوت الرفض الصامت، حيث { لم يكن هناك صوت لأحد، خراب عميم ضرب العائلة، وبدا النمش على أهبة الانتشار، بل بدأت سنوات النمش تعد على أصابعها، كان لا بد لصوت عمتي فريال أن يعلو وأن يظهر كعادته في النوائب كما في المسرات، هي شاعرة العائلة، تحفظ بعض الشعر السائر، ينشده عابرون بربابة أو دونها وتصنع الباقي على يدها حسب الحالة، أنشدت تقول رغم أنها تطلقت في الليلة نفسها: “ضربة كانت من معلم خلت الاستعمار يسلم”}. ولم يكن إختيار الكاتب للعمة “فريال” إختيارا عشوائيا، ولكن الإشارة إلى أنها كانت(هى شاعرة العائلة) اى ان الصوت الصادر من وسط الهمس أو الصمت، كان هو صوت الثقافة، والرؤية الحالمة.
فإذا كانت العمة “فريال” قد ابتعلت الجوع والحرمان من الحياة، فطفح من داخلها إلى خارجها، فإن الأخت قد أخرجت، ليس شهوة الحياة فقط، وإنما شهوة السلطة، فتزوجت من أطيب ضابط في العالم، أمين شرطة درس الحقوق أثناء عمله لتحسين وضعه،ويحدد الكاتب هنا نقطة جوهرية، بتحديد وضع الضابط لدى العامة، وهو الوضع الذى سمح به، وأراده “عبد الحكيم عامر” للضابط فى تلك الفترة-قبل النكسة_ فيقول السارد { وضع الضابط عندنا في المرتبة الثانية بعد النبي}،غير أن روح صاحبنا الضابط- فى تلك الفترة-، وإن كان الكاتب يشير بطرف خفى إلى من كان بيده الأمر والنهى، فلم يكن بها مكان للكبر والزهو.
{وحين تزوجته كانت كريمة معه، تركته في غيّه الوحيد القادر عليه، المشي بالعرض، جاء على مقاس حلمها تمامًا، ليس مطلوبًا منه أن تكون البدلة على مقاس الباترون بالضبط، ربما من حظها أنه كان أفضل من الباترون والحلم، سقط بطيبته بين ساقيها، وبسرعة تتوافق مع النوايا أخذت زمام المبادرة، أمسكت لجامه ونشطت عندها مرة أخرى غُدد الزعامة} فهو { يعود من العمل، يدخل ببدلة الضباط، تلقف الكاب منه، تطوحه على أقرب كنبة أو طاولة، لا تترك له فرصة ليتنفس، بالكاد يخلع حذاءه وأحيانًا لا، يجلس القرفصاء على الأرض لتصعد هي فوق الكنبة وتبدأ خطبتها، زعيم شديد على شعب مستسلم من فرد واحد، تلوح بيدها في الهواء، تغيّر لون عينيها الملونتين، تخطب حتى تتعب، في الحقيقة لا تتعب، كل يوم تعاود الكرة}. ولكن الكاتب بخبرة عالية يمرر ما يود قوله، وكأنه الكلام العابر، او المعبر عن الموقف المحدود، فيصبح على القارئ الاستيقاظ، والانتباه كل ما (يحدفه) الكاتب، وكأنه شئ عادى. وإن لم يكن عادى، النظر إلى وضع الضابط، وربطه ب(زعيم شديد على شعب مستسلم). وهى الحالة التى سنأتى إليها. وحتى لا يهرب خيط (الهم الخاص)، أو الرؤية المحدودة بحدود الرؤية المباشرة، يخرج الكاتب عن تحديد الشخصية المراد التأشير إليها، إلى الجموع التى عاشت الفترة، واستوعبت الدرس، بأن الزعامة لا تخرج عن الخطابة، والكلام المعسول، وهى السمة التى وصمت ذلك العهد، حتى يمكن رؤية المشهد السابق، بأن المسئول الأول كان مستمعا، وكان منصتا، لتلك الخطب التى راح يطرب لها. ونجد الأخت المهووسة بالزعامة، وقد مات زوجها- الضابط- أو (شرابة الخرج) فيصفها الكاتب{شهوة الزعامة ما زالت نابضة في عروقها لا تفكر في رجل أو شعب آخر بل تصعد مرات فوق الكنبة ذاتها، تلبس الكاب على رأسها، تضبط مقاسه، تجرب حنجرتها بأصوات متعددة، بطبقات حماسية وأخرى حنون مملوءة بالوعود، تخطب وترى جماهيرها وحدها، تفكر بصوت عالٍ في الترشح لعضوية البرلمان وخوض الانتخابات التي تتيح لها أن تفرغ شهوتها أمام الجماهير والميكرفونات وأن تنتقم على طريقتها من غيابه} وما أتصور أن الكاتب أراد توصيله ، هو أن الخطابة كانت هى المفتاح السحرى للوصول إلى السلطة. وإن كان استخدام (وأن تنتقم من غيابه)لا يجب أن تمر عابرة، دون التمعن فى دلالتها، والتى تكشف عن رؤية مرحلة بأكملها، وكيف أن رفض الموت للرمز، كان هو السائد، وهو ما يؤكده الكاتب، حيث تبدو آثار الحزن والموت على الجميع، وعلى الوالد تحديدا، ويتسلل الطفل ليعرف السبب، وكان عنده عشر سنوات، لسمع: “جمال عبد الناصر مات يا ولدي”. وليكمل هو (السارد): {لا تصدق الكتاب والشعراء حين يقولونها إلا إذا كنت عشت ليلة موت جمال عبد الناصر، ماتت القرى كلها، كابوس حقيقي والناس الذين خافوا من التسليم بالخبر لم يناموا، خرجوا يتطلعون للسماء ربما يمر عزرائيل فيستعطفونه أو يقبضون عليه}. وهو الأمر الذى يُشعل عديد المصابيح عن رؤية تلك الفترة، والتى ابدع الكاتب فى تصويرها، من خلف السطور، التى تتحدث عن مكان، يُخَبىُ فيه رؤية تلك المرحلة، ومن خلال رؤية الرجال فيها، فإذا كانت النساء هن من يمثلن الشعب، الساكن المستسلم، إلا من بعض الثورات المكتومة، فالرجال هم السادة، وهم القادة. ويأتى فى مقدمة الرجال، الأب، والد السارد، وأكرر بأن اختيار الكاتب لهذه الشخصية (الأب) كانت هى الرؤية السائدة فى تلك الفترة، حيث نظر الجميع إلى “عبد الناصر” على أنه الأب، وليس الرئيس. حيث تتجلى أولى مشاهد الزعامة بعد التحولات فى القرية فى عهد عبد الناصر.. كثر موت البهائم، فحمل الأب “نادى” -اسم الشهرة للأب الذى كان اسمه محمد- حمل الفلاحين إلى مبنى المحافظة: { رحل الشباب للجيش، للحرب القادمة، خلت الغيطان، ونفقت الأبقار مرة واحدة في حدث نادر، جمع الفلاحين، ربت على ضعفهم وشحن عظامهم، أركبهم في مقطورات الجرارات الزراعية بملابس الغيطان، وفيما يشبه موكب العصاة لم يقف به الركب إلا أمام مبنى المحافظة، كان المشهد أقرب ما يكون إلى مظاهرة احتجاج أو إلى مشهد عرابي الشهير مع اختلاف الهدف، وإن كان الموضوع واحدًا، كرامة الناس، وقف أمام المحافظ المستغرب من الموقف وقال: كرامة الفلاح في بقرته، يخاف عليها ويحميها مثل أبنائه.
لم يتحرك من مكانه سوى بقرار شفهي تم تنفيذه أن يأخذ كل فلاح بقرة من مشروع الإصلاح الزراعي على أن يسدد ثمنها بأجل طويل جدًّا.
ذهبوا حزانى دون أمل وعادوا يرقصون في مقطورتهم: الحادي الحادي، البادي البادي، ورئيسك مين، الشيخ النادي.
ويا شيخ نادي يا شيخ نادي، أنت العمدة في الناحية دي.
ويا شيخ نادي كتر خيرك، إحنا غلابة وملناش غيرك}. ولا ننسى أنه بعد موت عبد الناصر، تحول بيت “النادى” إلى محزنة ظن السارد أن الأب هو الذى مات، وكان الأب يبكى، حيث رآه السارد للمرة الأولى التى يبكى فيها. كما جاء الوصف، وكأنه يصف “عبد الناصر { الشيخ نادي، معتدل القامة، بوجه بشوش صاف كأنه غسله باللبن، تحبه وتخشاه، أنيق، أكثر من لبس الجلباب أناقة في بر مصر، أكتاف عريضة تأسر القماش، حين يسافر للمدينة يتخيلونه أميرًا من بلد آخر، ذكاء حاد وفراسة لم أصادفها في رجل، قادر على قراءة الأشخاص بشكل نادر، كأن معه ميزانًا حساسًا في مخه أو في روحه، لذا استطاع أن ينال محبة الناس وهابه الصنف الشمال، عرف كيف يسوسهم والذين حقدوا عليه بقوة عاشوا يشتكونه وحين مات ذرفوا الدمع عليه، الرجال تُعرف أحيانًا بالرجال}.خاصة أنه فى عهده، وكأنها إشارة إلى التعليم الذى –يُدعى- أن “عبد الناصر” أول من فتحه للجميع، ففى عهد “النادى” تم إنشاء المدرسة لأول مرة على ألا يقل عدد التلاميذ عن ثلاثين، ولما لم يجد العدد لجأ للحرامية والقتلة ليكمل بهم العدد وتقام المدرسة. وكان قد جمعهم “النادى” من القرى والعزب البعيدة المتناثرة، يحضرون على كيفهم، فكانوا تسعة تلاميذ من القرية وثلاث بنات. وأيضا لم تكن (ثلاث بنات) أمرا عفويا، ولكن تأكيد أن الزعم هو من بدأ تعليم المرأة.
فضلا عن قول العم الذى هرب السارد عنده أنه أحبه، لكنه أحب الوالد أكثر من أولاده ومن كل الدنيا، ويؤكد أنه هو الذي جعل من أبناء المنطقة آدميين، لولاه لعاشت المنطقة في خراب طويل، جاء بالتعليم والسينما والأبقار، حتى ولو كانت الأفلام تعرض على حائط الجمعية الزراعية، نقل الناس من الجهل والعراك، أمسك عيونهم وفتحها على آخرها}.
ورغم أن لاستعمار والملوك قبل الثورة قد فعلوا أشياء بقيت واستفاد منها أهل المنطقة، إلا أنه تمت محاولة التقليل منها، فلم تكن الدنيا قبل مجئ 1952 فراغا، إلا أنها عارية، ترى السماء فيها أكثر مما ترى الأرض، رغم الغيم الكثيف المقيم، لا أحد ينظر أبدًا تحت قدميه، كأن السماء لا تهطل ماءً بل طينًا، شتاء بالطين لنصف السنة، بضعة كباري ولو صغيرة الحجم والاتساع تصل بين القرى أو المغارات التي يعيش فيها الناس، أقيمت فوق المصارف والترع كمعبر من طين إلى روبة، لا يعرف أحد من أقامها بالضبط، ليس محمد علي لأن المنطقة كانت بحيرة بكاملها في وقته، ولا الفرنسيون بالطبع، لم يسعفهم الوقت رغم أنهم نزلوا في مدينة رشيد القريبة نسبيًّا، ليس الملك فؤاد بالطبع فقد كان نطعًا مهمومًا بالخلافة والنساء، ربما فاروق عند البعض، المؤكد أن حكومة الإنكليز كانت رحيمة وهم من فعلوها، الغريب أن الحكومة لم تضع أسماء لهذه الكباري، لكنها كانت على ميعاد مع القدر، الأحداث كانت هي البطل، هي من صبغت الكباري وأعطتها أسماءها.
{محطة جميلة كالأحلام من مخلفات الإنكليز الحلوة رغم كرهنا لهم في حصة التاريخ، نعم نكرههم في حصة التاريخ لِما فعلوه بنا ونحبهم في حصة الجغرافيا لما فعلوه لنا، قطار وكباري وترع ومصارف، وكلها أماكن للحب}.وأستطيع استشفاف، ما يخبئه الكاتب وراء هذه السطور، التى تشير إلى تلك الفترة التى حاولت بكل السبل محو كل تاريخ قبلها، وكأنها هى التى بدأت الحياة بهؤلاء البشر.
وتبدأ أحداث 1952 بتصدر محمد نجيب للمشهد، ولا يغفل الكاتب أن يخلق له شبيها، فى المصير، حيث إختفى سريعا، بعد أن استولى عبد النتاصر على الحكم، وتم حبس(نجيب)، فخرج من القصر الرئاسى، رغم ما كان الناس يحملون له من حب، لتبدأ لعبة السطلة والحكم {السلطة تضعف المشاعر، تزيحها للمرتبة الثالثة، الحب أحيانًا كذاب ومنافق، يجور على الضعيف والطيب ويخاف من القوي والصايع. من يفكر في حكايته واللهب الذي أشعله، والشعلة التي كان أول من أوقدها كأنه بطل في أوليمبياد الحب يجدها حدثًا عارضًا، سميّه أيضًا كان عارضًا، حدوتة تذكر ولا تعاد، ولعلها ماتت حين قفز جمال عبد الناصر على السلطة فقفز معه، وبدت حكايته كنتوء وسط أرض بكماء طواها النسيان بل سرحت فيها الفئران حول أرجل فوزية كما سرحت حول أرجل الرئيس نجيب في القصر الذي سجنوه فيه}.
ولم يكن الأب وحده هو العاشق للزعامة، بل كان الجد، والجد الإحتياطى، والعم الذى عاد للمكان بعد عشرين عاما من الغياب، والدراسة فى الأزهر، وهواية القراءة فى وعن السياسة، وأثناء الحرب العالمية الثانية، بينما لم تكن إسرائيل { قد هزمتنا بعد، ولم يكن هيكل قد ظهر خلف جمال عبد الناصر للتبرير، عرج على الأردن فالعراق فتركيا ثم عاد إلى سوريا، أكلت منه الأيام عشرة أعوام، وفي الأخير استقر في لبنان. وصل هناك إلى الضاحية الجنوبية قبل أن يصل قطار حزب الله، خطب وأكل ولعن الحرب والإنكليز وهتلر ولبس الكاكولة فوق البدلة وأصبح اسمه أحمد الفقيه المصري}.. ويجب ألا نُفلت كلمة جاءت عابرة، لكن الكاتب عنيها (للتبرير) حين إشارته لهيكل، فاقترح على الناس تشكيل حكومة أزمة فى المكان، ف{ بلدتهم كبيرة مترامية الأطراف لا يعرف لها أحد آخرًا، فيها من الذئاب والثعالب قدر عدد البشر، اختار لها بعض من رآهم يصلحون لها، في الحقيقة لم يكن فيها أحد ممن حصلوا على قدر تعليمه، يعتقد أنهم بهائم يصلحون بالكاد لتحفيظ القرآن في الكتاتيب، مرة في سهرة تمطى أحدهم للكلام وعمامته على رأسه وقال:
“بريطانيا ضربت إنجلترا علقة كبيرة”}. وإزاء ما اقترحه لتكوين حكومة الظل {بدأوا يعاملونه على أساس أن قميص مستشفى الأمراض العقلية في انتظاره وأن النمش بدأ يظهر على محياه وتسرب إلى مخه}. حيث أن الأمر هنا يشير إلى وأد كل محاولة للخروج على النظام الذى وضعه الزعيم، او القضاء على كل معارضة لساساته.
ويقول السارد –الطفل- عن والده، بعد أن جاء السادات { كان أبي زعيمًا عندنا وعبد الناصر زعيمًا هناك، لم يكن أحد قد اعترف على الإطلاق أن أنور السادات رئيس، بالذات أبي الذي ظل يردد دائمًا جملة ينطقها بازدراء واضح: “عمر ما حد احترمه”، يرددها في كل مناسبة من فرط عشقه لعبد الناصر}، ليقى الكاتب على مرحلة ما بعد الزعيم، حيث كانت القلوب كلها معقودة لحب الزعيم زكره من يجرؤ على أن يجلس على كرسيه. وحيث تكر الأيام، وتمضى ايام الحرب العالمية، وتتابع الأجيال، وكل يمثل مرحلة تاريخية، لياتى السارد ابن العشرة أعوام، والذى يؤرخ للفترة، وكأنه يكتب مذكراته حيث يستمر السلسال. ويمتد من الجد إلى الأب والعم، ليأتى دوره فى الفعل، والزعامة{كنت بين حربين، حرب في الظاهر وأخرى في الباطن، أقود طابور المدرسة، أردد القصيدة التي حفظني إياها أبي، كنت أقف وأنا ابن العاشرة أيام حرب الاستنزاف بين الناس، كلهم أكبر مني، أقف على كومة من طين ناشف وسط أعضاء منظمة الشباب أردد بقلب الشاعر قبل صوته: أنا طفل ولكني شباب}. فى إشارة أيضا لما كانت تفعله منظمة الشباب (حديثى السن) من تعبئة وشحن للزعيم، والتى استعلها الكثيرون وصولا للسلطة.وهو ما يوضحه بصورة أكثر استكمال الطفل للحديث:
كانوا يسموننا شباب المنظمة التي تحارب إسرائيل بالقصائد هنا، وإخواننا يحاربونها بالمدافع هناك}. وقد كان المحاربون بالقصائد والخطب، اكثر من أولئك الذين يحاربون بالسلاح، حيث كانت قد ترعرعت مدرسة الاتحاد الاشتراكى، ومجموعات المستفيدين، مثل “غازى” ابن القرية الفقير الأب والأم. يسعى لأن يكون تحت الأضواء دائما، يبحث له عن دور.. عمل مذيعا لمباريات كرة القدم فيسمعه الجميع{يعرف كيف يتقلب مع الأزمنة، تعرفه جماهير الكرة في المنطقة، يتغير اللاعبون مع الزمن ويخلد المذيع، أخذ عضوية المجلس المحلي بمنتهى السهولة، كل الناخبين يعرفونه من صوته في الملاعب، وعلى الطريق إن شاء الله. مراوغ عالمي، لا تستطيع أن تعرف بطنه، ولا أين يقف، يضحك مع الجميع ومن الجميع، يضحك لنفسه}. فقد اصبحت الانتخابات لعبته، حيث ترشح للإنتخابات و{انتظر المرشح الكبير، كان يعرف أنه قادم، كانت الصفقة مخفية، كل ما تسرب منها تكهنات حول المبلغ الذي أنفقه مع أنه لم ولن ينفق شيئًا، ومبلغ للتنازل، على أن يختفي تمامًا من المشهد، وأن يقف بكل قوته خلف المرشح، كان له شرط غريب أن يتولى هو رئاسة حملة منافسه الذي تنازل له. الذي يعيش بدودة يموت بها، تولى الحملة، لديه كشوف الناخبين، وغريزة المذيع تنقح عليه والأضواء لا يجب أن تبتعد عن أنفه، سرق الكاميرا من الجميع، يذيع في السرادقات، يقدم المرشح، يخطب قبله وبعده، يركب فوق سطح سيارته قابضًا على الميكروفون ليراه الجميع، يجمع له كل الأوصاف، ينادي: زكي شرف الدين نصير الإسلام، زكي شرف الدين نصير الاشتراكية، نصير الديكتاتورية، يغمزه من معه، اسكت: الديكتاتورية حلوة جدًّا، نصير الفلاح والموظف والضباط، زكي شرف الدين نصير الشيوعية}. ولذلك كان الكاتب موفقا لحد بعيد أن يجعل من السرقة فى المنطقة، هى القاعدة، وأن يتعامل معها الأب “نادى” كحقيقة لا علاج لها، لذا كان حتما أن تقع النكسة، بظهور مجوعة “الزعالكة” والتى استولت على قطعة أرض، واخذت فى توسيعها { في الجانب البعيد من قريتنا استقر نفر منهم، جدهم اسمه زعلوك، مع الوقت صار اسمهم الزعالكة، انتحوا جانبًا، صنعوا قرية كبيرة واستصلحوا نحو ألفي فدان بعد أن كثرت ذريتهم، إخوة هبطوا للمنطقة معًا، عمروها واستعمروها، ملامحهم مختلفة قليلًا عن باقي البشر}. وتتضح الصورة، ويتيقن القارئ أن هذه المجموعة، ليست إلا إسرائيل، مغتصبة الأرض، وزارعة الكراهية فى تلك المنطقة ف{الأرجح أنهم هم سبب وجود النمش في المنطقة، البذرة الأولى، وهم الذين حولوه من بقع على الوجه إلى بقع في الروح وفي إحدى الروايات إنه ليس مرضًا يأتي من الطبيعة أو من الجينات أو الوراثة، بل يعتقد أنهم زرعوه في بداية هبوطهم للمنطقة وانتشر كوباء في الفعل لا كبقع خجلى على الوجه}. لنقترب أكثر من المعنى المقصود بالنمشن، والذى اصبح (الكراهية). إذ هنا، يصرخ السارد ويعلنها للمرة الأولى، خروجا على السياق الذى سار عليه فى فلك الأب “نادى”:
{ كرهت أبي وأمي.
في لحظة واحدة فعلتها. أبي يصارع طموحات عائلة زعلوك، استولوا على الجزء الكبير من المنطقة وصنعوا قرية كبيرة بحجم خمس قرى، يصارع أوهامهم التي تحولت بفعل الزمن إلى يقين بأنهم أصحاب المكان وسادته}.
وهذا يجعلنا ننظر فى مسيرة الراوى، بإعتباره السارد المحيط بكل التفاصيل، او كما يقول النقاد (السارد العليم)، فمن اللافت للنظر، إرتباطه بالجدة { تلك المرأة الفاتنة بحضورها قبل شكلها، الجدة التي لا تعشق شيئًا غير المعسل والحكايات، ورثتهما عنها بجسارة} { تحب جدتي عبد العليم، ابن ناس، ابن صديق جدي، يأتي لها بقصص مكتوبة، يقرأ عليها بالفصحى ويترجم لها بالعامية لكنها لا تستمتع كثيرًا وإن أخفت، يغيب الوهم من الحكاية، يغيب من صوت الحكاء الذي ينقل فقط، الحكاء غير المغرم بحكايته، وأتولى أنا فيما بعد أن ألفِّق لها الحكاية متناغمة متسلسلة} { استسلمت، كان عليّ تأليف الحكايات حتى يمر مغنٍّ آخر، استسلمت ثم غنت معي، صوتي جميل، أقرب للمؤدين من المغنين وذاكرتي حاضرة}.
{ قلت لنجعل الغراب رماديًّا حتى نخفف لون بشرة أبو زيد، صمتت قليلًا ثم قالت لا بأس هذا كذب جميل أيها الكذاب الكبير، النمش الذي على وجهك علامات الكذب} فالجدة-حتى فى العموم- تهوى وتعشق الحكايات، وسيرة السارد توحى [انه سيكون كاتب(مؤلف قصص) أو شاعر (كذب جميل أيها الكذاب الكبير)، إلا أننا نجده فى النهاية وقد اصبح (مغنيا). واختفت فكرة (المؤلف). حقيقة أن الغناء هنا يشير إلى الحياة، البهجة، وكأنه- والحياة جميعها- تحول من الحلم وسط الأموات والحرمان، او وسط الآخرة، إلى الحلم بالحياة ليثور التساؤل، وأين التنشئة التى كانت تؤهله للتأليف؟.
غير أنه –السارد- من يحيلنا إلى العتبة الأولى للرواية، وما يثيره من غموض، أو لبس فى معنى النمش، لنجده يحدده فى {الأرجح أنهم هم سبب وجود النمش في المنطقة، البذرة الأولى، وهم الذين حولوه من بقع على الوجه إلى بقع في الروح وفي إحدى الروايات إنه ليس مرضًا يأتي من الطبيعة أو من الجينات أو الوراثة، بل يعتقد أنهم زرعوه في بداية هبوطهم للمنطقة وانتشر كوباء في الفعل لا كبقع خجلى على الوجه}. فالنمش وفق هذا التعريف، يعنى سنوات القلق، الذى زرعته جماعة (الزعالكة) –على مستوى الهم الخاص- أو إسرائيل – على مستوى الهم العام. وليصبح ذلك هو الذى على أساسه إختار الكاتب فترة عبد الناصر. كمرحلة تاريخية، كان للوجدان الإنسانى فيها دور كبير.
وإن كان الكاتب قد اشار إلى إفريقيا، بإعتبارها أحد الأذرع التى مدها عبد الناصر إلى خارج البلاد، فكان الأوجب- من وجهة نظرى- أن يشير إلى اليمن، بإعتبارها أحد مسببات النكسة، فلم يذكرها إلا فى إشارة عابرة، مشبها بالقذافى المحلى{ سمع في الراديو أن الرئيس علي عبد الله صالح أشار إلى خنجر يعلقه في وسطه وقال: “أخذت الحكم بهذا الخنجر ولن أتركه إلا به”، وهو قرر أن يكون نسخة منه وأن يفعل مثله مع استبدال النبوت بالخنجر}، إلا أنه منح مساحة كبيرة للقذافى، ربما لكاريكاتورية شخصية القذافى، حيث ربط بين القذافى المحلى، والقذافى الحقيقى، ليؤكد أن محاولات قد حيكت بالزعيم، ولكنها فشلت، إمعانا فى ترسيخ فكرة حب الشعب للزعيم{ ذراع القذافي ونبُّوته، يطيعه طاعة عمياء، لا يناقشه في شيء كأنه عبد السلام جلود في الحكاية الحقيقية، القذافي يحلم وهو ينفذ، وإذا كان القذافي قد قام بانقلاب على الحكم المستقر وصار قائدًا لثورة، فإن القذافي نسختنا يحلم أن يقوم بانقلاب مماثل يستولي به على مقعد الحكم المستقر أيضًا في العائلة والقرية، ولديه النبابيت التي سوف تساعده على تنفيذ مخططه وهي تحل محل الدبابات هناك}. فكان وصف القذافى (المحلى) {الإثارة للأمانة بدأت من عند القذافي، ابن عم من فرع على طرف العائلة، أبوه وأعمامه ورثوا أرضًا كثيرة، لا يطمحون لشيء، في حالهم، فرع ضعيف ليس منبوذًا لكنه ليس في الحساب، يزرعون ويتكاثرون، إلى أن قضت المشيئة أن يتعلم هذا القذافي في البندر، في النهاية سيحصل على دبلوم تجارة وهي شهادة فاخرة، من يحملها الآن تؤهله بالكاد لأن يحمل الكراتين على كتفه في أي شركة أو مصنع، لكنها في وقتها كانت تؤهل حاملها لأن يعمل أمينًا عظيمًا للمخازن في جمعية زراعية أو سكرتيرًا محترمًا في مدرسة ابتدائية يتيمة}. وإمعانا فى السخرية التى هى أحد أساليب الكاتب، لم تغب، وخاصة عندما وصف المحلى، بما كان يوصف به الحقيقى { معتوه طامح للسلطة، في فمه جملة واحدة يرميها بالتتابع على كل العائلات حسب لحظة جنونه: “العيلة دي لازم تتأدب”} {يشعر أنه مجنون وأن عنده خمسة في دماغه}.
إلا أن الطويلة لم يستطع التخلى عن الكثير من سمات كتابته، والتى يمكن إيجازها فى:
من المعروف أن وحيد الطويلة، يقضى معظم وقته على المقاهى، بل ويكتب فيها، لذا فكتابته دائما معايشة للواقع، ويلمس نبضات الشارع، لذا نستطيع أن نجد أثر ذلك فى الكثير من المواقف فى “سنوات النمش” ، منها على سبيل المثال، ذلك التعبير الذى لا يتطبق إلا على الأمثال الشعبية، من وسط المجتمع { ما حدث كان غريبًا لكن يبدو أن “التخين كان في القعر”}.
كما يأتى التعبير عن معايشة كرة القدم، وقد انطبعت على لغته وإسلوبه { لكنه حسد الغبطة يرتطم بالقوائم والعارضة دون أن يدخل المرمى}.
كما ياتى الكثير من أوصافه الدقيقة للمجتمع وأحواله، والتى توحى بالمعايشة مثل:
{عائلة تعيش بهائمها لسنوات، تلد أسرع من الخيال، في البطن بطنان، دارهم تفوح دائمًا برائحة السمن والمورتا واللبن السَّرْسوب، ذاك الذي ينساب من ضرع البقرة أو الجاموسة بعد الولادة مباشرة، يحوي كل فيتامينات العالم، السر الباتع للعرسان والرجال الذين تعطل محراثهم}. {في دكان صاحب الكوكا يتجمع الكبار في العصاري حتى المغرب، شيخ ضخم الجثة والمعرفة، حصل على العالمية أيام الملك لكنه لم يستطع أن يجد وظيفة، الوظائف كعادتها بالواسطة مهما كان معك من شهادات}. {ناس ذمتهم واسعة أو بلا ذمة من أصله، ربما ليس هذا هو السبب، السبب أن كل شيء هنا متوقع، كأن الناس يحتاجون للدين والقانون وإن لم يجدوهما خلقوا دينًا جديدًا أو طوعوا الموجود على كيفهم، والقانون! ما يفعلونه هو القانون، إنها الغابة والقوي يأكل الضعيف}.{الجميع بظهور محنية طوال العام بل طوال العمر، يرمون شتلات الأرز أو يجنون القطن أو ينقون الدودة، أجساد منخفضة وعيون في الأرض، ربما لهذا كانوا يحبون بقوة، حبًّا متقدًا كأنهم يواجهون به الفقر والانكسار، تتسلل كلمات الغزل بين خطوط القطن، تحضر الأعين والنظرات كما لا تحدث في الأفلام، لا مانع من قرصة خفيفة في الفخذ، القرص في الفخذ دليل حب الفقراء، حب المتعبين، والقطن يضحك بين أيديهم، يضعونه في حجر جلبابهم بين أفخاذهم}.
كما كانت السخرية، وخفة الروج متجلية، كما هى فى العديد من رواياته السابقة، كانت هنا أيضا فى:
{ من لا تنجب فلتنتظر ضرة في الصباح تقف لها خلف الباب، إن فتحته ووجدتها فلترحب بها أو ترضى بقضائها، ولها فقط أن تبعبع بما تشاء من جمل حول العويل وغدر الخسيس وبنت الحرام لتبرد نارها، وعليها أن تشرب الكثير من اللبن}.
وحين جاء العريس المنتظر للعمة { بطرف عين من تحت البطانية، وهي بقميص خفيف بكامل مشمشها أو بكامل رمانها وبطيخها، تشبك ضفائرها، حين انتهت من الأولى تقول: “قوله يا وله: عينها حلق وضهرها فلق”، ثم حين انتهت من ضفيرتيها رمتهما طويلتين عفيتين مكتنزتين على ظهرها الفلق وراحت تغني:
“أسمر سمير وكل الناس حبوني، بين المزانق وبين النهد حطوني”}.
{ قامت الحرب وحدتث الثغرة في الدفرسوار وفي البلد، انقطع الشاي والسكر، وفاطمة ضجرة لم تنقصها وداعة نجاة لكن غابت عنها شقاوة سعاد حسني}
ويتحدث السارد عن العم (الشيخ) الذى قلب المسجد إلى مسرح:
{ كان صادمًا وجارحًا للبعض، لم يستطع أحد أن يعارضه إلا تحت إبط السر، لم يقدر أحد أن يواجهه وهو أيضًا أكابر ابن أكابر، لديه ملكة الاحتواء، كاريزما الممثل الكوميدي البارع، حين تغص قاعة أبي برئيس مجلس الشعب وبطانته الخمسين يتفرق الحديث، بعد حضور الشيخ حامد بخمس دقائق يكون قد وضع القاعة كلها في جيبه وسيطر عليها، حين سأله رئيس البرلمان عما إذا كانت أمه تدعو له أم هو الذي يدعو لها باعتباره شيخًا، أجاب أنه ينتظر دعوتها كل صباح، فسأله عما دعت به اليوم، أجاب بسرعة: “قالت لي روح، إلهي ربنا ما يحْوِجَك لرئيس مجلس الشعب”}.
وإذا كان الدين، بعنصريه، القرآن والسنة، له سطوته، وله سيطرته على تصرفات البشر فى مثل تلك المنطقة التى صورها، فكان التناص مع القرآن والسنة، فى :
{ والأغرب أنها تستطيع أن تعرف بطها من بط غيرها ولا تسمح لأحد أن يقول أمامها: “إن البط تشابه علينا”}. (إن البقر تشابه علينا)
{بهدوء وهي ترفع رأسها مدت يدها خلعت خاتمًا قديمًا ووضعت جديدًا، اختارت صاحب السوابق والخواتم، خلعت عليًّا مرة أخرى ووضعت معاوية}.
ومع السنة {قال واحد: “عمر ابن الخطاب تخشاه الشياطين، وحسن أبو حسن تخشاه الكلاب”. وفي كلٍّ خير}. فى إشارة إلى الحديث الشريف: أما بعد: فيقول النبيُّ ﷺ في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضَّعيف، وفي كلٍّ خيرٌ.
{خلف حائط السرادق رجلان واحد من شيعته وواحد من عدوه، قال المسكين: “من للغلابة بعدك يا شيخ نادي!”} إشارة إلى الحديث (حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قَتادة) (فوجد فيها رجلين يقتتلان.هذا من شيعته وهذا من عدوه).
يُنكر البعض أن التاريخ لا يُؤخذ من الروايات، وهو ما لا أتفق معه، حيث أن التاريخ، الرسمى، لا يتحدث إلاعن القادة، لذا فهو دائما غير صادق، فهو يُكتب فى زمنهم، أما الرواية فإنها تكتب تاريخ الشعوب، تاريخ ما لم يذكره التاريخ، ولا شك أن “سنوات النمش” قد نجحت فى استبطان الأفراد العاديين، لتجعلهم ستارا شفافا يخبئ خلفه تاريخ القادة، ليؤرخ لفترة ثار حولها ولايزال يُثار الجدل، حول التجربة التى حملتها خمسينيات وستينيات القرن العشرين، هل كانت ناجحة أم فاشلة. وقد استطاع المبدع وحيد الطويلة أن يحولها إلى رواية ممتعة، ليثبت أنه روائى باقتدار، الأمر الذى يجعلنا ننتظر أن نقرأ باقى أجزاء التجربة التى ما زلنا نعيشها حتى اليوم.
……………