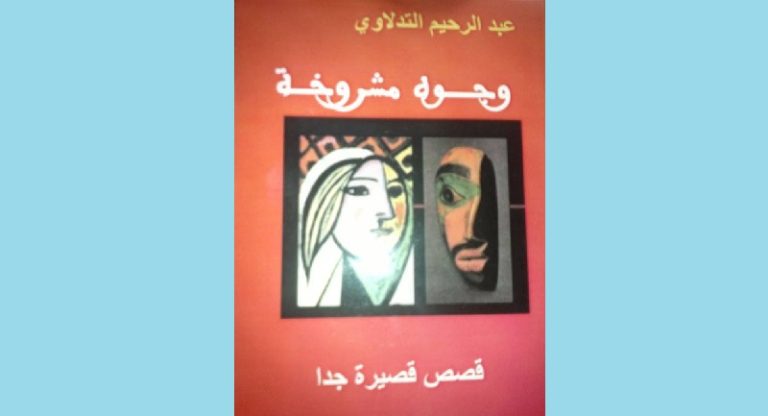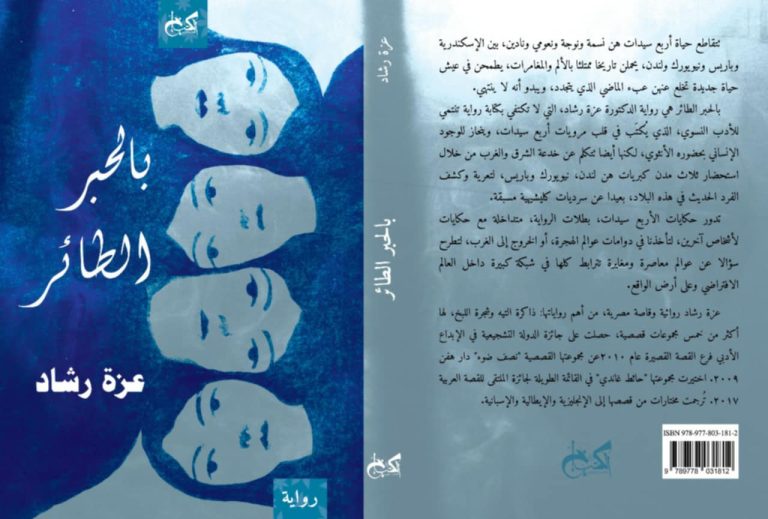عبد اللطيف النيلة
قبل أن يشرع الشّْريفْ في إعداد اللفافة، أدنى قطعة الحشيش من أنفي قائلا: “شُمّ القُح، ليس مثل ذلك الحشيش الرديء الذي أتيتنا به أمس!”. بنفَسٍ عميق شممتُ القطعة، وقلت مجاريا الشّْريفْ: “بدون تعليق، هي بالذات!”. قال هشام ضاحكا: “بالذات والصفات!”. تابع متفلسفا: “هل صفاتها هي ذاتها، أم ذاتها غير صفاتها؟”. ضحك مرة أخرى، وردد: “ذاتها عين صفاتها!”. تحول ضحكه إلى قهقهة مسترسلة عالية. عقبتُ ضاحكا: “يبدو أنك انتشيت قبل الأوان، حتى من غير أن تدخن!”.
غزاني إحساس مفاجئ بالشفقة عليه؛ مجاز في الفلسفة طُوِّحَ به معلماً إلى جبل بإحدى القرى النائية، فوجد نفسه مجبرا على تلقين أطفال صغار: “ا، ب، ت، ث”، وذهبت معارفه حول سقراط وديكارت وكانط ونيتشه أدراج الرياح. هو ذا يصرّف الحكمة بين جدران هذه الشقة الضيقة، هاربا من مصير خالف كل توقعاته.
لما أعددت إبريق شاي ثقيل، تناوبنا على تدخين اللفافة، إلى آخر نفس، على رشفات كؤوس الشاي. لذت بالصمت، وعيناي الناعستان تسترقان النظر، من حين لآخر، إلى صورة ذات إطار مُفضَّض معلقة على الجدار المقابل. سألني هشام: “إلى أين شرد بك الخيال؟”، ملمحا إلى صورة أخت الشّْريفْ.
قبل أكثر من عام، ركبت معها المصعد إثر صدفة سعيدة (أيام كان المصعد يشتغل)، كنا وحدنا من دون مزاحم، التقت نظراتنا في البداية عندما أرادت أن تضغط على الزر، وسألتني بنظرة من عينيها أي طابق أريد، اخترقني سحر نظرتها، فلم أحر جوابا. لكنها قالت: “أنا صاعدة إلى الطابق الخامس”. فأجبت دون تفكير: “وأنا أيضا”. ضغطتْ على الزر، فانطلق المصعد إلى أعلى. لم نتبادل كلمة أخرى، وترقبنا توقف المصعد والصمت مطبق علينا. كابدتُ، في خضم الصمت، أشق امتحان يختبر رجولتي، إذ كنت أدرك جيدا أن عليَّ أن أكون مبادرا، أن أباشرها بالغزل، أو بالحديث على الأقل، غير أني طيلة الصعود، الذي بدا لي لا نهائيا، تقوقعتُ داخل صمت رهيب، حتى أني لم أستطع أن أرفع رأسي وأرشقها بنظراتي. لما فُتحَ الباب أخيرا، التفتتْ إليَّ مستفسرة: “هل تسكن في هذه العمارة؟”. رددت عليها: “أجل!”. لوحتْ لي بيدها مبتعدة: “متشرفين!”. غادرتُ المصعد، ولبثتُ واقفا في جمود لِلَحْظَة في الممر كما لو أن حواسي تعطلت، قبل أن أنزل الدرج لبلوغ شقتنا في الطابق الثالث! صادفتُها بعد ذلك مرارا، وكنت أبادلها التحية دون أن تواتيني الجرأة لاجتراح خطوة أخرى، وظللت على هذا الحال إلى الآن، بل إن خجلي تفاقم حين علمت أنها أخت الشّْريفْ.
لم أرد على سؤال هشام، ارتخت أجفاني فيما كنت ألتذ بنشوة الحشيش، وأنتشي في الآن نفسه باستحضار صورة أخت الشّْريفْ. دعانا هشام إلى النزول إلى الأرض لنبدأ لعبتنا الأثيرة: لعبة السلطان. شكلنا حلقة، وأخذ هشام في توزيع الأوراق علينا، معقبا: “دعونا نختبر النوازع البشرية كالعادة”. رد الشّْريفْ: “حاكم ومحكوم، غالب ومغلوب، دائما وأبدا، لا شيء يتغير. فمن يكون اليوم الملك؟”. فاجأتهم صادحا:
“أَرْفـَقْ أَمـَالـْكِي ْبعَبْدَكْ وَاعْطَفْ يَـا سابْغْ النـّْيَـــــــامْ
يـَا بَـدْرْ نْـبَـا مَـنْ الـْغـْتـَـامْ
يَـهْـديـكْ الله لاَ تْعَـذَّبْ قَلْـبِـي قَـصِـيـتْ مَـا كـْفـَــــــــى”.
صاحا، دون سابق اتفاق، في وجهي: “واوّاوْ أَ قلْبي!”. أكمل الشّْريفْ بصوته الرخيم:
“فـَبـْهـَاكْ أَ مَالـْكِـي افـْنِـيـتْ لاَ حَـالَةْ كِـيـفْ حَالـْتِـي
فـَطـْرِيقْ هـْوَاكْ مَا عْيِيتْ حَـتَّـى تَقْضى حَاجْتِـي”.
وضع هشام بقية الأورق أمامه، فسحبتُ منها ورقة، وألقيتها في وسط الحلقة. كانت ورقة الصوطا الحاملة للسيف. بدتْ لي، تحت تأثير المخدر، امرأةً ترمقنا بنظرة هادئة لا تخلو من صرامة، وتدعونا للنزال. أمرني هشام: “العبْ يا صاحبي!”. علق الشّْريفْ: “بل قل له أَشْهِرْ سيفك”. بحثت عبثا عن سيف بين أوراقي، ومددت يدي لأسحب، أو بالأحرى لأَلْعَقَ (على حد التعبير المستعمل في اللعبة) ورقة من الأوراق المتبقية، وقلت بتأفف: “الصوطة المسخوطة!”. ألقى الشّْريفْ ورقة اللاس، فبدت لي شخصا متجسدا في هيأة سيف. ألقى هشام ورقة السيس، معقبا بزهو: “العقْ ورقة أيها المسخوط!”. سحبتُ ورقة وأنا أتخيلني كلبا مد لسانه ليلعق.. قال الشّْريفْ، وهو يلقي بورقة الكابال: “أُطالب”. رأيت في وسط الحلقة فارسا يمتطي حصانا وهو يشهر سيفه، كما لو كان قائد كتيبة. سأله هشام: “بماذا تطالب؟”. أجاب الشّْريفْ وهو يحك ذقنه: “سأمنحكم استراحة من صليل السيوف ونقع الغبار، أنا أطالب بالطبائق”. بدت الخيبة على وجه هشام فيما هو يتفرس في الأوراق التي بين يديه، وعلق: “لقد أخمدت حماسي يا صاحبي، هل رأيت مقاتلا صنديدا يستريح من أهوال المعركة بطبق حساء؟”. قلت له مستعجلا: “العبْ يا صاحبي، أو العقْ مثل كلب!”. سحب ورقة، وعقب: “لقد أنقذك الفارس من حد سيفي، كنت سأجعلك تلعق مرتين”. ألقيتُ ورقة الضوس، رادا عليه بتشف: “أغمد سيف سبعتك في (..)!”. ضحكتُ بصوت عال، وشاركني الشّْريف الضحك، فيما عقب هشام مغتاظا: “الطرح لا زال في بدايته، سنرى من سيضحك أخيرا”. ألقى الشّْريفْ بدوره ورقة ضوس حامل للذهب، فتغير الرمز من الطبائق إلى الذهب…
على إيقاع التراشق بالتعليقات المتبلة بالسخرية والتأمل والتفكه، مضينا في اللعب. كل واحد منا يسعى إلى أن يتخلص من أوراقه ليُتوَّجَ سلطانا يستمتع بحق إصدار الأمر إلى صاحبيه المهزومين. كانت تقلبات الأوراق مثيرة تستنفر الأعصاب. قد يتبقى في راحة يدك ورقتان أو واحدة فقط، فتحسب أن الانتصار أصبح وشيكا، تكفي لعبة أو لعبتان لتفرض سلطتك على الآخرين، لكن الحظ يعاكسك، فلا يواتيك الرمز المطلوب، وتلعق ورقة، فتَعِدُك بتجاوز المأزق، غير أن اللعب ما يلبث أن يتخذ مسارا معاكسا، فيتغير الرمز إثر لعب أحد خصميك، عَبْرَ كابال يطالب برمز جديد، أو عبر ورقة مطابقة تقلب الرمز، و قد يُجبرك خصمك على لعْق ورقة أو ورقتين. ألقى هشام آخر أوراقه، كابالاً، وصاح بسعادة: “أنا السلطان!”. سأله الشّْريفْ وهو ينظر إلى الكابال: “بماذا تطالب مولاي السلطان؟”. جال بنظراته برهة بيننا، يحاول أن يخمن ما يختبئ بين أيدينا من أوراق، وتبادل الغمز مع الشّْريفْ قبل أن يعلن: “أطالب بالزراوط”. لعقتُ ورقة خائبا، فيما ألقى الشّْريفْ ورقة خمسة حاملة للزراوط…
فتح هشام النافذة الوحيدة بالغرفة، ووقف خلفها ينظر إلى الخارج الذي اقتحمتْ آذانَنا أصداءُ أصواته. واصلنا اللعب، وقد زادت تعليقاتنا حدة واستفزازا، كنا منهزمين بالتأكيد، غير أننا كنا نتنافس على أفضل اللقبين المتبقيين، فالمنتصر سيكون بغلا، والمنهزم سيكون حمارا. أشعل الشّْريفْ سيجارة، وراح يدخن بشراهة. أشعلت بدوري سيجارة، وأنا أتطلع إلى الورقة الوحيدة التي تطل من راحة الشّْريفْ. لم يسعفه الحظ، فلعق ورقة، لكن عندما حان دوره مرة أخرى ألقى كابالا حاملا للذهب، وطالب بالسيوف، فسدد إلى صدري طعنة قاتلة. لم يفت هشام أن يعلق، وهو يقف متأملا النتيجة: “يا له من طرح دموي! ابتدأ بصليل السيوف وانتهى بها!”.
سألت هشام: “بماذا يأمر مولانا السلطان؟”. مكث ينظر إليَّ مبتسما والزهو باد على وجهه. قال الشّْريفْ: “احكم عليه بأن يقرأ علينا قصيدة حب!”. قهقه هشام، ورد: “وحده الغرام يعشش في رأسه! سيموت ذات يوم ضحية رهافة قلبه”. رددتُ حانقا: “كِيّةْ اللي قَلْبو خاوي!”. فتضاحك هشام: “آ قلْبي!”. ثم أنشد:
“فَهْواكْ أَ مالْكي فْنيتْ لا حالَةْ كيفْ حالْتي
فَطْريقْ هْواكْ ما عْييتْ حتى تَقْضى حاجْتي”.
تابع الشّْريفْ بصوته الرخيم:
“أَ ما دُوَّزْتْ مْنَ وْقاتْ
كُنْتْ مْغَطّي بْثوبْها
تْسْوى الياقوتْ والثقاتْ
والسعْدْ سْكَامْ منّْها
والكاسْ مْدامْعُه جْراتْ
عْلى الشمعة وْضِيْها”.
كان هشام ينافسني في الاهتمام بأخت الشّْريفْ، لكن على نحو مغاير؛ في غياب الشّْريفْ، كان يحرك شفتيه باشتهاء: “يا لصدرها الشهي برمانتيه النافرتين! ويا لخصرها الناعم الناحل ينادي على ذراع قوية لتطويقه! ويا لاكتناز ربوتها ودفء ما تحتها!”… عديدا من المرات، أشار إلى باب غرفة نومها، وتساءل: “ماذا يوجد خلف ذلك الباب الموصد؟”. ثم أضاف: “حرام أن يقطف غيرنا الثمار الطازجة لذلك الجسد. أَتَعرِفُ أنني ضبطتها يوما بين أحضان رجل في غابة الشباب؟”.
تأكلني الغيرة ممتزجة بالغضب. صورتها في عيني أطهر من أن تُلوِّثها ادعاءاتُ هشام. أقول له، مشتهيا أن أخنقه: “لا تتجَنَّ عليها وأنت في بيتها”.
أمرني أخيرا: “أعد لنا طاجينا لذيذا فوق جمر الفحم بأصابعك الخبيرة”.
بخطى متثاقلة مضيتُ إلى المطبخ. كلما دخلتُه وقفت مبهورا أمسح بنظراتي أشياءه. تتراءى لي أخت الشّْريفْ، بقامتها القصيرة المكتنزة في اعتدال، تمرر إسفنجة مبتلة بمُنظفٍ له رائحة الخزامى على المنضدة الرخامية حيث يستوي الموقد الكهربائي، ورف قارورات التوابل الخشبي، وشبكة الأواني البلاستيكية، والمجلى بصنبوره الأنيق. أتخيلها تتحرك، بهمة، في المساحة الضيقة للمطبخ؛ تفتح دفة من دفات الخزانة الخشبية المعلقة بأعلى الجدار، على امتداد المنضدة الرخامية، تسحب طنجرة ضغط صغيرة، تشللها بالماء وتضعها فوق الفرن، تفتح باب الثلاجة ذات الحجم الصغير، تستخرج من المجمد لحما، تغسله لتضعه في جوف الطنجرة، تصب عليه قليلا من زيت العود، وتُقَطِّع فوقه بصلا، ثم تشعل الموقد. بعد برهة، تستخرج من الخزانة الخشبية الممتدة تحت المنضدة الرخامية حبات طماطم وبطاطس، لتشرع في تقشيرها وتقطيعها… يتابعها خيالي، بمتعة، وهي مستغرقة في تفاصيل أشغال المطبخ، يلفّها جوٌّ يشع نظافة وجمالا، حيث أشعة الشمس الدافئة تغمر الأشياء بالضوء، وتجعل المجلى وصنبورَه الأَلُمِنْيومِيَيْن يتلألآن، وحيث يتناغم اللون الأبيض، لون رخام المنضدة وشبكة الأواني والثلاجة، واللون الشُّكْلاطي، لون الخزانتين الخشبيتين.
أحدث نفسي أن الخطة التي طبقَتْها في تهييء المطبخ، الذي استلمته من شركة العمران أَجْرَدَ قبيحَ المنظر مصنوعاً من مواد رديئة، ستُعممها على باقي غرف الشقة. كانت الغرفة التي نجلس فيها عادية، مفروشة بحاشيات من الإسفنج وزربية حمراء وطاولة. لم تطل لمسة الفخامة بعد المرحاض والحمام ولا الغرفة الصغيرة حيث وُضعتْ حاشيتان ومنضدة صغيرة وملاءات صوفية. لكني موقن من أن غرفة نوم أخت الشّْريفْ، وإن كان بابها موصدا دوما بالمفتاح، مهيأة في أبهى صورة…
لم أستعمل الموقد الكهربائي، رغم ما يثيره في النفس من شعور بلذة البذخ. دلفت إلى الشرفة، أوقدت نارا في فحم المِجْمَر الطيني، قبل أن أعكف على إعداد طاجين من لحم الخروف والخضر. وأثناء ذلك صاحبني طيف أخت الشّْريفْ، بوجهها المدور القمحي البشرة، وفكرت في أني لو أقلعت عن هدر حياتي بين جدران هذه الشقة، وبحثت عن عمل، لأصبحت امرأتي فعلا. بدا الحلم قريب المنال؛ يكفي أن أقوم بالخطوة الأولى الصحيحة، من المستبعد أن ترفض شابا مجازا يطلب يدها على سنة الحلال. لكن ماذا لو كانت تفكر في شخص آخر؟ لو كانت تراني مجرد عاطل، تماما مثل أخيها الذي لم يستكمل دراسته الجامعية، ويحيا عالة عليها، فيما هي تكد صباح مساء، مقابل أجر زهيد، لتوفير لقمة العيش؟
“نوبتك حانت أيها الطباخ!”، نادى عليّ الشّْريفْ.
أنهيت آخر الترتيبات، وضعت الطاجين فوق المِجْمَر الطيني، وعدت إلى الداخل لأتناول جرعتي من الحشيش. انطلقنا في جولة جديدة من لعبة السلطان. واتى الحظ الشّْريفْ، بينما كنت حمارا مرة أخرى. عفا عن هشام، رادا له جميله السابق عليه. شد هشام على يده بحرارة، وقال: “نحن مثال للتحالف البنّاء”. عقبت والغيظ ينهش قلبي: “بل أنتما مثال للتواطؤ الفاضح”. رد عليَّ الشّْريفْ: “كُنْ سَبُعا وافترسني”. ثم أمرني بأداء رقصة الطائر المذبوح، وشغَّل شريط ناس الغيوان. انخرطت في الرقص على إيقاع أغنية “غيرْ خُذوني”:
“غيرْ خُذونييييي
غيرْ خُذونيييييي…”.
حركت جسدي، في البداية، بشكل عشوائي؛ لوحت بيدي يمينا ويسارا، ووقعت بقدمي على الأرض. تغلغل اللحن بكلماته في روحي، رويدا رويدا، فانتظمت حركات جسدي، وأغمضت عيني مسافرا مع الأغنية إلى مكامني جرحي. رددت الكلمات:
“آللهْ بابا جاوْبْني
عْلاشْ أنا ضْحيةْ للصمتْ
آللهْ بابا جاوْبْني
عْلاشْ سْفينتي ما وصْلَتْ”.
رحت أدور حول نفسي، يداي ممدودتان أفقياً إلى جانبي، اليمنى تشير إلى الأعلى واليسرى إلى الأسفل، تماما مثلما يرقص دراويش المولوية. في غمرة الدوران، تراءى لي طالب ينحشر يوميا وسط زحمة الأجساد، في حافلة متقادمة، ذهابا وإيابا، لكي لا تفوته الدروس، يكابد عناء الفهم والبحث، يشارك في مظاهرات الطلاب، ينتزع النجاح سنة بعد أخرى، ليتوج مساره الدراسي ببحث حول البعد النفسي في القصة القصيرة عند يوسف إدريس. رأيته يكاد يطير سعادة وهو يتملى شهادة الإجازة في الآداب، ثم رأيت بريق الأمل يخبو في عينيه، والخيبة والحسرة والرثاء تفيض بها ردود فعل والديه وأقربائه، إثر انسداد الآفاق في وجهه. سقطت فجأة على الأرض، دائخا والدمع يسيل من قلبي المقروح، لا من عيني. وعندما استرددت وعيي، شعرت بلطمات طفيفة على خدي، وكلمات الشّْريفْ تقرع أذني: “ما لك أحمودة؟ أفقْ أفق، بم تشعر؟ هل تعرف من أنا؟…”.
خيم الظلام على الغرفة، فأشعل هشام الضوء. بدأنا طرحا جديدا، فلم يسعفني الحظ إلا بدرجة بغل. كنت أشرد من حين لآخر، مشغولا بالتفكير في أخت الشّْريفْ، وفي مباشرة لعب الطرح الحقيقي، طرح الحياة. علق صاحباي ضاحكين، مرارا، على سهوي واقتراف أخطاء فادحة في اللعب. تربع هشام مرة أخرى على عرش السلطان، فأصدر أمره بالعفو على الشّْريفْ، وأمرني بنبرة مفعمة سخرية وعجرفة: “ستسدد ثمن الطاجين، بغلي العزيز!”.
من أين سأجلب المال؟ لقد استنفدت عطف أمي علي. كل يوم، تمدني بمصروف الجيب، تقتطعه بالكاد مما تقتصده من مصاريف البيت. تفعل ذلك سرا، دون علم أبي الذي يدعوني، كلما وقعت عينه عليّ، إلى الانضمام إلى حانوته بالسوق لأباشر التجارة بدل التسكع الخاوي. فاق تواطؤ هشام مع الشّْريفْ قدرتي على الاحتمال، فانفجرت: “في القضية إن.. تصرفك يدل على أنك تشتري رضاه بسبب زلتك بالأمس”.
“ماذا تعني أيها البغل؟”.
“أنسيت أنك أمرت الشّْريفْ، أمس، بفتح باب الغرفة الموصد؟”.
“وماذا في هذا الأمر؟”.
“أَلَمْ يَثُرْ غضبُه حين وجهتَ إليه الأمر؟”.
تدخل الشّْريفْ: “عادي جدا، هل تريد أن أخلع ثيابي لتتفرج على عريي؟”.
قلت: “هذا هو تحديدا سبب تواطؤه اليوم معك”.
رد هشام: “أنت تهذي أيها البغل!”.
قلت: “بل هي الحقيقة عارية، مولاي السلطان. لقد تجاوزت حدودك بالأمس، جرحت إحساس صاحبنا، وفضحت، في الآن نفسه، دون أن تشعر، ما يعتمل في دواخلك”.
احتد هشام: “هل تدرك ما تتلفظ به، أم أن الهزيمة أعمت بصيرتك؟”.
“إن كنت تملك الجرأة، فقل لنا، إذن، لماذا رغبت في فتح الباب الموصد، باب غرفة أخت الشّْريفْ؟”.
لبث الشّْريفْ واجما يتابع حوارنا.
أجاب هشام: “الأسرار طعم الوجود، وكل سر يولد رغبة الإنسان في فضه”.
“بل قل إنك ترغب في رؤية سريرها لتغذي استيهاماتك”.
زعق الشّْريفْ: “كفى أيها الأحمقان، هل لم يبق أمامكما شيء تتشاجران حوله سوى سرير أختي؟”.
رد هشام: “هو من يسقط علي خياله المريض”.
لم أدر كيف فقدت السيطرة على أعصابي، فانقضضت عليه، شادا على خناقه. فصل الشّْريفْ بيننا، صائحا: “مخجل ما تفعلانه، كفا عن حماقتكما”.
كأنما أيقظتني صيحته من عمانا، تسمّرتُ في مكاني مطرقا برأسي. خطا الشّْريفْ باتجاه الغرفة الموصدة، فتح بابها، ونادى علينا: “تعالا لتشبعا فضولكما”. لم نتزحزح من مكاننا، تضاعف إحساسي بالخزي. لكنه أَلحَّ في النداء، وأردف: “هذا فراق بيني وبينكما إن لم تأتيا”. أذعنا لطلبه، فدخلنا وراءه الغرفة. كانت غارقة في الظلام، وحين أشعل الضوء اتسعت أحداقنا دهشةً وخيبة: كانت عارية تماما إلا من مرآة مستطيلة انتصبت أمام الجدار ذي النافذة المغلقة.
تذكرت الطاجين فهرولت باتجاه الشرفة، كان الهواء مضمخا برائحة الاحتراق. رفعت غطاء الطاجين، وعدت إليهما مهرولا.
“احترق طاجيننا!”، صحتُ في تذمر، وقد أحسست بالبرد يخترق أضلُعي.