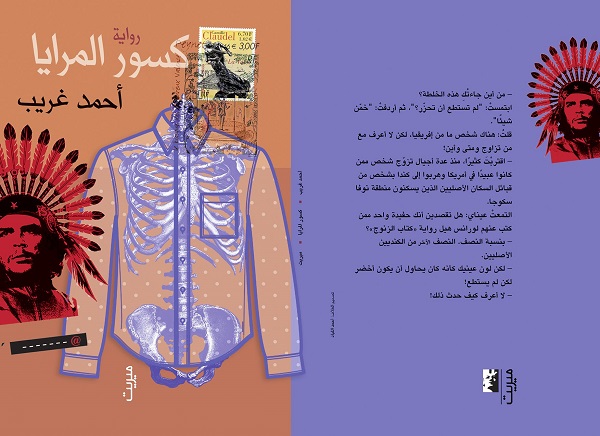– “هيه يا زينب هتعملي بالفلوس إيه.”
أردّ بأنني سأشتري جوز حمام وسأسميه سعيد وسميحة. فتضحك وتطلب من المصور المصري المرتدي جيليه به مائة جيب أنْ يأخذ صورة لي لوحدي.
غية الحمام التي أعيش فيها هذه فوق العمارة القديمة في ذلك الحي العريق الذي يسكن فيه الخواجات لم تكن مسكونة حتى اكتشفتها بالصدفة، في ليلة شتوية انهمر فيها المطر بقسوة لا يعلمها إلا من يعيش بلا سقف وبدون عشاء مثلي. كان المطر ينهمر ليغرق القاهرة التي مات قلبها عندما شاهدت الشاب الذي كان يخرج من البار القديم ويمشي تحت المطر منتشيًا ويغني … “يمامة بيضة ومنين أجيبها طارت يا نينه عند صاحبها…”. مشيت وراءه أسمع أغنيته وأبكي من نشوته ومن شيء لا أعرفه. و الشاب الملئ بوجد و محبة غامضة توقف و ربت على رأسى قائلا :
“عايزة حاجة يا شاطرة؟”
“أغنيتك حلوة قوي يا أستاذ “
“أنت بتباتي في الشارع؟”
فهززت بنعم رأسي، فأخذني إلى غية الحمام المهجورة.
هذه عمارتنا، صحيح أن والدي أجرها كلها ونحن لا نسكن فيها ولكن إن كلمك أحد فقولي له إنَّ ابن صاحب العمارة هو من أجلسني هنا.
ومن اليوم الأول وأنا أخلع قميصي الأحمر لأثبته على تلك العصا الطويلة وأطلع على سطح العشة وألوح بالعلم وأزم شفتي السفلى وأصفر. ويومًا بعد يوم بدأت الحمامات تهبط. وفي الليل أحكي لها حكايات المناديل الورقية التي ألف بها على المقاهي والرجال الطيبين الذين يشترون المناديل ويعطوني الباقي، وأغني لها… ” يمامة بيضة.”
اليوم اكتشفت بقعة دم صغيرة في البنطلون. فاتن “الهبلة” كما يسميها العيال أخبرتني وهي ترفع ابنها الرضيع الذي بلا اسم إلى صدرها :-
“كبرت يا أم الحمام وبقيتي ست، خدي بالك يا بت، محدش يلمسك وإلا هتجيبي لنفسك مصيبة زي اللي على إيدي.”
اليوم أيضًا لم يعد سعيد وسميحة فبكيت، وأخرجت زجاجة “المنوكير” التي بلون الدم الذي في بنطلوني لأضعه على أظافرى.
في قسم الشرطة لم تسقط دموعي بعد الصفعة التي صوبها المخبر العملاق إلي وجهي، لأتكوم بعدها مع كومة اللحم البشرية المكونة من أطفال في نفس عمري يشم أحدهم “الكلة” في علبة بيبسي فارغة. يشير علي المخبر محدثًا الباشا الضابط :
“يا باشا دي البنت اللي بتخوف الخواجات في العمارة اللي في جاردن سيتي.”
أنا لا يهمني ماذا سيفعلون بنا في هذا الممر القذر الذي سنبيت فيه، ولا حتى يقلقني أصابع العيال المستغلين لتكومنا والعابثة في جسدي، يشغلني فقط أين ذهب سعيد وسميحة. نادى علي الضابط وسألني عمن سمح لي أن أسكن في غية الحمام؟ لأرد بأنه ابن صاحب العمارة، فيقول كلام لا أفهمه، ولكني أشعر بأنه يعرفه، وبأنه يقول عنه أنه شيوعي وكافر، وبأنه بتاع نسوان، فأنظر إلى الضابط لأسأله:
“هو أنت يا باشا تعرف مكان سعيد وسميحة؟”
لتنزل يد المخبر على وجهي. فأجدني أعود للأصابع التي تنتظر جسدي الصغير وأشعر بالدم يتدفق بين رجلي من جديد. في الصباح كنت أتسلق السلم الخشبي الصاعد لغية الحمام متجاهلة كل تحذيرات المخبر والبيه الضابط مدفوعة بهاجس واحد فقط، سعيد وسميحة. وجدت رجالا يزيلون غية الحمام التي لا أعرف غيرها بيتًا، و”الخوجاية” العجوز التي تسكن في الدور السابع تنظر إلي وتبتسم ابتسامة شماتة و انتصار، منتشية بمنظر الحمام يطير مفزوعًا. ساعتها عرفت أنّ سعيد وسميحة لن يعودا أبدًا. فوقفت على سور العمارة القديمة والواقعة في جاردن سيتي ولا يسكن معظمها إلا الخواجات. فردت يدي وانطلقت إلى السماء الزرقاء الواسعة أبحث عن سعيد وسميحة.