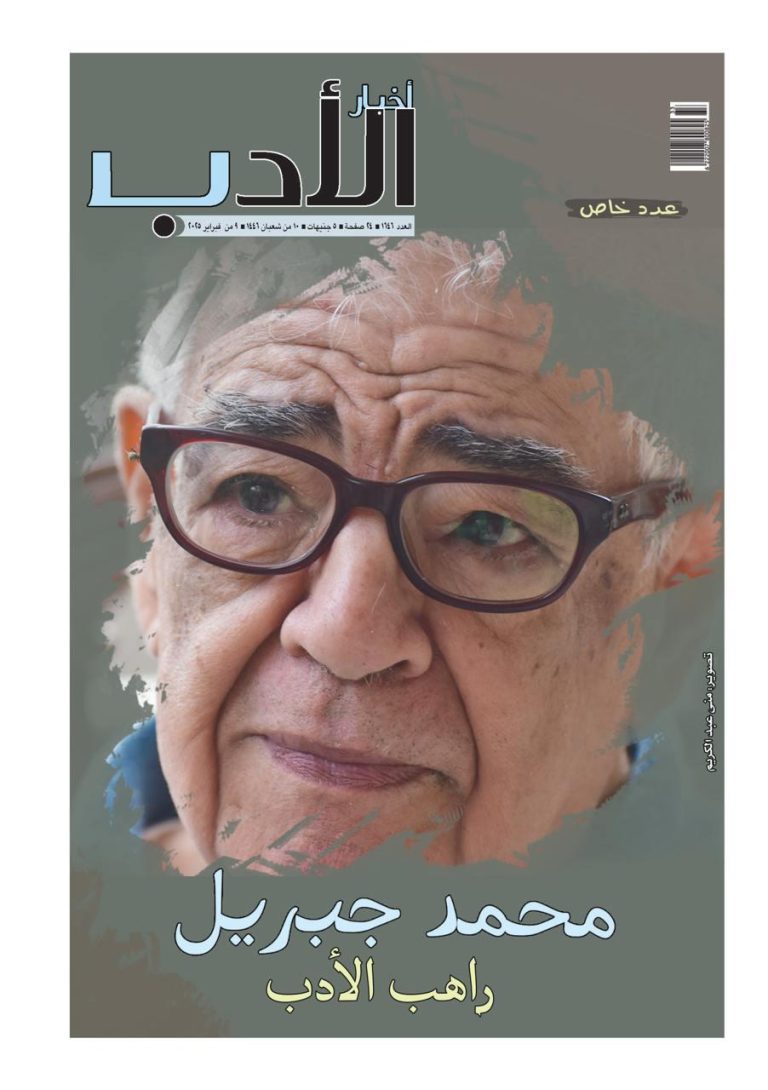عماد غزالي
(1)
كلما حاولت الالتفات إلى الخلف، وتأمل ما مضى، أجد القلق يكاد يكون العنصر الحاكم في تشكيل تجربتي الشعرية. تلك التجربة التي كانت طوال الوقت تبحث عن مرتكزات لها، لكنها لم تكن تطمئن إلى أيّ من هذه المرتكزات وقتا طويلا. الشيء الوحيد الذي – ربما – لم يتغير هو سعيي إلى المتعة وفراري من الألم، كأي إنسان على وجه الأرض.
كنت ولم أزل قارئا هاويا، أطارد لحظات الجمال والنشوة عبر ما أقرأ، وكنت ولم أزل شاعرا هاويا أحاول اعتصار الألم أو تفتيته، أجتهد لأحفظ لذاتي شيئا من اتزانها باقتناص لحظة الكتابة المراوغة. فإذا تحقق القنص، تبدّل العالم في عينيّ سويعاتٍ قليلة، وأصبحت الأشياء ومفردات الطبيعة أعمق ألوانا وأغزر وجودا، ولمست من نفسي حدبا وارفا على الآخرين.
أما القلق، فدائما ما تعلق بالطريقة التي أفكر بها وأُعمل خيالي، وفي رؤيتي للكتابة الإبداعية ذاتها، وفي القدرة على رصد المتحقق قياسا على ما كنتُ أظنه قائما في نفسي قبل الكتابة. مثل ذلك الرصد هيمن على ذاتي زمنا ليس بالقليل.
في البداية، لم أفطن مطلقا إلى وقوعي في شرك. كنت أبحث في القصيدة عما كنت أفكر فيه قبلها، وعن الهواجس والدفقات الشعورية الحارة، وعما كنت أريد قوله للحبيبة مثلا. كان يصيبني الإحباط الشديد عندما أجد أنني لم أقل أشياء كثيرة كنت أريدها، وأن أشياء مختلفة جرى بها قلمي لحظة الكتابة. كانت فكرة البوح والإفضاء هي المهيمنة على عقلي في تلك المرحلة المبكرة (المرحلة الثانوية والشطر الأول من المرحلة الجامعية).
تنقلت بين أشكال من الكتابة والتعبير (الرسم، القصة القصيرة، الشعر)، وخضت مطالعات نهمة توزعت بين الرواية والشعر والتاريخ والكتابات الفكرية والدينية، حتى وصلت إلى شعر “ناجي” (والشعر الرومانسي بوجه عام)، وبدأ الشعر يوجّهني إلى الحياة – وهذه علاقة معكوسة بالطبع – فأخذت أبحث عن حبيبة (صنعتُ بيدي – كما فعل بجماليون – حبيباتٍ كثيرات من خلق توهُّماتي. لكن الحقيقة – حين تنفخ الروحَ في إحداهنّ – كانت تصعقني بالمفارقة. ضلت عيناي بحثا عن أثرٍ للوهم في الجسد الحيّ، فعجزتُ عن رؤية المحبة الحقة، حين جاءتني من بعيدٍ ذات يوم، لكنها عبرتني دون أن تشعر بها عيناي الزائغتان).
بحثتُ أيضا عن سرّ ذلك النغم السحري المنبعث من القصيدة الكلاسيكية – كنت لا أعرف غيرها في ذلك الوقت – فدرست عروض الشعر العربي من مصدر تيسر لي بعد جهد، وأخذت أزهو بذلك أيّ زهو.
في كلية الهندسة، جامعة عين شمس، أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، تفتحت مداركي على حياة جديدة وبشر كثيرين وكتابات متنوعة وأشكال شعرية أخرى، حدّت كثيرا من زهوي الشخصي بما أمتلكه من مهارة. صدمني أن أجد بين زملائي شعراء يكتبون شعرا حقيقيا وموقّعا دون أن يدرسوا عروضا أو يوجعوا أدمغتهم بما أعيه من مصطلحات ذلك العلم المعقد، والذي واجهته بكل ما أملك من تفوق في الرياضيات لأتمكن من استيعابه.
بدأت تطرق أذني أسماء كثيرة لشعراء لا أعرف عنهم شيئا، وبدأ الحراك السياسي في محيط الجامعة يؤثر على وعيي، خاصة ذلك الصراع المحتدم بين تيارات اليسار المختلفة والتيار الديني الأصولي، ذلك الصراع الذي كانت ذروته مقتل الرئيس السادات مع بدء العام الدراسي الثاني لي في كليتي.
لم تكن لي بطولة تُذكر، وأنا أعاصر تلك الأحداث، كنت مراقبا ومتفرجا فحسب. فالصراعات التي احتدمت بداخلي كانت تكفيني وتزيد: انتقالي من الحي الشعبي الفوضوي في حدائق القبة إلى أفنان الكلية وأفنيتها وقاعاتها الواسعة، اصطدامي بالأنثى واقترابي منها زميلة وصديقة وربما حبيبة، مع عدم قدرتي على التعامل معها ككيان من دم ولحم، تمزقي الداخلي المتصاعد بين مكنون ذاتي وتوجهها الأدبي المتنامي وطبيعة والتزامات الدراسة العلمية والهندسية الثقيلة، الاشتباك الحاد مع خجلي وتلعثمي الطفوليين، ازدياد اضطرام الخيالات والمشاعر المكبوتة جراء مواجهة عالمي الجديد المجهول، وأخيرا الحيوية الجمة التي يضج بها ذلك العالم متمثلة في العقول النابضة حولي بثقافات ومشارب متعددة ومتداخلة.
لم يكن لصلابتي أن تستمر طويلا. وقبل العام الجامعي الأخير كانت قد جرّحتني التجارب العاطفية المثالية، وكنت قد نهلت الكثير من الثقافة الأدبية والشعرية، وأصبحت ملما إلى حد ما بالتجربة الشعرية المعاصرة وصولا إلى جيل السبعينيات، الذي كان يحاول فرض حضوره في ذلك الوقت، بعد أن اقتصرت بداياته الأولى على تجارب الماستر المحدودة.
(2)
مع العام الجامعي الأخير، بدأت أشعر بأن تجربتي الشعرية – التي صارت تفعيلية – قد دخلت طور التشكيل. وأخذ مفهوم البوح يتلاشى تدريجيا من أعماقي. وفي نهايات العام ذاته (1985) ظهرت قصائدي الأولى المنشورة في “القاهرة” ثم “إبداع” و”الشعر”، وقُدّم بعضها عبر أثير البرنامج الثاني بالإذاعة.
لكن هذا التشكيل لم يكن حرا تماما، فقد كنت أمر بمرحلة التمثل لكل التجارب الشعرية السابقة قريبة العهد: عبد الصبور وأمل دنقل وحجازي ونزار والسياب ومطر وفاروق شوشة وأبو سنة وفتحي سعيد – الذي عرفته عن قرب وساعدني كثيرا على تخطي رهبة البداية – ثم محمود درويش الذي طالت وقفتي مع شعره. كان طبيعيا أن تتردد أصوات هؤلاء الشعراء في قصائد “أغنية أولى”، الذي قدمته إلى هيئة الكتاب عام 1986 ونشر أوائل 1990، وأن يؤثر فيّ صوت درويش ويمتد إلى أبعد من ذلك بخطوة.
ثم حدث أن التفتُّ إلى التجارب السبعينية – خاصة عبر مجلة إبداع – واقتربت من “محمود نسيم”، أحد شعراء ذلك الجيل، وكان يتميز بروح متوثبة وشخصية دمثة. لم ألبث قليلا، حتى شعرت بحاجز حقيقي بين ذاتي وهذه العوالم اللغوية المعقدة، كما لم ترحني الصيحات الساخطة والتنابذ الشديد ورفض الإقرار بحق الأسلاف من الشعراء في الحد الأدنى من التوقير أو العرفان. كانوا في ذلك الوقت عاجزين عن ممارسة فن الاختلاف. كما أن الذهنية الواضحة التي طغت على التجربة، والتعمد الفاضح في اختراق ما سُمِّي بالتابوهات، ذلك الطريق السهل للفت الأنظار والإعلان المراهق عن الذات، كل ذلك نفرني تدريجيا من شعرية السبعينيات، وإن لم يحل ذلك دون انجذابي للمواهب الحقيقية بينهم، ومحاولتي كشف وامتصاص العناصر الإيجابية في تلك التجربة. وربما أرى الآن أن إيماني بمبدأ بسيط وأوّلي، وهو ضرورة أن يحقق ما ننتجه من شعر التواصل والتأثير، هو الذي حدّ كثيرا من انجرافي إلى تلك الموجة، التي رأيتُ فيها عزلة للشعر وإلغاء لدوره، كما وجدت فيها ميلا شديدا إلى التجريد وتحويل النص إلى أبنية لغوية مغلقة تعتمد على الألاعيب الذهنية والمعجمية، وهروبا من الحياة وخصوبتها وتحولاتها.
لم ينقذني الوعي بمبدأ التشكيل من المساءلة والقياس، وإن انتقلت بهما إلى مستوى أعلى. أصبحت القصيدة بالنسبة لي – منذ أوائل التسعينيات – عملا صعبا أتأهب له طويلا، فأمسك بالومضات وطرَقات الشعور وانهمارات الصور فترات طويلة قبل أن أسمح لها أو تسمح لي بالتدفق. أصبحتُ أحاول أن تقدم القصيدة عالما متشابكا له علاقاته الخاصة، من غير أن تنفصل تماما عن العالم الحقيقي. كأنني كنت أعقد مصالحة عميقة بين ما أنجزته قصيدة الريادة (في الخمسينيات والستينيات) وبعض ما رأيته إيجابيا في التجربة السبعينية. لم تعد الأرض التي أتحرك عليها مفارقة لمخاضات الحياة وتعقيداتها الصعبة (مثلما كانت في عزلة أسوار الجامعة وما تلاها بقليل). غدوت أخوض معاركي كإنسان مع الواقع لأحفر لنفسي موضع قدم صغير فيه، فيما كانت كل المواضعات – مصريا وعربيا- تتبدل وتتحول مع غزو العراق للكويت ومشاركة القوات المصرية لقوات التحالف الأورو- أمريكي. سقطت القومية العربية وتم قبرها، وأصبح الاتحاد السوفييتي شيئا من الماضي وتفتت إلى دويلات، وانهار سور برلين. سارت أوروبا في طريق التوحد، وسرنا كبلدان عربية باتجاه التشرذم. وشيئا فشيئا أخذ عالم جديد يتشكل، عالم القطب الواحد والشركات العابرة للجنسيات، عالم الصورة والكمبيوتر والإنترنت والهواتف المحمولة، العالم التخيلي الافتراضي، واستعصى العالم الحقيقي على الفهم والتصور. سقط إنسان هذه الأرض – الذي لا يشارك في صنع ذلك العالم الجديد على أي نحو – في وهدة عميقة من الحيرة والشك وفقدان اليقين.
(3)
كانت التسعينيات فترة قلقة وخصبة أيضا من حياتي وتجربتي. قدمت في بدايتها ديوانين هما: أغنية أولى 1990، ومكتوب على باب القصيدة 1991. ثم بدأت أترجم الشعر عن الإنجليزية، مهتما أكثر بالشعر الأيرلندي والأمريكي، ومركزا على الأسماء المجهولة والتي تكاد تكون مجايلة لي. كانت هذه الخطوة مهمة وكاشفة في ذات الوقت، وضعت يدي للمرة الأولى على حقيقة أن الشعر يكمن في البنية والصورة وروح السرد وزاوية النظر وبراعة الرصد والالتقاط، وأن ذلك كله يخلق إيقاعا للنص أعمق بكثير من ذلك الإيقاع الخارجي المعياري والذي يتمثل في التفعيلة. كنت أترجم القصائد نثرا لقناعتي أن عملية النظم لو تمت على الترجمة فستصبح اجتراء شديدا، بل جريمة في حق النص المترجم. فالنظم يستلزم التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والإضافة واختيار المرادفات المتسقة معه دون التزام بالمفردة الأصلية. وضعتني تلك التجربة في قلب شعرية النثر، ووجدت نفسي أكتب نصوصا نثرية للمرة الأولى.
ولا يمكنني أن أغفل الأثر العميق لعلاقتي بصديقين: القاص والمترجم “سيد عبد الخالق” ، الذي ترك برحيله ندبة يانعة تستعصي على الذبول. كان سيد محبا وراويا للشعر، يردد دائما مأثورات شعرية ينتقيها بنفسه لشعراء كبار أو من إبداع أصدقائه، كما كان مولعا بالإنجليزية. فقادني إلى الترجمة، ثم إلى الالتفات لجماليات الشعر العميقة دون تركيز حاد على الإيقاع. ثم “عاطف عبد العزيز” الذي انطلق بعد ديوانه التفعيلي الأول إلى فضاء قصيدة النثر دون تردد. فكانت حواراتنا المستمرة مجازا لي إلى مفاهيم جمالية جديدة.
لكن علاقتي العميقة بالتراث الشعري وارتباطي باللغة الشعرية السامقة في مراحلي الأولى، كل هذا مثّل عائقا حقيقيا لي وأبطأ من خطواتي باتجاه قصيدة النثر. ظلت بداخلي أوهام عدة مرتبطة بمحاولة تحقيق معادلة صعبة وهي اقتناص جماليات النثر وتخصيب أشكال شعرية أخرى بها، كما نجح في ذلك سعدي يوسف ومحمود درويش في دواوينه الأخيرة. ظللت منذ عام 1993 وحتى أعوام ثلاثة مضت أزاوج بين قصيدة النثر وقصيدة التفعيلة، وكان ديواني الثالث “فضاءات أخرى للطائر الضليل” الصادر في 1999 حاملا لتلك الازدواجية على مستوى الشكل. لكنني أرى أنه يمثل البداية الحقيقية لطرح صوتي الخاص منفلتا من الاشتباك مع أي أصوات شعرية أخرى. وهو كما يطرح هذه الخصوصية يقدم أيضا الملامح الأساسية لتجربتي مثل تعدد الروافد المكونة للصوت والتقاطع مع التراث الشعري البعيد والقريب، وافتراع لغة شعرية تسعى إلى التجدد وملامسة الأشياء بدينامية لا تفقدها أصالتها أو تسقطها في أيّ حس تغريبي.
(4)
قادتني تحولات اللغة الشعرية، واكتسابي التدريجي للحساسية الجمالية الخاصة بقصيدة النثر إلى تأملات خاصة في مفهوم المجاز الشعري، وكيف يمكن تخليصه من التجريدية والذهنية البغيضة. عاونتني القراءات الفلسفية حينما طالعت عرضا شائقا لفلسفة “ديفيد هيوم” للمفكر الراحل “زكي نجيب محمود”. كان هيوم يفرق بين المدرك الحسي وصورته في الذهن، فيسمي المدرك الحسي: الانطباع، أما صورته في الذهن فيسميها: الفكرة. ويقسم بذلك الإدراكات العقلية إلى “الانطباعات الحسية والشعورية” وهي الأكثر وضوحا والأقوى أثرا لأنها ناتجة عن التجارب والخبرات المباشرة، ثم “الأفكار” وهي الأقل وضوحا والأضعف أثرا لأننا نستعيدها على مسافة من الانطباعات القوية. أما الأفكار التي لا تستند إلى أي انطباعات ناجمة عن التجارب والخبرات الحسية والشعورية فهي ليست أفكارا على الإطلاق ولا يُعتد بها.
تأملت كثيرا في هذه الفكرة الفلسفية الناصعة التي مثلت الجذر العميق للوضعية المنطقية التي اجتاحت التفكير الفلسفي، فوجدت فيها وجها جماليا جاذبا، وبدأت أدرك لماذا أصبحت أنفر من تلك النصوص التي تراكم المجازات بآلية شديدة، ولا يراعي كاتبوها وجود خيط شفيف من الانطباعات أو الأفكار التي يمكن ردها إلى الخبرات النابضة الحقيقية وإلى الحواس واللحم والدم. وهذا اللون من الكتابة الشعرية هو الناتج من التقليب في النصوص والمعاجم واللهاث وراء التوليد البلاغي البارد وتدويره، وتقديم مهارة ذهنية لا يمكنها أن تنفخ روحا في أي كتلة كلامية.
من تلك النقطة، بدأ يتسلل إلى نفسي الوعي بالجوهر العميق لجماليات القصيدة الجديدة. كل مجاز لا أجد بين طرفيه تلك العلاقة التي تربط بين الخبرة الحسية أو الشعورية المباشرة والمغزى الجمالي أو الشعري أو الرؤيوي أصبحتُ أعتبره استهلاكا وإعداما للكلام، وتفريغا للنص من كل شعرية محتملة.
(5)
في ديواني الرابع “ظل ليس لك” – صدر في 2004- رهانٌ على كسر الرتابة التي وصلت إليها قصيدة التفعيلة، وانعكاسٌ ما لتأملاتي السابقة في مفهوم المجاز الشعري. هناك أيضا تجربة في تفتيت الوحدة التفعيلية والاستفادة من تداخل الدوائر العروضية في الانتقال الحر الذي يستهدف الحس النثري الخافت دون الخروج على العروض كلية. في ذلك الديوان أيضا نص طويل ذو طابع درامي: “حارس البستان”، يقدم محاولة لتجاوز مأزق الشكل بالمزج بين النثري والتفعيلي والمراوحة بين الإيقاعات العروضية داخل الأجزاء النصية الموقعة.
كتبتُ “ظل ليس لك” بالتوازي مع قصائد النثر التي شكلت ديوان “صيد فاسد” – صدر هذا العام، 2009، ذلك التزامن يكشف عن الأزمة العميقة التي كنت أعيشها، والتي ساعدتني على التأكد من أن الشكل يحمل معه قيما جمالية وبلاغية غير منفصلة عنه. فعلى الرغم من تقارب العالم الشعوري في الديوانين فإن الشكل الشعري فصل بينهما تماما، وأحدث ما يمكن تسميته باختلاف الرؤية. فديوان “صيد فاسد” يقدم بلغته وتشكيله وأبنيته شعريةً تنتمي إلى اللحظة الراهنة، دون أن يفقد قدرته على الإيحاء بالجذور والمكونات الخاصة لكاتبه.
(6)
كان عليّ – دون أن أدري لماذا – أن أُخرج كلّ الطاقات الغنائية الكامنة بداخلي دفعة واحدة، لأتخلص منها ربما للأبد. كان ذلك مع بدايات 2004. انتابتني حالة من الاعتقاد أن كثيرا من النماذج النثرية التي يقدمها بعض الشعراء ينضح بالركاكة، وبفقر اللغة، بالإضافة إلى العجز عن تقديم حالة شعرية مقنعة. كما أخذت أعتقد أن الإطار الكلاسيكي – العمودي – لم يفصح عن كل مكنوناته، وأنه بتعامل جمالي وفني مختلف قد يكون بمقدوره النطق بلغة وصورة وأبنية جديدة. هكذا كُتِبت قصائد “لا تجرح الأبيض” التي تمثل اشتباكا مع المخزون التراثي الضخم القابع بداخلي ومحاولةً لتفجيره عبر مجموعة من القصائد التي تتناص مع قصائد معروفة في الشعر العربي قديما وحديثا، مع إحداث الانحراف الفني الذي يقود السياق إلى أفق آني متحرك. كما حاولت استكشاف مواقع الهمس والنثرية داخل هذه البنية الصلبة بعد تفكيكها، معتمدا على البحور المركبة والمهجورة.
حين عدتُ إلى القصيدة العمودية إذن، كنت أحاول تفكيكها من الداخل، لذا فإنني أرى أنها مغامرة جمالية مشروعة وليست ارتدادا لنموذج كلاسيكي، هي محاولة اكتشاف وتوظيف فني وتسريب لشفرة شعر الحداثة إلى الإطار الكلاسيكي، وهي حالة خاصة جدا، خرجت منها مباشرة إلى استكمال مشروعي الذي تركّز – منذ أواخر 2006 وإلى الآن – في قصيدة النثر.
(7)
في 2008 صدر لي ديوان: “المكان بخفة”، وهو يمثل – بالإضافة إلى “صيد فاسد” – المرحلة الفنية الأخيرة والمتصلة إلى الآن. وهذه المرحلة تجسّد تخلصي الكامل من مشكلة الشكل الشعري. هناك أدوات تشكيلية وبلاغية جديدة تولد مع هذه القصائد النثرية، وموسيقى وإيقاعات فياضة تحتاج إلى الإنصات فحسب، وإلى التخلّص من الوهم العروضي الذي يعتبره البعض من المسلمات.
قصيدتي في هذه المرحلة تشكيلٌ في المقام الأول ومحاولة للقبض على اللحظات الهاربة ومواجهة فنية لقبح الواقع استنادا إلى كلّ ما هو شخصي ووثيق الصلة بالذات دون الاتكاء على أي يقين زائف. أصبحتُ أرى أن قصيدة النثر التي تستحق هذا المسمَّى غنية موسيقيا، لأنها تستثمر كل الإيقاعات الخليلية المعروفة بعد تفكيكها وإعادة تركيبها، لتنتج ما لا نهاية له من الاحتمالات الموسيقية، وهي تثري بذلك الإيقاع الخليلي ولا تعصف به. لكن ذلك كله لا يحول بيني وتذوق الجمال الشعري وعمق التجربة في أي شكل آخر، فقد راكمت عبر رحلتي خبرة جمالية، تجعلني أبحث باستمرار عن شعرية النص لا عن شكله.
(8)
أنا واحد من ذلك الجيل الذي يطلقون عليه “جيل الثمانينيات” ، وسواء أكانت تلك التسمية دقيقة أم لا، فإنه يمكنني القول إن هذا الجيل استطاع التواصل مع النماذج البارزة للشعرية العربية الجديدة منذ جيل الريادة مرورا بالأجيال التالية، وحاول تجاوز المأزق الذي وصلت إليه القصيدة في مصر على أيدي شعراء السبعينيات، وحالة التوتر التي سببوها بطبيعتهم الهجومية الحادة، بالإضافة إلى النموذج الشعري المغلق الذي قدموه، فتسبب مع عوامل اجتماعية وثقافية وسياسية أخرى في عزلة تامة للشعر وانفصال حاد بينه وبين المتلقي.
جاء جيل الثمانينيات وطالع هذا المشهد فسعى إلى تجاوزه عبر منجز إبداعي بدأ بإحداث عملية التواصل التي أشرت إليها، إذ نجد القصيدة الثمانينية تطويرا حقيقيا للمنجز الشعري في الخمسينيات والستينيات وليست رفضا باترا له، كما أنها استفادت من الجوانب التي رأت أنها إيجابية في التجربة السبعينية، فالشاعر الثمانيني – على الأغلب – متواصل مع آبائه والأجيال السابقة عليه.
ويعود لعدد من الأصوات المهمة في هذا الجيل التطوير الجذري الذي حدث بالاتجاه إلى قصيدة النثر التي تكاد تتسيد المشهد الآن. لم يكن ذلك التحول شكليا، بل كان مصحوبا بتغييرات شاملة في بنية القصيدة وتشكيلها وجمالياتها، ابتعادا بها عن الإنشاد والبلاغة المألوفة والتحليق الصوفي والمجاز اللغوي الآلي، وصولا إلى بلاغة جديدة تقدم الشاعر الفرد والإنسان البسيط بتفاصيل عالمه وتجاربه الخاصة عبر لغة سردية وصور بصرية تتميز بدقة تكوين المشهد. أصبحت الصورة جزءا من عالم متكامل تقدمه القصيدة لتومئ إلى مرماها بما يقارب مفهوم الكنائية، لذا أسميها الصورة الكنائية. كما تقدّم على يد هؤلاء الشعراء لونٌ من السرد الشعري الذي استفاد كثيرا من تقنيات السينما والرواية الحديثة والفن التشكيلي في بعض النماذج ووصل إلى درجة كبيرة من النضج الآن.
(9)
إنّ تركيز جيلنا على تحقيق جدارته واختلافه عبر إنجاح تجربة قصيدة النثر وتأكيد اقترابها يوما فآخر من ذائقة شريحة من المتلقين آخذة في الاتساع، لا يجب أن يُنسينا أن انتصارنا للجمال وللقيمة الإبداعية مُقدَّم على الانتصار للشكل، وأن انحيازنا يجب أن يكون دائما باتجاه الجمال والقيمة.
وإذا كنا نؤمن بأن حساسية النثر هي القادرة على التعبير عن روح اللحظة الراهنة فلا يجب أن يفوتنا أن الواقع سريع التغير، وأن القصيدة تموت في اللحظة التي تعجز فيها عن الاستجابة لإيقاع تحولات هذا الواقع، فتنتهي إلى عمود جديد له وصفة محددة وقوالب سابقة التجهيز، وهو في تصوري خطر كبير ينبغي التنبه له.
أما النقاد، فلم يمنحوا أنفسهم وقتا ليتأملوا الفوارق الظاهرة بين أنماط قصيدة النثر المصرية المطروحة الآن، وأيضا الفوارق بين قصيدة النثر المصرية ونظيرتها العربية. كما لم يركز أحد على بنية هذه النصوص وما يستحق منها مسمَّى القصيدة وما لا يزيد منها على كونه خاطرة أو كتابة مفتوحة.
ما أريد أن أطرحه هنا هو مفهوم خبرة الكتابة، واكتناز ذات الشاعر بجماليات متعددة الطبقات، وتمثّله لروح وجوهر التراث العربي عبر نماذجه الشعرية العليا. ليس من المعقول أن تطغى على التجربة نماذج مغتربة في روحها وفي خيالها وفي لسانها، وليس من المتصوَّر ألا يمتلك الشاعر أداته الأساسية هنا وهي اللغة، فهو بذلك يصبح غير واعٍ بما يقول ولا يعنيه ولا يسيطر على تشكيل قصيدته سواء بوعيه أو حتى بلا وعيه الإبداعي.
إن السهولة الخادعة لهذا الشكل تغري بالجرأة على الكتابة دون مراجعة ودون تأمل، وتجعل بعضا من الشعراء الجدد يتعجّل ويراكم الإصدارات، فللنجاح الآن معادلات جديدة مرتبطة بالقدرة على استثمار أساليب الترويج والانتشار والإلحاح الدعائي التي تمر بأطوار جديدة تماما. أما العكوف على التجربة والتأني واحترام المتلقي، فهذه كلها أمور تبدو غائبة في كثير من الأحيان. لكننا في النهاية سنصبح مهددين جميعا كشعراء بفقدان ثقة الجمهور المتعاطف مع التجربة، وهو نخبوي بطبيعته، ولن يستمر في الإقبال على مُنتج أدبي يتسم بالارتجال والإهمال لأبسط مفاهيم الأدبية.
هناك حراك ما في الساحة الإبداعية وأسماء جديدة تبزغ كل يوم وأسماء أخرى تقدم شيئا وتختفي. لكن الفاعلية الآن سمة غالبة يجب أن نستثمرها لصالح صنع صورة جديدة للإبداع في مصر، في كل الأشكال الإبداعية وفي مقدمتها الإبداع الشعري .
…………
*ألقيت هذه الشهادة في مؤتمر أدباء مصر الدورة 24