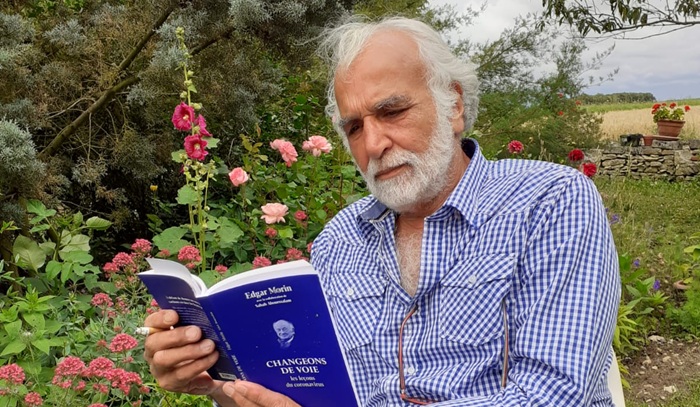حسن عبدالموجود
لا يوجد أشباه كثيرون للمعلّم الفلسطينى زياد خداش فى العالم. وهذه الجملة ليست من قبيل المبالغة، إذ يمكنك أن ترى حباً كبيراً يطلّ من وجوه تلاميذه، بينما يحاورونه، ويسمعون حكاياته، ويسمع حكاياتهم. بينما يرقصون أمامه أو معه. بينما يضحكون على نكاته أو يسخرون منه. بينما يصفّق لهم أو يصفقون له، بينما يواسونه أو يواسيهم. بينما يمنحهم الحكمة ويستمد منهم بعض البراءة، بينما يحولهم إلى شيوخ ويتحوّل هو إلى طفل كبير، طفل لا يجد حرجاً حينما يرقص فوق الطاولة على أغنية لـ«إنريكى إجلاسيوس».
يترك زياد الفرصة لصغاره، فى الغالب، ليكونوا هم الأساتذة وكتّاب الحكايات والمؤرخين الصغار. كنت أتابع ما يكتبه عن تلاميذه على الفيسبوك، ومع مرور الوقت أصبح بمقدورى أن أرى تلك الحكايات مصوَّرة فى فيديوهات. صرتُ أنتظرها، كما ينتظرها كثيرون غيرى، إذ تمنحنا طاقة صافية من الأمل. وأتخيل أن أحد هؤلاء الأطفال سيصير يوماً كاتباً كبيراً يتحدث عن تجربته مع ذلك المعلّم الفريد. وربما يستعيد ذكرياته العظيمة عنه: «كنت أنتظر أول شعاع للشمس، أنهض فرحاً، وأقفز فى ملابسى، أحمل حقيبتى، وأقطع الطريق جرياً إلى المدرسة، إذ لا أطيق الانتظار لرؤيته بشعره المهوّش وضحكته الصافية وصوته الطفولى».
المدهش أن اليوم الأول لزياد فى الوظيفة كان عذاباً صافياً، يحكى: «أنا من الأشخاص الذين لا يألفون بسرعة الأماكن والأشخاص، جلست فى غرفة المعلمين. كرهتهم ورفضتهم، كنت أحدق فيهم، وأراهم كائنات لزجة تضحك وتمزح، وتسخر من كل شىء، وفيما بعد رأيت نفسى لزجاً مثلهم فكرهتنى، ورفضتنى. صرت مثلهم تماماً أثرثر حول الراتب والترقيات ونكات الجنس الفاحش وترقب مواعيد المفتشين. أما المدير فكان فى نظرى آمراً صارماً للسجن».
لم يحب صاحب «الشرفات ترحل أيضاً» و«كأن شخصاً ثالثاُ كان بيننا» و«شتاء ثقيل وامرأة خفيفة» و«أوقات جميلة لأخطائنا النضرة» و«أسباب رائعة للبكاء» يوماً التعليم، كانت مشكلته الدائمة مع القوانين. يعلق: «التعليم أكثر المهن احتواء للقوانين، وبسببها كرهت اليوم الأول، شتمت المعلمين وصرخت على الطلاب، وهربت من الحصة الثالثة، لكنى عدت مكرهاً لانعدام البديل وواصلت التأقلم مع العذاب، لكنى فى منتصف الرحلة سمعت طالباً يسألنى فيما أنا نائم فى الحصة: أستاذ لماذا يوجد هناك فصل خامس فى العام؟ فطار صوابى، وأنا أفكر فى فصل آخر بخلاف الشتاء والصيف والخريف والربيع. إلهى. ثمة مبدع وفيلسوف هنا فى الصف السادس. خجلت من نفسى، ومن سؤال الطالب رام، وتغيرت حياتى، إذ قررت أن أحول العذاب إلى أغنية أو رقصة أو نص أدبى، وهذا ما حدث».

لم يختر زياد التعليم: «أنا خريج لغة عربية، وتلقائياً فى بلادنا هذا التخصص يجرّنى من قرنىّ كشاهٍ حزينة إلى مجزرة التعليم. وهناك يتم ذبحى كل يوم بسكين الوقت الطويل. بالطبع لو كنت مواطناً سويدياً لكنت معلماً سعيداً، فمشكلتى، كما قلت، ليس مع فكرة التعليم بل مع القوانين المؤذية، التى تقتل الطالب والمعرفة والمستقبل، فى السويد كما أعلم هناك سطوة أقل جداً لتلك الأنظمة الصارمة، وهناك متسع من الخيارات ومساحات النقد التفكير وفرص التحليل والرفض، لكن بعد عذاب سنوات طويلة من الروتين والثبات وبعد أن غيّرنى سؤال الطالب رام، صار الطلاب أصحابى، نصنع معاً الرفض ونتخيل أننا طيور أو أنهار ونقاتل من أجل التغيير والاستمتاع بكوننا بشراً».
كان زياد منذ فترة وجيزة، وقبل أن يضرب وباء كورونا العالم، يجوب شوارع الخليل بـ«باص المكتبة» ويمر على مدارسها ويشارك الأطفال والكبار ورشاً فى الموسيقى والألعاب والتدريبات الدرامية والقراءة وغيرها. وهكذا يمكنكم أن تروا مجموعة من طلاب يقرأون قصة معاً وهم يتذوقون كل حرف منها ابتداء من عنوانها الشعرى «نعم القلب يرى». يمكنك أن تراه يجهر بالنداء: «يا مديرو ومديرات مدارسنا انهضوا عن المكاتب وصيروا موسيقى تتجول بين الطلاب والطالبات».
قصصه مع التلاميذ ليست مقتصرة على فلسطين. يحكى واحدة من قصصه التى يطيب له أن يدونها على الفيسبوك: «فى لقاء الكتابة المجنونة.. سألتُ مريمَ الطالبةَ المغربيةَ سؤالاً غريباً جداً عليها:
-مريم متى آخر مرة رأيت فيها البحر؟!

ضحكت مريم طويلاً وضحك الصف كله: ما هذا السؤال يا أستاذ؟ أنا الآن أرى البحر. وأشارت إليه، كان يجلس طويلاً وعريضاً تحت النافذة، فارتبكت أنا وصمتُ دقائق.
نسيت لأول وهلة طبعاً أنى فى الرباط ولست فى رام الله. ولم أخبر طلاب وطالبات الرباط حتى لا يتهموننى بالجنون أن 27 طالباً فى صفى من 35 لم يروا البحر إلا فى شاشات التلفزيون».
درس زياد فى جامعة اليرموك الأردنية، ولم يتخيل أبداً أنه قد يعمل معلماً. كان يظن أنه سيصبح صحفياً مهماً، لطالما رأى نفسه فى أحلام اليقظة يكتب عن الروايات، ويغطى الأحداث الثقافية الكبرى ويجرى حوارات مع أدباء العالم، ولم يكن لديه، مع الأسف، معلمون ملهمون، مثله، طيلة مراحل دراسته، لكن شخصيته المغامرة تشكلت من خلال قراءات لمجانين أدباء العالم وجعلته شخصاً يهوى تكسير المتفق عليه وإغضاب كل مرضى عنه من شخصيات وممارسات وسياقات تاريخية..
يحكى: «أما أستاذى الكبير فكان خليل السكاكينى، الذى ولد فى القدس عام 1898 ومات فى القاهرة عام 1953 مهجّراً بفعل النكبة، هذا العظيم اتفق الجميع على أنه سبق زمانه، وللأسف لم تنصفه الثقافة الفلسطينية كما يجب، ولم تستفد من نظرياته وأفكاره التربوية. أسس السكاكينى – وهو مقدسى عروبى مسيحى رفض سيطرة الكنيسة الأرثوذكسية على إدارة الكنيسة، وناضل لتعريبها – المدرسة الدستورية فى القدس عام 1911 مع مجموعة من تربويى القدس. كانت معايير القبول فى المدرسة حضارية جداً ومستنيرة، أهمها لا أهمية للدين أو الطائفة أو اللون، لا أهمية للعلامات لا للضرب، ونعم لتطوير الميول الصالحة لا قمعها. هذا الكبير صدرت مؤخراً يومياته موزعة على 12 كتاباً، يروى فيها يومياته التفصيلية عن حياته الشخصية والمعرفية والمهنية والوطنية. السكاكينى هذا هو الذى حوّل تفكيرى ورسم مساراته الحداثية وألهمنى المغامرة فى التعليم والكتابة وحب الحياة».

وكيف كان تأثير الوظيفة عليك؟ يجيب: «جعلتنى المهنة بعد أن طورت إحساسى بها أقرب للهامش وغير المرئى والمحطم، والمستبعد. فى كتاباتى القصصية صرت أميل لمن لا صوت لهم».
ورغم ما يبدو من السطح أن زياد يعيش يومه بالكامل كمعلم إلا أن الحقيقة غير ذلك: «لا أسمح للمعلم بأن يعيش معى إلى ما بعد الثانية ظهراً، أطرده وأقول له بلهجة غير مؤدبة: اذهب إلى مكان آخر ونلتقى صباحاً عند بوابة المدرسة، ويحضر معى فقط الأديب المغامر المجنون، ناهب الوجود وعاصر المشاهد الحياتية الغريبة غير المفهومة وغير الملتفت لها يوصلنى المغامر الحسّى إلى بوابة المدرسة ويلتقى هناك لثوان مع المعلم يتبادلان النظر الحاد، يغادرنى المغامر ويدخلنى المعلم».
هذا المعلم المتواضع لا ينسى كثيراً من أسئلة عصافيره المحرجة والطريفة. سأله أحدهم: «أستاذ ما بدك تحلق شعرك؟!» سأله آخر: «أستاذ عن جد انت مش متزوج؟!» وأخبره ثالث: «أستاذ أختى قرأت قصصك وبتقول عنك قليل أدب!
زياد ينشر يومياته مع صغاره المجانين المبدعين على مواقع التواصل الاجتماعى ليطلع العالم عليها، يفسّر ربما لنفسه: «أظن فى الأمر رغبة غير واعية للتباهى بصخب حياتى وتنوعها واختلافها، أنا الذى أعيش فى قلب بلاد عنوانها الجمود والخوف من التغيير، فربما يجعلنى ذلك أعيش أكثر».
وأكثر ما يخشاه زياد التقاعد. يقول أخيراً: «إنه يعنى لى أياماً صعبة، لا أتخيل أنى سأنهض صباحاً ما إن أفتح عيونى، ثم لا يكون فى ذهنى مكان ينتظرنى ويحتاجنى. التقاعد تدريب على الموت، وهذا يشل تفكيرى تماماً، أنا أتدرب على الموت. أى شعور قيامى هذا يا الله؟!».