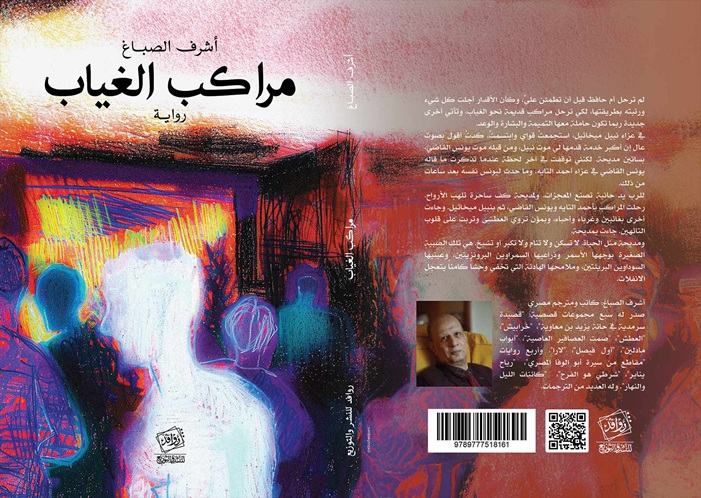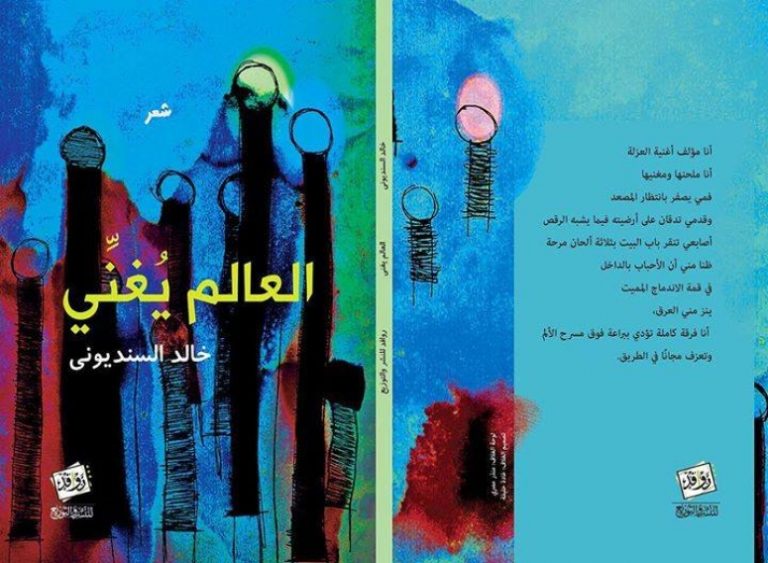شيرين أبو النجا
كانت مي التلمساني، الكاتبة المصرية المقيمة في كندا، وستظلّ، في رحلة بحث دائمة عن الزمن المفقود، عن اللحظة الجوهرية التي تتسرب وتتبخر لنتساءل عن وجهتها. منذ أن بدأت الكتابة في عام 1995، عرفناها باحثة تيأس أحياناً لأنها لم تصل إلى غائية الرحلة، ثمّ تعيد الكتابة ولا تصل. ولكن في محاولة وصولها إلى إيثاكا، تصل إلى طبقات الزمن المتراكمة داخلنا- نحن جيل التسعينات- وتستحضره، بمنتهى التكثيف والتقشف.
يأتي هذا التكثيف من تتبعها لفكرة وتداعياتها، فتختفي تفاصيل السرد ليتصدر الإحساس المشهد، ويجيء التقشف من توظيف الكلمات لرسم صورة وليس حدث. وبتضفير الإحساس مع الصورة، تستعيد التلمساني مكانها الأثير والغرام الأول، شاشة السينما، تلك العين السحرية التي تُعيد قراءة العالم من زوايا متعددة. تبدو إعادة قراءة العالم مصطلح مستحيل، فالقراءة الأولى التي عشناها لا تتغير. القراءة تبقى، ويذهب الزمن، بحيث كان لا بد لمن تُقيم خارج أسوار هذا العالم (عالم الطفولة والمراهقة والصبا أي زمن التكوين) أن تسعى إلى استعادة ما فُقد من الزمن تأثراً بمارسيل بروست في سباعيته «البحث عن الزمن المفقود» (1905-1922)، وهو الكاتب الذي تناولت التلمساني أول أعماله- «الملذات والأيام»- في رسالة الماجستير من جامعة القاهرة.
تُنشئ مي التلمساني عبارة «عين سحرية» ولا تجد سوى مسمى «قصص» لتضعه علي الغلاف (الدار المصرية اللبنانية، 2016)، ولستُ على يقين من صحة الجنس الأدبي، فالسبعة مشاهد (مع تقسيم المشهد الأخير إلى اثني عشر جزءاً/مشهداً) متتالية تستعيد زمناً مفقوداً ولا تدع حيلة إلا وتجرّبها من أجل هذه الاستعادة، فتضفر عينها مع الأدب والموسيقى والسينما، لتخرج من ثنايا هذه الأجناس بلحظة منفلتة أو هاربة، لا تستقر بل تستمر في المراوغة.
تبدأ الكاتبة بمحاولة الإمساك بأصعب لحظة، لحظة تصوير المشهد على الشاشة، وكيف يعيش النجم- عبد الحليم حافظ- زمنه المفقود على مدار عشر سنوات. فكأنه كان يخطّط لرحلة «تسلل منظم» من الحياة. تسعى التلمساني في هذا المشهد إلى تثبيت لحظة الشجن والوعي بالفقد، وتُطور المسألة في مشهد «شرع المحبين»، إذ تمنح هنادي (زهرة العلا) صوتها في فيلم «دعاء الكروان»، وتجعل لها مساحة حضور أكثر تميزاً من العمل الأدبي والفيلم السينمائي. وباستنطاق هنادي يستعيد الوعي تلك اللحظة المفقودة من السيناريو.
هي تحاول سكن بيوت قديمة لتستحضر زمنها الغائب. تندمج في الأحلام، فتراوغها اللحظة، حتى تستسلم وتصل إلى زمن تسعى إلى امتلاكه، زمن الأب- صوتاً وحضوراً ورائحة. يبدو محمول الأب ثرياً جداً في النص، حتى أنها تكرس له مشاهد عدة، تدخل كلها في زمن التكوين، اللحظة التي نتعلم فيها الكيفية التي نصافح بها العالم، حتى أن يدها ويد الأب تتداخلان في عينها السحرية، تتداخل معهما في دائرة حلزونية ليس بها أي ثغرة. ثم تنتزع اللحظة المفقودة مرة أخرى عبر استعادة تفاعلهما مع السينما، فتبقى الصورة أقوى من الكلمة، تحاور الفيلم وأبطاله وتتماهى مع أورفيوس لجان كوكتو، وأوبرا كارمن.
ولأنه علّمها الفصاحة التي تعتبرها «كتابة ذهنية»، فإنها وجدت بلاغة في الصمت الشبيه بنهاية أوبرا كارمن، ذاك الصمت الذي يُخيم على المشاهد كافة، بحيث تدور محاولات استعادة الزمن المفقود في وعي الكتابة ذاتها فتتحول إلى كتابة ذهنية. على الطرف الآخر، تظهر الأم لتؤكد استحالة عودة ذاك الزمن. تظهر الأم بمحمول الحاضر، ألم الجسد- «سبعة عشر نوعاً من الألم»- الذي يوقظ الراوية من محاولات استعادة طعم اللحظة مع الأصدقاء. نسمع أنات الأم ودعائها وكأنها منبه لثقل الحاضر ووجوده الراسخ الذي لا يُمكن تجاهله، الألم الذي «يظهر فجأة في صورة بكاء وتأوهات، ويتأكد لأن ثمة جمهوراً يشهد عليه».
بتحطم كل المحاولات لا تجد الكاتبة مفراً من «استعادة هليوبوليس»، وهو عنوان المشهد الأخير. وكأن مروية «هليوبوليس» التي أصدرتها الكاتبة عام 2001 (دار شرقيات) لا تكفي لتثبيت المكان الذي تفتح فيه الوعي، فجاءت «استعادة هليوبوليس» لتعيد المروي والمسرود من قبل، عبر الرائحة وهو ما يستدعي قصة أنتيغون، التي منعت وصول رائحة جثة أخيها إلى الملك.
وفي الوقت ذاته يستدعي ذلك رائحة «كعك المادلين»، التي حفزت مارسيل بروست على الكتابة. وعبر هذه العين السحرية، تلتقط مي التلمساني تفاصيل الوعي التي سقطت منها عام 2001، الأصوات والروائح والأسماء والهدايا والقراءات والصور الفوتوغرافية والأصدقاء والبيئة المدرسية التي تشهد على خيباتنا. تلك الخيبة التي تُحولها الكاتبة إلى انتصار بفضل المتابعة الدقيقة للأفلام السينمائية.
يبدو هذا المشهد الطويل وكأنه شهادة كاملة على زمن مفقود، زمن ولّى، ولن يعود حتى مع إعادة الكتابة. إنها شهادة يعاود فيها الأب الظهور بحضور طاغي، على رغم صمته الدائم، فكأنها بلاغة الصمت. هي شهادة على المكان، ولكن بدلاً من الحديث عن المكان راحت تستعيد ما حدث فيه. المكان في النهاية لا بد أن يكون مسكوناً (إنسانياً)، ولا بد له من الإعمار ليبقي حياً، وإعمار المكان من دون حياة مستحيل. «الزمن يمر والمكان يبقي، يحفظ سر الزمن ورائحته. كيف مر الزمن؟ وأين راح؟ لا أحد يعرف. المكان يعرف»… لذلك كان عليها استعادة المكان، وتماماً كما مر عبد الحليم حافظ بلقطتين يفصل بينهما عقد من الزمان، يمرّ المكان مع التلمساني بلقطتين، الأولى عندما أرست وجوده والثانية في محاولة استعادة زمنه المفقود. تعتمد المشاهد كلها في «عين سحرية» على المفهوم الفلسفي البرجسوني للحياة بوصفها ديمومة تراكم، وهو ما يعني أن الزمن هناك سواء كان مفقوداً أم مستعاداً، الحياة لدى مي التلمساني هي تراكمات «لحظات من تاريخ النظر».