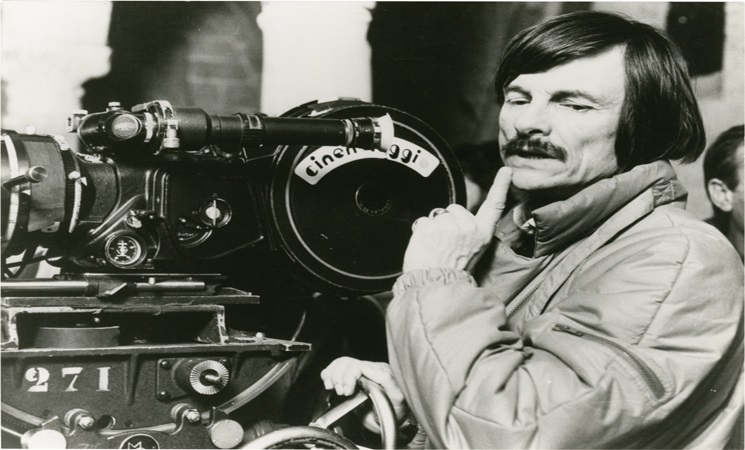أحمد عبد الرحيم
ملخص الفيلم:
(يحيى المصرى) بطل الجمهورية فى الكونغ فو يسعى للانتحار للعديد من الإحباطات: اللعبة التى يلعبها ليس لها أى جماهيرية فى مصر، أسرته لا تفهم شغفه بهذه الرياضة، (منى) الفتاة التى يحبها لا تشعر به، يعمل مدرس ألعاب بأجر بخس.. إلخ. بعد فشل محاولة انتحاره، يقابل ساحرًا يحقِّق الأمانى المستحيلة، ويهبه الحاسة السابعة؛ وهى القدرة على قراءة أفكار الناس. فى البداية، يتعذب (يحيى) بسبب تلك القدرة الخارقة، وينزعج من كثرة الحقائق الخفية التى اكتشفها عن أقرب الناس له بفضلها، لكنه يدرك إمكانية استخدامها فى مباريات الكونغ فو، ليقرأ أفكار منافسيه، ويهزمهم بسهولة. كذلك يستخدمها فى كسب قلب الفتاة (منى) التى تقع فى عشق هذا الذى يفكر مثلها تمامًا!
يتحدى (يحيى) البطل الصينى الأسطورة (فومانشى)، الذى لم يُهزَم من قبل، ويدعوه بتبجح إلى مباراة حاسمة يهزمه فيها بمصر. يصاب (يحيى) بالغرور، ويصبح ألعوبة فى يد الاعلام ليبدأ استغلال صورته كبطل دائم الانتصار، ويبدأ هو فى هجران أصدقائه، والابتعاد عن أقرب الأقربين له، مثل جده الطيب، ومُعلِّم الكونغ فو العجوز (رشدان).
تكتشف حبيبته (منى) أنه لم يتقرَّب إليها، ولم يهزم منافسيه، إلا بهذه القدرة السحرية التى كان يخفيها عن الجميع، فتهجره لكذبه وزيفه، كذا يرى (يحيى) تغيره إلى الأسوأ فى تشوّه صورة تلميذه الوحيد (دودة)، ويتأثر بقصة قطز الذى صمّم على هزيمة الغزو التترى، مُحققًا النصر التاريخى المشهود فى (عين جالوت).
يذهب (يحيى) إلى الساحر مجددًا، لكن للاستغناء نهائيًا عن الحاسة السابعة، ويعود إلى حياته الطبيعية بعيدًا عن أضواء الشهرة وعالم الزيف، وبينما يسترد محبة الجميع يصر على ملاقاة البطل الصينى معتمدًا على امكانياته الذاتية فقط، والتى تمكِّنه من الفوز أخيرًا.
التحليل:
قد يعرف جمهور اليوم (أحمد مكى) كنجم كوميديا فى التليفزيون والسينما، أو مطرب راب، لكن عددًا كبيرًا منهم لا يعرف أنه – فى الأصل – دخل إلى عالم الفن كمخرج ومؤلف سينمائى. درس (مكى) الإخراج فى المعهد العالى للسينما، وفى عام تخرجه 2003 قدم مشروع تخرّج عبارة عن فيلم فانتازيا كوميدى قصير بعنوان (الحاسة السابعة) حظى بتقدير نقدى طيّب، ونال عددًا من الجوائز المحلية والعالمية. بعدها بعامين، صمّم (مكى) على أن يقوم أول أفلامه الروائية الطويلة على قصة فيلمه القصير السابق لكن مع بعض التعديلات، ليخرجه ويشارك فى كتابته ويقوم بعدد من الأدوار – صوتيًا فقط – فيه (كدور مذيع الأخبار الرياضية فى الإذاعة، أو مخرج فيلم الأكشن العصبى). لا شك أن الفيلم – بوصفه فانتازيا كوميدية ترتكز على عناصر حرفية جيدة – تجربة مختلفة للسينما المصرية فى الفترة الأخيرة، لاسيما بعد سيطرة الفيلم الكوميدى التقليدى، فى أسوأ صوره الحرفية غالبًا، على مقدرات الإنتاج منذ عام 1997، بدون أى محاولة للتجديد أو التميّز. لكن المشكلة أن (مكى) أراد أن يقدم العديد والعديد من الأمور فى الوقت نفسه، من خلال فيلم واحد بفكرة مدهشة، لذا غرقت – للأسف – هذه الفكرة المدهشة تحت زخم ضخم من المعانى، والشخصيات، والخطوط الدرامية..
لقد كان الخط الأساسى هو قصة الشاب (يحيى) الذى لابد أن يثق فى نفسه وقدراته بعيدًا عن أى سحر إلا إرادته الإنسانية الخالصة وذلك من خلال مغامرة فانتازية كوميدية، لكنك ستجد بالإضافة إلى هذا: محاولة لتقديم ونقد صور الكذب المختلفة فى المجتمع (نجم أكشن مزيف، راقصة تزعم أنها مطربة، ..)، رداءة أساليب الدعاية المصرية أمام نظيرتها الأمريكية (تتابع المقارنة الطويل بين الإعلانين الأمريكى والمصرى عن أبطال الكونغ فو)، خسارة نموذج البطل المصرى أمام نموذج الـAmerican Pop أو الثقافة الشعبية الأمريكية بعيدًا عن تأصيل هوية مصرية عربية، ويصل الأمر لأقصى درجاته حينما تجد نفسك أمام محاكاة ساخرة لأغانى فيديو كليب مصرية! (علِّى الضحكاية لهانى شاكر، على بالى لعايدة الأيوبى، الكليبات المثيرة..)، أو القنوات الإخبارية العربية والأجنبية، أو الأفلام الصينية المدبلجة!!! ناهيك عن الاستغراق فى إفراد أول 40 دقيقة من الفيلم لمجرد تقديم الشخصيات، وهذا قبل حتى الدخول فى الموضوع الرئيسى؛ وهو نيل (يحيى) للحاسة السابعة! كل هذا ويزيد أرهق الفكرة الأصلية اللطيفة للعمل، لدرجة شعورك القوى بالملل طوال مدة الفيلم التى استغرقت ساعتين، والتى كان من الممكن – ومن الأفضل – أن تكون أقصر من ذلك.
فى قائمة التطويل ستجد أيضًا خطًا قصصيًا شمل أكثر من مشهد لـ(يحيى) يتعلّم فيها اللغة الصينية ليتمكَّن من قراءة أفكار منافسه الصينى بسهولة. فى الواقع، هذا الخط كان يمكن اختصاره فى مشهد واحد لـ(يحيى) وهو يتسلّم شهادة من أحد الكورسات تفيد بأنه صار قد مؤهلًا للحديث بالصينية، بدلًا من مشاهد عديدة، باردة وثقيلة الظل، يردِّد فيها الألفاظ الصينية بصعوبة (عليه وعلينا!). ثم بمجرد اكتشافك كمشاهد أن (يحيى) وصل فى مرحلة ما إلى سماع أفكار عصافيره بلغتهم؛ ستتأكد أن هذا الخط كان من الممكن حذفه بالكامل!
تمامًا كالخط الخاص بالبطل الرياضى المصرى وبطل أفلام الأكشن (أداء لاعب كرة القدم خالد الغندور)، حيث نرى هذا البطل فى “مجموعة مشاهد” وقد سبَّب عقدة لـ(يحيى) بسبب نجاحه وشهرته، بينما صنّاع الفيلم أكدوا هذا الأمر سابقًا من خلال شخصية (فومانشى) البطل الرياضى الآخر ونجم أفلام الأكشن أيضًا! لذا يبدو هذا الخط زائدًا كصدى طويل بلا لزومية إلا ربما استغلال شعبية ونجومية خالد الغندور لصالح تحقيق جماهيرية للفيلم، وقدرة توزيع تجارى لعمل أغلبه وجوه جديدة، وهو ما أدى إلى اختلاق هذه الشخصية التى كان من الأجدى كثيرًا حذفها لتسريع الإيقاع وتخفيف الترهل من على كاهل الفيلم.
بمناسبة الاختلاق والافتعال، ستجد ذلك من جديد فى استغلال هزيمة الملاكم الأمريكى تايسون كدافع لظهور رغبة (يحيى) فى تحدى (فومانشى)، بينما المفروض أنه متحمس لذلك من البداية! أو الافتعال الميلودرامى فى إماته شخصية والدة الصديق، لا لشىء سوى إظهار كيف أن (يحيى) – الذى عرف الخبر متأخرًا – صار لا يهتم بأصدقائه كما كان يومًا ما قبل هذه القدرة الخارقة؛ طبعًا هنا السيناريو يخلق شخصية، ويفرد لها مشهدًا، فقط كى يقتلها، بينما الأمر أبسط من ذلك، والجو أساسًا كوميدى خفيف لا يحتمل هذه المبالغات، أو هذه القتامة. أو كيف يلجأ الفيلم لإظهار تغيُّر (يحيى) للأسوأ، وتنامى غروره بإمكانياته، من خلال موقف مثل إبعاد جده عن كاميرات التلفزيون لأنه يرتدى البيجاما، بينما قد يبدو هذا خوفًا بديهيًا على صورته؛ فمن الطبيعى ألا يسعى أحد لظهور أقاربه فى لقاء تلفزيونى وهم بملابس النوم، وكان من الأجدى أن يسعى (يحيى) لإبعاد جده عن الكاميرات بأى صورة، حتى وهو فى قمة أناقته، لتأكيد رغبته فى تسليط الأضواء عليه وحده، وتعاظم إحساسه بذاته.
أضف إلى ذلك التتابع الطويل جدًا عن قصة البطل قطز، وكيف استطاع قهر الغزو المغولى؛ وهو درس تاريخ مفتعل يسمعه (يحيى) من جده وهو يذاكر لأخته الصغرى ليتأثر بشدة، وكأنه طوال عمره لم يستمع لهذه القصة سابقًا، أو يدرسها فى المدرسة (كحدث تاريخى وكرواية ضمن مقرر اللغة العربية عنوانها “واإسلاماه”؟!)، أو لم يرها ضمن فيلم سينمائى وأكثر من مسلسل تليفزيونى تناولوها؟! الفكرة أن التتابع – غير ملله بصريًا – كان مُفبِّرَكًا كى يسترد (يحيى) ثقته فى نفسه، علمًا بأن كل المعارك الحربية فى التاريخ البشرى قامت – وتقوم – على الاعتماد على النفس، زائد أن قطز – فى الأساس – لم يكن مصرى الجنسية، إذا ما كانت الإشارة للبطولة المصرية مُجسَّدة فى إنسان مقصودة هنا. واضح أن صناع الفيلم لم يجتهدوا فى البحث عن موقف تاريخى أو إنسانى أكثر تعبيرًا عن البطولة المصرية، أو أزمة (يحيى) كبطل مُفتَقِد للثقة، بدلًا من هذه القصة البعيدة عن ذلك، والتى تدفع البطل ليسأل جده بسذاجة: “مش أكيد قطز ده فيه ناس وقفوا ضده وما شجعهوش؟!”. وربما كان الدافع الحقيقى لصناع الفيلم فى استخدام هذه القصة بعينها هو الرغبة فى إحياء نموذج البطل الذى سيوقف هؤلاء “المغول” الذين استولوا على “بغداد”، ويعرقل حلمهم بالسيطرة على بقية العالم العربى؛ وهى محاولة إسقاط سياسى معاصر، أو إيقاظ لضمير الوعى العربى، خاصة بعد عامين من الغزو الأمريكى للعراق، لكنها فى غير محلها تمامًا، ولم تجئ مقنعة دراميًا أبدًا!
مشاهد مثل مشهد تلصص (يحيى) على المدرس فى الحمّام لتفسير صوت هديل “الحمامة” الغريب الذى يصدر من أعضائه فى أثناء التبول، أو مشهد الجار الذى يقابل أخت (يحيى) بدون معرفة الأخير ويفتعل موقفًا ليزور بيتها، لتعلو صرخاته فى مشهد اكتشاف (يحيى) لما يحدث من ورائه، ومواجهته لخيبة رجولته طوال الوقت: “بـيـض بـيـض!!”—كلها كانت محاولات بذيئة لاستمالة جمهور الدرجة الثالثة، وخطب ود لسوقية أرى أن روح الفيلم بعيدة عنها؛ فجاءت إما زائدة، وإما صادمة.
رغم كفاءة المونتاچ، فإن هناك تتابعات صحيح أنها موضوعة داخل إطار سريع كوحدة ذاتية، إلا أنها عند نسبتها للفيلم – بشكل عام – بدت زائدة عن الحاجة، ومملة كالإطناب اللغوى عندما يعيد ويزيد لتأكيد شىء، أو لعرض حالة واحدة بأكثر من شكل. مثلًا:
علمنا – والله العظيم – أن (يحيى) يحب (منى) حبًا صادقًا، وأنها بدأت تحب (يحيى) حبًا صادقًا أيضًا، لكن صنّاع الفيلم يستغرقون فى تقديم ذلك بصريًا، مرارًا و تكرارًا (أكثر من فوتومونتاچ ليحيى ومنى فى رحلة بحرية، وفوتومونتاچ لهما فى مطاعم، وفوتومونتاچ لهما فى جلسة تصوير فوتوغرافى..) مما أعاد المعنى وابتذله. تتكرّر المشكلة ذاتها فى طريقة عرض شك، ثم اكتشاف، (منى) لقدرة (يحيى) على قراءة الأفكار بأكثر من مفارقة صوتية / بصرية لـ(يحيى) يستمع فيها لصوت عقلها، ثم يواجهها به لتتفاجأ. ثم الكرة نفسها من جديد، ولأكثر من مرة، عند شكها فيه!
ناهيك عن التتابع الأخير لتدرُّب (يحيى) قبل المبارة المُنتَظَرة، والذى يمتد فى فوتومونتاچ لحوالى خمس دقائق، لنرى (يحيى) يدرِّب نفسه، ويدِّرب تلميذه دودة أيضًا؛ كأننا نتابع روكى 1، وروكى 5 فى الوقت نفسه! كل ذلك ينجح فى خلق حس من المط الفعًّال، ويعكس كيف أن صنّاع الفيلم لم يريدوا الاستغناء عن أى شىء قاموا بتصويره، ولو لحساب تسريع الإيقاع فى فيلم كوميدى لاهث بالأساس، مصنوع بأسلوب يُخلِص لأفلام الكارتون والقصص المصوّرة.
وعليه، رغم جودة الفكرة، وجدِّة الجو، فإن كل هذه الافتعالات والتطويلات أضعفت قوة الإقناع فى الفيلم، وأصابته بالترهل، ومثّلت مفارقة مؤسفة ما بين فكرة بارعة وعمل ضاحك ذى رسالة طيبة من ناحية، وفيلم ثقيل، مكتظ، يُهلِك ما سبق بما هو زائد، ومكرَّر، ومختلق، وخارج الموضوع كدليل جلى على أن الإفراط فى الشىء يفسده.
من جهه أخرى، يتفوّق الفيلم دراميًا فى عدد من الأمور؛ كصياغة شخصية (منى) على غير ما عهدنا المحبوبة فى أغلب تاريخ السينما المصرية: ضعيفة، بلا شخصية، أو هى ضمير البطل ولا تفعل شيئًا فى حياتها غير أن تحب بطل الفيلم لدرجة تجعلك تتساءل دومًا ماذا ستفعل بعد زواجها منه فى النهاية غير الاستمرار فى حبه فقط؟ وماذا ستعلِّم أولادها؟ بل ما حلمها الشخصى بعيدًا عن الحب والزواج؟ وما الذى يمكن أن تفعله فى حياتها لو لم تنته بالزواج ممن تحب، أو تزوجته ومات مثلًا؟!
هنا (منى) شخصية فاعلة، تحب العصافير وتسعى لفتح متجر لبيعها ورعايتها، بالإضافة إلى أنها تحلم بإنتاج فصائل جديدة منها، وتنجح فى ذلك رغم محاولات الكل لتحجيمها أو إفشالها أول مرة، لتجسِّد نموذجًا مخالفًا للمألوف الأبدى، وتكون الفتاة العاملة الساعية لتحقيق حلم يؤرقها، فضلًا عن أنها قدّمت النموذج الضد للبطل فى صدقها، واعتمادها على نفسها، حتى لو غاب التشجيع من حولها (تعيش شبه وحيدة بعد وفاة والدها)، مع حسها الفنى ورعايتها لموهبتها فى التصوير الفوتوغرافى. إنها صورة مُشرقة تغيب عن ذهن صناع أفلام كثيرين قد لا يدرون بها فى الواقع شيئًا، ونموذج يختلف والصورة المعتادة للبطلة فى أفلام “النجم الأوحد” الكوميدية الأخيرة؛ حيث دائمًا هناك بطل فى صراع، وبطلة ليتزوجها فى النهاية!
تعلو جودة الحوار فى مشاهد بعينها سواء كان كوميديًا (نص خطاب تحدى يحيى لفومانشى، مواجهة أعداء فومانشى له بالصين..)، أو غير ذلك كمشاهد (يحيى) والساحر (إيه مشكلتك؟ / قصدك إيه مش مشكلتك؟!)، أو مشهد مقابلة (يحيى) و(منى) فى أول مرة يقرأ أفكارها، حيث ندرك شخصيتها بوضوح مع بدء ميلها إلى (يحيى)؛ هنا الحوار مكثف، ظريف، ويبلِّغ المعلومة فى سرعة وبساطة، أو مشهد اللقاء التليفزيونى مع (يحيى) حيث المذيعة والمخرج أجزاء من ثقافة تنهار، وإعلام معدوم الشخصية، فقير الفكر، لولا تطويل تتابع الإعلانين فيه. وفى هذا المشهد، نجد واحدًا من أجمل مواقف الفيلم دراميًا، عندما تتصل (منى) تليفونيًا على الهواء، و”تهنئ” البطل بسخرية مريرة، لتحقيقه كل ما تمناه؛ فى تدشين لنهاية العلاقة بينهما، ورثاء لكل ما أحبته فيه فعليًا.
نلمح أيضًا ذكاء عرض شخصية (دودة)، التلميذ الوحيد لـ(يحيى) والمقتدى به، صامتًا تمامًا كصورة سينمائية خالصة تعكس فى رقة وجمال شخصية (يحيى) فى تحولات مشواره. هذا الذكاء ستجده فى تقديم بعض اللحظات الكوميدية المتقنة؛ مثل هجوم المعجبين على (يحيى) بعد فوزه ببطولة الجمهورية بينما هم متجهون إلى خالد الغندور خلفه! أو تقديم مفارقات ضاحكة لكن مثيرة للفكر، ومتماسة مع رسالة الفيلم الأصلية؛ كمفارقات حقيقة مشاعر الأب والأم تجاه بعضهما، مع تأكيد ضغط صورة نجوم الغناء والتمثيل كبديل للمشاعر الحقيقية، فى زمن نحن فيه أضعف صدقًا فى مواجهة النفس، وتحسين الذات، ليصبح الزيف جزءًا من حياتنا؛ ترى ذلك فى زيف أسطورة (فومانشى) الذى يُقهَر فى النهاية بعدما واجهه (يحيى) بإمكانياته العادية، تلك التى سعى لتصعيدها ليصبح هو (فومانشى) أو “الصورة” التى كان يرغبها ويظن أنه أضعف من تحقيقها. ترى ذلك ثانية فى عجز الأم أن تكون مثيرة كشاكيرا فى عيون زوجها، وعجز الزوج أن يحقِّق رومانسية كاظم الساهر فى التعامل مع زوجته. البلاغة نفسها تلمسها فى اكتمال فوز (يحيى) فى النهاية باجتماع الكل لتشجيعه؛ وكأن البطل يتطلب وجوده إيمان مجتمع ما بفكرة أو وحدة كل مع جزء.
جاء بناء الفيلم متماسكًا (لم يلجأ للصدف مثلًا)، وإن ترهلت التفاصيل لتُشوِّش رحلة البطل. النموذج المثالى لتوضيح ذلك هو الثلث الأول من الفيلم، حيث اختار السيناريو أن يعرض شخصية وتاريخ ومشاكل (يحيى)، إلى جانب تركيبة عالمه، عبر أكثر من Flash Back أو عودة إلى الماضى تُروَى للساحر فى المقدمة. لكن هذه “المقدمة” ذاتها تطول، وتطول، وتصبح متخمة لدرجة تحوّلها إلى فيلم آخر؛ خاصة عندما تصل لما يقارب الساعة إلا الربع، بدون الوصول للموضوع الرئيسى. صحيح أنها – كفكرة مجردة – وسيلة موفَّقة لعرض كل المعلومات اللازمة فى هذه المرحلة داخل إطار سريع، لكنها لم تكن موفَّقة فى تنفيذها، والذى لم يكن سريعًا بالمرّة!
ستقابل هذه المشكلة مجددًا فى عنصر المونتاج، والذى نجح فى صياغة إيقاع وفى لأفلام الكارتون الطريفة اللاهثة (مشاهد معارك الكونغ فو مثلًا)، أو التعبير عن أحاسيس مختلفة (توتر يحيى فى تتر البداية)، وحافظ على امتداد لطيف للمشهد بحس ساخر باطنى قريب جدًا من الكارتونية المبدعة (منى تصدم يحيى بسيارتها، أو تتابع مفاجآت يحيى بحقائق أسرته بعد بدء استماعه لأفكارهما)—لكن كل هذا داخل إطار الوحدة المنفردة للتتابع الواحد، إذ إنه فى الإجمال جاءت هذه التتابعات المتقنة فى ذاتها كثيرة جدًا، وشديدة الإرهاق لروح الموضوع المرحة، ما دامت لم تكن هناك نية للاختصار، بقدر ما كان هناك تصميم على قول كل شىء، وعرض كل شىء، مع ترك جمل تتكرر بهدف إضحاك لا يتأتى مع الإفراط فيها (دعونا نقتل يحيى بالقتال.. لأ بالسم!)، أو لتجسيد انبهار بشكل مُبالَغ فيه (صراخ المقاتل الصينى عند رؤية فومانشى باسمه حوالى 6 مرات فى 6 كادرات!) ليبدو الفيلم كاملًا مثل Comic Book أو رواية مصوّرة.. لكن أطول من اللازم!
تميّز الأداء التمثيلى إلى حد كبير، وهذا لا يشير إلى جودة اختيار فريق الممثلين فحسب، وإنما إلى جودة إدارتهم أيضًا، وهى نقطة تصب فى صالح الإخراج بالطبع. يكفى أن (أحمد الفيشاوى) قدّم أفضل أداء له حتى حينه، متجاوزًا كل ما قدمه فى مسلسلات السيتكوم التلفزيونية، ومُحققًا طرافة ملموسة، وإقناعًا بارعًا. ورغم عدم امتلاك المطربة والمذيعة الأردنية رانيا الكردى لناصية العامية المصرية، لكنها أثبتت قبولًا على الشاشة، وتلقائية فى الأداء، فى أول وقوف لها أمام كاميرات السينما. الجيل الأقدم (عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد راتب، يوسف داوود) قدموا أداءً متزنًا وذكيًا لا ينفصل عن خبرتهم الطويلة فى الأعمال الكوميدية. حتى (أحمد عقل) و(عبد الله مشرف) حققا حضورًا لافتًا رغم قصر مساحة دوريهما. وإن يفلت من هذا التميز أداء (إيناس مكى) فى المشهد الذى تنفجر فيه غاضبة، والذى جاء زاعقًا للغاية وغير متماس مع حالة الفيلم ككل، وقد يُعزى هذا إلى عدم التمكن الكامل من كتابة هذا دورها، والذى بدا زائدًا، أو غير موظَّف ببراعة.
تصوير (مازن المتجول) بدا بليغًا فى تعبيره عن أجواء السيناريو (قاعة اجتماعات فومانشى مُقبضة شريرة – موقع انتحار يحيى كئيب وميت)، ويتفوق بوضوح فى مشاهد (الساحر) حيث غرابة الشخصية واللحظة والحدث فى أحسن صورة ممكنة، وبدت الصورة ناعمة فى المشاهد العاطفية بين (يحيى) و(منى)، غير الحس الجمالى سواء فى تكوينات الكوميكس بالعدسات المكبرة (الجار ذو العلاقة مع أخت البطل، ظهور دودة بملابس مطرب الراب الأمريكى..) أو فى استعراض مكان (ساحة تدريب فومانشى)، أو فى مهارة تجسيد حالة السمو والبراح الإيمانى (مشهد المسجد).
فضلًا عن مساهمة الأزياء فى تقديم جو نابض بالبهجة طوال الوقت (ملابس زاهية الألوان نابضة بالحياة لشخصية منى)، كان هناك لمسات تعكس ثقافة متفرِّدة لصناع العمل؛ فـ(يحيى) بعدما يتحوّل إلى صورة إعلامية، ورمز إعلانى للمدرسة، نراه فى الرداء المميَّز الشهير لبروس لى من فيلم Game of Death أو لعبة الموت (1978)، حيث اللون الأصفر الغامق والخط الأسود؛ وهى بالمناسبة ألوان خدمت الحالة المقصودة وقتها لشخصية تعيش ذبولها وليس نضجها. كذا جاء ظهور (منى) ببلوزة مرسوم عليها رمز سوبرمان، وهى تصدم (يحيى) بالسيارة، ربما كإرهاصة بأنه سيصبح “البطل الخارق” بعد قليل، أو هى تحية بشكل عام لهذه النوعية من الأعمال فى السينما الأمريكية، التى يعكس الفيلم تأثرًا شديد الإيجابية بها.
هذه الحالة من الإبداع الذى يطمح للاختلاف، وهذه الروح المرحة، وهذا التأثر الذكى بالسينما الأمريكية وأفلام الكارتون ومطبوعات الكوميكس؛ أظن أنه منطلق أساسًا من روح (أحمد مكى) الذى تمكّن تكنيكيًا كمخرج من تقديمه وأكثر، ويُحسب له – سواء نجح فى ذلك تمامًا أم لا – أنه أراد تقديم ما يزيد على مجرد الكوميديا أو الفانتازيا، فطموح النقد الاجتماعى ظاهر فى الفيلم وإن لم يحقِّق نفسه بشكل صائب، لأن (مكى) فى فيلمه الأول أراد إنجاز الكثير معًا: تأكيد البراعة الحرفية له ولطاقم كبير من المواهب الجديدة خلف الكاميرا، وصناعة فيلم مختلف وسط مناخ تقليدى، وصياغة رسالة أساسية عن الإرادة، مع رسائل أخرى متعددة لانتقاد أوضاع مختلفة.. كل هذا أنتج فى النهاية زخمًا سمعيًا بصريًا كبيرًا، وإن كان ممكنًا أن تميِّز فيلمًا بارعًا ممتعًا.. وسطه!
بطاقة الفيلم
الحاسة السابعة (2005)
سيناريو وحوار: أحمد مكى – محمد جمعة (هذا على التترات أما على البوستر/ قصة وسيناريو وحوار: محمد جمعة!)
بطولة: أحمد الفيشاوى – رانيا الكردى – أحمد راتب – عبد الرحمن أبو زهرة – يوسف داود – عبد الله مشرف – ايناس مكى – أحمد عقل – عمرو القاضى – خالد الغندور – هالة فاخر
نيجاتيف: نيرفانا حسن
تترات: ليلى فخري
ملابس: داليا محمود
مدير الإنتاج: سيف الدين يوسف
مهندس الديكور: سامر الجمال
موسيقى تصويرية: شادى السعيد
مهندس الصوت: أحمد جابر
مونتاچ: عمرو صلاح الدين
مدير التصوير: مازن المتجول
منتج فنى: ايهاب أيوب
اخراج: محمد مكى
انتاج: نيوسنشرى فيلم – دولار فيلم
التوزيع: شركة دولار فيلم
مدة العرض: 116 دقيقة
الحالة اللونية: ألوان