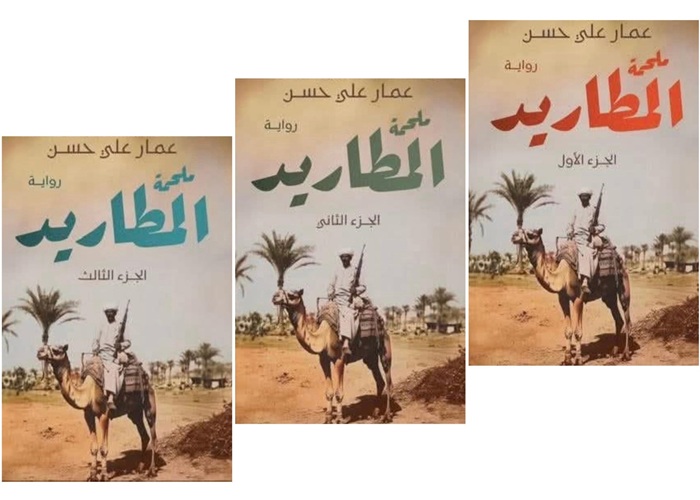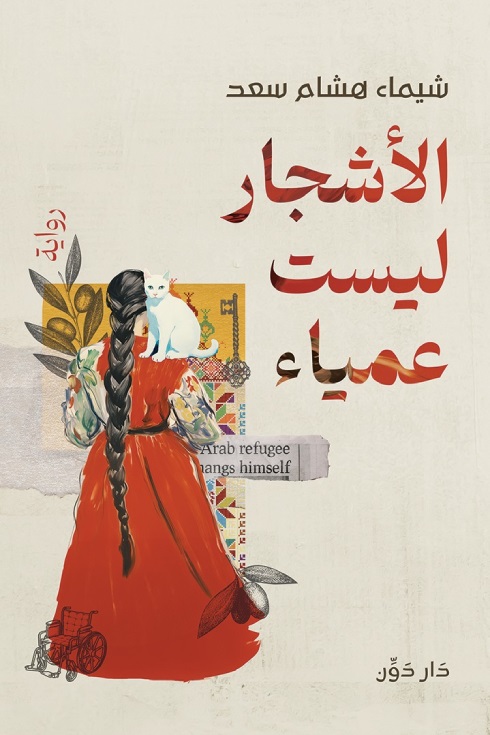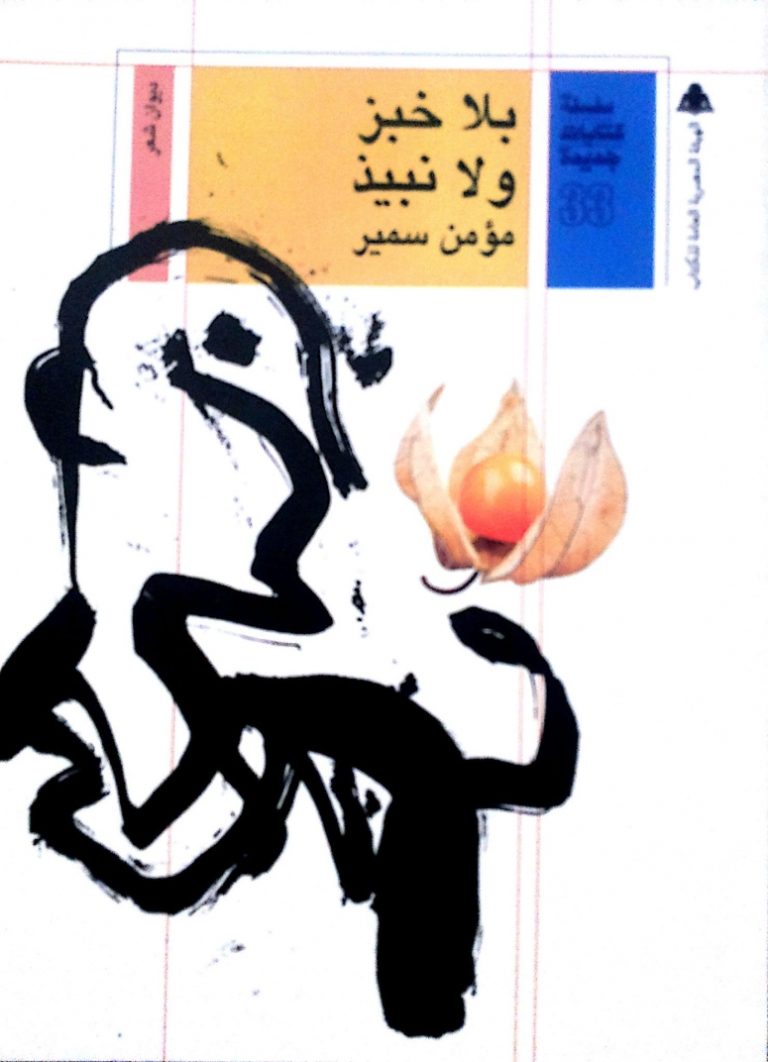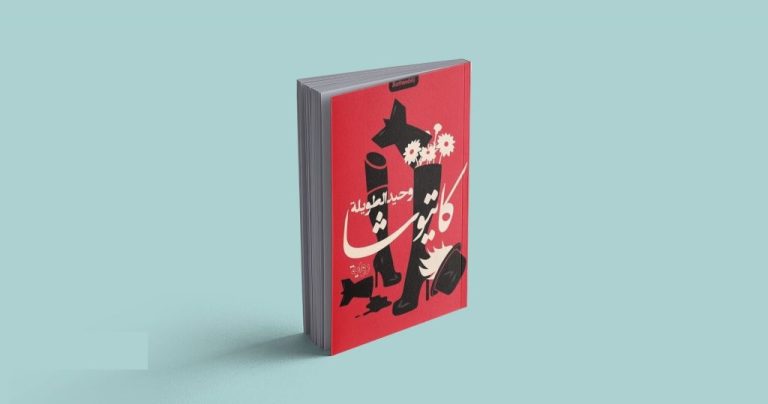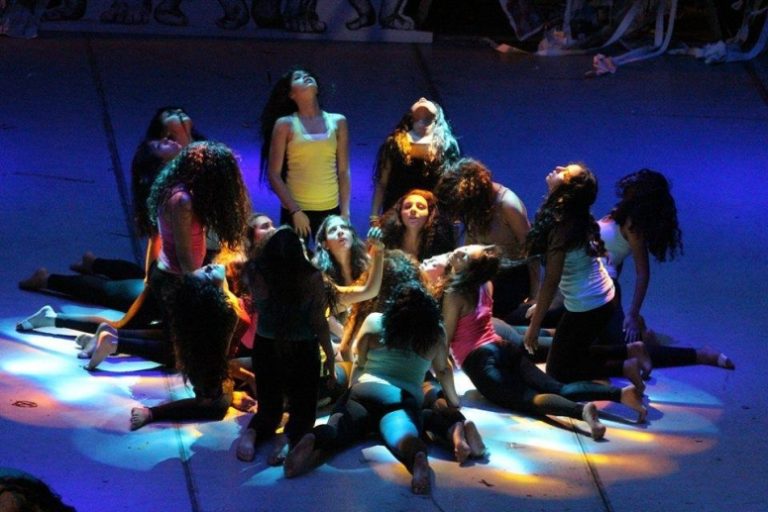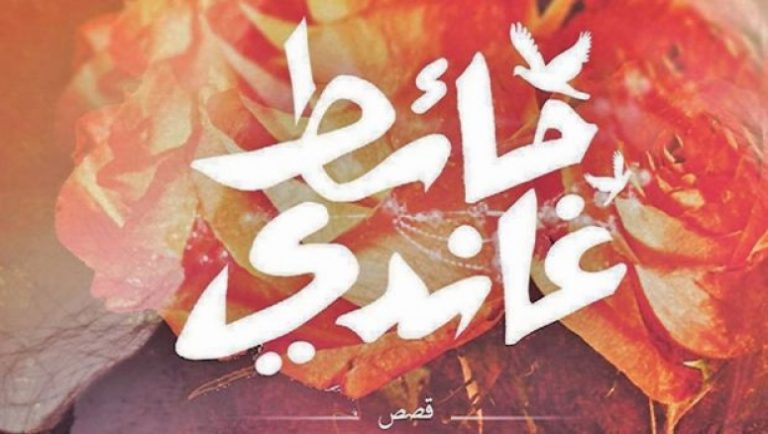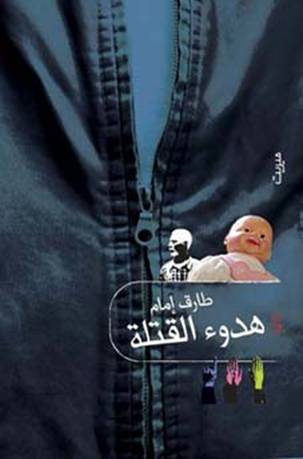د. عيدة محمد أحمد*
تأتي رواية ملحمة “المطاريد” التي صدرت عن الدار المصرية اللبنانية، للكاتب والمفكر عمار على حسن، كحلقة في سلسلة المقاربات التي تبين، عبر طريقة فنية، بنية مجتمعنا، وما عاناه من قهر وظلم وقسوة، على مدار زمن الرواية (1419 ـ 1919) وتحليل معالم الحياة الإنسانية، ونمط المعيشة، مع التركيز على قرى الجنوب ونجوعه، وما كان ـ ولا يزال ـ يعانيه من تهميش، لطالما أوقعه في غياهب الضياع بسبب الفقر المُدقع والجهالة المحتومة وما تبعهم من تفشي الأمراض.
قدم الكاتب ملحمتة في ثلاثة أجزاء، مقسمة إلى فصول متعددة، صور عمار علي حسن فيها حلقة من حلقات الصراع الإنساني، حول المال والجاه والطرد والتشريد، والحنين للعودة للوطن، ومحاربة الطبيعة وقسوتها أثناء الفيضان، وشدة الأمور سوءًا مع غدر البشر؛ من خلال قصة عائلتين متصارعتين في قرية -المُفترض أنها تقع- في صعيد مصر، حيث تسرد الملحمة قصة صراع طويل بين هاتين العائلتين، يُفترض أنهم عاشوا في قرون متتالية في قرى الصعيد “الصوابر” و”الجوابر”، ورغم أن اسم العائلتين وطبيعة الأحداث من بنات خيال الكاتب، إلا أنه أضفى عليها كثير من الواقعية، خلال تتابع الأحداث، التي تأثرت بشخصية الكاتب وثقافته، فيما خلقه من تشابه كبير مع طبيعة ومفردات الحياة الريفية في الصعيد، ولعل ما ساعده على هذا نشأته في إحدى قرى الصعيد، فتحكي الملحمة معناة المصريين مع فيضان النيل، وتبعاته على الفلاحين الأُجراء عبر الزمان، في حين أن خير عملهم وعائده يسكب في جيوب أصحاب الالتزام من الملاك والعمد وأمراء المماليك والضباط وموظفي الحكومة ثم النصيب الأكبر يعود للباب العالي الوالي العثماني (المُحتل)، وتسرد الملحمة حكايات رحلة طويلة ومتكررة من جنوب مصر –الصعيد-ومرتبطة على امتداد عدة قرون من الزمان، فنجد أبطال الملحمة طوال الأحداث يتنقلون بين قرى الصعيد شمالًا وجنوبًا، وأحيانًا إلى القاهرة للدراسة في الأزهر، أوللهروب من القتل أو الخزي والعار، أو للتجارة وبيع المحاصيل، أو شراء العبيد من أحد أسواق حي بولاق على شاطئ النيل مثلما حدث حين ركب “رضوان” النهر لزيارة مسجد الحسين في المحروسة، وعاد ومعه جاريتين من سوق الجلابة، واحدة حبشية، والأخرى شركسية.
ومع اختلاف الأشخاص طوال الملحمة، إلا أننا نجد معظم الحكايات تتفق في الخطوط العريضة، والرابط الأساسي فيها” القهر”، الذي طالما يتعرضون له، والصبر الذي لازمهم للتمكن من العيش والنهوض من جديد، والخط العريض والفكرة الرئيسة التي تدور حولها الحكايات، هي معناة المصريين مع فيضان وتبعاته على الفلاحين، واستغلال القلة لخيراتهم، ومحور الأحداث هو نهر النيل، الذي يُمثل الخير والشر في نفس الوقت، فهو في رضاه منبع الخير وأهم أسباب الحياه، في حين أنه عند غضبه- وقت الفيضان يصبح مصدر الشقاء والطرد والتهجير، بل والموت أحيانًا، ولعل هذا ركناً أساسيًا في تلك الملحمة، يُصور العناء الناتج عن الطبيعة، وفي المقابل تحكي الملحمة عن عناءًا آخر ومتكرر لطالما عاشه المصريون، ألا وهو العناء الناتج عن ظلم البشر، بداية من المستعمر المستبد(الترك) ومعاونوههم من المماليك والمساعدون من أذرع الفساد المتلقون للسلطة والممثلون للسلطة الظالمة من(الملتزمين).
فأبطال الملحمة متنوعون، فمنهم الوجهاء والملاك والجازيب ورجال الدين من المشايخ والقسيسين، وكذلك المزارعين والخفر وغيرهم من الصيادين والمراكبية والنجارين والحدادين، ولطبيعة تلك الحقبة الذمنية ظهر من بين شخصيات الملحمة العبيد والخدم والخادمات، والتجار والباعة في الأٍسواق وكذلك اللصوص والنصابون، كما ظهر من بين الشخصيات المحتلون الأجانب من العثمانيين أو الحبش أو الشراكسة، والمتصوفة ورجال الديانات المختلفة، ومعهم المساجد والكنائس والمعابد، إلى جانب الزاوية التي يقطنها أحد المجازيب،
الذاتية في ثوب موضوعي
تعتبر الملحمة ابنة شرعية لكاتبها، فتتجسد فيها رؤية الكاتب، فهو المفكر السياسي والكاتب باحث الاجتماع السياسي، والمثقف الموسوعي، الذي من أهم قناعته، أن الأدب إحدى وسائل القوى الناعمة ومن أهم أدوات التغيير في المجتمع، من خلال تعميق فهم أفراد المجتمع لأنفسهم ولمجتمعهم ولعالمهم، ولعل في هذا طريقة للتغير للأفضل، وبالتالي النهوض بالمجتمع؛ وهو كذلك الشاعر والأديب والروائ والناقد، الذي يتخذ من كتاباته مجالًا وميدانًا لإسقاطات عن مواقفه السياسية والحياتية المُعلنة، ويُلبثها ثوبًا من الرمزية المشوقة التي تجعل القارئ دومًا سابحًا بخياله للبحث عن تفاسير للرموز المتضمنة بين السطور.
ويتضح من الإهداء ذاتية الرواية، فالكاتب نفسة وأهل قريته “الوصلية” ، التي أكلها نهر النيل في أحد فيضاناته قبل قرن، ونتيجة ذلك هرب أهلها، وأخذوا يسردون الحكايات عبر الأيام، إلى أن وصلت إلى مسامع الأحفاد-ومن بينهم الكاتب- كأسطورة كبرى، يتحاكون بها وهم يعيشون في شوارع قرية جديدة أسموها “الإسماعيلية”، وسط الصعيد، ومثل هذا القرية كان حال باقي القرى المجاورة، فالواقع لم يتغير كثيرًا، إلا عن بعض الأسماء والأحداث أحيانًا، فقرية الصابرية التي تولدت من خيال الكاتب اشتق ملامحها ومفردات الحياة فيها من الصورة الذهنية المستقرة في أعماقه عن قريته والقرى المجاورة لها، كذلك الأحداث التي ترويها الملحمة- حتى وإن كانت خيالية- فهناك أحداث تشبهها حدثت على أرض الواقع، عاشها الكاتب ذاته، أو ربما سمع عن أحداثها، ومع هذه الذاتيه المتعمقة في تناول الكاتب؛ إلا أنه تطغى عليه الموضوعيه في التناول، فغلبته طبيعته كمفكر وكاتب سيايسي، عند تناول الأمور والأحداث، فلم يصور الصعيد- منشأه- بصورة مثالية كنوع من تجميل النشأة، بل أظهره بصورته الواقعيه والحقيقية، في جماله وقبحه، وعفويته كما عاشه هو في طفولته وصباه، فكان الهدف الأهم لديه هو كشف الستار عن تلك البقعة المنسسية من أرض الوطن، التي عانت ومازالت تعاني من التهميش والتعتيم، لعل هذا الكشف يكون سببًا للتدبر، وتحليل حقيقة الأسباب التي ألقت بجزء مهم من أرض الوطن في غياهب النسيان.
السردية والحبكة الدرامية
تبدأ الملحمة بخلاصة من الحكم على لسان الكاتب، تُلخص مُجمل المتضمن في أحداث الرواية، فلأن العيش لم يمض على وتيرة واحدة؛ هناك من يرتبك، ومن لا يتحمل وطأة التغيير؛ فيقع في يأس أويستسلم، وهناك من يألف غدر الحياة وخياناتها، ويعتبر الدهشة أو الحسرة التي تصاحب تقلباتها شيئاً يكسر الرتابة، أو محنة تنتهي بمنحة، ويؤمن أن العظمة لا تولد إلا مع العرق، أو الوقوف على حافة الخطر، وبعد تلك الحكمة الحاكمة لحياة البشر، انتقل الكاتب لواقع الحياة في مصر في تلك الحقبة الذمنية، حيث تساءل سؤاله الاستنكاري الذي لا يخلوا من إيماءات وإسقاطات على الواقع المصري حتى الآن: منذ متى كانت الأرض في مصر ملك الناس؟، وبادر بالإجابة المُحزنة عن الواقع في تلك الفترة التاريخية، حيث الوالي العثماني الذي اعتبرها ملكًا له، يأتيه خراجها، ويعاونه المماليك والسناجق، ليس هذا فحسب، بل هناك من أبناء البلد ممن يساعدوهم، حيث كان يشاركهم ملتزمون من أهل مصر.
وتستمر الملحمة في تصوير مظاهر الحياة الخشنة في صعيد مصر، فهم حتى عند نومهم، هاجعون في مخادعهم الخشنة، يصارعون البق والبراغيث والكوابيس، وفي وسط هذا الواقع المرير، يجدون سلوتهم في الحكي والسرد لبعض الحكايات عما يجهلونه، ومن بين هذه السرديات كانت تدور حول سور عال-(الحديقة ذات السور المرتفع)-، كانوا يتطلعون إليه في رهبة، ويُطلقون تصوراتهم عما خلف الحديقة، التي طالما تطلعوا لدخولها، وكشف أغوارها وهتك سرها، ولكنهم كانوا يكتفوا بمحاولة القبض على أي ثمرة مدلاة من أشجار المانجو العالية، وحتى عندما أبلغهم أحدهم”محروس” أن في الداخل هناك صنوفًا أخرى من أشجار الفاكهة، كالجوافة والرمان والتفاح والبرتقال والتين والليمون وتكاعيب من العنب، لم يتغير الأمر، بل ظلت أمانيهم تموت عند السور، لا يبقى لهم إلا استحلاب ريقهم، مفتتنين بطعوم لم يتذوقوها لثمار يانعة، يرونها ويحجبها عنهم أشواك الأشجار، حيث كانت كل محاولات الفوز بإحدي الثمار دائمًا ماتؤدي إلى نزيف دم.
فنشأت أحداث القصة في إحدى القرى على ضفاف النيل، مع أجداد أسرتي ” صابر” و”جابر” والذين بدأ تواجدهم مع بعض من المجازيب الذين لم يكن لهم أطماع في أي شيء، وسُميت البلدة في البداية تبركًا باسمائهم (نجع الجازيب)، ثم تغير اسم القرية إلى الصابرية، نسبة لصابر، ومع تواتر الأحداث يتسيد الصراع الموقف، ويتحول حب الأرض والرغبة في امتلاك السطوة والسلطة إلى معركة دائمة، بما لها من تبعاتها من قتل وتنكيل وطرد، فيتحول الصوابر والجوابر إلى أعداء متنافسين، بقاء أحدهم في القمة، يستوجب التنكيل بالآخر وتشريده في العراء، فحين يقوى الجوابر، ينتزعوا الأرض، وتمُحى الصابرية، وتطغى أطماع الجابرية فوق كل حلم قديم للصوابر، وهكذا تتناوب العائلتان القوة والضعف، كدلالة على أن القانون الدائم هو التغير والحقية المستقرة أن الأرض تأبى وترفض الاستقرار.
ومن منطلق تلك الفكرة المتأصلة طيلة الأحداث، تأتي نهاية الملحمة مفتوحة، رغم عودة “الصوابر” إلى قريتهم، وتمكنهم وامتلاكهم لزمام الأمور فيها بعد الإبعاد والتشرد، إماءة من الكاتب إلى أن الأمر لن ينتهي، فقد يعود المنهزم مرة أخرى ليتصدر المشهد، حيث أن ذلك الصراع الأبدي والمستمر بين البشر، على الثروة والنفوذ لن ينتهي، وسيبقى مادامت الحياة، وقد يعود”الجوابر” الذين خرجوا مشردين من القرية يومًا ما، فالحكايات -المحملة بأمجاد الأجداد حينًا، وبالمرارة من الهزيمة أحيانًا أخرى- التي تُدس على مسامع صغارهم منذ نعومة أظافرهم، ربما تكون يوم ما مبعثًا لتحقق حلم العودة، وقد يكون من بين هؤلاء الصغار من يعود ليثأر لانهزام الأجداد- كما حدث سابقًا عند الصوابرو الجوابر أيضًا-، وانتزاع رغباتهم الدفينة للعودة لأمجادهم التي تغنت بها الأساطير التي تتوالد بلا توقف، يالها من فكرة عميقة، تبعث بالأمل الدائم، فمهما ساءت الأحوال، دائمًا هناك فرصة للصعود من جديد.
سلاسل الرمزية المشتقة من الواقع
يأتي السرد الحكائي في الملحمة في صورة متلاصقة ومترابطة من التعانق المستمر بين ملامح الواقع ومفرداته، ولكن بصورة غير مباشرة، لتجعل القارئ يجول بخيالاته ويستنبط بذكائه لمدلولات بعض الرموز المتضمنة في الأحداث والأفراد، فالنيل رغم كونه مبعث الخير إلا أنه أحيانًا مبعث الشقاء، وهو بهذا رمز للطبيعة التي تجود وتبخل وقتما شاءت، بينما يُمثل المجاذيب ضمير المشهد ومرجعيته، فهم رغم تواجدهم المستمر طيلة الأحداث، وتزوج أبناء “رضوان”من بناتهم، وانغماسهم في ذلك الواقع المتصارع بين “الصوابر” و”الجوابر”، وقربهم من كبرائهم، إلا أنهم لم يسعوا لامتلاك أرض، ولم يهتموا بالحصول على مركز، واكتفوا بالبقاء على هامش الأحداث يتأملون ما يدور حولهم في هدوء، حتى مع انحدار الحداث إلى صورة من الهمجية، وبذلك أصبحوا يمثلون رمزًا للشفافية والزهد وسط صراعات التملك والنزاع الذي لا ينتهي. أما الحديقة ذات الأسوار العالية والمنيعة، وأشجارها اليانعة، وصاحبها العظيم وحرسه الكثيرون، واستحالة اقتحامها، كانت رمزًا لتلك المرئي الغامض الذي طالما يقابله الإنسان في حياته، ورغم أنه واقعًا موجود بين مفردات الحياة، إلا أنه يظل منبعًا للخيال، لجهله وعدم قدرته عن الوصول للتعرف على تفاصيل حقيقته، وحتى اسم الصوابر كان رمزًا ذو دلالة، فاسم “رضوان الصابر” كبير الصوابر رمز مركب للدلالة على طبيعة حياة الرجل يتكون من رضوان حارس الجنة، ويأتي الصبر كصفة ملازمة له، فهو يزرع ويصبر على مصاعب الحياة، ويتحمل عناء وقسوة الصراعات، وما تسفر عنه من قتل وإبعاد وتهجير، في حين يبقي المتصوفة من رجال الدين بزواياهم ومعهم المساجد والكنائس والمعابد، إلى جانب الزاوية المنفتحة على الكل؛ رمزًا للمقصد والملاذ الدائم، لمن يبتغي النجاة وسط الصراع والتخريب وأطماع المتصارعين، وتظهر المقابر بالملحمة كرمز لنتائج الصراع، فحيث يكون هناك غالب ومغلوب، تحدث الخسائر في الأرض والأنفس من كلا الطرفين (الصوابر والجوابر)، وكلما زادت مقابر أحد الطرفين يدل على خسارته، كما جاءت بالملحمة وسط البناء الدرامي بعض العبارات والمقولات الدارجة، المشتقة من الحديث النبوي والأقوال المأثورة والحكم والأمثال الشعبية في المجتمع المصري مثل مقولة:”تعطي الكادح في أرضك أجره قبل أن يجف عرقه” و”الخائن هو من يضيَّع أهله “و”ثرثرة النساء في آذان الرجال أمَّر من السحر“و “إن جاك الطوفان حط ابنك تحت رجليك.”.
البناء التصويري والخيال
تطفوا الملحمة على نهر من الخيال، فالملحمة أساسًا حكاية خيالية من اختلاق المؤلف، ابتدعها في صورة من الحكي الأسطورى، وأفراد العائلتين والشخصيات كلها من مخترعات خيال الكاتب، كذلك الحكاية بتفاصيلها مخترعة ومتصورة، في حين أن التفاصيل والصور والخلفيات والسياقات والمحطات التاريخية وتقلبات السياسة هي بنت الواقع المشابه لما يجري في الملحمة.
كماغلبت على الكاتب طبيعته الأدبية العذبة، فسرد الأحداث بطريقة شيقة، تفيض بالصور الأدبية الجميلة، مثل ما جاء في عبارة“سرى عزف الرباب يداعب نسائم الليل، وقلوب الساهرين، وينذر بما هو آت في قادم الأيام” لتصور متعة السماع لمُستخلص الملاحم والحكايات على أنغام الربابة، كمفردة مهمة من حياة المصريين، كذلك صورة“يشدون عربة الحياة الثقيلة إلى الأمام”التي تعبر عن شدة معاناة المصريين مع الحياة، والصورة المركبة في “نزع “آل صابر” حكايتهم من قبضة النسيان. أورثوها لأولادهم قبل المال، وضعوها في أرحام النساء قبل نطف البنين والبنات. أطلقوها في مجرى النهر، بعد أن غنَّاها القوَّالون على الرباب “التي تصور حرص الصوابر على الاحتفاظ بتفاصيل تاريخهم الذي يمثل أحد ملامح وعناصر هُويتهم، وأهم أسباب وعوامل بقائهم، كذلك التصوير في“مات النور، وانطلقت الأقاويل الحائرة ” ، التي تصور الضبابية وعثرة الوصول للحقيقة، والصورة في جملة غمس أحدهم إصبعه في عمق الظلام متسائلا : أليست هذه هي الصابرية ؟ لتعبر عن استفسار الحقيقة واسترشاد الخبرات والمعلومات السابقة.
النزعة الشعرية
طغت الطبيعة الشعرية على المؤلف، وظهرت في بعضت الأبيات التي نظمها على ألسنة رواة الربابة، وتغنى بها القَّوالون على الرباب، حتى صارت حكايتها كالسيرة الهلالية، وقال السامعون وهم يهزون رؤوسهم مع العزف المجروح: كأن “الصابر” أبو زيد الهلالي، وكأن “الجابر” دياب بن غانم.ومن هذه الأبيات :
“صابر والزمن غدَّار .. يعاند اللي يريده بيده كاس دوار .. كل ما ينقص يزيده”
، للتغني بالمآساة المتكررة للصوابر، وكذلك بعض الأبيات التي تستقي الحكم من الأحداث، وتصيغها في بناء شعري، يفيض بالصور الشعرية، والاستعارات التي تجسد الحالة المحكية ،في صورة شعرية بإيجاز وتوضيح مثل:
الأرض وش مقسوم .. بين الغنم والديابة
والفتنة لمَّا تقوم .. تكسر قلوب الغلابة
***
عمود البيت اتكسر .. نخطت حيطانه العلالي
والقلب لما اتعصر .. راحت ساعاته الخوالي
***
راح الوجيه الأصيل .. سايب وراه الهوايل
ييجي زمن العويل .. يهد شمل العوايل
***
تراب السكك هاج وماج .. خلَّي طريقي متاهة
والخوف له سياج .. وضاقت الأرض وسماها
***
الضبع صالح الديب .. على نهش لحم الغزالة
والهزة لما تصيب .. غرابيلنا ترمي النخالة
***
فلاتي ينادي ليلاتي .. ع الخلا يستر هروبه
والخوف لمَّا يواتي .. السبع تهرب دروبه
***
يا نجع نخله مال .. وأهله فروا هرايب
وكيف يتعدل حال .. اللي همومه قرايب
وأخيرًا فنحن بصدد عمل أدبي متميز ومتفرد، لكاتب متعدد النتاج ، وقدم عمار من خلال ملحمته المطاريد، سردًا لبعض ملامح رحلة الإنسان الطويلة، وما بها من العراك والتصارع على الثروة والتسيد، وما ينتج عنه من جشع وحقد وهلاك وقتل ونفي وإبعاد وفقد، وبهذا تتحدث تلك الملحمة عن حلقة مهمة من التاريخ المصري، ولكن من زاوية جديدة، لطالما غابت عن المشهد المدون للتاريخ، ولم يظهر من تفاصيلها إلا القليل، حيث تسيد المشهد التاريخي الأخبار القاهرية أو الساحلية، بينما ضن المؤرخون والأدباء عن الإفصاح عن كثير مما كان يجري في هذه البقعة المهمة من أرض مصر، وسواء كان هذا التهميش عن قصد أو مصادفة، فالنتيجة واحدة أننا نجهل الكثير عن جنوب مصر، ولا نكاد نذكره ألا مصادفة، عندما نوثق أنساب بعض المفكرين والأدباء والساسة، الذين يحتفي بهم التاريخ، كالطهطاوي وطه حسين وغيرهم، ممن فروا من غياهب الجنوب إلى أضواء البندر، وتخطوه إلى الغرب وذاع صيتهم، وقد يكون هذا التوجه سببه نشأه الكاتب واعتزازه بتلك النشأة، فهو منذ بدايته الأدبية حمل على عاتقه مهمة كشف أغوار واقع الحياة الجنوبية-الصعيد- وظهر هذا في سيرته الذاتية(مكان وسط الزحام) وفي ديوانه(غبار الطرق)، وفي عدة أعمال أخري.
ومع هذا الظهور الكبير للواقع الجنوبي الذي كان طاغيًا وغالبًا ومسرحًا لمعظم الأحداث، كان هناك حضورًا قاهريًا، بانتقال الأحداث-بشكل منطقي ومبرر- بين الصعيد الجواني وعمق القاهرة، تمثل في بعض الأحياء العريقة بالقاهرة، مثل الأزهر والحسين وما يجاورها من أحياء ملاصقة للمساجد الكبرى، وهذا أمر منطقي حيث كان الفارون من الجنوب غالبًا يقصدون الأزهر للتزود بعلوم الدين،، أو الأسواق للتجارة، فرجال الملحمة إما فلاحون أو تجار أو ممن هجروا تلك الأعمال إلى العلم الديني، وتميز أسلوب الكاتب بالبساطة والعذوبة، تجعل القارئ يستمتع بقراءة الأحداث، ليس هذا فحسب؛ بل قد يشعر القارئ أن أشخاص الحكاية يجاورونه ويشعر بنبضهم وكأنهم صاروا معه، أو صار هو أحدهم، وأخيرًا لايبقى لدي إلا أن أتمنى أن أرى هذه الملحمة عملًا يُجسد سينمائيًا ليُوثق لدى العامة كثير مما يجهلونه عن طبيعة الحياة للمهمشين من قاطني صعيد مصر.
……………………..
* ناقدة وباحثة تربوية
نقلا عن مجلة “الثقافة الجديدة” عدد سبتمبر 2025