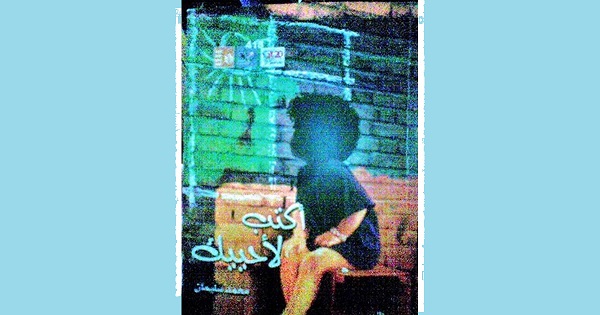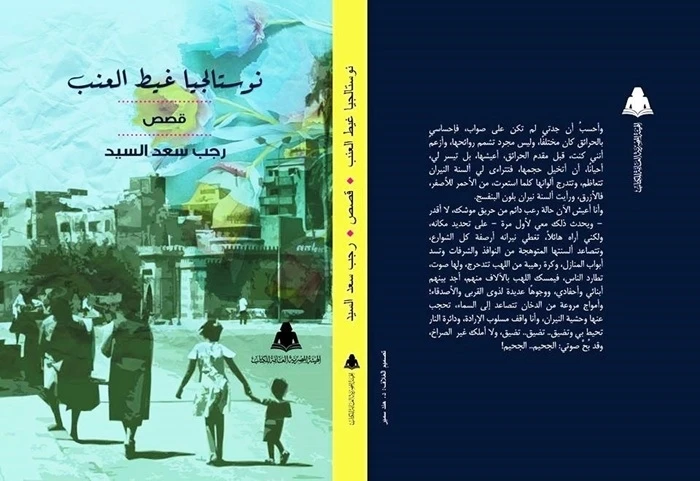د.محمد حافظ دياب
كيف السبيل إلي قراءة ليل أوزير؟
سؤال أرّقني، فحاولت الإجابة عليه بأن أعدى منه، وأسافر في فضائه، بقلب العاشق، وأمارة الباحث، وعنفوان المواطن، مع أن المتصوفة ينبهون مرتحلا مثلي إلى أنه: «كلما سافرت أبعد، عرفت أقل».
للوهلة الأولى، يبدو عالم هذه الرواية مهمشا متشظيا، تسوده الفوضى، لا تلتئم فيه الوقائع إلا لتتفرق، والأشياء تنمو على نحو عشوائي، رغم ما في البناء من دقة وإحكام واتساق. إنه عالم معاد تمثيله طبقا لرؤية احتجاجية، ما يصيره نصا حداثيا متميزا بالدينامية والتوالد والانفتاح، أنجزه الروائي المصري سعد القرش.
ومع هذه الوصفة التعريفية، بوسعنا تلقي ليل أوزير كنسيج يمتلك طاقته الدلالية، أو كحوارية من معمار الانتظام والفوضى، والتعقد والتشابك، مع إعادة توزيع المواقع في النقلة من الوجد إلى الفقد، من الوعي إلى الوجود، من المنام إلى اليقظة، ومن البوار إلى الخصوبة، عبر بنية تتطور نحو اختلاف يمارس حوارية الغياب والحضور، ويلتزم بتنسيق فوضى الذاكرة، وتفجير كثافة اللحظة، وتقليص الزمن في أتون توهجه. وبهذا المرام، فإن ليل أوزير لن يكون منجزا أبدا، فكل تجل له هو إعادة تجل، ما يشي أن متنه يبدأ ولا ينتهي، كنص مندمج، أشبه ببؤرة متشظية بانشطار الخلية إلى التوالد، كي ينثال سهرا وحمى.
ازدحام النصوص
واستتباعا لهذا التوالد، يتراءى الوقوع على تخوم حساسيات إبداعية، والتماهي بين حدودها.
على أن ما يرمي إليه سعد القرش ليس مجرد نقل هذا المحتوى أو ذاك، بله اقتحام وزحزحة النصوص، كل النصوص، وحمل حصاد اختمارها، والتشبع بها. لنقل إنه يفتح خزائن النصوص، يقارف صداقتها في الفكر والذكر، في الاستحضار والذاكرة، أو بالحري في صدق التعامل معها، لا مجرد مصاحبة أوراقها، ليتمخض نص يحتمل الإحاطة بجبروت الكتابة السائدة، بحثا عن الكامن والمستتر فيما وراء القادم، وإعادة قراءة الفائت بآليات جديدة،لا ثبات لها، ولا ركون ولا انصياع لبداهاتها.
بهذا الفحوى، يريد سعد القرش أن يرافق أصدقاء من النصوص الأخرى، نحو اقتسام مشترك للحقيقة، لا يقتصر على عبور من نص إلى آخر، بل يحتوي أكثر من نص يكون مندرجا قبلا، ليرمي به في إطار ليل أوزير، سواء كانت هذه النصوص شفاهية أو تدوينية، شعرية أو دينية، تاريخية أو يومية، أملا بتحريض نهم القراءة المفضية للتأويل، في تناسله إلى قراءات شتى.
ومع ازدحام ليل أوزير بهذه النصوص (الشفاهية، التدوينية، الشعرية، الدينية، التاريخية، واليومية)، لا يدخل هذا العمل في الحساب الروائي الشائع، مع تصادي هذه النصوص في إهابه، على هيئة تقاطبات تتفاعل داخل متنه السردي، فتتضافر في تأكيد طابعه الإشكالي، المتعالي على الحدود والضوابط، فيما يظل قابلا لأكثر من فهم، وصورة تفسير، وأفق تأويل.
من هنا، يبدو انحراف كتابته عن جلي «معروفها» نحو خفاء «مجهولها» الساعي إلى غموض أوضح. هذه صعوبته: صعوبة امتلاكه بقبضة قراءة واحدة، وعسر انتزاعه من بلاغيته.
خطاب التاريخ والموروث والتشكيل
ونبدأ بخطاب التاريخ الذي يتواتر كإطار لهذا العمل، دون الوقوع في شراك الإسقاط والتعسف، اعتبارا من أنه لا يمكن أن يدرك إلا مرويا، على ما يقول بول ريكير، وفيما ليس من البساطة اعتبار ليل أوزير كتعبير روائي لفترة عما جرى في الماضي المصري، وتحديدا ما بين دخول الحملة الفرنسية مصر نهاية القرن الثامن عشر، حتى عشرينات القرن الذي يليه، أو اعتبار صاحب هذا العمل كعارض لهذه الفترة، فيما هو أقرب إلى راء يتجاوز ما تمثله. إنه التقاط الوقائع الدالة في بدء مسيرة الحركة الوطنية المصرية، ورصد امتداداتها وتعالقاتها، من أجل أن يمنح الذاكرة أسرار غيابها أو هذيانها، انطفاءها أو تلاشيها، أو حتى بياضها واستحالتها ضمن لعبة الانكشاف والخفاء، كمحاولة لترتيب ما تبعثر من شظايا وطن صعب، لا يتعب من ليله الطويل ولم يعد يبقي منه إلا «حلما في الكرى، أو خلسة المختلس».
ورغم تسليط سعد القرش في هذه الرواية الضوء على حقبة مضت، إلا أن التاريخ لديه يبدأ من المستقبل. أي من القلق على الآتي. ذلك أنه يتعامل مع التاريخ انطلاقا من «النحن» الموجودة في «الآن» والمتجذرة في «الهنا».
إنه لا يستحضر أرواحا ميتة، ولا زمنا كان، لأن عملية الاستحضار تتم بالنسبة لما هو غائب، وهل الزمن الماضي غائب؟ هل الشخصيات التاريخية غائبة؟ إن مثل هذا الغياب لا يمكن أن يتحقق إلا بغياب الذاكرة، ذاكرة الفرد أو ذاكرة الجماعة، التي هي الموروث والتاريخ والوجدان الشعبي بكل محمولاته ومخزوناته، ما يشير إلى أن الماضي لدى هذا الروائي لا يمضي، طالما حضوره رهين بحضورنا، لأنه موجود فينا وبنا ومن خلالنا. إنه «نحن» في امتدادها إلى الخلف.
وجنب التاريخ، يتشظى الاشتغال بالموروث، يلبد في جسد النص على هيئة علامات وإشارات من معتقدات ومعارف شعبية، وعادات وتقاليد: شرب جعران مسحوق مخلوط بماء لحمل ذكر، جرح شجرة جميز ورشف لبنها للخصوبة، صب البيض فوق عنق المرأة لزيادة الإنعاظ، تجنب دخول الحائض أو حليق الشعر على العروسين، قطع أذن أي من الإخوة في الرضاع ليتم زواجهما، حمل الوليد لاسم من مات في العائلة للتفاؤل، نبوءة العرافة، النداهة، الاعتقاد في الأعداد، مواليد السيد البدوي في طنطه.
على أن هذا الموروث لا يظهر على سطح الصورة، ولكن في عمقها، فهو ذاكرة اليومي ووجدانه ولا وعيه الذي يسكن ليل أوزير وصاحبها، فيقاسهما الكتابة عن همومها الآنية والتاريخية، بدءا من المعيش والمحسوس، حتى يغوص في جسد الذاكرة والوجدان.
ومع التاريخ والموروث، يجيء خطاب التشكيل، خاصة ما يتعلق بالمكان باعتباره قطب الرحي وخيطها الناسج. إنه متشظ ومتسع ومرتبط بطبقات النص، وخاضع في معاينته لتمرس قصي وفاتن من قبل صاحبه.
ولعل ما يجعل من حديث الأمكنة في ليل أوزير حديثا مخصوصا، هو اشتغاله البصري، حين يعمد إلي تشبيع النظر، بالانفتاح على الألوان والزخرفة والنمنمة والتعشيق، سواء كان المكان مقهي، دارا، نهرا، غيطا، شرفة، حارة، غرفة، زريبة، بوابة، مسجدا، سورا، حديقة، مدينة، سطحا، مصطبة، أو جبانة.. ينسجها سعد القرش في هيئة صاعدة هابطة، مشتبكة ومتقاطعة، ملتفة وموصولة، كأنها مخطوط رحيل.
كل مكان هنا تسيل معالمه، وتتراكم أزمنته، تأخذ لحظاتها برقاب بعضها، فتتعاشق مع ذهاب الشتاء وتفتح نوار البرسيم، والسعي للرزق مع شروق الشمس، والصباح الرباح، والأذان، والليل كمأوى، ونضج القمح والشعير والكتان في آخر بشنس وأول بؤونة، ووقت الفيضان.. وذاك تواصل يضفي على هذا المكان أو ذاك الزمن طابعا إنسانيا، حين يمتزج بالطبيعة والخصوبة، فتتوه بينهم الحدود.
وفي إهاب التاريخ والموروث والتشكيل، يتراءى خطاب الحلم كحاجة إلى الامتلاء الحدسي، أو كمسافة بين الحالة وإشكالية التعبير عنها، طالما الحلم حر والواقع مقيد، وكمقام للتطهر، وليس هذيانا باذخا، أو مجرد بارقة يفرضها اللا وعي على الخيال، بل ملاحقة للزمن كفعل توتر وقلق وقاعدة يقين، يحمي الذاكرة من يقظتها المتواصلة، ويعيد استرجاع إنتاجها، ويشيلها من الوجود المعطل، ويؤمن امتدادها.
الحلم هو هاجس ليل أوزير وجدواه، حين يؤطر المسافة بين الوجود وإشكالية الوجود، في شبكة من الاحتمالات.
البناء التعبيري
يجلو هذه الخطابات بناء لغوي، ينهض على اختراق وعيين: وعي يرتجل تجربة الذاكرة بملفوظات ودوال لغوية مستعادة، وآخر يعكس لسانيا تجارب معقدة، تكشف الكائن المصري إلى نفسه.
إنها اللغة المشاركة حين تحلق بوعي معجمي يستوصي حقلا من الدوال، وتترجمها كلمات تبث شجنا يتغلغل ويستقر دون أن يرى.
ونبادئ هنا بالقول إن ليل أوزير ليست قابلة لتطبيق مقولة مقابلة الفصيح بالعامي، ما دامت ممارستها الكتابية تغتني وتتجدد وتتعدد وتتهجن بكليهما في آن.
دليلنا في ذلك، ما ينبهنا إليه عبد القاهر الجرجاني في دلائل إعجازه، حين يذكر: «أن الفصاحة لا تكون في أفراد الكلمات، وأنها إنما تكون فيها إذا ضم بعضها إلى بعض.. فإنا نرى اللفظة تكون في غاية الفصاحة في موضع، ونراها بعينها فيما لا يحصى من المواضع، وليس فيها من الفصاحة قليل ولا كثير، وإنما كان ذلك لأن المزية التي من أجلها نصف اللفظ في شأنها هذا بأنه فصيح، مزية تحدث من بعد أن لا تكون، وتظهر في الكلم من بعد أن يدخلها النظم، وهذا شيء إن أنت طلبته فيها وقد جئت بها أفرادا، لم ترم فيها نظما، ولم تحدث لها تأليفا، طلبت محالا».
ففي ليل أوزير هناك العبارات الضاربة في فصحاها:
«يكبر مثل فيضان…»
«رصاصة فرّقت الصمت…»
«امتص الظلام الرجاء والأرواح…»
«يسري الهسيس…»
وهناك المفردات والتعابير العامية المعتّقة:
«طاجن الفخار، يسحب الأنفاس، وحْل السكك، ولا حس ولا خبر، اختشي، خلاني، خش الزريبة، تخاريف، تشغي، اعملي لك همة، احمي الفرن، نار الكانون، الغشيم، صاحبة واجب، الزمام، كوز الذرة، الطاقية، الكلابة، الغيطان، الدكة، البنت العفية، يلبد الواحد منهم، من طلعة الشمس، الملقف الخشبي، كل نبق بشنس، غراب البين، الدريس، نقلة سباخ، الحلاليف، المشعوف، الدقشوم، الهرش، الخرا، فرحانة يا نظري، رحمة ونور، ينخس البغل، الخص، ما أعرف كوعي من بوعي، عفاريت الدنيا قدام عيني، عيلة وغلطت، ربنا يخلصك من وشي، فرس النبي، عقبي لكل الحبايب، من الباب للطاق، المراكيب، الطبلية، العيشة مرار، التربي، الشقارف، اختشي، الجميز الباط، داخت، الجدع، يحوش، طولها قد عرضها، الموكوس، الفواعلية، الدار، الصباحية، الشعر الناشف، لبوهم بالفرقلة، وشك ولا القمر، التلفيعة، المخبول، التجريدة، جبر الخاطر، عيب على شيبتي، المربوط».
وهناك كذلك ما بين الفصيح والعامي:
«شايب ويتصابي، يدك ملزقة، تحشم يا رجل، صار أكرش، الفاجرة، الغاوي يبين كرامة..».
وهناك مفردات فصحى:
«اليحموم، العبوس، السياج، هدها الإعياء، الأزيز، المغارم، رفع سبابتيه، يتحسس فوديه…».
وفي التقدير أن سعد القرش كان متوجسا من هذه المقابلة بين الفصيح والعامي، فتحرك فوقها بكثير من الحيطة، وهو ما حفزه لأن يعمد إلى تكثيف عبارته، وتوظيفه لتعددية اللغة، فيه كثير من الاجتهاد نحو تخصيب الدلالة وتوسيع أرجائها، بما يجيز تواصلها كحقل للتلفظ وليس إلى حقل اللغة. إنها الوسيط بين النص ومحيطه، كنقطة تتقاطع مع «الكلمات» الأخرى، فصيحة أو عامية.
على أننا لا نكون قد وفينا البناء التعبيري لهذه الرواية حقه، إذا وقفنا به عند مستواه اللغوي، دون البلاغي.
ويلفت الانتباه هنا استخدام سعد القرش أسلوبين بلاغيين هما الاستعارة، والرجع:
تعمل الاستعارة في هذا العمل على المحور الاستبدالي، وتأتي غريبة عن المنظومة الدلالية للجملة، فعندما يقول الراوي «طق المشيب» في وصفه لكبر سن عامر البطل، يقف القارئ خاصة عند الفعل «طق»: إنه علامة لغوية لا تتناسق دلالتها مع دلالات العلامة الأخرى «المشيب»، فالنواة الدلالية للعلامة «طق» تنتمي إلى نمط القوة، فيما تنتسب العلامة التالية «المشيب» إلى نمط دلالي مختلف هو الضعف والعجز، وتأتي الصورة من هذا الاختلاف.
أما الرجع، فله تركيب التصادي، ويتم بربط الزمن بمواجيد أهل القرية: فذهاب الشتاء يستتبعه تفتح نوار البرسيم، وشروق الشمس يتراءى مع السعي للرزق، والليل للمأوى، والأذان للتنبيه، وآخر بشنس وأول بؤونة لنضج القمح والشعير، وأمشير لتقلب المزاج، ووقت الفيضان للاستعداد.
المتن الحكائي
لنخفف من استعجالنا مقاربة هذا العمل، بحديث عن متنة الحكائي الذي يصور عالم قرية مصرية، هي قرية أوزير، وسيدها هو عامر كائن نصي ينتمي إلى عائلة يهلك منها عزيز كل خمسين سنة، وجده عمران هو مؤسسها. وبحجة الدفاع عنه، يأتيه منصور القهوجي، وابنه خليفة، ليستلبا مسئولياته في الحفاظ على القرية وأهلها، ومعهم الغجر وبعض الأعراب والغرباء، منهم موران الفرنسي وكارلو البندقي.
ينجب عامر ولديه يحيى وإدريس من زوجته صفية المتوفاة. وحين يشتد عسف منصور ومن بعده ولده خليفة، يلوذ يحيى بالسلف الصالح، فيما يتولى إدريس منطق المقاومة.
إن عالم الرواية مهشم متشظ، تسوده الفوضى، لا تلتئم فيه الوقائع إلا لتتفرق، رغم ما في بنائه من دقة وإحكام واتساق. إنه عالم معاد تمثيله طبقا لرؤية احتجاجية، ما يصيرها نصا حداثيا متميزا بالدينامية والتوالد والانفتاح، أنجزه روائي مصري شاب، ويتم إنجازه قارئ ذكي من خلال ملئه الفراغ واستحضار الشاهد على الغائب واستنطاق المكتوب واستجوابه ومحاورته.
يفتتح سعد القرش نصه باستهلال أقرب إلى مقدمة طللية، تشرع الباب على ما سوف يأتي، ويجمع عنوانه بين الإيحاء ودقة المطابقة، وينتثر متنه على هيئة شجرية. الشجرة الأم هي عامر، وأغصانها أربعون فصلا بعناوين رقمية، خلا الفصل الأول الذي أعطاه عنوان «منصور»، والفصل السادس والعشرين بعنوان «إدريس».
وفي طوايا المتن، تتبدى نصوص موازية من أهازيج النساء، والشعر القديم، ووثائق حول عمرو بن العاص وعبد الملك بن مروان والمأمون والوالي مزاحم بن خاقان، ومعها تتواصل بهجة الحياة في رمزية أجساد مسكونة بالرغبة والتوق إلى الجديد، يستشهد بها سعد القرش كدليل مضاف، لكونها بقول ابن الخطيب «من الشجرة بمنزلة النسيم الذي يحرك عذبات أفنانها».
هذا عمل يخط صدقه في ملامسة الأزمنة الثلاثة: الماضي، الحاضر، والمستقبل، فيما الخيال فيه إحلال للواقع بغية تلقيه وإدراكه. وهنا ينعقد سؤال ماثل: هل يدعي ليل أوزير شيئا، لو قالت إن محتواها هو في فقه سؤال الحرية؟ وذاك سؤال يمتحن صدق نوايانا، بقدر ما يفضح مزاعمنا الحالة في إرادة التحرير والمعرفة. إنه الرهان الواجب على النص الروائي أن يأخذ به: الإطلال على الحاضر والمستقبل عبر ماضيهما. لكن المسألة هنا ليست مجرد ثنائيات ناجزة، وإنما ما يقع بينهما من تفاعل، تجاذب، تواطؤ، وتناكر، وتلك كتابة عاشقة: الوعي بها مكابدة للخروج من عكارة الاستبداد ولظاه.
ذلك أنه مع قراءة نص سعد القرش، يقع اجتثاث عروقنا من موضع تربتها القديمة، تماما كما اقتلاع المولود من رحم أمه، وزرعه في تربة لا تقل خصبا وحياة، هي تربة الذاكرة وهي تسألها، إسهاما في إعادة صوغ أسئلة الراهن والقادم، من خلال مقدرة إيحائية، ألمحت وهيأت وأشارت: قد تتحول إلى ما يرتد كاهلا نحو طفولته، إلى ما عاش يخافه ويرتابه، إلى ما يتمناه على صعيد التحقق الإنساني، ويحلمه بين اليقظة والمنام، في زمن متحول نحو الأفول.
وهل تطمح الكتابة إلى أبعد من هذا النصر على أحط الاتهامات، وفي أولها الاستبداد؟ نعم، ليكن كل شيء دفعة واحدة، فالأهم أن نصهل بزيفنا كي نكون بعد السفاح في بداية المبادرة.
…………..