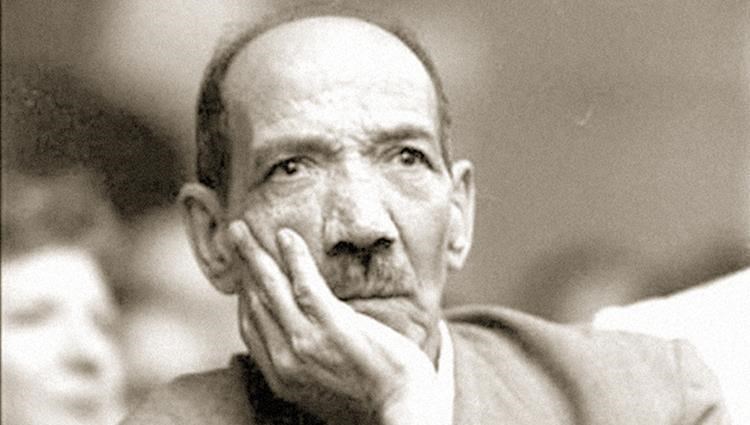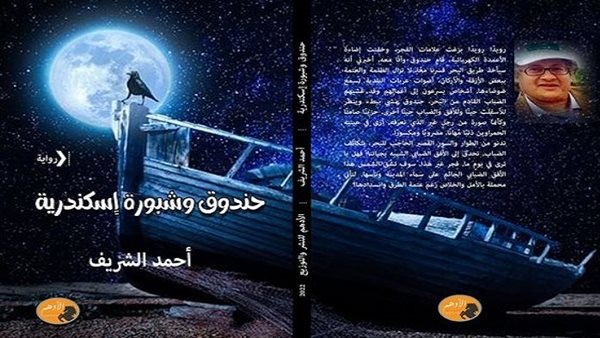محمد أبوالدهب
أدخلتْني رواية (بسمة) في حالةٍ من (الاضطراب العاطفي الفني!) إذ وجدتُّني واقعًا في غرام صفحات منها قبل أن أضبطني متثاقلًا عن مواصلة قراءة صفحات أخرى، وظللتُ مذبذبًا بين الحالتين، وإنْ كانت الغلبة بالتأكيد للوقوع في الغرام!
للروائي رأفت الخولي قدرة ملحوظة على الإعداد الذهني المبدئي (لا أقول وضْع خطة كاملة مهندَسة) لروايته من حيث زمان ومكان وشخوص عمله وميزان الصراع بينها صعودًا وهبوطًا (الدراما في الحقيقة بمعناها الماضي المستمر!)، وهذه القدرة تفرز إشكاليتها من داخلها، فكَونها ملحوظة لا يعني أبعد من تلمُّسها في أثناء القراءة باعتبار أنها استُهلكت (كُتبت ذهنيًّا) قبل الشُّروع الفعلي في عملية كتابتها، ثم خُزِّنت ليجترَّها الكاتب، أو يستحضر ما يتاح له استحضاره منها، بخطوطها العريضة والمتفرّعة وشخصيّاتها المتعددة وتفاصيلها الكثيرة، في الشكل والمضمون النهائيين اللذَين يراهما مناسبَين، أو اللذين لا يرى غيرهما. لنتأرجح، معشر القراء، من موضع إلى آخر بالرواية بين ما حصل استدعاؤه من خزينة الذهن بتمكُّن وانفعال و(انتقاء) وبين ذلك الذي ينطبق عليه القول: سبق اللسانُ القلبَ!.. ثم في الأخير ما سقط سهوًا فاستُبدل بما حضر عفوًا! سواء على مستوى لغة المسرود أو خيط المحكيّ، وتزيد وتيرةُ تأرجحنا كلما بعدت مسافة الزمن بين الإعداد والتنفيذ. قد تنسحب هذه الفكرة، بنسب متفاوتة بالطبع، على روايات رأفت الخولي الخمس التي أصدرها في السنوات الخمس الأخيرة عن دار النسيم، وآخرها رواية (بسمة) التي نحن بصددها. ألا يبدو كلامي غريبًا، ضربًا من التنجيم أو رجمًا بالغيب؟!
تقوم قيامةُ رواية (بسمة) على أضلاع ثلاثة، الأول علاقة حبّ (لا بُدّ أن أقول إنها أخذت منحى شاذا)، على الأقل من جانب أحد طرفيها -وأخذت طابعًا جنسيّا منقوصًا- بين طه وزوجة أبيه (بسمة)، طه الذي صُدم يومًا في الفصل حين علمَ من مُدرِّسه على نحوٍ غير مباشر أنها ليست أمه، فتحوّل مبكّرًا جدًّا وباندفاع من الإبن إلى الإبن العاشق، في حياة أبيه وبعد موته، وفي هذا الشأن تُحيلنا فقراتٌ عديدة بجدارة من روايتنا (بسمة) إلى الرواية الإيروتيكيّة القصيرة البديعة (امتداح الخالة) للروائي البيروفي الإسباني ماريو بارجاس يوسا، خاصة في أول افتتان طه بها وغيرته عليها من أبيه. ربما يكون هذا الضلع هو الذي أُفرغ بالتّمكن المشار إليه سابقًا. لكن رأفت الخولي لا يريد، لاعتبارات قد ندرك بعضها، أن تقوم روايته كلها على علاقة ملفوظة بامتياز، خاصة حين نعرف أنها تشكّلتْ ونمتْ في قرية بعمق ريف الدلتا وفي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وبالتالي أضاف ضلعًا ثانيا: علاقة حب (طبيعية هذه المرة، ظاهرًا وبدايةً) بين طه وسحر، الشابّين الجامعيين المغتربين في أسيوط للدراسة في كلية التجارة بجامعتها. هل تعيد هذه العلاقة التوازن الذي شبَّ طه على فقده مع بسمة؟ بالطبع لا، لأن هذا الضلع من صناعة فئة الاستدعاء الثانية: سبقَ اللسانُ القلبَ. وأنتج هذا السبق مصادفةَ اللقاء في قطار الصعيد بشرط أن يتعطّل القطار (مع أنها مصادفة لا غبار عليها في حدّ ذاتها) ثم المصادفة الأفدح أن لسحر زوج أُمّ مثلما لطه زوجة أب، هل يكسر رأفت الخولي توقعاتنا؟ إنه لم يفعل، فزوج الأم واقَعَها وفضّ بكارتها، ثم زوَّجها ابنَه لعدة أشهر بعِلم أمها مداراةً للموضوع. ويعترف لها طه بما كان منه مع بسمة، ليتجابها بعُقَدهما بدلًا من أن يلتحما للتخلُّص من أثرها. وأنتج السبق أيضا سفرَ طه فجأة إلى الاسكندرية التي لم يرها من قبل، ليقتل حسن غريب (زوج أم سحر) الذي لم يره من قبل!.. وموتَ سحر في حادثة قطار. الضلع الثالث قام على نثار شخوص وأحداث وأماكن ساهم حضورها في الربط والتقريب بين مسار الضلعين الآخرين تارةً وفي الحصول على هدنةٍ من زخمهما تارةً أخرى (زواج بسمة من فتحي الأعمى بعد وفاة والد طه.. محمد عايد ناظر الزراعة يشتهي بسمة ويطاردها.. مقتل السادات قبل سفر طه إلى أسيوط “محافظة أسيوط تحديدًا كان لها وضع أمني خاص بعد هذه الواقعة”.. شقة مصطفى زميل طه وما يحدث فيها.. ملخص مفاجئ لقصة حياة فتحية الجارة……) وكان هذا الحضور متفاوت التأثير في مسيرة الرواية إذ يصل من القوة بحيث يؤدي إلى أن يقتل طه “محمدَ عايد” لأنه حاول الاعتداء على بسمة فينحرف مسار حياة طه تماما، ويظهر أيضا عديم التأثير، وإنْ أراد الكاتب غير ذلك، كاعتقال إمام مسجد القرية بعد اغتيال السادات لفترة ثم خروجه.
الحدوتة إذن مشوّقة (لماذا أتحدث مع ذلك عن إشكاليات!) ويمكن القول إنها صادمة لوعي زمانها ومكانها، داخل وحول ولصق ضلعها الأول بالتحديد. لذلك كان الجزء من الرواية الذي دارت أحداثه في القرية -حتى بعد العودة القصيرة لطه من غيابه الطويل (قصيرة لأن الرواية انتهت بها مثلما بدأت بها لاعتمادها على تقنية الاسترجاع)، كما لو أن القرية كوجودٍ مجرّد فقط هي السر- بعيدًا عن أسيوط وعن المصحة النفسية التي مكث بها عشرين عاما في قسم المودعين كقاتلٍ مختلّ عقليا، هذا الجزء هو الأكثر تماسكا شكلا ومضمونا والأكثر تفلُّتًا من توقعات القارئ والأقل احتياجا إلى الاختزال. تبدّتْ فيه إمكانات الروائي رأفت الخولي في وصف الأماكن والمشاهد باستمتاع وحميمية حتى أني أكاد أجزم أن هذه الرواية سيكون لها رصيد كبير من الألفة والمحبة لدى شريحة معينة من قرائها، أولئك الذين يَفَعوا في ريف سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وأنا منهم، لأنها تضعهم في حالة خالصة من النوستالجيا لأماكن زمانٍ ولَّى ومناسباته وأحداثه، ولا يزالون يرونه جميلاً. فلنقرأ معا هذا المقتطع: (أول بيت في هذا الشارع الذي يربط النهرين، والذي يبدو مستقيما كأنبوب هواء معتدل، عُلِّقت على حائطه الخارجي لافتة واضحة المعالم أظنها من الألمونيوم، مكتوب عليها “شارع سيدي العاصمي”. عند المنتصف، وعلى يسار المتجه إلى النهر الصغير، بعد نهاية سور معهد الفتيات، تقبع قبّتان لضريحين… يؤطرهما سور من الجصّ الأصفر، تتوسطه بوابة حديد مغلقة دائما بقفل وجنزير صدئ، يجاور البوابةَ مدخلٌ يتقدمه باب متهالك من خشب السنط، مكتوب عليه بخط النسخ “محطة شفط الصرف الصحيّ”).. ليس الأمر إخبارًا عن التطور الذي أصاب القرية فصار بها محطات شفط بعد أن كانت تعوم على بحيراتٍ من الخزانات القديمة المتسرّبة تحت البيوت وفي الشوارع، إن مَن يتلقون الخبر على هذا النحو هم بلا ريب خارج الشريحة التي ذكرتُها آنفًا، والتي سيتساءل المنتمون إليها عن الشارع الذي يربط النهرين هل ما زال يربطهما أم أن الدنيا تغيرت؟ وعن مقام سيدي العاصمي وليلته السنوية (وكل قرية فيها سيدي العاصمي -أو كان فيها- وإنْ بأسماء أخرى) وعن قبة الضريح وسور الجص الأصفر والبوابة، والأيام والليالي التي كانت فيها هذه المعالم ملء السمع والبصر ومقصد الجميع. إن رأفت الخولي خيرُ مَن يأخذ بيد قارئه في جولة غير مملة بين داير ناحية قريته وحاراتها، بين الجسر الذي على النهر أو تحت ظلّ شجرة على الترعة، ليُطعمه على رأس غيط (ويدشّ له بصلة) أو يدخله بيتًا لم يعد له وجود (لم يعد لطرازه وجود) ليفتح زلعة المِشِّ ويُخرج له من كنوزها!.. كأنه يدافع بآخر أنفاسه، حتى لا يكون الخسران مضاعفًا، خسران المعايشة والذاكرة، خاصة أن طه نفسه بعد عودته رأى الذي كان وقد صار فراغًا في فراغ: “….ربما أمست الأشياء هي التي لا تعرفني. تغيرت جغرافيا المكان، الجمادات والناس والضوء والطيور، حتى سقف البيت وجدرانه لم تعد هي، لم أعد أراها ولا هي أصبحت تراني كأنني متمدّدٌ في الفراغ”.
يستطيع رأفت الخولي أن يتقافز خفيفًا سلسًا من ربوةٍ إلى أخرى على هضبة سرديته، على كثرتها وتباين ارتفاعاتها، ويُشعرنا أحيانا أن هذا التقافز يأتي عفويا دون أن يُرهقه كأنه تقافُز مَن يلهو، فقد ننتقل معه في صفحة واحدة بين وصف خارجيّ لمكان ثم سرد ذهني لهواجس إحدى شخصياته أو ذهاب إلى نبأ من تاريخ قديم لشخصية أخرى قبل أن يعود بنا إلى نقطة الدفق الأولى دون أن نتهمه بتشتيتنا. لكنه حين يستنيم تماما لحماسة الحكي (حماسة استدعاء المحكي مسبقا في ذهنه، خصوصا فئة الاستدعاء الثالثة التي يحلُّ علينا بعضها كيفما اتفق) فإنه لا يشتّتنا أيضا إنما يقسو علينا إذ يطردنا (بتأدُّب) لبعض الوقت خارج مقر ضيافتنا المختار بعناية بروايته (الآن أعرف كيف تفرّقَ دمي بين الوقوع في الغرام والتّثاقل!) وإلا فأي معنى لهذا الإطناب الطويل (هل أقول المبالَغ فيه؟) لشرح وتفسير وتحليل دوافع محمد عايد وحسن غريب تجاه بسمة وسحر؟ أو حين يفاجئنا في أواخر روايته بقصة حياة فتحية (ذكرتُ ذلك سابقا) دون أن يلقي إلينا طُعما في أوائلها لنلتقطه ثم نبتلعه بشأنها!.. هي نفسها الحماسة التي تجعله يتخلّى قليلا عن ميزان لغته الحسّاس على مستوى تركيب الجملة (قبل وفي أثناء وبعد كتابتها) وزحمة الضمائر، مع التسليم بأن لغته بوجه عام تحافظ على علاقتها العضوية بالنصّ.
أثبت رأفت الخولي جدّية محبته لفن الرواية، برواياته الخمس التي كتبها في فترة زمنية ليست بالطويلة، وأن حالته الروائية لا تقبل التهاون بها أو التراجع عنها، وأتصور أن سِرَّ أسراره فيما يخص هذه الحالة هو (القرية)، قريته بمواصفاتها الزمنية والتراثية المشار إليها، بتخاطره الروحيّ الحميم والمختلف معها، ستكون منبع ألقه الروائي الخاص، وسيختزل الاحتفاء بها دون شريك كثيرا من إشكاليات نصّه، ودون أن تستحيل بأي حال نسخة من قرية سعيد الكفراوي أو يوسف أبو ريّة أو محمد إبراهيم طه.