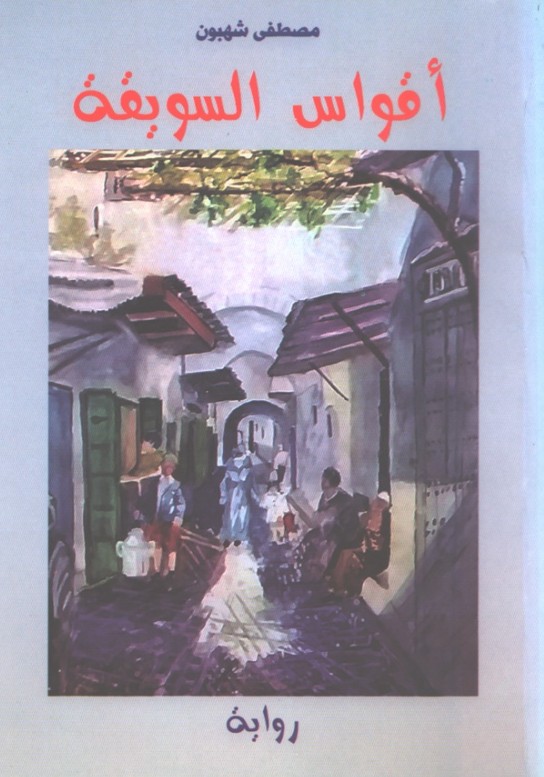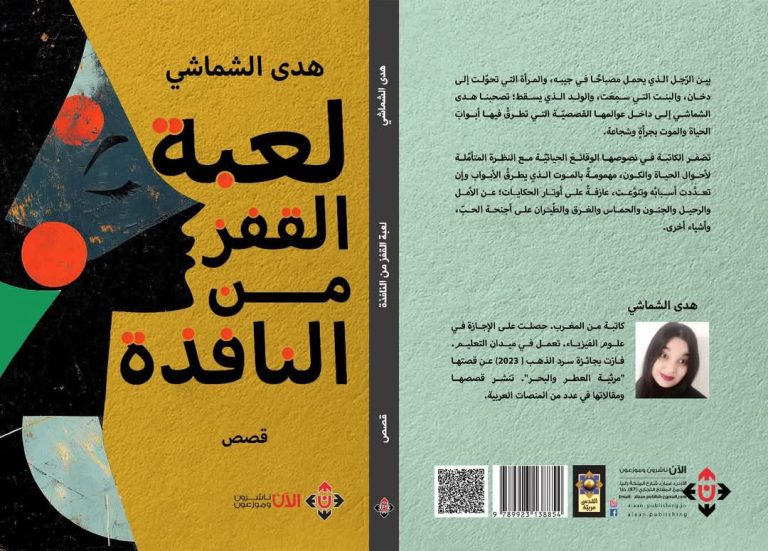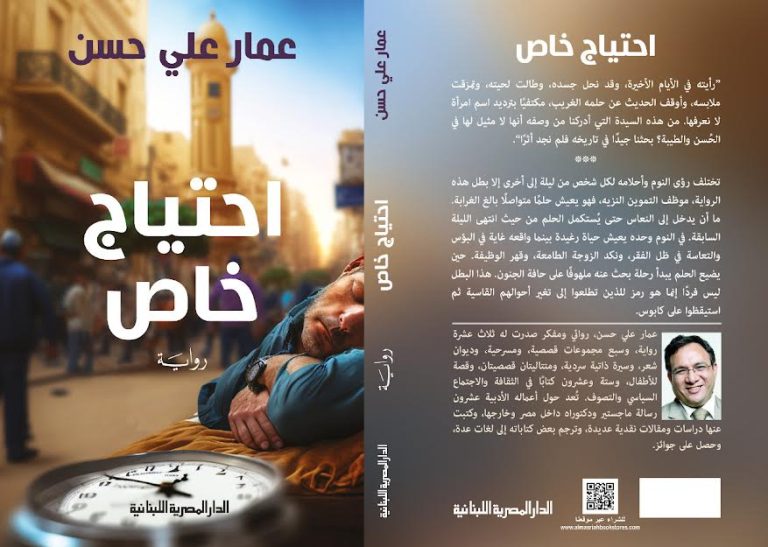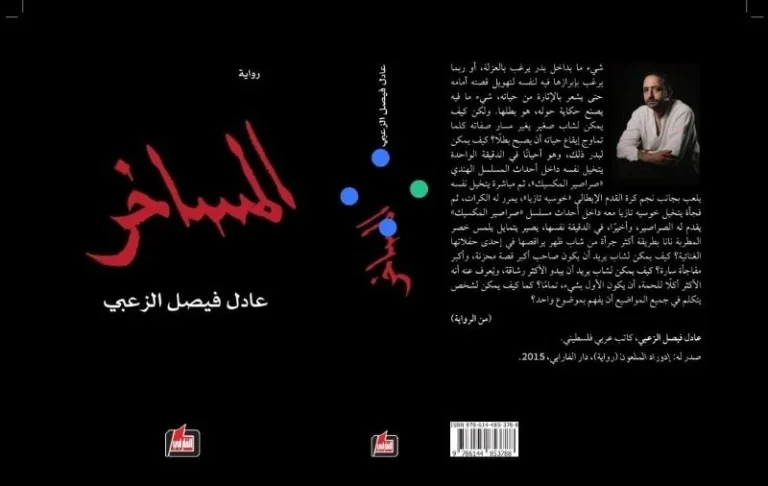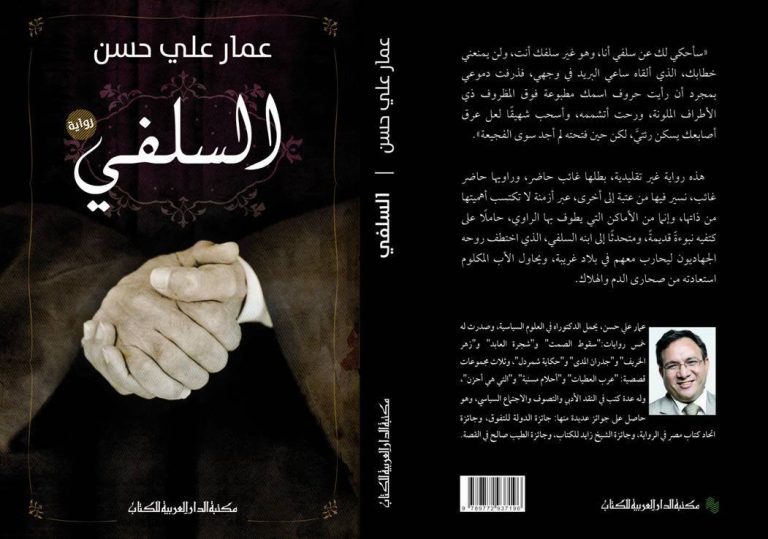خالد البقالي القاسمي
المبدع مصطفى شهبون روائي مغربي ينتمي إلى جيل الرواد الأوائل الذين خبروا جيدا تجربة الحياة في فترة الستينيات من القرن العشرين. وهي فترة تميزت بكثير من التحولات على مستوى جميع المجالات. كما تميزت هذه الفترة كذلك بنوعية الأحلام، والطموحات التي كان الشباب يحملونها، باعتبارها سلما سوف يفضي بهم إلى تحقيق ما كانوا يصبون إليه من حياة كريمة، توفر لهم ولذويهم شروط العيش اللائق. المبدع مصطفى شهبون كان يحمل أحلاما تتجاوز طاقته النفسية، وتفيض عن كفايته، بحيث عمل بعد حصوله على شهادة جامعية عليا على تجاوز أحلامه المادية الصرفة، وانتقل إلى مرحلة أرقى، وأوسع، وأرحب، وهي مرحلة توثيق الأحلام، فاستثمر الفائض في كتابة رواية ذات بعد سيرـ ذاتي، أو لنقل سيرة ذاتية روائية، أثبت فيها تاريخ حي السويقة الذي تربى فيه، وترعرع بين جنباته. فكان بهذا العمل بمثابة شاهد على عصره، وبمثابة مشخص لطبيعة العلاقات وأنواع التواصل التي كانت سائدة بين أفراد جيله. وقد أسهم بعمله الروائي الجميل هذا أقواس السويقة في تسجيل كثير من عناصر التطور، والتغيير، والتنمية التي عرفها هذا الحي بمدينة تطوان المغربية، باعتباره تمثيلا لباقي الأحياء بالمدينة بصفة خاصة، وتمثيلا كذلك لباقي أحياء مدن المملكة المغربية بصفة عامة.
عندما اختار المبدع مصطفى شهبون عنوانا له علاقة وطيدة بجغرافية الحي كان يدرك جيدا بأنه بصدد تسجيل رسالة تاريخية لكل من عرف الحي، أو كان مستقرا به، أو سمع به من بعيد. هذه الرسالة لها دلالة حضارية ومعمارية تفضي إلى تصور أكيد، وهو أن الحي عبارة عن معلمة فريدة بين الأحياء. وأن أقواس السويقة هي مكون أساسي من مكونات حياة كثير من الناس الذين عاشوا بالحي، ودرجوا مع أبنائهم وبناتهم على اعتماده منطلقا لبناء التصورات الضرورية لوسائل عيشهم. لقد كان المبدع يرمي إلى إيقاظ جذوة الذكرى المشرقة في نفوس كل من عشق حي السويقة بأقواسه، ودوره، وطبيعة الحياة التي كانت سائدة في زمن مضى. لقد كان هدف المبدع هو أن يبرز حجم الحب الذي يكنه للحي الذي سكن قلبه، وأن يبرز حجم الوفاء الذي يحتفظ به في وجدانه تكريما للحي العريق.
يعتبر القوس بالمعنى الهندسي المعماري بمثابة هيكل، يتميز بأنه منحني من الجانبين. وقد يكون هدف القوس هو العمل على تدعيم الوزن فوقه، بمعنى أن يكون القوس حاملا لبناء مقام فوق قاعدته. وقد يكون القوس عاديا، لا يحمل أي وزن أو بناء فوقه، فقط هو قوس مقام بغرض إثبات نوع من الجمالية، أو البراعة في إقامة الأبنية.
وقد عرفت كثير من الحضارات في تاريخ البلدان إقامة أقواس أثناء تشييد المباني، والقصور، والمعالم التاريخية. ويمكن أن تكون تلك الأقواس صغيرة الحجم فتعبر بذلك عن نوع من الضرورة الهندسية أو الجمالية، وقد تكون كبيرة الحجم فتعبر بذلك عن نوع من الأحلام السيادية الهائلة التي ليس لها حدود على مستوى الطموحات والتطلعات. ثم إن الأقواس قد تشكل محل عبور سريع، أو عبور مؤقت، أو قد تشكل محل استقرار دائم، يبقى أن الأمر متروك لطبيعة التعامل مع الأقواس، ولطبيعة التواصل معها، من حيث احترامها وتقديرها، أو من حيث ابتذالها والاستهانة بها.
يدل الاهتمام بالأقواس، والتركيز عليها بالبناء والزخرفة على:
ــ الإعلاء من شأنها، والرفع من قيمتها.
ــ اعتمادها كقاعدة لإقامة الاحتفالات الجماهيرية ( = أقواس النصر ). بمعنى أن الأقواس في ذاتها لها بعد احتفالي، أو إنها تندرج ضمن مجال الاحتفالية في الكتابة.
ــ الاحتفال بذكرى محددة، أو بحدث مقصود، أو تمجيد لبعض الشخصيات.
ــ نوع من الائتمان الشخصي، فيحس الروائي أو صاحب السيرة الذاتية بكونه يحمل فوق كاهله أمانة نفيسة، ينبغي الحفاظ عليها وهي محاطة بذكرياتها المجيدة.
ــ حدوث ما يمكن تسميته بالاختلال، أو التغير السريع، وهو أمر يصيب بالفزع، ويدفع المبدع إلى الالتصاق بالأقواس اعتقادا منه بأن الكتابة عنها سوف تضمن لها الإنقاذ، والتحصين من كل تأثير سلبي خارجي.
وبما أن المبدع عمل على صياغة نص سردي احتفاء بالأقواس، فإنه بالتأكيد قد قصد إلى سبب من الأسباب المدرجة أعلاه، أو لنقل إنه قصد إلى هذه الأسباب كلها، لأن الحي الذي اعتمده للكتابة هو حي يعرف انتشارا كبيرا للأقواس، إذ هي بمثابة علامات راسخة في هيكل الحي، إنها الأصل والمحتد، ولذلك كان المبدع يرمي بعمله إلى استعادة الأصل، وتكراره من جديد، وكأنه يغوص في الماضي مرة أخرى من أجل بناء الأصل والمصدر، أو كمن يعتقد بأن الكتابة عن الأقواس هو إعادة الريادة لشموخها وعنفوانها. والذي يثيرنا هنا هو هذا الغوص في الماضي، إذ هو الذي نطمع أن يحدد لنا طبيعة هذا النص، فهو يبدو كأنه سيرة ذاتية، ولكن شروط السيرة الذاتية لا تتوفر فيه بالأصالة، إذ هو بقدر ما يثير الحديث عن نفسه وذاته بقدر ما يركز قصه على كثير من شخصيات الحي، ثم إن الأمر ربما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الحي هو الذي يحظى بسيرته الخاصة ضمن هذا النص، وحضور الشخصيات الأخرى الكثيرة هو من باب التأثيث فقط، وقد أشرنا سابقا إلى أن النص ربما كان من نوع السيرة الذاتية الروائية، إذ: إن أهم سبب في قيام علاقة مميزة بين الرواية والسيرة الذاتية إنما يتمثل بداهة في أن السيرة الذاتية قد جعلت لنفسها هدفا مماثلا لهدف فصيلة كاملة من الروايات، وهو أن تقص علينا حياة شخص (1).
بهذا المعنى نستطيع أن نقول إن النص الذي كتبه المبدع هو من قبيل السيرة الذاتية، لأنه يركز في نصه على حياته وحياة الآخرين بين أقواس الحي، ولهذا فإننا يمكن أن نكون بإزاء نص سير ذاتي. ولكننا عندما نتقدم في القراءة والتحليل سرعان ما نستشف بأن النص ينحو نحو مجال الرواية، ولهذا فإننا وفي نفس الوقت يمكن أن نكون بصدد نص روائي، إذ هما كما نلاحظ قريبان من بعضهما البعض، وبهذا التقارب: يتضح لنا أن القص السير ذاتي يمكن له أن ينسج على منوال القص الروائي، ويظهر بمظهره، حتى إن المرء ليعجز عن التمييز بينهما إذا لم يعتمد مقاييس خارجية (2).
ولكننا مرة أخرى سرعان ما سوف نلاحظ بأن المبدع أثبت في ظهر الغلاف الخارجي بأن عمله هو رواية، ولم يحدد عقدا أو ميثاقا يتعهد فيه بأنه بصدد كتابة نص في السيرة الذاتية، لأن الميثاق السير ذاتي ضروري الإثبات في بداية العمل: إنه نمط من أنماط القراءة مثلما أنه ضرب من ضروب الكتابة (3). وكثيرا ما يختلط العمل الروائي بالسيرة الذاتية من حيث التقاؤهما في طريقة الحكي، ولهذا فإن: ما يميز موقفنا عند قراءة سيرة ذاتية من موقفنا عند قراءة رواية، ليس كون الأولى حقيقية والثانية خيالية، وإنما كون الأولى تظهر لنا في لبوس الحقيقة، والثانية في لبوس الخيال (4). وبما أن الحقيقة والتخييل يختلطان في هذا العمل بدرجة طاغية، فإننا نستطيع أن نختصر الإشكال ونعتبر أن النص الذي بين أيدينا يندرج في مجال السيرة الذاتية الروائية كما صادرنا على ذلك سابقا، حيث لا يستطيع المؤلف أن يقنعنا بجدارة تمثيل سيرته لكل الحقيقة، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يقنعنا بمجانبة التخييل الروائي لديه للواقع في صفائه وكماله. ورغم أن المبدع وضع مسمى رواية في الغلاف الخارجي للنص، فإن السياق العام لا يدل حتما على أن الأمر يتعلق فعلا برواية، ويبقى أن حضور النوعين في النص له مبرراته المنطقية، والفنية، وبالتالي فهو يظل مشرعا على كل التصنيفات النظرية.
سياق المبدع لأقواس السويقة لا يعد عاديا، بل إن الاحتفاء بهذه التحف المعمارية يرتبط لديه بما يمكن أن نصطلح عليه بمنحنى الشخصية، أو قوس الشخصية، وهذا الارتباط هو الذي يسوغ له إمكانية تحقيق التشابه بين الأقواس، والتشابه منطقيا عبارة عن علاقة تجعل الطرفين يلتقيان ضمن عدة وجوه وصور. وقوس الشخصية الروائي أتاح للمبدع عملية توضيح المسار الذي سوف تجتازه كل شخصية روائية في تدافعها مع الشخصيات الأخرى، حيث لكل شخصية في النص مسار خاص. وتتقاطع المسارات فيما بينها وهي تخترق العمل الإبداعي من الداخل، مستفيدة من الإمكانات التي توفرها التغيرات والتطورات التي تحل بمنحنى الشخصية في تفاعله مع الأحداث والشخصيات الأخرى في الرواية.
لقد عرفت ذاكرة المبدع صحوة مميزة فعمل على إنتاج هذا النص، وذلك انطلاقا من مزجه بين الحلم، والتخييل، واستثمار الصور الذهنية المستعادة التي كانت مغيبة في عمق اللاشعور، إن ثقلها الروحي هو الذي حذا به لكي يقوم باستحضارها وتفريغها ضمن الوعاء الروائي المناسب لشروطها، وإمكاناتها، وخصوصياتها. صيغة الأحداث هي التي أوحت للمبدع بإمكان تحويلها إلى متن حكائي مميز. لأن الأمر غالبا ما يحدث في شكل اختراق للمكان، بمعنى أن المكان في هذه الرواية هو الذي يتحدث، ويروي، ويوجه. وبما أن المبدع اعتمد حي السويقة إطارا إبداعيا فإنه أصبح فضاء روائيا مستفيدا من جميع المزايا التي تتيحها الأقواس. واختراق المكان هو فقط انطلاقة وبداية، إذ يوفر هذا الاختراق إمكانية التوقف في جميع الأمكنة التي تعانقها الأقواس، وتحتويها، سواء تحتها، أو بمحاذاتها، أو بين قوس وآخر، والتعبير عنها بواسطة المشاعر والعواطف المتنوعة التي يكنها الراوي للشخصيات الروائية التي تمت عملية إبداعها حسب الأحداث والوقائع التي شهد عليها المكان.
لقد انطلق الحكي في الرواية بصيغة فريدة من نوعها، وهي صيغة أراد بها المبدع ربط حي السويقة بعمقه الأصيل والمتنوع. الانطلاقة كانت من داخل الحمام الشعبي، وبالضبط بحدث عاشه الكثير من الذكور الصبيان عندما كانوا يرافقون أمهاتهم في صغرهم إلى حمام النساء. وكأن المبدع أراد أن يشرع في عمله بتعميد شخصياته، عن طريق تحقيق طهارتهم البدنية والروحية معا. والسارد هنا كأنه مسيح حي السويقة، لأن الأصل أن التعميد طقس مسيحي خالص، وقد كان أول من تم تعميده هو السيد المسيح، ويكون التعميد من أجل محو الأخطاء، إلا بالنسبة للسيد المسيح، فقد تم تعميده لكي يتحمل هو أخطاء المسيحيين. الاغتسال في حمام حي السويقة هنا هو إعلان، وإيذان بولوج الشخصيات مجالها الروائي، بمعنى أن المبدع أباح للسارد تحريك الشخصيات، وإدخالها غمار صنع الأحداث وتبادلها، ومن ثمة سوف يتمكن من استعادة الحي الذي كان بالنسبة للمبدع قد أصبح ضمن الزمن الماضي.
استثمار الزمن في هذا المقام هو الذي أعطى للمبدع إمكانية العودة لتمثل الحياة التي عاشها سابقا، إنه يستطيع الآن بواسطة مجتمع الرواية أن يسترجع الأمجاد التي اعتبرها غاضت في حي السويقة بسبب الحداثة، والعصرنة التي عرفتها المدينة، إنه يقف الآن على ماضيه الذي كان قد تلاشى، واضمحل تماما، لقد استطاع أن يستعيد ماضيه بواسطة اللغة، وهو بذلك يوظف لغة حاضره لكي يعالج بها أعطاب ماضيه، إنها عملية قلب زمني ممكنة على مستوى تشغيل حيز اللاشعور وجعله في أقصى درجات نشاطه، مما يمكن من ليس فقط فهم الأبعاد الرمزية لمعاني ودلالات الأحداث التي عرفها حي السويقة، بل وكذلك القيام باستيعابها وإدراكها جيدا. إذ إن لعبة القلب الزمني تتيح للمبدع بواسطة سارده فهم الأشياء في الزمن الحاضر فهما جيدا، والعودة إلى الزمن الماضي من أجل إعادة تشكيل نوعية العلاقة معها بمنظور جديد يبرز فيه الوعي اليقظ بشكل واضح، وفعال. إن هذا الإدراك الجديد الذي هو ثمرة السفر عبر الزمن ذهابا وجيئة، والذي يعتقد المبدع في روايته بأنه جيد، ومصيب، سوف يكون بالضرورة مساعدا له على استثمار طاقته الإبداعية في إنتاج تخيلات خاصة مرتبطة بكل موضوع، أو اسم، أو شخصية ضمن العالم الروائي. سوف يصبح في طاقة المبدع إنتاج الأحداث الروائية، وتحقيق التدافع بين الشخصيات، وتصنيف الوقائع حسب طبيعتها، وأهميتها، انطلاقا من الفهم الجديد الذي اكتسبه بواسطة المراوحة الزمنية بين الماضي والحاضر.
إن الصورة الروائية التي انطلق بها النص داخل الحمام توحي بأن المبدع يفضل ولوج المتن الحكائي من الداخل حتى يحكم عليه قبضته الفنية، ومن ثمة يستطيع بسهولة التسلل إلى الخارج أي إلى فضاء حي السويقة. وبما أنه يعرف أسرار الحي، فإنه يدرك جيدا بأن ما يختزنه الداخل هو أكثر عمقا وسمكا من مثيله في الخارج. مقابلة الداخل بالخارج توحي بأن فضاء حي السويقة كان يتم التحكم فيه من داخل الحجرات المغلقة التي كانت تخفي أكثر مما كانت تعلن. فكان الانطلاق من الحمام بكل ما يكتنزه من خبايا وأسرار، إذ كل ما يحدث بحي السويقة يتم تداوله في حمام النساء، بما هو تمثيل للوعاء المعرفي السائد. جميع ما يتعلق بتدبير حي السويقة يتم طبخه على نار متفاوتة الحرارة حسب درجة أهميته أو خطورته، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الخارج معدا للتنفيذ والتطبيق. وهذا المعنى هو الذي أتاح للمبدع إمكانية إعادة تشكيل رؤيته لحقيقة ما يجري بالحي انطلاقا من المعالجة الزمنية التي استثمر حركيتها السردية، ومن ثمة قام بإعادة تفسير ما يحدث، وتأويله وفق الآليات التي توفرت له، بحيث إن المسافة الزمنية التي أبعدته عن الحي هي التي ساعدته على تعديل منهجه في التعاطي مع أحداثه، وموضوعاته، ووقائعه، وشخصياته.
إن ما أشرنا إليه أعلاه يفيدنا بأن النص مشحون بالرموز التي تضفي على الرواية طابعا جماليا، وإذا كان الحمام مركزا لتوزيع الأبعاد الرمزية من خلال الطقوس التي تجري بداخله، وتشرط إمكاناته التي يتيحها، فإن ذلك يمنحنا إمكانية الحديث عن هذا النص الروائي باعتباره نصا طقوسيا، وبما أن النص طقوسي، أو إذا سلمنا بذلك فهو يمتلك طابع الفرجة، هو فرجوي تتمثل فيه عناصر الفرجة الكاملة من أداء، وحركة في الزمان والمكان، وعناصر السرد والتلقي المتوفرة في النص الذي هو العنصر الرئيسي في الفرجة. ولكي تكتمل الفرجة ينبغي للنص الطقوسي أن يتوفر على مقوماته الاحتفالية، والرواية التي بين أيدينا تزخر بالمقومات الاحتفالية التي تثبت الطابع الطقوسي للنص:
1ــ يتحدث النص عن كثير من المناسبات الاحتفالية المختلفة التي تتم عملية إحيائها من طرف الجماعة، إذ يطلعنا الراوي على طقوس حفلات الختان، والاحتفال بالأعياد الدينية والوطنية، وحفلات الزفاف، وحفلات الذهاب إلى الحمام ضمن الجماعة…
2ــ مفهوم العبور بالمعنى السوسيولوجي والأنتروبولوجي، أو طقس العبور Rites de passage وهو حدث احتفالي يعني: الانتقال من طور سواء أكان زمانيا أو مكانيا إلى آخر، وكل انتقال هو تحول من حالة إلى أخرى كتحول الشاب الأعزب إلى متزوج . (5)
ويثير النص الروائي طقوس العبور من الفرد نحو الجماعة. والعبور في الحمام من الدنس إلى الطهر. والعبور من الداخل إلى الخارج. والعبور من اللاختان إلى الختان. والعبور من حي السويقة إلى الأحياء الأخرى البعيدة أو المجاورة. والعبور من البيت إلى المدرسة. وتدخين السيجارة في الحافلة أثناء الذهاب إلى مدينة فاس من أجل الدراسة الجامعية، إذ بها عبور من التحفظ والتستر إلى التجاسر والعلن…
وتتوزع طقوس العبور إلى ثلاثة أنواع:
أــ طقوس التجميع، مثل حفلات الزواج… التي تحدثت الرواية عن تقاليدها في حي السويقة.
ب ــ طقوس الانفصال، مثل الموت، أو الطلاق… وقد عمل المبدع على وصف الطقوس المصاحبة للجنائز في الحي العتيق.
ج ــ الطقوس الهامشية، مثل الحمل والخطوبة… وقد أسهب السارد في وصف الطقوس التي صاحبت خطوبة خاله. إن: جميع هذه الطقوس التي لها حضور يومي، وأهداف خاصة مستمرة، تتجاور مع طقوس العبور، أو تلتحم بها، بصيغة أحيانا حميمية، مما يؤدي إلى صعوبة تعرفنا على طبيعة هذه الطقوس تفصيليا، وذلك من حيث انتماؤها إلى نوع طقوس الحماية، أو طقوس الانفصال . (6)
3ــ ثم هناك قاعدة التقعيد، بحيث توجد قواعد منظمة ومضبوطة لكل طقس، سواء من طرف السلطات التي تضمن تنظيم هذه الطقوس بقيد القانون والشرع، أو من طرف الجماعة التي تستحضر مجموعة من التقاليد والمواضعات المصاحبة للطقوس في احتفاليتها الخاصة. ونجد في النص الروائي تركيزا دقيقا على طبيعة القواعد التي تتم وفقها الطقوس المصاحبة للشعائر المتنوعة، والتي لا يستطيع أحد تجاوزها أو اختراق سياجها القانوني أو العرفي…
4ــ وهناك مفهوم التكرار، لأن الطقوس تتكرر باستمرار وفق توقيت معين، وشروط محددة، وظروف مواتية، ومناسبات ملحة…
إن الطابع الرمزي الذي أشرنا إليه، والذي يصاحب ممارسة الطقوس والشعائر في حي السويقة، يختلف من طقس إلى طقس، ومن شعيرة إلى شعيرة، ويبقى المهم الذي عمل المبدع بواسطة سارده على إثارته ضمن النص الروائي هو تلك الطاقة، والقدرة، والقناعة التي يتوفر عليها أهل الحي جميعا، والتي تمكنهم من الإسهام معا في إعادة إنتاج نفس الطقوس والشعائر، وتكرارها في كل مناسبة، أو حدث، دون كلل، أو ملل. وتدل هذه الممارسة الوطيدة على استحضار المتعة والقدسية عن طريق استعادة تاريخ الوقائع الطقوسية بواسطة الحديث عنها، ورواية الغريب، والعجيب، والممتع منها، باعتبارها متجذرة في المتخيل الجمعي من حيث إنها تمكن الجميع من الإحساس بشعور التوق الدائم، والمستمر، والأبدي للعودة إلى الانغماس في الاحتفالات الطقوسية انتظارا، وشوقا لما سوف تمنحه لمريديها ومرتاديها من حصاد، وغلال، وبركة. ولذلك فإن الجميع يتفق ضمنا أو علنا على احترام وتقديس الإطار الزمني الذي يحتفي بطبيعة الطقوس الاحتفالية في حي السويقة، مثل زمن الأعياد والمناسبات، والاغتسال في الحمام يوم الجمعة، والانتقال من الفرد إلى الجماعة، والانتقال من الحي إلى حي آخر، والذهاب إلى المدرسة… إن الطقوس في الأصل عبارة عن لغة متداولة، متعارف عليها، وهي مشبعة بكثافة خطابية، متوفرة على مقومات محددة ومضبوطة، ولذلك فإن ممارستها تأكيد على طابع الانسجام، والتناغم، والتعايش الذي يسود بين سكان حي السويقة في المتن الحكائي.
يحلو كثيرا للمبدع على لسان سارده في ثنايا النص الروائي أن يركز الأنظار، والاهتمام، والحديث، والسرد على بعض الشخصيات بسبب نشاطها الحركي، والحماسي، ولذلك نجد أن كثيرا من إشارات الراوي تدل على أن الشخصية المعتنى بها أكثر هي التي تتجلى في الرواية متحركة، ونشيطة، ولها قابلية كبيرة لإنتاج الأحداث، وتطوير عملية السرد الروائي، ويبدو هذا الأمر طبيعيا للغاية، من حيث كونه يوفر للمبدع إمكانية تطوير الحكي، وتنمية القدرة على تدبير الأحداث، والسير بها نحو الأهداف المنطقية المطلوبة في البناء الروائي. ويتوفر المبدع عبر سارده في هذا النص على تمكن ملحوظ من تحقيق التدرج في الحكي بواسطة سلاسة، ومرونة، وتمهيد لما سيأتي من أحداث، عبر فتح أقواس تشير إلى تعدد المجالات التي ما زالت تشكل أفقا للارتياد من طرف الشخصيات المتفاعلة في النص الروائي. وهكذا نجد أن ذاكرة السارد تمتد عبر الزمن الماضي حتى تصل إلى مرحلة الطفولة الواعية، بمعنى المرحلة التي تحقق له فيها الإدراك، والمقصود هنا الذاكرة الحسية المرتبطة خصوصا بالنظر، والسمع، واللمس، والإحساس… ولكي يقنعنا بانتصاراته الطفولية ذات الطابع الحسي يطلعنا في صورة روائية مثيرة على التجمعات التي كان يعقدها عقب كل ارتياد لحمام النساء مع والدته، من أجل تسريب أسرار الأنوثة الساحرة، وبثها بين الذكور المتطفلين اليافعين، والبالغين من سكان الحي، قصد الاستمتاع بعطرها، وبوحها الخفي. إن هذا الأمر يعني في الحقيقة بأن الذهاب إلى حمام النساء مع الأم عبارة عن اقتحام الحجب الكثيفة التي تحيط بجسد المرأة، والعمل على تدنيسها بين جنبات الحي، مع الإحساس بالعلو، والرفعة من خلال امتلاك معرفة مختلسة، تندرج ضمن مجال المتعة الممنوعة والمحرمة.
في تقديمه لشخصيات الحي على لسان السارد الذي هو شخصية مشاركة، كونه يقوم بفعل الحكي مستعملا ضمير المتكلم، قام المبدع بتقديم أول شخصية، الأمين صبي الفران، ثم تلاه عريف المسيد، ثم فقيه المسيد، ثم اكتفى بالإشارة المقتضبة جدا إلى الأب والأم، ثم السيدة فطومة، ثم السيدة رقوشة وهما صديقتان مقربتان من الأم، أي أم السارد، ثم بنات الجيران، ثم الجدة، ثم الخال، ثم الحاجة الزهرة الخطابة، ثم العروس وأهلها، ثم العدلان الموثقان، ثم المدعوون والمدعوات لحفل قران الخال، ثم ميمون و شعايب الذي تجاوز كل منهما الستين من عمره، ثم العم، ثم الحلاق الشريف التجكاني الذي تكفل بختان السارد، ثم العياشي صاحب المقهى، ثم المعداني موزع الحليب، ثم الدوص و احميدو ابنا المعداني اللذين يشتغلان لدى الخياط، ثم فاطمة زوجة المعداني، ثم بوشتى صانع الإسفنج (= فطائر مغربية لذيذة ومقرمشة يتم إعدادها بعجينة خاصة، وتقلى في الزيت )، ثم الشريف سيدي أحمد صاحب الدكان، ثم النتيفي بائع السجائر، ثم عبد الله صبي صانع الإسفنج، ثم أحمد الغماري العامل ببلجيكا، ثم الحسين العامل بالحمام العمومي، ثم العياشي صاحب المقهى، ثم صاحب الدكان الآخر أحمد الرويز، ثم أحمد بائع الحلويات الملقب بطرارة…
سياق هذه الكثافة في ذكر الشخصيات لم يكن وليد ترف فكري، أو رغبة في ملء الفجوات، وترميم الفراغات، بقدر ما كان ضروريا في هذا النوع من النصوص. حيث إن حي السويقة حي شعبي، تنتمي جغرافيته إلى المدينة القديمة التقليدية، التي كانت هي الواجهة الحضارية والمعمارية للمدينة في حقبة مضت، وحضور الشخصيات بهذه الكثافة مرتبط بضرورة العلاقات الفعلية التي تجمع بين الأفراد في الحي العتيق، بحيث كلما ذكرنا شخصية إلا واستحضرنا مقابلا لها من نفس الحي. وبحكم تنوع الوظائف، وتعدد المهام فإن الشخصيات حتما سوف تكون كثيرة لكي تقوم كل واحدة منها بمهمة أو عمل يحتاجه أهل الحي جميعا، لأن الأحياء العتيقة كانت تتميز بالاكتفاء في مجال تلبية الحاجات، إذ كل حي كان يتوفر على الصناع، والعمال، والتجار، والحرفيين… القائمين بإنجاز طلبات أهل الحي، ولذلك قلما نجد في السابق حيا عتيقا لا يوفر لأصحابه كل ما يحتاجونه، يوميا، وموسميا.
يمكن أن نعتبر حضور هذه الشخصيات في النص الروائي عبارة عن حضور مجازي، لأن فلانا صاحب الدكان قد يكون هو نفسه وقد يكون غيره، ثم إنه قد يوجد في حي السويقة، أو في حي آخر مشابه، ونفس الشيء ينطبق على باقي الشخصيات، إذ إن حضورها هو تمثيل لبعضها البعض، ولا توجد شخصية لها حضور خاص أو مستقل، إن حضورها ينتهي بالضبط حالما تنتهي مهمتها أو وظيفتها، ويبقى هذا الحضور رهينا بالحاجة التي يبديها أهل الحي في قضاء أغراضهم، وتحقيق حاجياتهم. وحضور الشخصيات في هذه الرواية أو تلك لا يعني أن تمثلهم في النص الروائي كان دقيقا، أو مضبوطا، لأن وجود الشخصيات يتجاوز كثيرا المجال الخاص للرواية ويهيمن على التصور في كينونته السيكولوجية، والسوسيولوجية، وبذلك تظل أبعاد الشخصية ممتدة إلى خارج حدود أي نص روائي، وتعطي دائما الانطباع بكونها تتوفر على قدرة وقابلية تامتين للتسلل إلى نص روائي آخر، وقد نجدها تتربص بنا في أكثر من نص في نفس اللحظة، وهذا يدل على الكثافة العميقة التي تتميز بها كل شخصية روائية تتوفر على كامل الأهلية للإسهام في عملية الخلق الإبداعي. وينطبق الأمر على الشخصيات المذكورة سابقا من حيث تأثيثها لعالم حي السويقة الإبداعي، والوقوف عند كل شخصية يحتاج إلى كثير من الجهد والتحليل، خصوصا عند تحليل أبعادها في علاقتها بأبعاد الشخصيات الأخرى، فهي جديرة بأن تنبئ عن كثير من الأسرار والخفايا التي لها وقع مدهش في تدبير، ومتابعة شؤون حي السويقة في صورته العتيقة.
لقد استطاع المبدع وهو يسطر روايته عبر تشغيل هذه الكثافة من الشخصيات أن يمنحها كثيرا من الثقة، والقبول، والتماسك، والحيوية. هذه العملية تجعل المبدع يبرهن على قدرته في مجال نحت الشخصيات وتقديمها كمجموعة مشاركة في إنعاش الحياة، وتدبيرها داخل حي السويقة العتيق. إذ في اللحظة التي يتعامل فيها المبدع مع شخصية من الشخصيات علينا أن نكون على يقين بأن جميع الشخصيات المتورطة في النص تقوم بدورها اليومي، والمستمر، بمعنى هناك حياة تجري أطوارها داخل الحي، وعلى جميع الشخصيات أن تعلن ليس عن حضورها في هذه الحياة فقط، بل عليها أن تقوم بنحت بصمتها، وأثرها في عملية القيام بعناصر هذه الحياة. ومن هنا تظهر براعة المبدع في الإمساك بخيوط الحكي ككل، بمعنى أنه ينسج الفعل ويتتبع رد الفعل في نفس الوقت، فهو يوجه شخصية إلى مهمة ما، وعينه لا تغفل عن باقي الشخصيات في تتبع حركيتها، ونشاطها، وتكليفها بمهام جديدة. والسرد ينمو، ويتراكم، وهيكل الرواية يتربع على أسسه، وآنذاك تنبثق الهوية الدالة على طبيعة النص الروائي.
تحريك هذه الشخصيات التي ذكرنا سابقا، وتشغيلها يتم بواسطة المشهد، أو المشاهد الروائية، وفيها عمل المبدع على بناء الصور الروائية التي قام بتأثيثها من خلال الدمج بين الزمان والمكان، ويدل هذا على البعد الزمني الذي تظهر فيه الشخصية، وكيف يستغرق وجودها كينونتها بواسطة تصور زمني محدد، قد يكون ساعات، وقد يمتد لأيام، أو أكثر، حسب الحاجة، والضرورة التي يفرضها زمن الرواية في تحريك الشخصية. ولا نتصور أن يكون تحريك الشخصيات، وتشغيلها ضمن المشاهد الروائية متساويا بين جميع الشخصيات، إذ يتفاوت الزمن الذي يجريه المبدع من شخصية إلى أخرى، ولا يعني هذا أن الشخصية التي تسجل حضورها ضمن زمن ممتد أكثر من غيرها هي الشخصية المهيمنة في الرواية، فقد يكون حضور شخصية في مشاهد قليلة ضمن زمن محدود أكثر سطوة، وتأثيرا، وقيمة من حضور شخصية ضمن مشاهد متعددة، لأن الزمن الروائي هو زمن قابل للاختزال، كما أنه قابل للتمديد حسب الحاجة، إذ يظل المبدع مسيطرا تماما على مجريات الزمن في تدبير شؤون الشخصيات، وقد يحتفظ لشخصية أثيرة بمقام أسمى، وأعلى من مقام الشخصيات الأخرى، ومع ذلك يظل حضور الشخصيات جميعا متساويا من حيث القيمة الحاسمة في تحديد سمو طابع الإبداع والفنية في العمل الروائي.
وقد عمل المبدع مصطفى شهبون على بسط رؤيته لتحريك الشخصيات بواسطة عملية نقل أنشطتها من طرف السارد، الذي كان يزاول أنشطة متعددة بالإضافة إلى رعايته وتتبعه لباقي الشخصيات، فهو يشتغل بتغطية الأحداث كمهمة إعلامية انطلاقا من إشرافه الكامل على الحي من فوق السطوح، فكان مثلا يمد خاله بجميع الأخبار التفصيلية المتعلقة بخطبته وإتمام عقد قرانه. وقد كان ينحو إلى ممارسة كثير من الأنشطة الجانبية تهربا من المسيد، إذ كان يجاهر برفضه الشديد لطقوسه، ولصبيانه، ولتوقيته. وقد كان له وعي تام بعملية ختانه، وببعض تفاصيلها، رغم أنه لم يتوسع كثيرا في بيان هذا النوع من الطقوس.
ومع تقدم عملية السرد في الرواية، بدأت الفصول أو الأجزاء الثلاثة والخمسون تكبر أكثر، مما يدل على ثقة المبدع، وقدرته على تشغيل الذاكرة، وإنعاشها باستمرار حقيقة وتخييلا. ولم يكن المبدع يمعن كثيرا في وصف الشخصيات، بل كان يمر عبرها مرور الكرام، ولا يعدو الأمر أن يكون عاديا وطبيعيا عندما نقف على الوصف المسند إلى السارد الطفل، الذي لم تكن تسعفه ذاكرته الحسية كثيرا، لذلك يمكن أن نقول إن وصفه كان تاريخيا، مرتبطا بالزمن الخاص بكل شخصية. وهكذا وفي الصفحة 22 سوف يعرض علينا شخصية ميمون، وشخصية اشعايب وهما يتنافسان في عرض مخزونهما من الأخبار المتعلقة بالحرب الأهلية الإسبانية التي شاركا فيها جنديين مقاتلين، وكان يروقهما حكاية البطولات الحربية الوهمية للأطفال الصغار.
وفي الصفحة 40 تركيز شديد على شخصية بنعيسى مقدم (= شيخ) زاوية للاعربية الموجودة بحي العيون، بعيدا عن حي السويقة، وقد اهتم السارد كثيرا بوصف هذه الشخصية بعناية، وأشار إلى أن المقدم كانت له هيبة تشل حركة الجميع في حي السويقة. ثم إشارة إلى شخصية السي محمد ولد القايد الذي كان في حي السويقة مثالا لشارب الخمر الذي يعاشر أعتى المجرمين مثل التومي و جبيلو، وغيرهم من الذين كانوا يضفون المهابة والرهبة ضدا على خصومهم من مجرمي الأحياء الأخرى.
ثم نجد السارد يجمع أحيانا بين المتناقضات مثل الحديث عن عمي عبد السلام صاحب المقهى الذي يمتهن القمار بالكنييلة (= لعبة الحظ الخاصة ببطولة كرة القدم الإسبانية)، وفي نفس الفصل حديث عن الفرطاخ الموظف بمندوبية (= مديرية ) التعليم ودروسه الدينية بمسجد للافريجة ومسجد الساقية الفوقية والتي ينهى فيها بشدة عن لعب الكنييلة . وبالإضافة إلى ذكر هذه الشخصيات نرى أن السارد يعرج في حكيه على حي الملاح حيث تسكن جدته، وتوقف مع اليهود يروي أحوالهم، وأعمالهم، وعاداتهم، وعلاقاتهم بالمسلمين، مثل جارة جدته كلارا، والحزان سيمون، ثم عقيبة بائع الذهب بحي الطرافين، إذ كان يبيع الحلي الذهبية بطريقة التوفير المعروفة لدى اليهود، قسطا قسطا، وعمل السارد على وصف حفل قران تالي ابنة اليهودي بائع الذهب الذي أقام حفل الزفاف بنادي اليهود بالمدينة الحديثة. وفي هذا الصدد نجد أن السارد سوف يعود في الصفحة 103 إلى الحديث عن الحمام بعد أن كان قد استهل الرواية بالوقوف عنده، ولكنه هذه المرة سوف يركز على حمام الرجال، إذ سيعود إلى طقوس الاغتسال في الحمام والعبور من الدنس إلى الطهر، وفي الصيغة الرمزية كأن الرجال يغتسلون ويتطهرون من خلافاتهم، ويستعدون لمواجهة يهود إسرائيل وإبادتهم بمناسبة حرب أكتوبر، ومع ثبوت الهزيمة العربية بدأ الاعتداء على يهود الملاح الذين اضطروا للهجرة خوفا على أرواحهم، وممتلكاتهم.
في الفصل 21 اتجه السارد إلى موضوع لا علاقة له بما كان بصدده من مجرى سيرته الخاصة، وعمل على سياق حكاية المسطاسي الذي تزوج بفاطمة لكي يحللها بعد أن طلقها زوجها الأول سلام الطلقة الثالثة، ولكن المسطاسي تمسك بفاطمة ورفض تطليقها، خصوصا بعد أن أنجبت له طفلا ذكرا طالما تمناه سلام . والسؤال الآن هو لماذا توقف السارد هنا عن سيرته الخاصة؟ هل هو ملل أو التقاط أنفاس؟ أم هي ثقوب الذاكرة ونفاذ الزاد؟ ألا يكون الأمر جرأة بالغة من السارد كونه أحس بقدرته التامة، وثقته البالغة في أن يجرب اقتحام المضمر، والمستور؟ ثم هل تعمد السارد عدم وصف أمه وأبيه؟ هل رأى بأنهما أقدس من أن يلطخا بترهات الحي وأهله؟ أم أنه أغفل الأمر دون أن يشعر بذلك؟ ورغم هذا فقد استمر تنوع السرد، والوصف بتنوع الشخصيات وتعددها، وبمدى حضورها في صنع الأحداث داخل الحي.
الصفحة 29 في الرواية، سوف نشهد أول توثيق من الراوي لحي السويقة السفلي، كملتقى طرق وأحياء مختلفة ومتفرعة، وهذا الجزء من الحي هو الذي يشكل مسرح الأحداث في النص، وهو يتواجد في مكان بعيد نسبيا عن بيت سكن أسرة السارد. وكأن المبدع بدأ يفكر هنا جديا في توسيع جغرافية تحرك السارد، حيث سوف يشرع في البحث عن آفاق جديدة وواسعة لروايته بعد أن ضاقت عليه الأمكنة التي يتحرك فيها… لقد فتح المجال لسارده لكي يبتعد عن بيت الأسرة تدريجيا، وبهذا التغيير سوف ينمو الحكي، ويزداد وفرة بالموازاة مع نضج وعي السارد من خلال خروجه من حي السويقة وتعرفه على أماكن خارج الحي… مما يعني انفتاحه على أماكن أرحب، وإنجازه لمهام أصعب، وهو ما عمق إحساسه بنمو وعيه بالأشياء وبالموضوعات. ونلاحظ أن بوادر الوعي بدأت تكتمل لدى السارد بالحكم على الأمور وتقويمها، مثل الانتخابات، والعلاقات الإنسانية، وعملية اختلاس مساعدات المحتاجين والمعوزين، والخواء والفراغ في الحياة العامة… واستنادا إلى هذا الوعي المبكر فإن السارد يشير إلى تشبعه في مرحلة طفولته بمنطق العناد، والرفض لجميع ما يقمع الحرية ويحد منها. أما في مرحلة المراهقة والبلوغ فإن منطق العناد والرفض لديه زاد حدة وإصرارا، خصوصا عندما بدأ فكره يرتاد التدقيق في مواضيع أكثر أهمية، وأشد غموضا مثل مفهوم المخزن، و البطالة …
بين الفصلين 19 و 20 اتصال مرتبط بوصف السارد لولوج المدرسة، وهذا يدل إما على اعتماد المدرسة دافعا لإتمام الفصل بآخر، وإما هي علامات نضج واستواء البناء الروائي. وفي الصفحة 48 سوف تصيب السارد صدمة الهوية، إذ من الغرابة بمكان أن نكتشف بأنه لا يعرف لقبه في اليوم الأول له بالمدرسة، بالإضافة إلى إصابته بغصة مريرة ألمت به عند ترديد النشيد تحية للعلم الوطني من طرف تلاميذ المدرسة… ولكن الذي دعم هويته في النص بعمق وتجذر، وجلب له الأمن والأمان، ودفعه لتجاوز صدمته، هو اعتزازه بانتمائه الأزلي إلى قيمة أمه البيولوجية التي كان يحن إلى قهوتها، وخبزها، ثم انتماؤه إلى الوطن، موطئ قدمه، وصلب حياته.
ثم عمل المبدع عن طريق سارده على حرق المراحل الزمنية انتقالا من التعليم الابتدائي، إلى التعليم الثانوي، ثم الانتقال من سنة التوجيه الثانوية، إلى شعبة الاقتصاد، ثم مباشرة إلى ولوج شعبة العلوم الاقتصادية بالجامعة. لقد كان يوم ولوجه رحاب الجامعة يوم انفصال من مدينة تطوان، واتصال بمدينة فاس، ثم انفصال من غرفة الأصدقاء بحي السويقة، واتصال بغرفة جديدة، وطلبة جدد، وشعب جديدة. لقد تماسك هنا وعي السارد، وأبان عن ثباته مع توجهه نحو الاختمار، ثم النضج في أحضان الدروس، والمحاضرات، والحلقات الطلابية برحاب جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، وبالضبط بحي ظهر المهراز.
صفحة 149 عرفت بداية انطلاق الحافلة من مدينة تطوان إلى مدينة فاس للدراسة، واستمر حكي السارد عن فاس وأحوال الدراسة إلى حدود صفحة 182 عندما عاد إلى مدينة تطوان إبان فترة الأحداث المؤلمة التي عرفتها المدينة في الثمانينيات من القرن الماضي… وقد قدم لها السارد مجموعة من التفاصيل التي وصفت تسلسل الأحداث المأساوية.
في الأخير يشير السارد بمرارة حارقة إلى تدهور أحوال حي السويقة، بعدما ظهرت فئة شابة اغتنت غنى فاحشا بشكل مفاجئ، فاضطرت الأسر التطوانية العريقة للخروج من بيوتها، وعملت على بيعها. فسكنها كثير من المهاجرين، والوافدين الذين حلوا بالمدينة بكثرة لافتة للنظر. بالنسبة للمبدع كان هناك حي يسمى السويقة، لم يعد يسكن الأذهان بعد اليوم. لقد انتهى مع الزمن الماضي، ومستقبله ما زال مجهولا، أو لم تبد بعد علاماته…
الهوامش:
- جورج ماي ــ السيرة الذاتية ــ القاهرة ــ رؤية للنشر والتوزيع ــ ط.1 ــ 2017 ــ ترجمة: د.محمد القاضي ــ د. عبد الله صولة ــ ص. 268.
- نفسه ــ ص. 269.
- فيليب لوجون ــ الميثاق السير ذاتي ــ باريس ــ لوسوي ــ 1975 ــ ص. 45.
- جورج ماي ــ مرجع مذكور ــ ص. 272.
- jean Missonneuve , les Rituels , presses universitaires 1ère édition, Paris 1988, p.07
- Arnold Van Gennep, Les Rites de Passage , Maison des Sciences de l’homme. Paris : Éditions A. et J. Picard, 1981, 288 pp + 29 pp. – p . 21