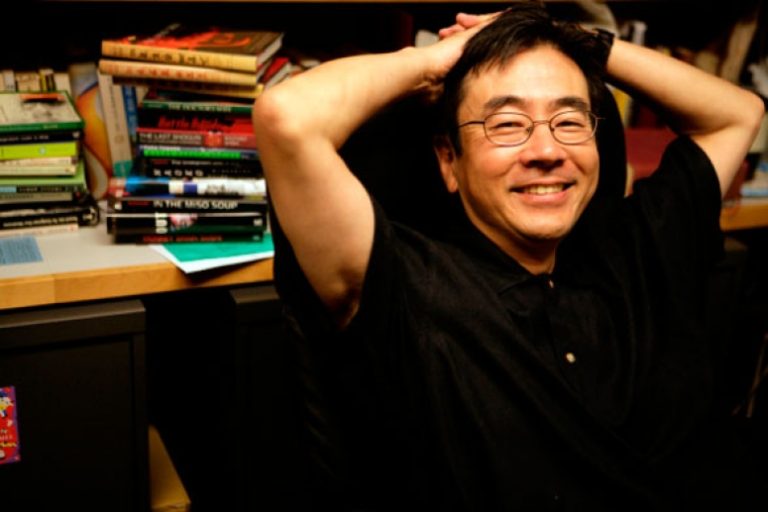فرانك أوكونور
ترجمة: ممدوح رزق
أيقظني سعال أمي. كان الصوت يأتي من المطبخ في الأسفل وعلى نحو أكثر فظاعة من الأيام السابقة. بات الأمر يستدعي الاهتمام. كنا نعيش وقتها في طريق يوجال القديم، المتخم بالتلال، والمؤدي إلى شرق يورك. ارتديت ملابسي، وبقدمين عاريتين نزلت السلالم. في ضوء الصباح النقي رأيتها منهارة على كرسي خيزران صغير بذراعين، وتمسك بجانبها دون أن تنتبه لوجودي. كانت قد حاولت إشعال النار، لكن الأمر لم يسر معها كما أرادت. بدت متعبة وعاجزة لدرجة أن الشفقة اعتصرت قلبي. ركضت إليها وسألتها:
“هل أنتِ بخير، أمي؟”.
“سأكون بخير بعد قليل” أجابت وهي تحاول الابتسام. “الأعواد القديمة كانت مبللة والدخان جعلني …”.
“عودي إلى السرير وسأشعل النار” قلت.
“آه. كيف يمكن ذلك يا صغيري؟” قالت بقلق.”حتمًا، يجب عليّ الذهاب إلى العمل”.
“لا يمكنك وأنتِ في هذه الحالة” قلت. “لن أذهب إلى المدرسة وسأبقى في المنزل لأعتني بكِ”.
فكرت مجددًا في تلك المسألة النسائية الغريبة؛ الطريقة التي تطيع بها المرأة أي شخص يرتدي سروالًا حتى لو كان عمره عشر سنوات فقط.
“سيكون جيدًا لو استطعت فقط أن تعد لنفسك كوبًا من الشاي، قد أكون بخير لاحقًا” قالت بتأنيب ضمير. نهضت ورعشة شديدة تتملكها ثم صعدت الدرج مرة أخرى. كنت أعلم حينئذ أن شعورها بالسوء بديهي.
أخرجت أعوادًا أكثر من حفرة الفحم تحت السلم. كانت والدتي مقتصدة جدًا لدرجة أنها لم تستخدم الكمية الكافية. لهذا كانت النار تخذلها أحيانًا. استخدمت حزمة كاملة، وسرعان ما بدأت النار تتأجج. تركت الماء يغلي، وأثناء ذلك أعددت لأمي شريحة من الخبز المحمص. كنت مؤمنًا للغاية بتأثير الخبز المحمص الساخن مع الزبدة في جميع ساعات اليوم. صنعت لها كوبًا من الشاي، ووضعته على الصينية.
“هل هذا جيد؟” سألت.
“هل يمكنك أن تأتيني بكوب من الماء المغلي المتبقي؟” سألت بصوت متشكك.
“إنه مفيد جدًا” وافقت بسرور متذكرًا صبر القديسين على محنهم العديدة. “سأصب نصفه”.
“أنا عجوز مزعجة” تنهدت.
“إنه خطأي” قلت آخذُا الكوب. “لا أستطيع أن أتذكر مقادير الشاي. ضعي الشال حولك وأنتٍ جالسة. هل أغلق نافذة السقف؟”.
“هل يمكنك ذلك؟” سألتني بتردد.
“ليست هناك مشكلة” قلت وأنا أحضر الكرسي. “سأسجل التعليمات بعد ذلك”.
تناولت الإفطار بمفردي إلى جوار النافذة ثم خرجت ووقفت عند الباب الأمامي مراقبًا الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة.
“عليك أن تسرع وإلا ستُقتَل، سوليفان” صرخوا.
“لن أذهب” قلت “أمي مريضة وعليّ العناية بها”.
لم أكن طفلًا خبيثًا بأي شكل، لكنني كنت استمد راحتي وأتأملها في ضوء مصائب الآخرين. سخنت وعاءً آخر من الماء ونظفت أدوات الإفطار قبل غسل وجهي ثم صعدت إلى الطابق العلوي مع سلة التسوق وقصاصة ورقية وقلم رصاص.
“يمكنكِ تدوين التعليمات الآن” قلت. “هل تودين أن أذهب لإحضار الطبيب؟”.
“آه” قالت أمي. “لن يفعل سوى إرسالي إلى المستشفى، وكيف لي ذلك؟ يمكنك التوقف عند الصيدلية وشراء زجاجة دواء قوي للسعال”.
“اكتبي ذلك” قلت. “إن لم تفعلي فقد أنسى. واجعلي (قوي) بحروف كبيرة. هل أحضر بيضًا للعشاء؟”.
كان البيض المسلوق هو الطبق الوحيد الذي يمكنني تحضيره. توقعت أن تطلب مني شراءه، لكنها أخبرتني بإحضار “النقانق” أيضًا في حال تمكنت من مغادرة الفراش.
في طريقي إلى الصيدلية مررت بالمدرسة. كان يقابلها أحد التلال فصعدت مسافة قصيرة ووقفت هناك لعشر دقائق في شرود هادئ. كانت المدرسة ببوابتها وفنائها تظهر كما لو كانت مرسومة في لوحة، منعزلة وهادئة باستثناء جوقة الأصوات المنبعثة من النوافذ المفتوحة، ولمحات متقطعة من المعلم داني ديلاني وهو يمر من أمام الباب الأمامي بعصاه خلف ظهره، مسترقًا النظر إلى العالم الخارجي. كان بإمكاني الوقوف هناك طوال اليوم. من بين المتع العميقة والبسيطة كافة في تلك الأيام؛ كانت تلك هي الأغنى.
وصلت إلى المنزل فوجدت ميني رايان تجلس مع أمي. امرأة في منتصف العمر، ذات معرفة واسعة، متدينة، وتحب النميمة.
“كيف حالك، أمي؟” سألت.
“بخير” قالت أمي مبتسمة.
“لكن لا يمكنكِ النهوض اليوم” قالت ميني رايان.
“سأضع الغلاية وأعد لكِ كوبًا من الشاي” قلت.
“بالطبع، سأفعل ذلك” قالت ميني.
“آه، لا تقلقي، آنسة رايان”، قلت بخفة. “يمكنني التعامل مع الأمر بشكل جيد”.
“أليس ولدًا صالحًا جدًا؟” سمعتها تقول بصوت منخفض لأمي.
“صالح كالذهب” قالت والدتي.
“لا يوجد الكثير مثله الآن” قالت ميني. “معظم من يخرجون إلى الحياة هذه الأيام أقرب إلى الوثنيين منهم إلى المسيحيين”.
في فترة بعد الظهر أرادت أمي أن أخرج للعب، لكنني لم أذهب بعيدًا. كنت أعلم أنه إذا ابتعدت لمسافة معينة سأكون عرضة للوقوع في الإغراء. أسفل منزلنا، كان هناك وادٍ وميدان تدريب خاص بالثكنات التي تقع فوقه على جرف جيري. أسفل ذلك، وفي حفرة عميقة؛ ثمة بركة وجداول الطاحونة تنساب بين التلال المكسوة بالأشجار. بمجرد أن أكون هناك، أنجذب بعيدًا عن العالم الحقيقي. لذا جلست إلى حائط خارج المنزل، وكلما مرت نصف ساعة أركض عائدًا إلى أمي لأطمئن عليها، ولأعرف إذا كانت تريد شيئًا.
حل المساء؛ أضيئت مصابيح الشارع، وجاء الصبي موزع الصحف يصيح في الطريق. اشتريت صحيفة وأشعلت المصباح في المطبخ والشمعة في علية أمي. حاولت أن أقرأ لها، لكن ذلك لم يكن ناجحًا جدًا. كنت أجيد فقط قراءة الكلمات ذات المقطع الواحد. كانت لدي رغبة كبيرة في إرضائها، وكانت لديها الرغبة في أن تشعر بالرضى. ذلك ما جعل علاقتنا جيدة إلى حد ما بالنظر إلى الظرف الصعب.
لاحقًا، جاءت ميني رايان مرة أخرى، وقبل مغادرتها توقفت عند الباب ونظرت لي من فوق كتفها …
“إذا لم تتحسن في الصباح، أعتقد أنني سأستدعي الطبيب” قالت.
“لماذا؟” سألت بقلق. “هل تعتقدين أن حالتها أسوأ مما تبدو، آنسة رايان؟”.
“آه، لا أود قول ذلك”، ردت متظاهرة بعدم الاكتراث. “لكنني أخشى من إصابتها بالتهاب رئوي”.
“لكن ألن يرسلها إلى المستشفى، آنسة رايان؟”.
“قد لا يفعل”، قالت بتململ وهي تسحب شالها القديم. “لكن حتى لو فعل، ألن يكون ذلك أفضل من إهمال الأمر؟ هل لديك قطرة من الويسكى في المنزل؟”.
“سأحضرها”، قلت على الفور. كنت أعلم ماذا قد يحدث للناس الذين يصابون بالتهاب رئوي، وماذا سيحدث بعد ذلك لأطفالهم.
“إذا استطعت أن تعصر ليمونة في جرعة الويسكي وتعطيها لأمك ساخنة فقد يساعدها ذلك على التخلص من السعال” قالت ميني.
رفضت أمي الويسكي. كانت تخشى من التكلفة، لكن خوفي العارم منعني من التراجع.
ذهبت إلى الحانة. كانت ممتلئة بالرجال، الذين تراجعوا جانبًا ليتيحوا لي الوصول إلى البار. كنت خائفًا لأنني لم أدخل حانة من قبل.
“مرحبًا زهرتي القديمة” قال لي أحد الرجال بابتسامة شيطانية “لابد أن عشر سنوات قد مرت منذ رأيتكِ آخر مرة. ماذا تريدين؟”.
أخبرني صديقي بوب كونيل ذات يوم أنه سأل رجلًا سكرانًا عن نصف جنيه فأعطاه إياه. كنت أتمنى دائمًا أن أقدر على فعل الشيء نفسه، لكنني لم أشعر أن ذلك قد يتحقق في تلك اللحظة.
“أريد نصف كأس من الويسكي لأمي” قلت.
“آه، يا له من غبي!” قال الرجل “يدعي أن الكأس لأمه، وآخر مرة رأيته فيها كان يجب أن يعود محمولًا إلى منزله”.
“لم أكن كذلك” صرخت بغضب. “وهو لأمي. إنها مريضة”.
“آه، اترك الطفل وشأنه، جوني” قالت النادلة قبل أن تعطيني الويسكي. توجهت إلى المتجر لشراء ليمونة دون أن يفارقني الخوف من رجال الحانة.
تناولت أمي الويسكي الساخن ونامت. أطفأت الأنوار وذهبت إلى السرير لكنني لم أستطع النوم جيدًا. كنت أشعر بالندم لأنني لم أسأل السكران في الحانة أن يعطيني نصف جنيه. استيقظت مرات عدة بسبب سعال أمي، وعندما دخلت إلى حجرتها ووضعت يدي على رأسها شعرت به ساخنًا جدًا. كانت تتحدث بشكل غير مترابط، وما أخافني أكثر من أي شيء آخر أنها لم تتعرّف عليّ. ظللت مستيقظًا أفكر في ما سيحدث لي إذا كانت مريضة حقًا بالالتهاب الرئوي.
في صباح اليوم التالي تفاقمت الكآبة. بدا أن أمي ليست أفضل من أمس. فعلت كل ما بوسعي، ومع ذلك شعرت بالعجز. أشعلت النار وأعددت لها الإفطار، لكن هذه المرة لم أقف عند الباب الأمامي لأراقب الأولاد الآخرين في طريقهم إلى المدرسة. كان يُحتمل أن تصيبني الغيرة حينئذ. بدلًا من ذلك ذهبت إلى ميني ريان وأبلغتها بالأمر.
“سأذهب إلى الطبيب” قالت بحزم. “من الأفضل أن نتأكد بدلًا من أن نندم”.
كان عليّ أولًا الذهاب إلى منزل أحد حراس قانون الفقراء للحصول على تذكرة تثبت أننا لا نستطيع الدفع. نزلت إلى العيادة بعد ذلك، والتي تقع في زقاق عميق وراء المدرسة، ثم كان عليّ العودة لتجهيز المنزل قبل وصول الطبيب. وضعت بجوار سرير أمي وعاءًا كبيرًا من الماء وقطعة صابون ومنشفة نظيفة. كان عليّ أيضًا تحضير العشاء.
وصل الطبيب بعد العشاء. رجل سمين، ذو صوت عال، ومثل كل المجذوبين في مهنة الطب، يرى نفسه “الطبيب الأفضل في كورك، لو فقط اهتم بنفسه”.
لم يكن يبدو مهتمًا بنفسه كثيرًا ذلك الصباح. “كيف يمكن أن تفعل ذلك الآن؟” قال متذمرًا وهو يجلس على السرير ودفتر الروشتات على ركبته. “المكان الوحيد المفتوح هو المستوصف الشمالي”.
“سأذهب يا دكتور” قلت على الفور، مرتاحًا لأنه لم يتحدث عن المستشفى.
“إنه طريق طويل” قال بارتياب. “هل تعرف المكان؟”.
“سأجده” قلت.
“أليس صبيًا رائعًا؟” قال لأمي.
“أوه، الأفضل في العالم يا دكتور!” قالت. “لا يمكن أن يكون هناك ابن أفضل منه”.
“هذا صحيح” قال الطبيب. “اعتن بأمك؛ ستظل دائمًا أغلي ما لديك. نحن لا نهتم بهم عندما يكونون معنا” أضاف لأمي “ثم نقضي بقية حياتنا نادمين على ذلك”.
كنت أتمنى لو لم يتفوّه بهذه الكلمات. كانت تتوافق تمامًا مع مزاجي، ولجعل الأمور أسوأ؛ لم يستخدم حتى الماء والصابون اللذين أعددتهما له.
أعطتني أمي تعليمات حول كيفية الوصول إلى المستوصف. انطلقت ومعي زجاجة ملفوفة في ورقة بنية تحت ذراعي. كان الطريق يصعد عبر منطقة فقيرة مكتظة بالسكان حتى الثكنات على قمة التل فوق المدينة ثم يهبط بين جدران عالية قبل أن يختفي فجأة داخل ممر حجري مرصوف بمنازل من الطوب الأحمر على جانب واحد، ينحدر بشدة نحو وادي النهر الصغير حيث يوجد مصنع للبيرة.
وقفت، وعلى الجانب المقابل من التل؛ رأيت مجموعة من المنازل المتناثرة، ترتفع بشكل جذّاب إلى القمة الدائرية، حيث ينتصب برج الكاتدرائية المشيّد من الحجر الرملي الأرجواني، ومنارة كنيسة شاندون المصنوعة من الحجر الجيري. على مستوى بصري كان المشهد شاسعًا جدًا، لدرجة أن الضوء لم يتخلله كليًا بالإشراق نفسه. كان نور الشمس يتجوّل عبر تفاصيله كما في البراري، يحدد في البداية صفًا من الأسطح بسطوع ثلجي، ثم يغوص في عمق بعض الشوارع المظلمة، ليرسم عبر الظلال أشكالًا لعربات متسلقة وخيول مجهدة.
استندت على الجدار المنخفض وفكرت في مدى سعادة الشخص الذي يتاح له التطلع إلى هذا المشهد دون أن يكون لديه ما يؤرقه. تخلصت من هذا الخاطر بتنهيدة ثم بدأت انزلق دون توقف إلى أسفل التل قبل أن أصعد عبر سلسلة من الأزقة المسقوفة والمصطفة حول مؤخرة الكاتدرائية التي بدت هائلة الآن.
كان معي بنس واحد، أعطتني إياه أمي كنوع من التشجيع، وقررت أنه بعد الانتهاء من مهمتي سوف أدخل الكاتدرائية وأنفقه على شمعة للعذراء المباركة كي أجعل والدتي تتحسن سريعًا. كنت متأكدًا أن ذلك سيكون أكثر فاعلية داخل كنيسة كبيرة حقًا مثل تلك، وقريبة جدًا من السماء.
كان المستوصف عبارة عن ممر صغير قذر يحوي مقاعد على أحد جانبيه ونافذة مثل تلك الموجودة بمكتب تذاكر السكك الحديدية في الطرف البعيد. فتاة صغيرة ترتدي شالًا مخططًا بالأخضر تجلس على أحد المقاعد. طرقت النافذة ليفتحها رجل يبدو متجهمًا ومتهالكًا. دون انتظار أن أتكلم؛ انتزع الزجاجة والروشتة من يدي وأغلق النافذة ثانية بلا كلمة واحدة. انتظرت لحظة ثم رفعت يدي لأطرق مرة أخرى.
“عليك أن تنتظر أيها الصبي الصغير” قالت الفتاة بسرعة.
“ماذا سأنتظر؟” سألت.
“يجب أن يُعدّها” شرحت. “يمكنك الجلوس”.
جلست، سعيدًا بوجود شخص ما يرافقني.
“من أين أنت؟” سألت.
“أعيش في شارع بلارني” أضافت عندما أخبرتها. “لمن الزجاجة؟”
“لأمي” قلت.
“ما خطبها؟”.
“تعاني من سعال شديد”.
“قد تكون مصابة بالسل” قالت بتفكير. “ذلك ما كانت تعاني منه أختي التي توفيت العام الماضي. أتيت لإحضار مقو لأختي الأخرى. يجب أن تتناول المقويات طوال الوقت. هل تعيش في مكان جميل؟”.
أخبرتها عن الوادي، وأخبرتني عن النهر القريب من بيتها. بحسب وصفها؛ بدا أنه مكان أجمل مما أعيش فيه. كانت فتاة صغيرة، لطيفة وثرثارة، ولم ألحظ الوقت حتى انفتحت النافذة وخرجت زجاجة حمراء.
“دولي!” صرخ الرجل الغاضب وأغلق النافذة ثانية.
“هذا أنا” قالت الفتاة الصغيرة. “زجاجتك لم تجهز بعد. سأنتظرك”.
“لدي بنس” قلت بفخر.
انتظرت حتى خرجت زجاجتي ثم رافقتني نحو الدرج المؤدي إلى مصنع البيرة. في الطريق اشتريت حلوى مقابل البنس ثم جلسنا على الرصيف بجانب المستوصف لنأكلها. كان الجو لطيفًا هناك مع برج شاندون في الظل من وراءنا، والفروع الصغيرة للأشجار تتدلى فوق الجدران العالية، والشمس بتوهجاتها الذهبية الكبيرة تلقي بخيالاتنا المتشابكة على قارعة الطريق.
“أعطني رشفة من زجاجتك” قالت.
“لماذا؟” سألت.
“ألا يمكنك تذوقها؟. “طعم زجاجتي مروّع” قالت.
“المشروبات المقوية طعمها سيء. يمكنك تجربتها إذا أردت”.
تذوقتها وبصقت رشفتي سريعًا. كانت محقة؛ طعمها مروّع بالفعل. بعد ذلك لم أستطع منعها من تذوّق زجاجتي.
“هذا رائع” قالت بحماس بعد تناول رشفة منها. “زجاجات السعال دائمًا ما تكون رائعة. هل تجربها؟”.
فعلت، ووجدتها محقة في ذلك أيضًا. كان طعمها حلوًا جدًا ولزجًا.
“أعطني رشفة أخرى” قالت بحماس وهي تمسك بالزجاجة”.
“ستنفد كلها” قلت.
“لا، لن تنفد” ردت ضاحكة. “لديك جالونات منها”.
لسبب ما لم أستطع مقاومتها. جرفتني من مرساي إلى عالم غير مألوف من الأبراج والأشجار والدرجات والأزقة الغامضة والفتيات الصغيرات ذوات الشعر والأحمر والعيون الخضراء.
أخذت رشفة وأعطيتها أخرى. ثم بدأت أشعر بالذعر. “لقد أوشك على النفاد” قلت. “ماذا سأفعل الآن؟”.
“أنهه وقل إن السدادة سقطت” أجابت.
ومجددًا، بدا ما قالته معقولًا بما فيه الكفاية. أنهينا الزجاجة بيننا، ثم، وبينما كنت أتظلع إليها وهي فارغة في يدي كما جلبتها، متذكرًا عدم الوفاء بكلمتي للعذراء المباركة، وأنني أنفقت البنس الخاص بها على الحلويات؛ اجتاحتني مرارة رهيبة. لقد ضحيت بكل شيء من أجل الفتاة الصغيرة، وهي في المقابل لم تهتم بي. زجاجة السعال كانت مطمعها طوال الوقت، واكتشفت خداعها متأخرًا. وضعت رأسي بين يديّ وبدأت أبكي.
“لماذا تبكي؟” سألتني الفتاة الصغيرة بدهشة.
“أمي مريضة، ونحن نشرب دواءها” قلت.
“آه، لا تبكي كالعجائز!” قالت باحتقار. “كل ما عليك قوله إن السدادة سقطت. بالتأكيذ هذا شيء يمكن أن يحدث لأي شخص”.
“وعدت السيدة العذراء بشمعة أيضًا، وقد أنفقت المال عليكِ!”. صرخت، ثم أمسكت فجأة بالزجاجة الفارغة لأركض في الطريق بعيدًا عن الفتاة وأنا أبكي متحسرًا على ما أهدرته.
الآن، لم يعد لدي سوى ملاذ واحد فقط. عدت إلى الكاتدرائية بأمل حدوث معجزة. ركعت أمام ضريح السيدة العذراء، أطلب المغفرة على إنفاقي البنس الخاص بها، ووعدتها بشمعة أخرى من أول بنس أحصل عليه إذا ساعدت أمي على الشفاء قبل رجوعي إليها.
زحفت بائسًا نحو المنزل، عائدًا إلى قمة التل العظيم، لكن بعدما انطفأ كل ضوء، وأصبح التل عالمًا موحشًا، غريبًا وقاسيًا، إلى جانب ذلك راحت الأعراض المرضية تداهمني. اعتقدت أني على وشك الموت، وكان ذلك من ناحية ما أمرًا جيدًا.
حينما عدت إلى المنزل لكمني صمت المطبخ ثم منظر المدفأة التي انطفأت نارها، فأدركت، وبمنتهى القسوة، أن السيدة العذراء قد خذلتني. لم تكن هناك معجزة، وأمي لا تزال في السرير. على الفور رحت أصرخ.
“ما الأمر يا صغيري؟” نادت أمي بقلق من الطابق العلوي.
“لقد فقدت الدواء” صرخت مندفعًا إلى الأعلى مجتازًا الدرج لأرمي نفسي على السرير وأدفن وجهي في الملابس.
“أه، يا عزيزي، إذا كان هذا ما يزعجك!” قالت بارتياح وهي تمرر أصابعها في شعري.
“هل حدث مكروه؟” أضافت بعد لحظة “حرارتك مرتفعة”.
“شربت الدواء”. صرخت.
“آه، ما الضرر؟” همست لتهدئني. “يا لك من طفل مسكين، سيء الحظ! كان ذلك خطأي لأنني تركتك تذهب كل تلك المسافة بمفردك، ثم تنتهي رحلتك بلا جدوى. اخلع ملابسك الآن. يمكنك الاستلقاء هنا”.
نهضت، وأخرجت نعلها ومعطفها، ثم بدأت تفك حذائي وأنا جالس على السرير. قبل أن تنتهي كنت قد استغرقت في النوم. لم أرها وهي ترتدي ملابسها ولم أسمعها تخرج، لكنني بعد فترة شعرت بيد على جبهتي، ورأيت ميني رايان تتطلع إليّ، وتضحك بسخرية.
“آه، ليس بالأمر السيء” قالت، وهي تسحب شالها حولها. “سوف ينام حتى الصباح. عزيزتي مدام سوليفان، تعرفين أنه يجب عليكِ البقاء في السرير”.
كنت أعلم أن ذلك حكمًا علىّ، لكن لم يكن بإمكاني فعل أي شيء. في وقت لاحق رأيت أمي تدخل بالشمعة فابتسمت لها وابتسمت لي.
قد تشعر ميني رايان نحوي بالازدراء كما تشاء، لكن هناك آخرون لا يشعرون بذلك. لقد حدثت المعجزة بعد كل شيء.