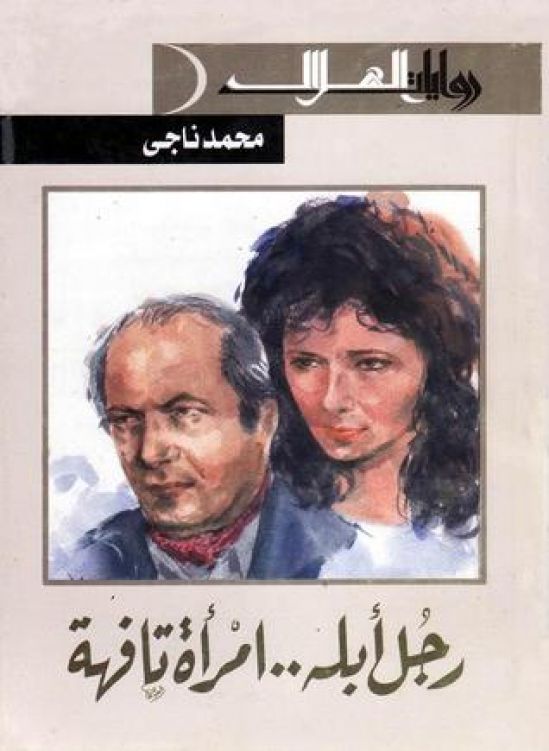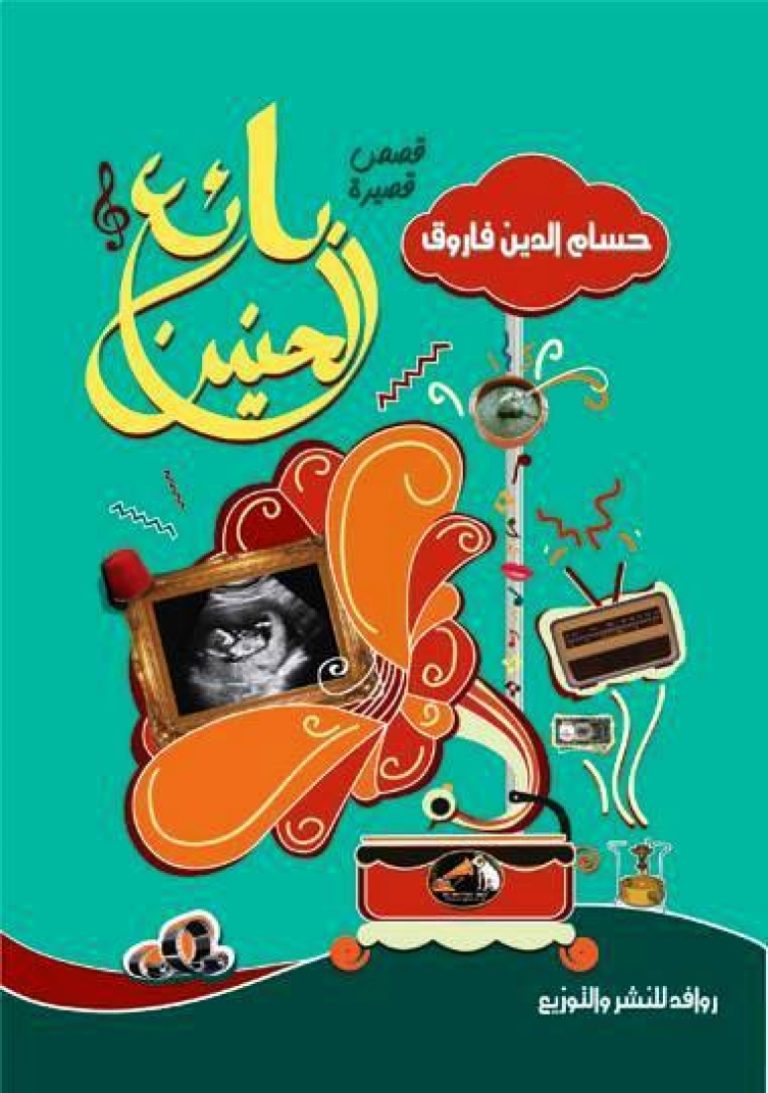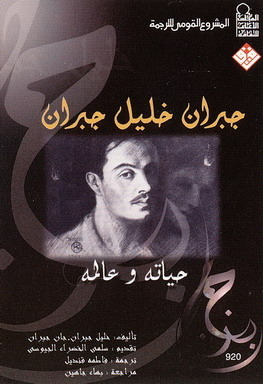من هذه الزاوية الواسعة ، فإن رواية مثل ” رجل أبله .. امرأة تافهة ” تبدو كإحدى أكثر روايات “ناجى ” خداعاً سواء من حيث مظهرها البسيط ، أو فى عنوانها الذى يبدو للوهلة الأولى ساخراً من الطرفين فيما هو يتعامل معهما بحب شديد راسماً قصة حب استثنائية فى ظروف صعبة ، مروراً بتجريد اسمى الرجل والمرأة مما قد يوحى للقارئ المتعجل بما يشبه “التنكير” و”التقليل” فيما يريد الراوى العكس تماماً وهو أن يجعل الرجل والمرأة عنواناً على جيل أعطى كل شيء ( على اختلاف الطريقة والأسلوب ) ولكنه لم يأخذ شئياً ، فلم يعد باقياً له سوى أن يدافع عن أيامه الأخيرة وسط أمواج عاتية ، وكأنه الإله ” شيفا ” متعدد الأذرع الراقص وسط النار ، وقد عقد بيسراه العالية دائرة اللهب المقدس ، وأطلق بيمينه إيقاع الحياة . ” رجل أبله .. امرأة تافهة ” خادعةٌ أيضاً بهذا السارد الماكر الذى يبدو أكثر ضجراً من أبطاله بينما هو يستدرجنا ليرسم صورة لفكرته البديعة : الحياة ليست أفكاراً كبرى فقط ، وليست تفاصيل تافهة فقط ، الحياة هى الإثنين معاً . الإنسان ليس عقلاً فقط ، وليس قلباً فقط ، ولكنه الإثنين معا ، وفى جسد واحد . علاقة الرجل بالمرأة لم تأخذ فقط بعداً قدرياً ، ولا هى اختيار من الرجل ليختبر حريته ، ولكنها الإثنان معاً . هى إذن رواية “تصالُح التناقضات” داخل الكائن الأعجوبة : الإنسان ، وهى أيضاً لعبة تعدّد زوايا الرؤية بين بطلى الحكاية ، هو يراها تافهة لأنها تضيع وقتها فى تفاصيل صغيرة ، وهى تراه أبله لأن الأفكار الكبرى التى آمن بها لم تستطع أن توفّر له الحد الأدنى من الحياة المادية اللائقة ، ولم تجعله بعيداً عن هاجس الموت وحيداً منبوذاً عارياً يدارى عورته بيده مثل أستاذه ، ولكن ما أن تنتهى من قراءة الرواية حتى تظهر وجهة نظر ثالثة : لم يكن الرجل أبله ، ولم تكن المرأة تافهة ، لم تكن مشكلته أنه يكتب عن العالم الثالث ولكن المشكلة فى أن يكتب عن العالم الثالث فى إحدى دول العالم الثالث ، فيدفع الثمن مرتين ، نظرياً وعملياً ، لم تكن المرأة تافهة وهى تحسب المرتب بالورقة والقلم ، لأن هذه هى الوسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة فى زمن المادة . يخدعنا السارد فى بداية الحكى بالإنحياز لوجهة نظر الرجل الخاطئة ، فالمرأة تزوجته من أجل الجاه والمال ، وهى من النوع ” الذى يرمى نفسه ويموت تحت أقدامك ، فتضطر الى حمله على كتفك ” ، فى النهاية تكتشف أنه لم يكن هناك أصلاً لا جاه ولا مال ، وأن المرأة هى التى ستحمل الرجل فى ايامه الأخيرة ، وأنه هو الذى سيموت بين يديها ، المعنى الظاهر هو السخرية من الطرفين ، ولكن المعنى المقصود هو التعاطف الشديد مع حكاية حب بديعة كل مشكلتها أنه جاءت فى خريف العمر بعد أن أصبح الرجل محبطاً إحباط “دون كيخوته دى لامانشا ” فى حربه العبثية مع طواحين الهواء ، ولكن الرجل مثل “دون كيخوتة ” لم يتخلّ أبداً عن افكاره الكبرى ، كانت المعادلة ينقصها قلب كبير فى صورة امرأة عاشقة ، أصبحت بينهما صداقة عميقة ، عميقة كالفجوة ، وكأنه وجد ما ينقصه ، وكأنها وجدت ما ينقصها ، وكأن الإنسان عاد الى ما يجب أن يكون عليه : عقل كبير ، وقلب أكبر .
وبقدر غياب الأسماء عن الرجل والمرأة ، وكأن الرجل “فكرة كبرى ” عن جيل الأحلام الكبيرة والإحباطات الأكبر ، وكأن المرأة فكرة كبرى عن إيزيس معاصرة تلملم بقايا جيل مثخن بالجراح ( الرجل الصحفى و الأخ مدرس الموسيقى الذى يحصل على نصف معاشها و زغلول الدسوقى الذى مات وهى تحمّمه و الطبيب المنبوذ من عائلته والتائه بين السياسة والطب والشعر) ، فإن ناجى يعادل هذا التجريد للبشر كأفكار ، بتقديم كل “التفصيلات الصغيرة” عن أبطاله : هو ولد وعاش وحيداً ، فقد أمه بعد شهرين من مولده ، لم يشعر بالإستقرار لتنقّل والده “شكرى أفندى” ناظر المحطة من مدينة إلى أخرى ، كانت علاقتهما هامشية ، وكانوا ينظرون للطفل الصغير على أنه رجل كبير فى طور النمو ، ثم جاءت مرحلة الانتماء السياسى والسجن والتخصص فى الكتابة عن العالم الثالث وقضاياه ، كان يفخرأنه ظلّ جاداً دائماً ، أما هى فقد تأخرت فى الزواج ربما لأنها جميلة ، عملتْ فى مهن مؤقتة حتى تحتفظ بمعاش والدها الذى تقتسمه مع أخيها المتزوج صاحب الأولاد ، إخصائية اجتماعية فى دار المسنين تؤمن بالقلب والإحساس ، امرأة عاشقة قوية الشخصية تذكرنا على نحو ما بتلك المرأة فى إحدى مسرحيات ” توفيق الحكيم ” ، التى ذهبت لتخطب الرجل الذى أعجبها ، إنها المرأة الأم والوطن البديل والطاقة البديلة التى ستمتد يدها الحانية الى كل التائهين والحيارى .
ليس هناك أثرٌ لمحاكاة ساخرة للرومانسية ، لأننا أمام قصة حب حقيقية جداً كل مأساتها أنه حدثت فى زمن أبله يسمح لرجل جاهل ولصّ للأفكار بأن يكون مديراً للتحرير ، وزمن تافه يترك مناضلاً حارب الإنجليز ورصّعتْ جسده عشر رصاصات لكى يموت خجلاَ مُعذباً مُخفياً عورته ، صمد أمام الرصاص ولم يصمد أمام نظرة شفقة من امرأة رأته عارياً ، كان يمكن أن يموت الرجل مثل أستاذه “زغلول الدسوقى ” لولا هذه المرأة التى اقتحمت حياته فأدرك لأول مرة معنى التفاصيل والأشياء الصغيرة ، الأشياء التافهة ، يقول محبطا “خربت ” فتقول له مشجّعة ” اكتُبْ ” ، يحدّثها عن الغريزة فتحدثُه عن الحب ، يكلّمها عن العقل فتأخذه الى القلب ، الرجل الذى كان يهرب ويشعر بالضجر سيردّد أخيراً كلمات الحب لهذه “المرأة التافهة الرائعة ” ، بل سيفكر أن يمنحها بوليصة تأمين بعد وفاته ، ولكن مشروعه يفشل بسبب أمراضه ، سنكتشف أكذوبة المال والجاه التى تبنّاها السارد الماكر الذى سرعان ما سيعود فى السطور الأخيرة الى أهمية التفاصيل الصغيرة من خلال امرأة أبرز ما توصف به أنها امرأة عاشقة .
الجدل والتآلف بين الأفكار المجردة والتفاصيل الصغيرة ليس فقط على مستوى السرد ، ولكنه أيضاً فى تحولات الشخصيات وأفكارهم التى تنطلق من تفصيلات صغيرة جداً ، هناك أربعة أفكار كبرى تتردد فى الرواية لأربع شخصيات محوريّة ، ولكنك لو تأملت لاكتشفت أن هذه الأفكار لم تولد هكذا ولكنها خرجت من تفصيلات بسيطة بل وتافهة ، “شكرى أفندى ” مثلا ناظر المحطة الصارم الذى يضبط ساعات الدنيا على ساعته السويسرية ، والذى يكرر عبارة ” الساعة كام ؟” انتظاراً لوصول القطار ، ينتقل بالسؤال المباشر الى ما يشبه حالة انتظار صوفية ، يزور الأولياء والصالحين ، ويصبح لنفس السؤال : ” الساعة كام؟” معنى أكبر وأخطر ، والمعلم “كسّاب ” الذى يبدو جاهلاً يتعلم الحساب بالكاد ، ولكنه ينطلق من المعنى البسيط للأرقام الى اعتبارها سر الكون ، بل إن حكايته عن تعلم الحساب تبدو كما لوكانت إلهاماً خارقاً وكشفاً يفتح مغاليق المعرفة ، والطبيب الذى يعيش حياته بمنطق البدائل يبدأ من خريطة الطاقة الجسدية الى التفكير فى خريطة طاقة للمجتمع كله وربما للكون أيضا ، حتى الرجل الذى يكره التفاصيل الصغيرة يبدأ من واقعة صغيرة شاهدها فى كل دول العلالم الثالث ، وهى ذلك الحاوى الذى يبكى ويقول : “قيدونى.. قيدونى ” ، لينتهى الى فكرة لامعة جداً وهو حال الدول نفسها التى مازالت تصر على تقييد نفسها حتى بعد الإستقلال ، وكانها لا تستطيع العيش بلا قيود . المعنى أنه لا أفكار كبرى بدون الإنطلاق من أفكار صغيرة أو حتى تافهة ، كما أن ” خلفية المشهد تؤثر على درجة رؤيتنا له ” ، وهو ما أدركه الرجل فى نهاية المطاف .
قصة حب وصداقة واحتياج متبادل ، فى منتصف الرواية يعلن السارد المتضجر بلامبالاة أن بطلنا قد مات ، وان المرأة قد واصلت دورها فقامت برعاية الطبيب الشارد صديق زوجها ، لم يكن الطبيب يحب التفاصيل الصغيرة فكتب توكيلاً لزوجته ، باعت أملاكه وطلّقته وتزوجت رجلا آخر ، ومع ذلك لا تنتهى الرواية بموت الرجل ، سيتحول الموت الى “تفصيلة عابرة” فى مقابل الحوار المتواصل بين الرجل والمرأة التى تبيع دبلة زواجها للإنفاق على المنزل ، وتتغاضى عن سرقة زوجها لخمسين جنيهاً من أجل أن يشترى السجائر والخمور ، تتحول المرأة الى أم تلقى درسهاً على طفل مستسلم ، ولكنها لن تنسى أنها عاشقة تريد ان تحفر اسمها وتاريخ زواجها على دبلة الزواج الجديدة ، تبدأ الرواية بلقطة محايدة وتقليدية : زوجان يتناقران مثل كل الأزواج ، وتنتهى بمشهد حب استثنائى شديد العذوبة عندما تصبح المرأة هى الباب الواسع للإحتواء ، والواحة الأخير للفارس المُتعبْ .
يقول المصّور صديق الرجل : “الحياة لقطة ” ، فيقول الرجل : “الحياة تصوُّر” ، والرواية تبدأ باللقطة ولكنها تنتهى بالتصوّر الجديد : لم تكن المرأة عاهرة تصطاد رجلاً ، لم تطمع فى المال أو الجاه ، كانت المرأة هى النصف الآخر المفقود لدى جيل الأفكار الكبيرة ، كانت القلب الذى يحتاجه صاحب السؤال ، كانت “إيزيس” التى تلملم الثروات البشرية والفرسان المهزومين الذين قصفتهم تفاصيل الحياة ، كانت نسمة الصيف لكل الذين كتبوا لمن تنفعه الذكرى ثم أصبحوا على هامش الحياة ، لم يكن ينفع الرجل أن يتزوج من صديقته المثقفة الراحلة “رورا” التى لم تهتم أبدا بالتفاصيل ، كان القطار فى حاجة أن يتوقف قليلاً عند المحطات الصغيرة بعد أن ظل طوال عمره لا يتوقف إلا أمام المحطات الكبيرة ، كان الرجل فى حاجة الى أن يصفّر بمرح وانطلاق بعيداً عن المارشات العسكرية المنتظمة .
ماذا بقى من رحلة الأفكار الكبيرة ؟ صورة مع “كاسترو” وأخرى مع “أنديرا غاندى” وأقنعة أفريقية وتمثال الإله “شيفا” الراقص فوق النار بأذرعه المتعددة ، وماذا بقى من تجربة التفاصيل الصغيرة ؟ رحلة حب عميقة ودرس فى معنى الحياة وعلامة استفهام مفتوحة على السماء والبحر بين رجل وامرأة .
هنا رواية عظيمة عن رجل محبط أنقذته امرأة عاشقة من موت مهين مجّانى فعاش لحظات عذبة فى زمن البلاهة و التفاهة والحواة والبهلوانات .
وتبقى الحياة كالرواية: مجرد لقطة ثابتة لا نعرف ” تصوّرها ” إلا فى اللحظات الأخيرة، أو فى سطور الرواية الأخيرة ، عندها فقط نتذكر السؤال المنسى: “الساعة كام؟”.