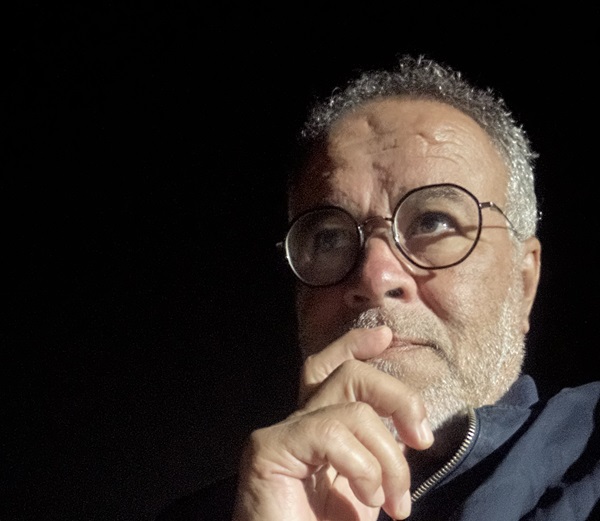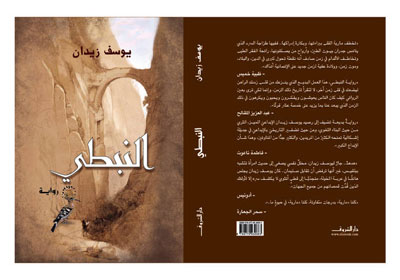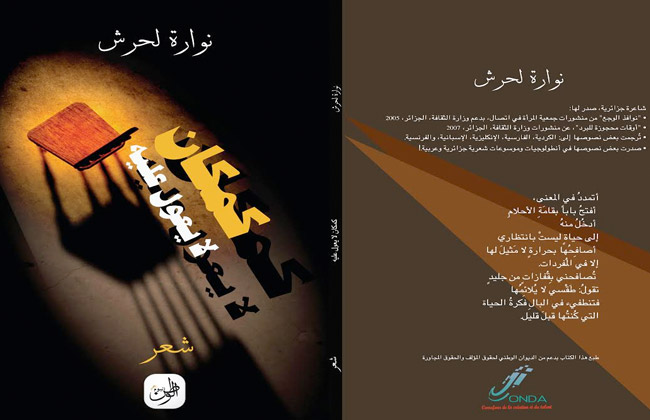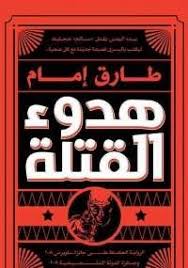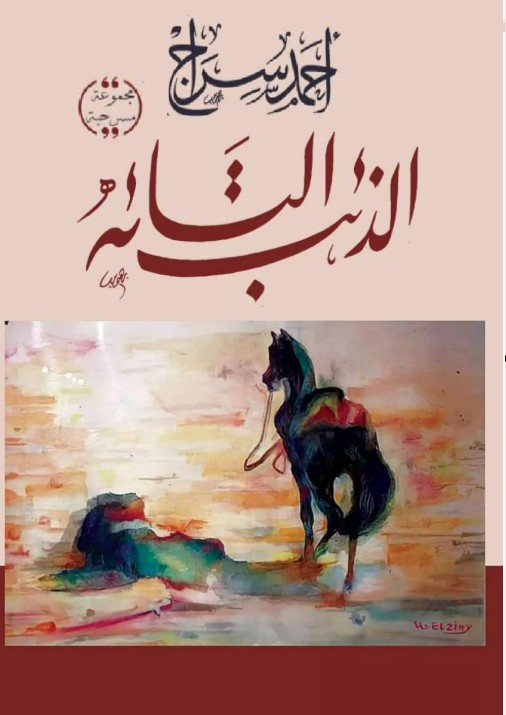د. محمد رزيق مبارك
«رائحة المكان» كما عرَّفَها كاتبُها، عبد الإله بلقزيز، نص» يكسر الحدود بين الأجناس الأدبية ليفتحها على بعضها «؛ صدَر النص عن منتدى المعارف اللبنانية في طبعته الأولى من العام 2010 من الحجم الصغير في 191 صفحة.
توشية
تيمّمْتُ الأطلس الكبير، أنتوي قمة جبل توبقال الشمّاء أو بُحيرة إفني العذبة الغائرة، فحال بيني وبينها أَلَمٌ ألَمَّ بظهري ألزمني المكوث بقرية إمليل الهادئة وواديها السخي بخيراته، مستمتعاً بصفاء الجو وخُضرة الأحواض وكرم الأهل والمكان. مكان يفرض عليك طقوساً تمليها طبيعةُ أشجارٍ باسقةٍ غنّاء، مثقلةٍ بثمارٍ تتنوع لوناً ومذاقاً، تصغي في قُدّاس روحي إلى انسياب السواقي التي تروي عطشها وتزيدُها النظراتُ نضارةً.
قفلْتُ منحدراً من صياصي الأطلس ومعي طلبٌ باقتناء بعض الحناء، وأنا أنحدر صوب مراكش قاصداً سوق السمّارين أو سوق العطّارين؛ في غفلة منّي، انعطفت بالسيارة خطأً صوب حدائق “أكدال” التي تحوي من أشجار الزيتون والليمون الشيء الكثير، ناهيك عن الورد الجوري الدمشقي، شُجيِّره ومُتسلِّقه، فانصرف بصري تلقاء أسوار مراكش وأبوابها. عندها تضاربت حزمة من الأسئلة في خلدي عمّا تحوشه هذه الأسوار والمدينة يحصِّنها رجالاتُها وأبوابُها*، ترجّلت ودلفت يساراً بعدما عبرت» باب دكالة«، حيث انتبدت بعد مسير ليس بالعسير مرقد أبي العباس السبتي، ذلك الذي ينْوَجِد الوجود عنده بالجود، ودنوت من الحوش سالكاً الطريق، فكانت تتصاعد إلى خياشيمي روائح تتوق من كل كوَّةٍ في الحوش، عطرُها توابل وشذاها أبخرة وأريجُها لَكْنة أهلها، أو أجراس عرباتها ووقْع حوافر أفراسها وهي تدوس أسفلتاً ماع حياءً من صفحة شمس لا تتوقف عن مغازلة الحمراء وهي تُبَشّر المراكشيين بليل دافئ يحلو فيه السّمَرُ البدْريُّ، وتُشكِّل حكايا الجدّات جوازات سفر بلا تأشيرات للصغار كما للكبار إلى عوالم خارقة، يتحول فيها المستحيل إلى ممكن، ويندمج رواد «الحلقة» مع أبطال الحكاية؛ لينسجوا من الغريب والعجيب خيالاً ليس حدود.
في هذه الأجواء ومن تلك الأنسام عبِقَتْ «رائحة المكان»، وامتشق عبد الإله بلقزيز يراعته وغمسها في دواة الذاكرة مدوناً مشاهدَ ومقاطِعَ تختلف طولاً وقِصراً، كثافةً وشَساعةً.
يفسح المجال ويقتسم مع قرائه جزءاً من حياته من خلال نص «رائحة المكان»، التي هي «ومضات من الطفولة والمراهقة ومطلع الشباب». «رائحة المكان» نصٌّ أدبي يندرج ضمن السيرة الذاتية، كما هو نصٌّ «ينتمي إلى جنس من الكتابة يكسِّر القوالب المألوفة في التعبير الأدبي، ويكسِّر الحدود بين الأجناس الأدبية ليفتحها على بعضها»[1]؛ لا ليجعلها مشاعاً مستباحاً بين هذه الأجناس، ولكن ليمتح كلٌّ من جميل ما في غيره، فيتشكَّلُ نص رصين يقاوم دواهي اغتراب الذات في وطنها كما في بلاد الغربة، يترنّح بين مدّ الأحداث وجزْرها غير متقوقع في برك يتسنّه ماؤها بالركود.
إنه جسر محبوك الصنعة بين النثر الأنيق والنظم الحرّ الرفيع، في انتقاء العبارات والمكونات بكل عناية وتبصُّر حتى تأتي دعامات هذا الجسر متراصة وأنيقة، كأنّ مهندس هذا الجسر/ النص، يخطُّ تصميماً هندسياً لما سيكون عليه العمل، فيَرُوح يملأه بلغة تتساوق مع ما أعتقده محدِّداً لهوية كاتبه.
السيرة الذاتية و«رائحة المكان»
ينزع الإنسان بطبعه إلى الرغبة في اقتسام تجارب حياته مع غيره، إنْ لتقويمِ وتشذيبِ فعله في الحياة، أو للكشف والإجابة عن أسئلة لدى الآخرين حول شخصه، أو ليترك بصمته في الدرب الذي مرَّ منه…ويُعبّر عن هذه الرغبة البشرية بالحكي الشفاهي أو التدوين الكتابي؛ ومن وسط التدوين والكتابة انبرت السيرة الذاتية في شكلين اثنين: أن تكتب عن حياة الغير كسيرة ابن هشام والرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري وغيرها كثير، أو أن تكتب عن نفسك كالاعترافات لجان جاك روسو، أو الأيام لطه حسين، أو الساق على الساق في ما هو الفارياق لأحمد فارس الشدياق، وغير بعيد حفريات في الذاكرة لمحمد عابد الجابري…
وفي كل هذا تأتي »السيرة الذاتية حَكْياً استعادياً نثرياً، يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصة[2]«؛ هكذا عرّف فيليب لوجون السيرة الذاتية؛ وإن كانت من الأجناس الأدبية الأكثر استعصاءً على التعريف، لكونها تتقاطع مع أجناس أخرى من قبيل أدب الرحلة، واليوميات، والمذكرات، أو الرواية الشخصية وقصيدة السيرة الذاتية، وكذا القصة والرواية ما كانتا واقعيتَيْن…ومن التعريف السابق نستخلص مقومات السيرة الذاتية باعتبارها جنساً أدبياً؛ فهي تتحدّد في شكل اللغة التي تكتب بها أولاً، وثانياً الموضوع الذي يقوم على رواية حياة فردية وتاريخ شخصية معينة يكون فيها توافق بين الشخصية الرئيسة والسارد، ثم ثالثاً ضرورة التطابق بين السارد والمؤلف وإن بضمائر مختلفة (أنا/ أنت/ هو)، بالإضافة إلى أنّ متنها خالٍ من الوصف باعتباره حكياً استعادياً.
أين تقع «رائحة المكان» من كل هذا؟ وما دلالة تذييل العنوان ب “نص“؟
يشهد ما تمَّ تدوينه على ظهر الكتاب على انتمائه للسيرة الذاتية: «النصّ من حيث خامتُهُ يشتغل على السيرة الذاتية: سيرة الكاتب في ومضات من الطفولة والمراهقة ومطلع الشباب»[3]. بدءاً، لا يقوم المتن على أخبار محكية أو أحداث تاريخية كما هي السِّير في الإبداع الأدبي، لكن «رائحة المكان» يقوم على حكي حقيقي واقعي في بناء متماسك وبلغة أدبية أخرجته من التاريخية إلى الفن الأدبي الممزوج بشيء من الخيال والصنعة الفنية. فلا شيء يُقال عن شكل الكلام أكثر مما تمت توشية النص به مما تزخر به أجود الأطباق العربية «إن الكلام مصايد القلوب والسحر الحلال»[4]. وما اقترب أحد، ممن أعرف، من هذا النص إلاّ ووقع في شِراكه يرتع من فقراته وأبوابه مرة ومرة. فهو نص يجمُل ببيانٍ أوصى بطلبه صاحبُ النص، «واطلُبْ لنصِّك من الجمال ما يكفيه ويرفع عنه حاجة إلى المدد»[5]. وقبل أن تطرق أبواب النص يستوقفك الوشاح المرصع على صدر الزميل ورفيق القضية محمود درويش، وشاح يحمل عبارات الاعتراف بالجميل للشاعر، لابن حورية حَنَّ إلى خبزها وقهوتها، عبارات الإقرار والبوح بمن دلَّ عبد الإله بلقزيز على ذاته وأناه؛ كان مِمَّن دلَّه على ذاته بعد محمود أو قبله: المِرْآة. تلك التي فضحت تقدم السنين عبر الجسد تاركة شواهدَ وهي تنصرم على شكل وعكات ألَمٍ أو جذواتِ شيبٍ تُلوِّح بالانفلات والانصراف البطيء من الزمان. «وحدها المِرْآة تفضحك حين تكتشف الطفولة تفرُّ منك والبراءة تبرَحُك»[6]. في “ما يشبه السيرة الذاتية، لأكيرا كوروزاوا الياباني (1910/1998) تحدّث عن الكتابة عن الذات قائلاً: «أن تكتب عن نفسك، تماماً، هذا يعني أن تجلس بين أربعة جدران مغطاة بالمرايا وأن تحدق فيها، تريد أو لا تريد، تجلس وترقب نفسك من زوايا مختلفة فتحس بأنّك مختلف بعض الشيء عن ذاتك»[7]. تلك هي المِرْآة تَلْجِم وتُلزِم، تلجمك فتقف أمامها واجِماً متطلِّعاً إلى نفسك لا تتحرك إلاّ لتتأكّد بأنّك أنت هو أنت الآن لا كما كُنْتَهُ بالأمس، ولا كمن ربط اليقطين إلى قدمه حتى لا ينسى من هو؛ كما تلزمك المرآة أن تستعرض المشاهد التي كنت بطلها ذات يوم، فانصرمَت تلك الأيام وانصرف الجمهور، فلم يبق منهم إلاّ أنت من يحكي التفاصيل لمن غاب عن الوقائع والأحداث.
ولعل نص «رائحة المكان» يتَعَصَّى على المتتبع والقارئ، أنّى له أن يتبَيَّن فيه عناصر السيرة الذاتية. فبناؤه سميك كما هي أسوار مراكش الحمراء، يعسُر تَسوُّرها إلاّ من أبوابها، وما من باب تدخله إلاّ وتكشّفَت لك حكايا وأساطير خلّدتْها كتب التاريخ أو الروايات الشعبية؛ تجد بعضاً منها يُحكى دون كلَلٍ أو مللٍ بساحة «جامع الفناء» أو بأفْنِية الرياضات بالمدينة العتيقة. تلك أبواب مراكش! فماذا عن أبواب «رائحة المكان»؟ إنها تُفْضي إلى إماطة اللثام عن بعض ما يثوي خلف شخص كاتبها؛ رجل يتمنَّع -كما هي الحمراء-بهالة حوله أو أرادها أن تكون كذلك بقصد أو غيره، حتى بات شائعاً أن قصره مرصود يصعُبُ الدُّنُو من سور حديقته؛ كنْتُه كذلك حتى فتحتُ أبواب «رائحة المكان» فانكشفت لي حقيقته وهو يردد «وحدي تعلمت ألاّ أكون وحدي في المكان. كل مَنْ حولي وجوه أعرفها وأسمعها وتسألني وأنا وحدي المجيب. وحدي من يوزع الحقائق والحقائب والأدوار والأحكام. وحدي الذي لا يُرَدُّ له كلام»[8]. هو ذا الرجل ينسجم مع ذاته، كبُرَ و«لا بُرْءَ له من داء المزاحمة» يخاطب ذاته قائلاً: «أيها الطفل الذي لازلت تسكنني، لا تزاحم»[9]. فلا أحد يزاحمه في التّربُّع على قلب الجدّة، لا يطيب لها المقام وهي تتفقد ابنتها الثانية، فتعود ويكون سؤالها الأول عنه، وإن كان هو الحادي عشر من إخوته والثالثة عشر من الحفدة. لقي دَلالاً أكسبه ثقة في النفس جعلته لا ينثني عن مبتغاه «وحدي تعلمت الصعود إلى شرفة أحلامي… وأوهامي: أبني مدُناً وأهدمها؛ أحيي الموتى وأسألهم؛ أُبارز الجن وأصرعهم؛ أتخيّل حريقاً في المدرسة؛ أهفو لعطلة لا تنتهي ولإخوة لا يُكذِّبونني»[10].
مورفولوجية النص: الأبوابَ بين النص والمكان:
وقبل أن تقرع أبواب النص، يفرش لك الكاتبُ الثرى خمائلَ تحت دوحٍ ظليلٍ ونبع لا ينضب معينه، إن أنت أردت الكلام فأحْسَنُهُ «ما… قامت صورته بين نظمٍ كأنّه نثْر، ونثرٌ كأنّه نظمٌ»[11] فيما طفح عن أبي حيان التوحيدي (310هـ/414هـ). هكذا توزَّعَ النصُّ إلى أبواب وساحة مع استهلال هو خَوْخَة البناء؛ وفي هذا مُعارَضة أدبية جميلة، طابَقَ الكاتبُ الشكلَ المعماريَّ لمدينة مراكش بهندسة النص، قصَدَ ذلك أم عفواً جاءَ الأمرُ. فقد بنى الكاتب نصّهُ على أسوار المدينة محافظاً على مورفولوجية المكان، لم يغيِّر سوى أسماء الأبواب والساحة؛ فساحة جامع الفناء توسّطت المدينة كما توسّطت ساحة هوشيه منه النص. الساحة المراكشية والتي أُريدَ لها أن تدخل التراث الإنساني بوضع لوحة تذكارية أمام بنك المغرب بالساحة، في محاولة إن للمحافظة على الموروث الثقافي أو لتكريس مفهوم الحلقة والحكواتي والحوّاة ومُروِّد القردة أو المجموعات الشعبية، وعلى هامشها ما لذَّ وطاب من الفواكه الجافة أو الأطعمة والأشربة المراكشية… كل هذا اختزلَه الكاتب في حكايا الجَدَّة والدَّادَة عبر أبواب النص؛ وحوّل مضمون الساحة إلى ما يتطلّعُ إليه كلُّ رافضٍ للوضع الاجتماعي والسياسي خلال السبعينيات من القرن العشرين. فإذا كانت ساحة جامع الفناء تُهدِّئُ الرّوْع وتُحْيِي ذكرى «سلطان الطلبة «و«البْساط «أو قصص من التراث الشعبي «احماد أُونمير « و«هينة« أو«سيف ذي يزن «… حيث تلتقي الخرافة بالواقع والمرئي باللامرئي، وبينهما يسبح الكاتب في برزخ عوالم التيه واليقين. فإنّ ساحة هوشيه منه، ساحة احتقان ورفْضٍ وثورة على الأوضاع، ساحة نضال وتربية ومراس على المقاومة. وفي هذا تكمن براعة الكاتب في طباق بديع لم يحضر فيه سوى حدَّيْ أو طرفيِ التشبيه. وفي الساحتين يجمُل السمر ويحلو الطرب حتّى وإن غاب القمر. ومع نسائم هذا السمر برع السارد في ثقافة العين التي يعدُّ نفسه بعيداً عنها تواضعاً؛ ف «الكلب وحده يستنفر الأذنين، وأنت لست كلباً ولا سمِّيعَ موشح كي تطلق لهما العنان وتعطل حاسة النظر. أنت من قبيلة البصر، من حضارة الحرف، أنت من بلاد سومر وكهوف اليمن وما حمل البربر من أسرار الماضي…ومن بساتين الشام وحدائق الأندلس بُعثت كي تجد الجواب عن سؤال لا يهدأ: لِمَ تقرأ؟»[12]؛ كيف يمكن حلّ معادلة من يقف واجماً عاملاً حاسة بصره في الصوّر: «يُلْقي التحية على التفاصيل ويسكُنُ طويلاً إلى الصّور، ثمّ يُوزّعها على العين درجات: ما أوجز وما ألغز، ما باح وما أشاح، ما سهُلَ قضمُه وما عسُرَ هضمه، ما انساب وما تخثّر…إلخ»[13]. أو عندما يوزِّع زوايا التقاط الصور ليعطي قيماً للمشاهد واللقطات في الجوازات: «يجوز التقاط الصور: من تحتٍ ومن علٍ ومن مركعٍ ومن منبرٍ»[14]. تلك هي زوايا التقاط الصورة وقِيَم اللقطة! ومن حاز فَهْمَها فقد حاز ثقافة العين، ناهيك أنه أفرد للصورة الفصل الرابع من النص: «الصورة ما في لحظة التجلي خُلق، وما النفس في نفسها حملته، وما الوجدان به بعد مخاض رُزق. وللصورة أن تكون كما شاء لها لهبُ الخيال. لها أن تعيد تنظيم فوضى الدلالة في انتفاضة الأشياء؛ أن ترد البداية إلى النهاية، وأن تهب الوجودَ الممكن للمحال…والصورة للبيان كالاسم للإنسان: تدل عليه وعن غيره تفْصل، والصورة ما يجُبُّ البداهة في الأشياء ويُذْهل»[15].
في عكاظ …العين تسمع والأذن ترى
امتلك الكاتب مهارة جعلت من نصه سوق عكاظ. سوقٌ جمع فيه الشاعرَ والمفكرَ، السياسي والمطربَ، المُبدعَ والمُنظِّرَ، سوقٌ تُتَبادل فيها الأقداح: الصهباء والشهباء، النبيذ والمخلّل، صاحبة اللون الأحمر والمعتق، كما تؤثته أزهار الياسمين والجلنار والورد والزهر في فصوله المائة والثمانين التي تكوِّن معماره. عمارة حضرتها المرأة بقوة من خلال الجدة والدادة والأم ثم الحبيبة والعشيقة والمدينة التي تُعمِّدها بخور الكهان. وفي بعض أزقة هذا المعمار تسمع عن الكرباج والأصفاد والسياط والمقصلة في إشارة ذكية إلى سنوات الرصاص. مهارة النص تجعل من الصَّعْبِ عليك أن تتملّص من شِراك الصورة البلاغية التي تشكِّله أو بيان العبارة التي طَلَت جدرانه بألوان تستعذب درجتها، فيها الناصع والفاقع والقاني والحالك؛ في تباعدها حُسْن وفي تقارُبِها طعم. لَبِناتُ النص حلقات مترابطة كخرزات عقد فريد؛ فأنت لا تُنْهي فقرة حتى تسْلِمُك إلى أختها في الفقرة التي تردفها، فالعبارة التي تنتهي بها الفقرة الأولى هي نفسها العبارة التي تبتدئ بها الفقرة التي بعدها،(الفصل1 ينتهي بالنصر الفصل2 يبتدئ بالنصر وهكذا دواليْك في فصول عدة)، فكل الفقرات تقبض في بعضها دون أن تُحِسَّ بارتجاج في البناء، أو تُحدثَ صليلاً يُعَكِّر صفوَ المقام، وكأنّك تنزل عبرها إلى دهاليز اللغة بجراح التاريخ المكلومة عن جاهٍ بلَغَتْه فأضاعه الوِلْدان…وما لك إلاّ أن تأخذَ «من الماضي قديمه كي تشهده على وهج الصبا في حضرة الكهولة»[16].
سليل قوم يخشون الفراغ في الطبيعة هو الكاتب، فحرفة أجداده «الشعر وترتيل البيان. (يقول) مهنة نُتقِنها ونَتوارثُها، ونقيم لها الشعائر ونرفع الأذان»[17]. فمملكته ومملكة أبي العباس تنسجمان وتتفقان في أن كل شيء في حيِّه بمقدار: «التكسُّبُ، والتكذُّب، والتأدّب، والتبتّل، والتأمّل، والتحمّل، والتجمّل، والتجارة في الأسرار. وكل شيء هنا يستعار: التقوى، والنجوى، والبلوى، وحَلوى لسان الجارة للجار. كل شيء يُزار، الأركان، والجدران، والأوثان، والأخذان، والغيلان، والأشياء هنا بميزان: ما مضى، وما سوف يأتي، وما خلّفه الدهر مما كان»[18].
زوار السوق /النص كُثرٌ، فهُمْ من يشكل مرجعية السارد في الأفكار التي يورِدُها في نص «رائحة المكان». يعرض للشك واليقين، للممكن والمستحيل، للوجود، للإرادة، للأمل والألم، للحرية والمصقلة، للجدل والسؤال، للغربة والاعتراف… وكلها قضايا ومفاهيم وتيمات فلسفية تناولها النص، وآمن بها السارد وهو المتسائل: «هل كان الحرف إلاّ فلسفيّاً فلا تتركّب من جموعه غيرُ مفردات المادّة، والسيرورة، والصيرورة، والهوية، والكينونة، والحركة، والتغيّر، والثورة؟ أين الوردة، والحسرة والمرأة، والجمرة، والمرْج، والموْج، والريح، والشمس والمطر، والقطاف وسورة الأعراف؟»[19]. كما أن زوار النص -وهم مَنْ بَنَوْا فكر السارد-كُثْرٌ، منهم من حضر باسمه صريحاً، وجمهرة منهم حضرت مُضمرةً في ثنايا أبواب النص أو من خلال تصانيفهم؛ تجد فيهم الصعاليك وأصحاب المعلقات، كما تجد فطاحل ما زَهَا من العصور الإسلامية: الفرزدق وجرير، المتنبي والمعري، البحتري والهمذاني…ولم يَدُعَّ الثلَّةَ التي حفظت اللسان: كِتاب بني جِلدَته، ثم ابن المقفع وابن قتيبة والجاحظ وابي حيان التوحيدي، ناهيك عن عبد الرحمن بن خلدون الذي دلَّ صاحبنا على تاريخ أصوله وفصوله، ومواقع أجداده وأحفادهم ممن نَسَل بعدهم. تعرَّف على هؤلاء وهو يُدْمن ساعتها على الخزانتين: دار الطالب والخزانة البلدية بمراكش. الخزانتان اللتان بات مُريداً لهما، بل يتسَتَّر بإحداها لما تعرّف على الحكيم الجرماني وصاحبه الروسي، يُمَوِّه ويتخَفّى حتى لا ينكشف بيانه الشيوعي؛ وقد «حدّثَك أترابُك عن كائنات أخرى تشبه الجن: تختفي في الضوء وتنبعث في عتمة الليل أو حين لا يندس شعاع بين خلال النافذة»[20]. يشكُّ فيوجد، ثم يَحارُ في أمر حيِّه الذي لا يُؤمِن بصراع الطبقات، «في الحي صلح بين الذين يملكون والذين لا يملكون […]، وأنت أيها المسكون بكومونة باريس، تسأل: أين المفر؟ وأين الاقتصاد والطبقات والصراع في هذا المقر؟»[21]. فذاك ما قاله إمام الكادحين في بلاد البلاشفة؛ أما أنت ف «اقرأ ما تشاء: شعراَ ونثراً وفكراً واقرإ المكشوف والمخبّأ. اقرأ تاريخ القدامى وتهتك الندامى، دروس الحروب والحضارات وتعاليم الأنبياء المخذولين من لهو شعوبهم، واقرأ ما قالت السماء لأهلها في الأرض وما حفر الشعراء من آثار الأطلال»[22].
أنا أشكُّ… إذن أنا موجود: شكوك وحسرات!
ساوره شك لما وقف أمام المِرآة التي باحت له بالمستور عن ناظرَيْه بأن شيئاً ما يتغير فيه، فراح «يقيس الفارق بين أمس ويومه، يمارس عادته في تلصّص على معدل الرجولة، يراقب أرنبته الصغيرة تنمو في حديقة البيت»[23]، يأتيه التحذير والتنبيه أن يخجل، فيتعرّقُ ويختفي خلف احمرار الوجنتين أو وراء تمَسُّح بأرداف الياقوت التي ما خافت عليه إلا من أعباء الرجولة وهو ما زال غضّاً طريّاً. فالياقوت «دولته وجيشه وإذاعته شريعتها شريعته، وتعاويذها مدافع تدُكُّ حصون الشيطان والجان في ليله، وتملأ الخيال وتصقل الوجدان»[24].
لم يساوره شكٌّ لما علِم وتعلّم من الياقوت وشقيقاتها أن «صدر المرأة أجيش، وعينها أمطر، ولسانها أذلق، وإحساسها أرهف، وحدسها أعرق، وخيالها أخصب، وعشقها ألهب. لكنها لا تبوح ولا تجهر، وإن باحت فلواحد لا أكثر، وفي فجوة ضيقة بين صمتين مديديْن»[25] صفات متى تجمّعت في ذات نظمت شعرا ورَوَت قصصاً، إذ القصائد نسوة يُمطرن ما يُضمرن. لهذا يتحسّر ألاّ تقرض المرأة شعراً فذاك لغز الألغاز عنده أن يفيض الشعراء وتندر الشاعرات؛ بل حسرته تكمن في أن سرّاَ إلهياً يحول دون قرضه الشعر وهو من يعاقر القصيد، فالشعر ملاذه في الشدة والضيق لكنه ينكسر بين أصابعه، ينشطر لُبّه ويخجل حين تكتب المرأة القصيدة، تتنافسان وتلغزان: هيْتَ لك! ما أخجلك! لكن في صدره شيئاً من الشعر. وهو الذي حفظ الشعر والْتَهَم دواوينَه، قديمها وحديثها، موزونه وحرّه، ما تغنى به الموصلي أو صدحت به فيروز ومع ذلك اعتقد أنه والشعر يسيران ولكل وجْهةٌ هو مُولٍّيها.
شكٌّ آخر ساوره وهو يستنشق نسائم الحكيم الألماني وإمام الكادحين في بلاد البلاشفة، حفظ البيان الشيوعي وآمن بالقضية وراح ينتسب إلى من وصفهم بالكائنات التي تشبه الجن: تختفي في الضوء وتنبعث في عتمة الليل؛ لم يُبِنْ بيانُه عمّا يجْري في حي سيدي بلعباس ف «في الحي صلح بين الذين يملكون والذين لا يملكون»[26]، صُلْح بين الحصير والحرير؛ وهو المسكون بصراع الطبقات وبكومونة باريس. في سيدي بلعباس بين الفقراء والأغنياء ميثاق ف «لا فقير اغتنى في هذا المكان، ولا غنِيَّ جار عليه فيه الزمان»[27]، إلاّ أنه كان «يطرب لغده المليء بالأحداث: من فتح إلياء إلى سقوط قصر الشتاء»[28]، يسافر عبر التاريخ مُهوَّساً بالقضية العربية الإسلامية قضية القدس / إلياء وفلسطين، منشغلا بالثورات حالماً بالثورة الحمراء التي أسقطت القيصر من على عرشه في قصر الشتاء، «ويرحل إلى تاريخ مَن صنعوا التاريخ، يُصادقهم، ينادمهم، يؤدّي اليمين أمامهم بأن يكون ما شاؤواْ له أن يكون. ويرحل قليلا عن حيّه كي يرحل الحيّ عنه قليلاً فيكون»[29].
يتحسّر بأن لا ينجليَ الليل عن أرض العُرب ولم تنكسر قيودهم، فيلجأ إلى القرطاس والقلم، ويلوم النفس وهو يوصيها: «عليكَ أن تقرأ كي توقد شمعةً في عتمة فراغ مجهِد. واقرأ كي تهب المعنى للأشياء وتقهر خوفك المدفون، واقرأ لئلاّ يضيع منك الليل وتنسدل الجفون»[30]. عليك أن تقرأ ففي البدء كانت الكلمة، «وأنت ابن أول الكلام في سفر شعبك: «اقرأ»، فلا تنس النّسب ولو أبطأت الذكرى ولا تتلكّأ»[31]. اقرأ حتى لا يحاصرك الغموض.
ستكون لي أوْبةٌ ثانية لنص «رائحة المكان» ورِدْفه «ليليات»، بعدما أتناول ُثالثَ النصوص الأدبية الذي صدر مؤخراً تحت عنوان «على صهوة الكلام» عن نفس الدار ولنفس المؤلف، أبحث عن المشترك بين هذه النصوص الثلاثة، وأتلمّس فيها وجه المقارنة بينها وبين الأعمال الروائية الأخرى التي صدرت للكاتب: «صيف جليدي»، «سراديب النهايات»، «الحركة» أو «ثورات وخيبات في التغيير الذي لم يكتمل».
…………………………………..
* رجال مراكش السبعة هم: 1- يوسف بن علي، 2- القاضي عياض، 3- أبو العباس السبتي، 4- محمد بن سليمان الجزولي، 5- عبد العزيز الدباغ، 6- محمد بن العجال الغزواني، 7- الإمام السهيلي.
وأبواب مراكش عديدة منها: – باب دكالة، باب أكناو، باب أغمات، باب المخزن، باب الخميس، باب تغزوت، باب الرب، باب الجديد…
[1] عبد الإله بلقزيز، رائحة المكان. (بيروت: منتدى المعارف،2010)، ظهر الغلاف.
[2] فليب لوجون، السيرة الذاتية: الميثاق والتاريخ الأدبي. ترجمة وتقديم: عمر حلي. (الدار البيضاء، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1994)، ص 8.
[3] رائحة المكان، عبد الإله بلقزيز. ظهر الغلاف.
[4] أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (213هـ/276هـ)، عيون الأخبار4ج. تحقيق منذر محمد سعيد أبو شعر. (بيروت: المكتب الإسلامي، 2008)، ج1، مقدمة ابن قتيبة ص4.
[5] رائحة المكان، ص16.
[6] المصدر نفسه، ص 40.
[7] أكيرا كوروزاوا، ما يشبه السيرة الذاتية؛ عرق الضفدع. ترجمة فجر يعقوب. (دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 1996) ص 9.
[8] رائحة المكان، ص 36.
[9] المصدر نفسه، ص 32.
[10] المصدر نفسه، ص 36.
[11] أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة: الليلة الخامسة والعشرين. تحقيق أحمد أمين ومحمد الزين. (المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، 2019) ص 338.
[12] رائحة المكان، ص 88.
[13] رائحة المكان، ص 53.
[14] رائحة المكان، ص 17.
[15] رائحة المكان، ص 14.
[16] رائحة المكان، ص 65.
[17] رائحة المكان، ص 50.
[18] رائحة المكان، ص 86.
[19] رائحة المكان، ص99.
[20] رائحة المكان، ص 79.
[21] رائحة المكان، ص ص 81-83.
[22] رائحة المكان، ص 88.
[23] رائحة المكان، ص 71.
[24] رائحة المكان، ص 70.
[25] رائحة المكان، ص 64.
[26] رائحة المكان، ص 81.
[27] رائحة المكان، ص 80.
[28] رائحة المكان، ص 76.
[29] رائحة المكان، الصفحة نفسها.
[30] رائحة المكان، ص 101.
[31] رائحة المكان، الصفحة نفسها.