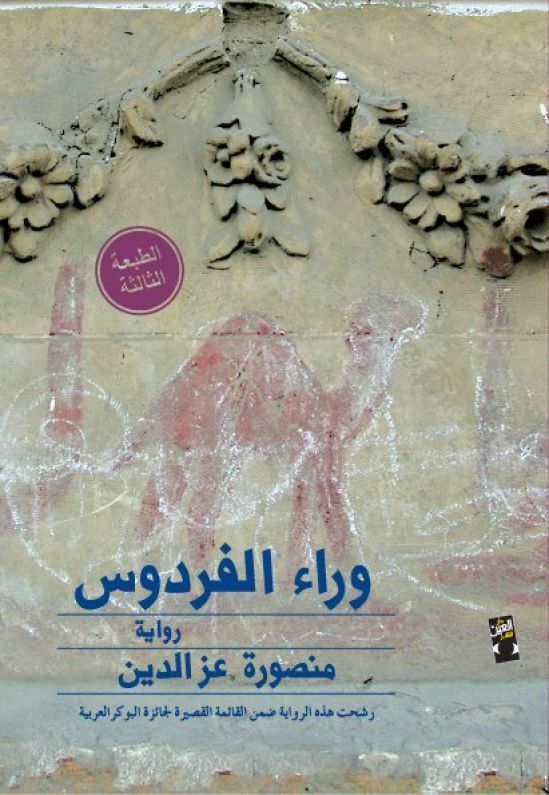د. شريف الجيار
يعد الكاتب الفلسطيني «غسّان كنفاني» (1936-1972م)؛ أيقونة نضالية بارزة، فى التاريخ المعاصر، لتجربة المقاومة الفلسطينية والعربية؛ حيث استطاع بوعيه الفكرى والسياسي، أن يدشن مشروعه الإبداعى الثوري؛ كى يجذِّر للهوية الفلسطينية، ويدافع عن قضيته المصيرية، المتمثلة فى الإنسان الفلسطينى /الأرض/ الوطن، مؤمنًا بحتمية المقاومة – بمفهومها الشامل- فى مواجهة المحتل الإسرائيلي، الذى مارس–ومازال- سياسات الاقتلاع والنفى والإقصاء والطمس، حيال الذات الفلسطينية، التى لم تجد مفرًا، إلا الموت أو الهروب واللجوء، فى ظل اغتصاب للأرض والتاريخ والحلم. وقد تلاحم هذا المنظور الثورى لغسَّان، مع قضية شعبه، عبر سياقات تعبيرية وإبداعية متنوعة، أنجزها طيلة حياته القصيرة، قبل أن يغتاله المحتل الإسرائيلى ببيروت، فى يوليو 1972م، عن عمر يناهز السادسة والثلاثين.
ويحسب لغسّان، أنه لم يقتصر فى خطابه الروائي، على الكتابة عن فلسطين، كقضية قائمة بذاتها، منفصلة عن عالمها؛ بل إنه انطلق من خصوصية التجربة الفلسطينية المأساوية، إلى رحابة التجربة الإنسانية فى العالم، لذا أضحت فلسطين فى عالم غسّان السردي، رمزًا إنسانيًّا متكاملًا.
وفق هذا السياق؛ يأتى الخطاب السَّردى لرواية «رجال فى الشمس» 1963م؛ لـ»غسّان كنفاني»، عبر بنية روائية قصيرة، تطرح تراجيديا الواقع الفلسطيني، طيلة سنوات العقد اللاحق لنكبة 1948م، وأصداءها المرة، التى ألمَّت بالشعب الفلسطيني، وأنجبت أجيالًا من اللاجئين، الذين تكبدوا مرارة البؤس والعوز، فى واقع المخيمات، بعد أن اقتلعوا من قراهم، وأضحوا فى ضياع التشرد والشتات، بلا وطن، ولا هوية، ولا أدنى سبل للعيش الكريم، إثر تقاعس الواقع العربي-حينذاك- فى التصدى للمحتل الإسرائيلي، الذى دربته القوى الاستعمارية، وسلحته، وسلمته مراكز القرار، وجميع المستعمرات، قبل خروجها من فلسطين.
وقد دفع هذا الأفقُ المأساوىُ، الإنسانَ الفلسطينيَّ، نحو الهروب إلى الشتات، كحل فردى للخلاص من واقع العدم، بحثًا عن لقمة العيش، فى رحلة الموت من أجل الحياة، أملًا فى الوصول إلى الفردوس المتخيل، والغائب المنشود؛ وهو ما تجسده الرواية، عبر إطار سردى خارجي، يهيمن فيه الراوى العليم، على جميع فصول الرواية السبعة؛ «أبو قيس، وأسعد، ومروان، والصفقة، والطريق، والشمس والظل، والقبر»؛ وتظل سلطة ضمير الغائب (هو/هى)، المؤطر الرئيسى لبرنامجها السَّردي؛ حيث ينطلق الخطاب السردى لـ«رجال فى الشمس»، وفق بنية نصية دائرية، تجسد مأساة الإنسان الفلسطيني، فى واقعه الماضوى المهزوم، وشتاته الراهن المأزوم، عبر تراتبية تصاعدية لفصول الرواية، توازت فى بنيتها، مع مسار رحلة الموت الفلسطيني، عقب النكبة، من ماضى المخيم الأليم، إلى حاضر الشتات والضياع، فى شط العرب بالبصرة العراقية، ومنه إلى المستقبل المجهول، فى صحراء الموت إلى الكويت، فى بنية تبدأ بالموت النفسي، وتنتهى بالموت الفيزيقي، فى ظل مأساوية شمولية، لم تقتصر على جيل فلسطينى دون آخر؛ بل ألمت بأجيال مختلفة، من ساكنى المخيمات الكادحين، الذين ذاقوا مرارة الشتات والغربة.
لذا شرع راوى غسّان نصه، بثلاث بدايات متعالقة، تمثل شكلًا من أشكال النصية المحاذية، التى تجنب فيها البداية الواحدة لخطابه السردي؛ مما فعَّل من مستوى التوالد النصي، فى طوايا الفصول الثلاثة الأولى للرواية، التى جاءت معنونة بأسماء ثلاث شخصيات محورية، (أبو قيس، وأسعد، ومروان)؛ حيث حرص النص على عبور حاجز النوع، فمزج القصصى بالروائي، على نحو لا تغيب فيه الروائية، فاحتضنت بداية الرواية، انفتاحًا سرديًا، لثلاثية قصصية، استثمرها الراوى العليم، فى طرح صور قاتمة، ومشاهد اجتماعية بائسة، لفلسطينى الشتات، الذين عانوا ذل المخيمات وفقرها، فى أعقاب الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين عام 1948م؛ حيث يقدم الراوى ثلاث تجارب إنسانية مأساوية، تمثل ثلاثة أجيال فلسطينية مأزومة، مشبعة بالانكسار، وذل الفقر، وهشاشة البنية الاجتماعية؛ أولها (الأب العجوز/ أبو قيس)، وثانيهما (الشاب القوى/ أسعد)، وثالثهما (الصبى الصغير/ مروان)، وكلها أنماط إنسانية ريفية كادحة، تتحرك مصائرها بالضرورة، فى ظل صراعها الحاد، مع فراغ الانتظار، الذى طال لعشر سنوات فى جحيم المخيمات، فــلم يعد لها من أمل، سوى مجرد الوجود فى الحياة، بعد سقوط قراهم المسكينة بيافا (أبو قيس ومروان)، والرملة (أسعد)، فى أيدى هذا المحتل الغاصب.
وطرح النص محنة هؤلاء الأفراد وأسرهم، عبر مسار سردي، يمزج حاضرهم الهزيل بماضيهم التعس، فى سياق ينتقل فيه الفعل السردي، من الغيرى إلى الذاتي، ومن النتيجة إلى السبب؛ حيث ينطلق الراوى العليم، من وهج حاضر الشتات- المفعم بشعور الغربة والوَحدة وفقدان الهُوية – فى شط العرب، بالبصرة العراقية، فى وهج صيف آب/ أغسطس، ليلتحم – كثيرًا- بوهج ماضى المخيمات البائس، الذى انتقل معه المنظور السردى إلى الوعى الفردي، لهذه الذوات الفلسطينية؛ حيث شرعت كل شخصية، فى تداعى تجربتها البائسة فى واقع المخيمات، كاشفة عن تفاصيل الحياة اليومية القاسية، وظروفها المأساوية، معتمدة فى ذلك، على سياقها المونولوجى مع ذاتها، والديالوجى مع ذويها؛ وهو ما عمَّق الأزمة، وفنَّد الدوافع والأسباب القهرية، التى دفعت بهؤلاء الأفراد – ودفعت غيرهم – نحو رحلة الشتات والموت، والهروب إلى المجهول، كوسيلة للخلاص من أتون الأزمة، إلى الفردوس المتخيل، إلى الكويت، أرض النفط والثراء، التى تمثل- فى تصوراتهم- الحد الأدنى للحياة، التى تحقق أحلامهم المتواضعة، التى تتيح للعجوز أبى قيس، أن يعيد ابنه الصغير قيس إلى المدرسة، ويبنى غرفة فى مكان ما خارج المخيم، ويشترى عِرْق زيتون أو اثنين، بعد أن تساوت لديه الحياة بالموت، وضاعت كرامته من أجل كيلو واحد، من طحين الإعاشة، على أعتاب موظفى هيئة إغاثة اللاجئين، لذا يحاور ذاته متحسرًا على وضعه الاضطراري، متذكرًا الأستاذ سليم، معلِّم القرية، الذى يغبطه لأنه مات قبل ليلة واحدة، من سقوط قريته فى يد الإسرائيليين: «ها هو إذن الشط الذى تحدث عنه الأستاذ سليم قبل عشر سنوات ،… يا رحمة الله عليك يا أستاذ سليم.. ترى لو عشت، لو أغرقك الفقر كما أغرقني..أكنت تفعل كما أفعل الآن؛ أكنت تقبل أن تحمل سنيك كلها على كتفيك وتهرب عبر الصحراء إلى الكويت كى تجد لقمة الخبز»/الرواية صـ14-15.ويراود الحلم نفسه الفتى القوى أسعد –المجسد لجيل الوسط- أن يرد قرض عمه العجوز، المشروط بزواجه من ابنته ندى، التى لا يريدها أسعد. وتصاعد هذا الحلم الكابوسي، حتى اخترق- أيضًا- جيل الصبي/ مروان؛ ابن الستة عشر عامًا، الذى تحمل جزءًا كبيرًا من الأزمة، بعد أن هرب الأب المُعدَم، والأخ الأكبر زكريا من مسئولياتهما، تجاه الأم وأربعة أطفال، فطلق الأبُ الأمَّ، وتزوج تلك المرأة الشوهاء/ شفيقة، ابنة صديقه القديم، التى فقدت ساقها اليمنى أثناء قصف يافا، حتى ينتقل من بيت الطين فى المخيم، إلى بيت ذى سقف أسمنتي، وتزوج الأخ الأكبر فى الكويت، تاركين المسئولية لهذا الصبى الصغير، الذى قد أتى دوره- كما يرى أخوه زكريا- و»…عليه أن يترك تلك المدرسة السخيفة التى لا تعلم شيئًا وأن يغوص فى المقلاة مع من غاص حتى يعيل عائلته»/الرواية صـ45.
والمتأمل فى هذه الأنماط الإنسانية الثلاثة؛ المجسدة- فى مجملها- للشعب الفلسطينى المنكوب، يدرك أن راوى غسّان، قد ركز على الفرد، الذى يعتبره «غسّان كنفاني»، عالمًا صغيرًا يعكس النضال الموجود فى الكون والمجتمع. مثلما نلحظ فى شخصيات غسّان، التى تشارك فى طرح قضيتها فى مرحلتها الأولى، من خلال وعى فردي، يفتقر إلى تراكم الخبرات السياسية والاجتماعية، ورؤية للمواجهة؛ لذا فقد اختزلت قضيتها فى لقمة الخبز، وفضلت الهروب إلى وطن بديل، للبحث عن حل لمشكلاتها، بديلًا عن البقاء، فهى تفتقر للوجود الحقيقى والهوية الملموسة؛ لأنها قد ضلت الطريق. فالنماذج جميعها تتشكك فى الوصول إلى الهدف، كما يقول «أبو قيس» للمهرِّب» وهل تضمن أننا سنصل سالمين؟»/الرواية صـ21؛ لأنها شخصيات عاجزة عن الصمود، فقرارها بالخلاص، جاء امتدادًا لنماذج فلسطينية محفزة، خاضت التجربة قبلهم نحو الشتات؛ فسعد حرك أبا قيس، وأبو العبد هرَّب أسعد من الأردن، وحسن ساعد مروان، فهذه الأجيال الكادحة، تعانى من ركود فى الوعي، لا يدرك مفهوم المقاومة الشاملة، التى تمسَّك بها الأستاذ سليم، معلم القرية فى يافا، الذى لا يعرف كيف يؤم المصلين يوم الجمعة، ولكنه يعرف كيف يقاوم العدوان الإسرائيلى على القرية.
وقد أدى هذا الخطأ المأساوي، والاختيار القاصر للهروب، عقب النكبة، إلى إلقاء هذا العالم الصغير/الإنسان الفلسطيني/ القضية، فى غياهب الشتات العراقي، بين رأسمالية عربية متكرشة فى شط العرب/ المهرِّب السمين، وقيادة فلسطينية انتهازية منهزمة وعاجزة/ أبو الخيزران، والجميع يتاجر به وبقضيته؛ حيث أصبح الصفقة التى تصاعدت بالفعل السردي، من التفاصيل الحياتية للأجيال الثلاثة، فى الفصول الثلاثة الأولى للرواية، إلى وحدة الهدف فى الفصل الرابع، بالاتفاق على السفر إلى الكويت؛ حيث فشل الاتفاق مع المهرِّب البصراوى السمين، الذى يهرب الناس من البصرة إلى الكويت، بمبلغ خمسة عشر دينارًا ، فهو يقول لأسعد: «- من الخير لك أن لا تضيع وقتك يا بنى ..كل المهربين يتقاضون نفس السعر، نحن متفقون فيما بيننا..لا تتعب نفسك…»/ الرواية صـ30. وهو ما دفعهم إلى الثقة فى القائد العنِّين«أبو الخيزران»، الذى يمثل جزءًا أصيلًا، من المأساة الفلسطينية، وأحد ضحاياها؛ حيث»… ضاعت رجولته وضاع الوطن، وتبا لكل شيء فى هذا الكون الملعون …»/الرواية صـ61. فقد أصبح -كما يدل اسمه- غير قادر على التوفيق بين ذاته وخسارته، لذا يهرب إلى عالم المكاسب المادية، التى تمنحه مزيدًا من النقود؛ لأنه يعانى من الفقر والاحتياج، ويريد أن يستريح، لذا وافق على خمسة دنانير من «مروان»، وعشرة لكل واحد من «أبى قيس وأسعد»، فى مقابل أن يهربهم من العراق إلى الكويت، عبر صحراء الوهج، داخل خزان ماء سيارة الحاج رضا الكويتي، التى يعمل سائقًا عليها. فهؤلاء الفلسطينيون، ضلوا طريقهم؛ لأنهم سلموا حياتهم ومستقبلهم، إلى قيادة انتهازية، ضعيفة، فقدت رجولتها، وضاع وطنها، وتدعى التفكير فى المجموع، غير أنها تسعى إلى مصالحها الشخصية؛ لذا قادت رفقاءها إلى القدر المجهول، إلى رحلة الموت؛ حيث قاد أبو الخيزران المخصي، سيارة الحلم والموت، بعد أن أقنع رفقاءه، بالمكوث فى رحم خزانها الصدئ، من خمس إلى سبع دقائق، عند نقطة الحدود فى صفوان العراقية، ومثلها عند نقطة الحدود فى المطلاع الكويتية.وقد اقترنت حركة هذه السيارة، التى تحمل فى جوفها، هؤلاء الفلسطينيين وقضيتهم، بحركة سردية تصاعدية، تنذر بحالة من الانتحار الجماعى المقنع؛ لأنهم يسيرون –بقيادتهم- فى طريق مجهولة، غير معبدة، مليئة بالحُفَر والعوائق، والمناخ الملتهب، لذا شعر أبو الخيزران، بالخوف الشديد على جيل الآباء الفلسطيني/ أبى قيس، فى حين قلَّ خوفه على الجيلين التاليين (أسعد ومروان)، لفتوة الأول، وصغر سن الثاني.
وعلى هذا، فهذه القيادة العاجزة / أبو الخيزران، تدرك قَدْرًا كبيرًا من خطورة الموقف، على الأجيال الفلسطينية المختلفة، ورغم ذلك تصر على الخوض بهم فى طريق الموت، وهو ما أدى إلى هلاكهم فى جوف الخزان؛ حيث إنهم لم يتحملوا بضع دقائق، غابها عنهم أبو الخيزران، فى نقطة المطلاع على الحدود الكويتية. ولكن أبا الخيزران عاد إليهم، فى الثانية عشرة إلا تسع دقائق، أى أنه أخذ ضعف الوقت المتفق عليه؛ حيث تأخر أربع عشرة دقيقة، وهم بداخل الخزان، فوجدهم قد فارقوا الحياة، قبل أن يحققوا شيئًا من أحلامهم المادية المتواضعة، من أجل البقاء، ومن المفارقة، أن الضحايا الثلاث، قد ماتوا فى الظلام، دون أن يروا الشمس التى قتلتهم. فقد ظلوا مسجونين، فى حالة فراغ من الانتظار الدائم، مناضلين ضد الكارثة الوشيكة، دون جدوى فقد زرعوا الأمل، لكنهم قد حصدوا المرارة والموت.
وجدير بالملاحظة – هنا- أن راوى غسّان؛ قدم وصفًا بصريًا دقيقًا، لهيئة جثث أبى قيس وأسعد ومروان، داخل هذا الخزان الحديدى الذى اطمئنوا إليه. فماتوا فيه خنقًا وضاعت هُوِيَّتهم، وهو ما كثَّف من المشهد التراجيدى لهذا الموت، الذى يمثل إدانة لهذه القيادة الضعيفة/ أبى الخيزران– التى تفتقر إلى الثقة، ويمثل – أيضًا- إدانة لهروبهم وقصور وعيهم بالهدف، وإدانة لخيارهم السلبي، الذى يكرِّس للخروج من الأرض، وضياع الهُويَّة، ومن ثم؛ فالجميع قد أصيب بفقدان للذات، السائق الضعيف أبو الخيزران، ورجل أمن الحدود أبو باقر، والفلسطينيون الثلاثة، الذين خرجوا من وطنهم دون مواجهة.
وعلى هذا؛ فإن هذا الضياع الفلسطينى العربى عقب نكبة 1948م، قد ألقى هذا «العالم الصغير» الشعب الفلسطيني، خارجًا فى الصحراء، فأصبح مصير فلسطين هو مصيرهم؛ وبذلك أصبح هؤلاء الفلسطينيون موتى بلا قبور، يموتون كما يعيشون، منفردين، ومبعدين، بعد أن لفظهم القائد أبو الخيزران، فى عراء الصحراء الصامتة المظلمة كالموت، رافضًا أن يتركهم فى رحم الخزان؛ وبهذه النهاية المأساوية، التى تشييء الفلسطيني، انهزم الشعب الفلسطيني، دون أن يرى عدوه. وهى نهاية مأساوية تحمل دلالة الموت الدائري، من بداية الرواية حتى نهايتها؛ حيث بدأ الخطاب السردى لهذه الرواية، بالموت النفسى فى يافا والرملة، وانتهى بالموت الفيزيقى للفلسطينيين الثلاثة، فى خزان الموت الصامت.
ومن اللافت للنظر؛ أنه رغم موت الرفقاء الثلاثة، فقد حافظ راوى غسّان، على حياة السائق العنِّين أبى الخيزران، فلم يمت وبقى مصيره مجهولاً. وهو ما يؤكد أن أزمة الشعب الفلسطينى مستمرة، وتعانى من العقم، لأنه يموت كل يوم فى الخزان، دون أن يصرخ، فعلى الأرض أن تصرخ الآن؛ لذا ينتهى الخطاب السَّردي، لهذه الرواية القصيرة، بسؤال استنكارى يمثل صرخة يكررها أبو الخيزران، وترددها بعده صحراء الموت،« لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟ لماذا لم تقولوا؟ لماذا وفجأة بدأت الصحراء كلها تردد الصدى».
لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟ لماذا لم تقرعوا جدران الخزان؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟»/الرواية93.
وهو سؤال ينتقل بالفعل السَّردى للرواية، من مجرد الوعى الفردي، إلى الوعى الجماعى بقضية شعب مضطهد، مطروحة مع نهاية الخطاب السردى للرواية، وهو سؤال يحمل فى طياته، إدانة ضمنية للضمير الإنسانى العالمي، الذى همَّش هذه القضية؛ لذا يطلق صرخة احتجاج ورفض، للحل المطروح فى الخمسينيات، حل البحث عن الخلاص الفردي، لمواجهة الهزيمة بالصمت والصبر. كما يطرح رفضه لصورة الفلسطينى اللاجيء، الذى يستسلم للموت السلبي، باحثًا عن الفعل الثوري/ دق الجدران، الذى يفجر المقاومة، والمواجهة الشاملة ضد المحتل الإسرائيلي، وهى الصيغة التى طورها «غسّان»، وطرحها فى رواياته، التالية «ما تبقى لكم 1966م، وأم سعد 1969م، وعائد إلى حيفا 1969م»؛ حيث تكرِّس هذه النصوص للوعى السياسى بضرورة المقاومة؛ حتى يحول الموت إلى حياة، والمهانة إلى كرامة؛ لذا يأتى «الفلسطينى الفدائي/ سالم»، فى رواية «ما تبقى لكم»؛ حيث تتحول رحلة الهروب عبر الصحراء، إلى ضرورة للمواجهة، ونجد فى «أم سعد»، أن الخيار المطروح هو الكفاح المسلح، فى حين يقدم «الفلسطينى الثائر/ خالد» فى رواية «عائد إلى حيفا»، وهو ما يجسد فلسفة غسّان الخاصة، التى بنيت على رفض الفرار، وتبنى موقف المواجهة الشاملة.