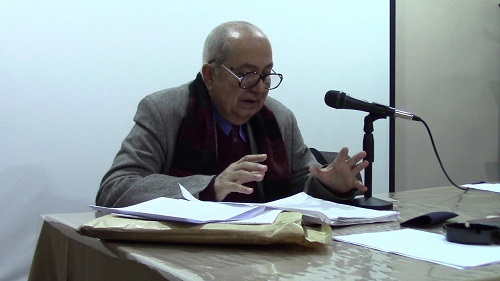خالد النجار
عندما ذهبت إلى أثينا في تلك السنة البعيدة كنت أمر بمرحلة يسكنني فيها المتوسط بأصيافه البيضاء، ببحره وقواربه وخيوله وأمطاره ولون نجومه أواخر الشتاء، بزهور البوغنفيلية التي توحد قراه البحرية… بعوالم شعرائه: جوزيب أنغرتي ولوركا وخوان رامون خيمينيث وكوازيمودو ورفائيل ألبرتي… كنت قرأت يوميات بحار لجورج سيفيريس التي ترجمها صالح القرمادي ونشرها في مجلة ألف… وعبر هذا الشعر اكتشفت نشيد العلم وأنا في زخم العشرين، وهي اللحظة التي تسمك بميسمها وتستمر معك لا تفارقك إلى الأبد…
كان آخر الخريف عندما وصلت إلى أثينا أول مرّة، أثينا التي تزدحم في المخيلة آلهتها، وفلاسفتها، وأساطيرها، ونساؤها التراجيديات، وباصاتها الكهربائية وحجارتها الألفية… آه ساحة بلاكا الهادئة الأرستقراطية أسفل الأكروبوليس ورجل صندوق الموسيقى الذي يأتي كل صباح مع عنزته. ما أزال اتذكر زيارتي ليانيس ريتسوس في شقته في الدور الرابع من تلك البناية البيضاء التي تقع في ضاحية القديس نيكولاس نيكولييدس في شارع كوراكا الطويل الضيق… أقف مترددا في الردهة شبه المظلمة أحمل باقة الزهور البيضاء. وبعد التردد الوجل ها أنا أحسم أمري على السريع وأكبس على زر الجرس. بعد لحظات فتح الباب وظهر من ورائه ريتسوس نفسه ببسمته النبيلة، وكلمة ترحيب. مرقنا إلى القاعة التي خلف الباب مباشرة، سار أمامي مسافة خطوتين؛ تطلعت إليه من خلف؛ رجل طويل يميل للنحافة يرتدي جاكة صوفية زرقاء فاتحة ورأس مائلة على كتفه الأيمن في انحناءة خفيفة لا تكاد تلحظ، أو هكذا بدا لي. ها الماضي يصير حاضرا…

عندما التقيته في هذه الزيارة الأولى كان ريتسوس في الواحدة والسبعين من عمره، بدا حيويا أقل من سنّه وهو يتحرك داخل الشقة بخفة يذهب ليأتي بكتاب أو ينظف غليونه ليشعل سيجارة… اليوم تعودني مرة أخرى تلك اللحظات في صالون شقته بشارع كوراكا، وضوء اغريقي ناعم يغمر المكان ما أزال أراه في تلك الظهيرة البعيدة في صورة لا تتغير جالسا فوق أريكته المنجدة بالرسوم الحمراء، أريكة فرنسية بدت لي موديل لويس الرابع عشر… تزدحم الكتب من حوله من كل جانب : كتب حذوه على الأرض وكتب فوق الطاولة الصغيرة التي أمامه؛ ومن خلف ظهره رزم أخرى من الكتب وقد وضع فوقها بيبلو : نرجيلة صغيرة، دمى شعبية ملونة مصنوعة من القماش الأحمر والاصفر وتماثيل صغيرة لجنود اسبرطيين وخيول اغريقية مندفعة وأبطال من الميثولوجيا اليونانية القديمة… لوحات وأيقونات شعبية تغطي جدران الشقة كما لو أنك في كنيسة ريفية فقيرة… وأعمال زيتية صغيرة ومتوسطة ذات أطر خشبية بنية ضاربة إلى سواد وأخرى ذهبية منها لوحة زيتية تمثل بورتريه الشاعر وتمثال نصفي يرتفع فوق قاعدة خشبية في زاوية الصالون…
وفي ركن قريب، في متناول يده تتكدس قطع من الحجارة الصغيرة، صفائح حجرية رقيقة كان يرسم فوقها وجوه المساجين أيام المنفى في جزيرة ماكرونيسوس، حيث كان يستيقظ باكرا قبل السجناء ويكتب يومياته الشعرية، قصائد قصيرة على أي شيء تقع عليه يده: قصاصات، مزق أوراق، علب سجائر أو أي شيء آخر يصادفه وهي القصائد التي شكلت ديوانه يوميات المنفى…

كنت أحمل رسالة توصية من صديقه الشاعر الفرنسي لوران غسبار الذي شغف باليونان. اشترى بيتا في جزيرة باثموس قريبا من الميناء القديم، جزيرة يوحنا الإنجيلي وهناك في خضم بحر ايجة القديم كتب يوميات باثموس التي صدرت لاحقا عن دار غاليمار تحت عنوان دفاتر باثموس، وهي تأملات في الشعر وفي البيولوجيا حيث ضوء الكلمة لديه هو ضوء انبثاق الحياة نفسه متجلية في اللغة. هناك أيضا بدأ يتعمق في فلسفة سبينوزا التي حضرت في نصوصه اللاحقة، وفي باثموس أنهى قصيدته أجسام أكالة. لوران المأخوذ بالجغرافيات والمدن التي كان لها دور دينامي في تاريخ الحضارة، تلك المراكز الروحية الكبرى: إسكندرية فيلون، أثينا، بيت المقدس، صحاري العرب، حيث كان يذهب من حين لآخر إلى مضارب البدو، ومصر منبع الحكمة، وأرض كنعان منبت الأنبياء؛ وبلاد الاغريق حيث ظهرت النصوص الفلسفية التأسيسية الأولى التي ما تزال تأثيراتها ممتدة إلى اليوم… لوران على شاطئ البحر الأحمر، يتأمل ظل فراشة في الماء… لوران الذي ربطته علاقة بشعراء اليونان وفي مجلة ألف التي بعثها في تونس أول السبعينات نشر أشعار كفافيس ومختارات من يوميات جورج سيفيريس جمعها لاحقا وأصدرها في كتاب بعنوان يوميات سيفيريس… مع لوران عبرت من كتابة البلاغة اللغوية إلى كتابة بلاغة الحياة، عبرت من الأدب إلى الكتابة… ركبت الطائرة إلى أثينا… وكان الزمن آخر الخريف، وكانت أثينا ما تزال مشتعلة شموسها في ساحة سينتاغما، والجندي بلباسه التقليدي يقف بلا حراك مثل التمثال الحجري مادّا ساقه في الهواء، ذكرى حية للبطل الاسبرطي … وأنا أصغي إلى يانيس ريتسوس لا أقاطعه يروي بعضا من ذكرياته وهو يتحرك بين كتبه ومنحوتاته البدائية: تلك الحجارة التي استمر يلتقطها من أيام المنفى في جزيرة ماكرونيسوس. تعودني صورة ريتسوس بلحيته الخفيفة الضاربة إلى شقرة لحية القديسين وهو يقف في سطيحة شقته وفي الخلفية بنايات عالية وسماء أثينا الزرقاء وتعبير فرح يملأ وجهه وهو يتكلم عن الشعر الذي لا يفسر، ما تقوله القصيدة لا يمكن التعبير عنه أو تفسيره؛ ما تقوله القصيدة لا ينقال من خارجها… وصورته واقفا وسط الصالون وهو يقرأ في فرنسية جميلة قصيدته : وراء أشياء بسيطة أتخفّى لكي تجدوني التي يشرح فيها الشعر شعرا… ويتكلم عن شعب فلسطين الذي أحب، تحدث عن نضال الفلسطينيين، وعن حيوية العرب الغنائيين، وعن أراغون وعن ترجمات شعره في اللغات الأخرى؛ وأنا أصغي إلى فرنسيتة تلك ذات اللكنة الاغريقية حيث يدوّر الراء الفرنسية، ويميل بحرف السين نحو مخرج الزين فيانيس ريتسوس ينتمي لذاك الجيل الذي تعلم الفرنسية في المدارس قبل أن تتحول اليونان إلى الانجليزية…
كان ريتسوس منفعلا بسعادة، وكيف لا، وهو يحس باعتراف العالم به وأن الناس تأتي لزيارته من بلدان بعيدة أو كما تقول العرب من كل فجّ بعيد… وأسمعه يقول لي كل العالم مهتم بشعر ريتسوس :
ــــــ جاءني الأسبوع الماضي شاعر فرنسي يريد حقوق ترجمة الأشعار الأخيرة وقبلها وصلتني رسالة من يوغسلافيا يطلبون نقل أحد دواويني الأخيرة، ورسالة أخرى من ألمانيا الشرقية…

بيد أن الشاعر كالفيلسوف لدى أفلاطون يظل خارج المدينة؛ بل للفيلسوف فرصة العودة حتى يغير المدينة؛ ولكن الشاعر يظل منفيا إلى الأبد… قبل يومين عشت موقفا صارخا لهذا النفي مهما كان احتفاء العالم به. رأيت العماء الأيديولوجي لمعاصريه من اليمين… فقد ذهبت أبحث عن رقمه وعنوانه في الحي القريب من ساحة البرلمان، ذهبت في الأول إلى المكتبة التابعة لدار كيذروس للنشر. دخلت المكتبة وما أن تلفظت باسم ريتسوس حتى تغيرت ملامح وجه موظف المكتبة من البشاشة التي استقبلني بها إلى الجمود. عاد وجهه إلى ذاك التعبير الجاد، البارد الذي يخفي تعاليا ونرجسية كثيرا ما تجدها لدى أنصاف المثقفين. وقال بهدوء واقتضاب لا نعرفه. وصمت، كما لو أنه يأمرني بالمغادرة… وغادرت على عجل وعندما عدت إلى صديقي نوبيل في مقهى ايفري داي الذي افتتحه أيامها وأعلمته بالأمر صرخ لقد ارتكبت خطأ فادحا هذه الدار تطبع أعمال سيفريس وهي معادية للشيوعيين كما أنها منافسة للدار التي تنشر أعمال ريتسوس، بينهما تنافر بل عداوة ايديلوجية كبيرة.
وعدت من سرحاني أصغي إلى ريتسوس. تكلم أول الأمر عن كفافيس الذي يعده صانع اللغة الشعرية اليونانية الحديثة، تحدث عن ثراء اليونانية الشعبية، لغة الناس قال: أفدنا أيضا من اللغة الديموستينية اليونانية الشعبية التي هيأها لنا شعر الأعراس وشعر النائحات وغناء العمل وترنيمات الأمهات؛ تلك الأشعار المشحونة بتجارب وحياة الشعب بواسطة اللغة اليومية أي اللغة الحية… كل تلك الأشعار ممتزجة بدمي، تلف في شراييني مع الدورة الدموية…
ثم انتقل إلى علاقته بناظم حكمت الذي جمعه به برنامج حواري في راديو براغ يقول: لا أنسى قبل بداية الحوار فقد أصر ناظم حكمت على معد البرنامج أن أتكلم أنا الأول. قال بالحرف الواحد أريد أن يكون الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس هو أول من يتحدث… وطوحت به الذكرى:
براغ من أجمل مدن العالم مدينة مهيبة ذات عمارة جميلة جدّا… مع هبوط المساء، وإذ تدق مجتمعة كل نواقيس كنائسها وكاتدرائياتها القديمة يغمرك إحساس بجلال كبير… يذكرني ترددها في أرجاء السماء الزرقاء الداكنة بجلال موسيقى باخ… باخ الذي أعتبره أكبر موسيقي على مر العصور… وانتقل للحديث عن صديقه الشاعر الفرنسي لويس أراغون قال دعاني أراغون إلى زيارة فرنسا ولكني لم أذهب إلى أن جاءني هو إلى هنا وقد كتب مقارنا بين شعري ورسوم ماتيس.
وقام إلى مكتبته وأخذ كتابا كبيرا عن الرسام ما تيس وفتح الصفحة التي بها الفقرة التي يضع فيها أراغون مقارنة بين أشعار ريتسوس وأعمال ماتيس كلاهما يستعيد تفاصيل الحياة اليومية في بعدها الغنائي الشاعري…
صورة أخرى تعودني ها هو في سطيحة شقته أقف إلى جواره ونحن نتهيّأ لأخذ تلك الصور التي ما أزال أحتفظ بها: صورة السيجارة مشتعلة بين أصابع يده التي يرفعها إلى قرب فمه ودوائر الدخان الأزرق تغطي جانبا من وجهه وترتفع في الفضاء وهو يحدق في الكاميرا السوداء الكبيرة التي بيد ابنته مثل طفل حريص على صورته. كانت هناك في الخلفية قمم جبال البارناسوس الزرقاء تخفيها في البعيد بعض السحب المتقطعة الرمادية والبيضاء الفضية… قال لي هنا في هذا الصالون أكتب أمام جبال البرناسوس…

جبال البرناسوس موطن آلهة الفنون والحصان المجنح التي تمثل جذوره الشعرية القصية. وعندما سألته عن علاقته بالماضي الاغريقي البطولي لم أجده شبيها بنا نحن العرب في تغنينا بماضينا البطولي وبأمجاده بل الماضي لديه طاقة لاستئناف مسيرة اليونان التاريخية الماضي قوة بعث دينامية لتشييد المستقبل وليس بكاء على الأطلال وتغنّ مرضي بالأمجاد تغنّ تعويضي على مهانة الحاضر… عوض العمل على البعث كما فعل اليونانيون بتاريخهم… ويجب أن ننتظر الاربعينات من القرن العشرين لنرى مثقفي الهلال الخصيب من بعثيين وقوميين اجتماعيين
كان ريتسوس قد أصدر أيامها ديوانه إيروتيكا… الايماء بالمرافق أو التنبيه بالمرافق… أخذه بين يديه وبدأ بتوريق الكتاب قال ها أنا في السبعين وأنشر ديوانا عن الحب… لأن الانسان عندما يحب يريد أن يشاركه الآخرون هكذا جعلت عنوانه التنبيه بالمرافق. ثم أخذ دفترا أسود كبيرا من رزمة الدفاتر التي تتكدس عند قدميه أسفل الكرسي. فتح الدفتر وهو يقول كل دواويني كما ترى أخطها بنفسي قبل أن أدفع بها إلى المطبعة.
أراني بعض دواوينه المخطوطة الأخرى كلها مكتوبة بخط جميل متقن بالحبر الأسود على ورق ضارب إلى صفرة كما لو أنها مجلدات من القرون الوسطى؛ فالحروف التي ترسمها اليد البشرية ساحرة، لأن الأنامل التي تخطها نافذة تتجلى منها الروح.
ثم، وضع الدفتر جانبا وناولني مجموعة ايروتيكا الصادرة حديثا وهو يقول نفذت الطبعة الأولى من إيروتيكا ولم يمر شهر على صدورها. وهناك دار نشر من ألمانيا الشرقية أرسلت تطلب حقوق الترجمة…واستطرد علينا أن نكتب ألف كتاب… يانيس ريتسوس يجلس كل صباح ليكتب قصيدة أو نصا نثريا… أحد النقاد الفرنسيين شبهه في غزارة انتاجه بفيكتور هيغو اذ صدر لريتسوس حوالي مائة كتاب بين مجموعات شعرية وترجمات كثيرة وأعمال روائية إضافة إلى رسومه ومنحوتاته الصغيرة… كل هذا الانتاج الغزير رغم السنوات الطوال التي قضاها في سجون البربرية سجون اليمين الفاشي وسجون العقداء بعد انقلاب 1967 …بيد أنه استمر يكتب ويكتب، ويكتب وهو داخل السجن.
تحدث أيضا عن الشعب الفلسطيني بكثير من الحب والتعاطف كان ريتسوس الشيوعي الحقيقي مناصرا في مواقفه لقضايا العرب ونضالات شعوب العالم الثالث. قال زارني محمود درويش هنا وقال لي إنه تأثر بشعري… أنا أحب العرب أحب لغتهم الغنائية وحيوية العربي… وأعتقد أنه لابد أن يكلل النضال الفلسطيني بالنصر وأن يعود الفلسطيني إلى بلاده وقريته وبيته وهناك سوف يغني أغنيته في أرضه وتحت سمائه لأن النشيد الحقيقي هو ذاك الذي ينبع من الأرض…

… في تلك اللحظة دق جرس مدرسي وسمعنا ضجيج الأطفال وهم يخرجون للاستراحة بين الدروس؛ فالمدرسة تقع خلف البناية التي تقع فيها شقته في شارع كوراكا … وعدت إلى تونس إلى المدرسة الصادقية وإلى ساحة القصبة؛ وهناك كانت الشمس تشتعل فوق قبة الساعة التي أمر بإنشائها خير الدين باشا التونسي أواخر القرن التاسع عشر. وساعة جدارية أخرى بمينائها الفيروزي وبعقرب واحد تعلن أيام الشهر القمري وفي الأسفل، في ركن من الساحة ساعة شمسية حائطية لتحديد أزمنة البروج حسب التقويم القمري، وهناك جامع الحفصي الذي يعلن عن مواقيت الآذان لكل مساجد مدينة تونس لدى اخراج البيرق الأبيض من أعلى الصومعة… وحديقة الدير المحاذي للمدرسة الصادقية، والنجوم التي كنت أراها تسقط بين أغصان أشجارها مثل الطيور الذهبية وتماثيل القديسين التي تتحرك في المنافذ أعلى الجدار في ظلمة المساء ونحن نغادر المدرسة تحت المطر والريح والراهبة في ردائها الأسود التي تراقب الأطفال سرا بعيون سوداء جاحضة من وراء زجاج تلك النوافذ العالية التي تغطيها الأشجار العملاقة. والحصان الأبيض الذي ظل أسبوعا كاملا لا يتحرك تحت المطر والذي كان يبدو أكبر من حديقة البيت والحوذي الذي اسمه حوتة الذي كان يعتني بالحصان وعود الثقاب والدمية والبحر والساعة الجدارية التي تدق رتيبة كامل الليل، وإذاعة الجزائر ورسام ريتسوس الذي اختفى في الورقة البيضاء والفراشة الميتة على الرف ومصباح النفط بهالته البرتقالية فوق جدار الغرفة الأصفر والشراشف البيضاء المطرزة بالورود وبتلك العصافير الصغيرة الحمراء والزرقاء والصفراء التي تعدها العذارى لجهاز العرس والجرار القديمة والمفتاح الذي تركه الميت تحت أصيص الزهر ليعود ويأخذه… و… و… كلها أشياء يا نيس ريتسوس اليومية والميتافيزيقية وهي في الآن أشياء كل الناس الذين حافظوا على صوت الطفولة في أعماقهم الصوت الصادر عن الانبهار الأولي بالعالم وبأشياء العالم وهي أشياء الشعر التي كثيرا ما يركنها الكبار في زاوية مظلمة من ذواتهم وينسونها هناك فينسوا بالتالي أنفسهم وكينونتهم ويعيشون نسيان الوجود الذي تحدث عنه هيدغر وتجدهم وقد انخرطوا في الآن في وجود زائف وعالم داخلي آسن… ينتظرون الموت
وعن هذه الكينونة المتجلية في الفعل الشعري كفعل وجود كتب يانيس ريتسوس
أومن بالشعر وبالحب وبالموت
و هذا بالضبط السبب الذي يجعلني أعتقد في الخلود.
أكتب بيتا شعريا.
أكتب العالم يعني أنا موجود والعالم موجود
ومن طرف إصبعي يسيل نهر
والسماء زرقاء سبعا. وهذا الصفاء
هو أيضا الحقيقة الأولى وإرادتي القصوى
كان الوقت قد عبر سريعا وكان ضوء النهار الذي يغمر الصالون ذاك الضوء الاغريقي القديم قد بدأ يخبو ويمضي نحو البرتقالي الشاحب عندما دلفت ابنته إلى الشقة تذكرت صورتها بالأسود والأبيض طفلة ذات سنتين تقريبا جالسة قبالة ابيها فوق مكتبه رافعة ذراعها الصغير كما لو كانت تعابثه…