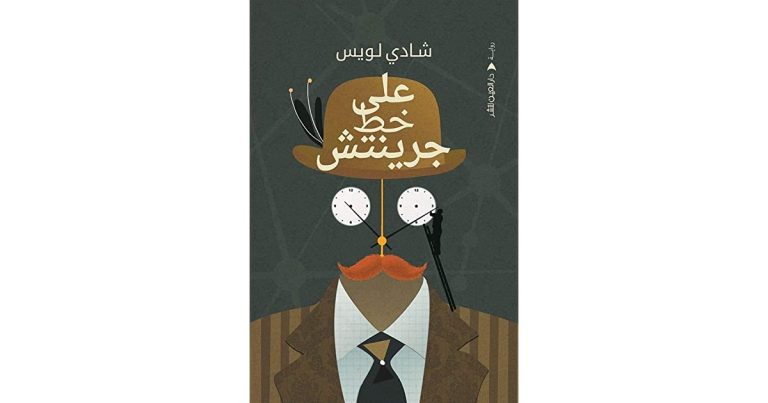حضور الحب.. تعدد التأويل
د. حمزة قناوي
يرى النقاد أن الشعر استخدام مغاير للغة، فهو انطلاق في مدى الأفق اللغوي إلى حده الأقصى، فالتجربة الشعرية في مجملها تبدو تجربة استكشاف للآفاق اللغوية الممكنة، ومن ثم فالشعر طريقة لتنظيم اللغة، واللغة وعاء الفكر، وعملية الاستكشاف هي مغامرة لغوية جمالية يقودها التجريب والتبحر في الجمال الإبداعي، ما يحقق متعة جمالية في القصيدة الشعرية وفق ما يشير إليه (مايكل هامبورغ)([1])، وعند وضع هذا في الاعتبار نجد أن قارئ ديوان «آخر قطرة حب» للشاعرة (ربا أبو طوق) يستشعر نوعاً خاصاً من السلاسة اللغوية، والترانيم الغنائية، وجمال الصورة، على نحو يجعله ديواناً فريداً يثير شغف الناقد لمتابعة مغامراته اللغوية والجمالية، ومتابعة تجربة تطويع الأفكار وتشكيل الأسلوب لتكوين جمال خاص بخطاب الشاعرة، وذلك ما نحاول تحليل عناصره هنا.
ومنذ العتبة الأولى، نلاحظ أن (أبو طوق) اختارت أن تعنون ديوانها بإطلاق اسم القصيدة التي تحمل الترتيب العشرين من بين القصائد التي يبلغ عددها إحدى وثلاثينَ وثلاثين قصيدةً، فهل يمكن اعتبار القصيدة التي يحيل إليها العنوان المختار قصيدة مركزية بالنسبة لباقي القصائد؟ وأنها تحمل بداخلها دلالات رمزية ورؤية شعرية تؤثر على تلقينا لجميع قصائد الديوان؟ تُرى ما الفارق عندما نتلقى القصائد بشكل منفرد عن تلقيها في شكل جماعي منضوية معاً تحت منظومة عنونة تجمعها معا؟ لمعرفة ذلك نستحضر مقولة (ميشيل فوكو): «خلف العنوان، والأسطر الأولى، والكلمات الأخيرة، وخلف بنيتها الداخلية وشكله الذي يضفي عليه نوعاً من الاستقلالية والتمييز، ثمة منظومة من الإحالات إلى كتب ونصوص وجمل أخرى»([2])، إذن فالعنوان الذي يحيل إلى كل القصائد من ناحية، ولقصيدة بعينها من ناحية أخرى، يجعلنا نتعامل معه عبر مستويين من التحليل، الأول مستوى تأويلي في ذاته، فآخر قطرة حب هي إشارة لتلك البقايا الأخيرة من الحب، مما يجعلنا نفترض أن الديوان عن غياب ما، أو عن اقتراب نفاد الحب من قلوب العاشقين، أو قلة ما يمنحه عاشق لآخر، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك احتمالية لأن يتغير المعنى ويتحول مع تأملنا لمعاني القصيدة التي منحت الديوان عنونته.
تقول (أبو طوق) في مفتتح قصيدتها:
«هذي دمشق/ مدينةٌ للياسمينِ/ هواؤها سرٌّ يبجله الزمان…/ سرب الحمائم/ سابح في شعرها/ وعلى يديها حنة بيضاء/ قد رسمت بزهر الأقحوان/ هذي دمشق جميلة…/ فيها الربا فستان نور/ فاض عن خيطانه بردى/ يبشر بالجنان..» ص112-113
يتبين لنا أن حالة الحب التي تتحدث عنها الشاعرة هي حالة من نوع خاص، هو حب الوطن، وحب الأوطان يتأثر بمعطيات الزمان والمكان والأحداث، فيصبح لذكر الوطن في وقت معين معنى وثيمة مختلفة عن وقت آخر، فربما كان الحديث عن سوريا في وقت سابق، يتخذ طابعاً مغايراً عن الحديث عنها في وقتنا الراهن، بعد ما شهدته من مواجهاتٍ مع الإرهابيين، وما شاهدته في وجود لقوى متعددة على أرضها، إنه وقت مأزوم بالنسبة للوطن، وتكتسب فيه المحبة بُعداً آخر، لأنها في هذا الوقت محبة مقرونة بالتضحية والعطاء، أكثر مما يترتب عليها الأخذ والتنعم بنعيم الوطن.

أما من ناحية الخصائص الأسلوبية والشعرية، فإننا نلمس هنا ظاهرة كسر أفق التوقع باستخدام المدلولات السياقية للمفردات اللغوية في غير المعتاد لها في المعجم([3])، فحين كنا نتوقع في الوقت الراهن أن تصور القصيدة مشاهد الجُرح أو الألم نجدها تستخدم الصور والتعبيرات التي ترفع سوريا إلى أفقٍ بعيدٍ، فهواؤها سر يبجله الزمان، هو تصوير يشف عن مقدار الاعتزاز، فإذا كان الهواء الذي هو أبسط العناصر وأكثرها شيوعاً، يتحول لكل هذه القيمة التي يعزها ويمجدها الزمان، فما بال باقي التكوينات؟ ثم تمضي بعدها في رسم صورتها المغايرة والفارقة لتصبح كل تضاريسها وربوعها مكاناً للتغزل، تماماً كمن يتغزل في حبيبته ومعشوقته، هنا يتبدى برهافة مقدار العشق والمحبة والتودد الذي تبديه (أبو طوق) لدمشق.
تستمر الشاعرة في التغزل ووصف الجمال في مختلف أنحاء ربوع دمشق، ثم وتأثراً بالظرف الحادث، تنقلب النغمة الخطابية، وتتحول الغنائية إلى رثائية، لتأتي الشعرية محلقةً في أفق التوجع؛ فتقول: «هذي دمشق سماؤها مخضلة/ تبكي دموع الكهرمان/ هذي دمشق شهيدة ودماؤها/ منذورة لشقائق النعمان» ص114، وتستمر الشاعرة هنا بإبداعية المكلومة على الوطن التي تعاني ويلات الإرهاب وتتعدد مظاهر الحزن، وأفق غياب الأمان، فدفء الوطن أصبح مسلوباً لصالح شتاءات التفكك، والدماء النازفة تغتال البراءة، والسقف يصبح خيمة عرضة للزوال مع أي هبوب للعواصف، ويصبح البحث عن الاحتواء بديلَ الشعور بالأمان، حتى نصل لختام القصيدة: «فأنا الوحيدة من شعاع الشمس / آخر قطرة …/ لم يبق للحب سوايا…/ لم يبق للحب سوايا …»ص119، نجد أنفسنا هنا غير قادرين على تحديد معنى دقيق لعنونة «آخر قطرة حب»، فختام القصيدة يتحدث عن آخر الموجودين من شعاع الشمس حاملاً هموم الوطن، وآخر قطرة حب هنا أراها كناية عن الاستعداد للتضحية بالحياة لتصبح موازيةً لآخر قطرة من دم الشاعرة لتقديمها فداء لدمشق.
إذن الهيمنة الكبرى للرؤية النصية هنا متأثرة بالظرف الراهن للوطن وبما يحدث في دمشق، وعلى هذه الخلفية من التضحية والمحبة للوطن، سنفسّر الكثير من المعاني المقدمة في القصائد، ومن ثم فحتى لو وجدنا حديثاً عن الحب بين العاشق والمعشوقة فإننا نضع في اعتبارنا أنه حب قد يكون فطرياً بين الرجل والمرأة، ولكنه أيضاً حبٌ مأزومٌ، مولود في ظروف خاصة، يتعرض فيها الوطن للتهديد، والخطورة محيطة من كل جانب بكل من الحبيب والمحبوبة، سواءٌ علِما بذلك أم لم يعلما.
ومع ذلك فإننا نتلمسُ غنائية صادحة تتميز بها قصائد الديوان، وهي غنائية قائمة على السلاسة اللغوية من ناحية، والتعالق الإيقاعي والوزني من ناحية أخرى، حتى أن مجمل القصائد هنا قابل للغناء، أما الموضوعات فهي متنوعة، ما بين العشق والغزل، ومحبة الوطن، ولكن الثيمة المميزة هي سلاسة اللغة، وامتلاء القصائد بالنغمية التي تدفع القارئ للتغني بالقصائد، مع محاولة رسم صورة جذابة، وكأن المحبة هي الأساس الذي تنطلق منه الشاعرة (أبو طوق) سواء أكانت المحبة بين الرجل والمرأة، أو المحبة بين الإنسان ووطنه، فالشعرية هنا شعرية ناشئة من نشر الحب، وبذر غرس التودد والتقارب، ويبدو أن أحد سبل مواجهة المخاطر المحيطة بالشعب السوري هو نشر الحب.
ومن بين عناصر بناء الشعرية التي تلفت النظر إليها في تقنيات الديوان حضور الرمز، مقدماً لنا أبعاداً جماليةً وموجهاً التلقي إلى أفقٍ خاص من الاشتغال العقلي والوجداني، فلنتأمل على سبيل المثال من قصيدتها: «فوضى الطلاسم»؛ تقول:
«جبل والعشق يفتفته/ شوقاً لسماء … تعشقه…/ سندا..مددا/ الروح تجلى موعدها/ في خيط الفجر/ إذا يسري من سم الليل/ ستنسجه لبدا لبدا/ الوتد الضارب عمق الأرض/ينادي … لا ترح أبدا/ فالجذر المرهق موصول/ بأديم سبح بسم الشرق/الغارق في عقد الأولى/ الضوء الهاطل من أعلى/ يدعو أيام الصلصال/ كي تنعش ذاكرة كسلى/ ويقول بعرض حناجره/إني أغلى .. إني أغلى» ص39-40
نلاحظ هنا كيفية بناء الرمز، ونتأمل مقولة (خالدة سعيد) عن الرمز: «بنية دينامية يسمح لها بالتعدد والتناقض، مقيماً بينها أقنية تواصل وتفاعل»([4])، إذن فالرمز في الإبداع الشعري ليس هدفه الإغلاق، وإنما هدفه تعدد التأويل، وإيجاد بنية دينامية تساعد على انفتاح الرؤية، ومن ثم فإن «الجبل الذي فتته العشق» رمزٌ يقبل التعددية في التفسير وفي الرؤية، هل هو إنسان عاشق؟ هل هو الوطن الذي تفرق دمه بين متعددي المحبة له ومتعددي الرؤية؟ هل هو ذلك الحائر بين ما يعرض عليه من رؤى وأفكار؟ ما هو «سم الليل» الذي يسري في الآفاق؟ وهل «أيام الصلصال» هي استدعاءٌ لأيام الخلق الأولى، أم إشارة إلى الزمن الذي كان يعيش فيه الوطن الاستقرار؟ يؤيد الكثير من الفرضيات التي أذهب إليها ذكرها فيما بعد: «الفوضى … خلاقة فوضى/ والكل يهلوس عن وطن»ص41، الإشارة إلى «الفوضى الخلاقة» هنا توجه الرؤية إلى تفسير الرموز بقلب موجوع على ما حدث في الوطن السوري في وقتنا الراهن.
وعند متابعة عناوين القصائد الإحدى والثلاثين نجد الشاعرة تميل لنوع من السلاسة والتبسيط في اختيار العنوان، فهي تميل إلى ذكر المسند والمسند إليه مع ترك مساحة من التخمين للقارئ، فتأتي العنونة سلسةً يسيرةً تصل أحياناً إلى حد الكلمة الواحدة مثل قصائدها: «نشاز/ دومينو/ ربما/ فراتي»، ولا تتجاوز بحال المفردات الثلاث بالاعتماد على إسناد المضاف والمضاف إليه مثل: «على وتر الكبرياء/ آخر قطرة حب/ سورية وحي المحبة»، وأحياناً تستخدم الصفة والموصوف مثل عنوان قصيدتها: «كان كابوساً جميلاً»، وبتحليل هذه الأساليب اللغوية نصل إلى أنها تقوم بإنتاج الشاعرية من السلاسة، ورغم استخدام تقنيات الرمز، فإنه لا يصل لحد الإغلاق، ونستطيع من عناواين القصائد أن نحدد تلك التي تقوم على الرمز، فنجد: «الضوء الغريب/ التوليبة البيضاء/ سك الهوا/ مؤامرة الشتاء…» نلمس في عنونة هذه القصائد رمزية بادية من عنونتها.
وأحياناً تعمل الرمزية بصورةٍ عكسية، فيكون الرمز دالاً على تأكيد المعنى المراد الإفصاح عنه بدلاً من الإشارة إليه، مثل قصيدة: «لا أعـ ـشـ ـقـه … لا أهـ ــواه»، والتي يتم كتابتها بذات الشكل المقطع، في إشارة إلى ما يوحي مبدئياً لمعكوسها، وكأن القصيدة بالأساس: «أعشقه – أهواه»، ولكن لكبرياء أنثى، أو لسبب ما مفترضٍ مسبقاً لدى الشاعرة، تقوم بنفي ونكران هذا العشق، وإذا كانت أحد أدوار العنونة في التشويق فإن العناوين الواردة في الديوان تؤدي دورها في ذلك على نحوٍ شديد الكفاءة.
وبما أن الحب والمشاعر النبيلة هي المهيمنة على الديوان، فإن النغمة الرومانسية المغلفة بشيء من الرمزية تلازمنا على امتداده، وكأحد العناصر الأساسية للرومانسية فإن توظيف البيئة والطبيعة كعناصر مشاركة للوجدان، ثيمة حاضرة في ثنايا قصائد الديوان بلا استثناء، فأنسنة المكان، وجعله شريكاً في المشاعر، واصطباغه باللون والحركة والإيحاء، عنصر رئيسي من عناصر شعرية الديوان، تقول في قصيدتها «لا أعـ ـشـ ـقـه … لا أهـ ــواه»: «هتك البدر ستار اللهفة/ سقطت نجمة شغب تهذي/ غايتها في كف الشرفة/ فضحت عينا/ جاءت تختلس الأنباء/ سكت الليل يراقب حدثاً/ ملغوماً بين الخفقات/ فاح الضوء على مخدعها/ فرأى قلباً في أضلعها/ تنضح من دمه الأنات»ص43-44
نجد هنا حضوراً كونياً حول بطلة القصيدة، البدر والنجمة والليل والضوء وغيرها من عناصر الطبيعة، تجتمع حول تلك العاشقة التي تعاني نيران الهجر وابتعاد معشوقها، أو ربما تعاني خديعة ما منه، فكثيرٌ من التفاصيل الممكنة حول المشاعر التي يتم تأويلها في القصيدة غير واردة هنا، ومتروكة لمساحة التخيل والافتراض، لماذا ترفض بطلة القصيدة هنا إعلان الاعتراف بالعشق؟ إن المشاركة الوجدانية للطبيعة من حولها تشي لنا بإيحائين: الأول: مدى طيبة قلب هذه العاشقة والتي من شدة براءتها تتوحد معها عناصر الكون والطبيعة من حولها، وثانياً: توحي لنا بصدق الحب، وبأن غايته ليس بها أي نوايا شريرة، ومع ذلك يذوب قلب العاشقة، حتى تلعن هذا الحب الذي فعل بها الويلات، فتقول: «داخت شتمت أم الحب/ أم القرب وأم البين/ خلعت عقدا/ يحمل نقشاً من حرفين/ اسم غاب واسم تاه…/ لعنت بصمة شغف/ طبعت فوق الآه»ص46
ثم، كما أوحت الكتابة المتقطعة للعنونة، تأتي القصيدة في ختامها، منقلبة تماماً على عنوانها، تقول: «لا أعـ ـشـ ـقـه … لا أهـ ــواه/ صاح القلب المغرم فيها/ كاذبة أنت والله»ص47، ونسجل هنا تقارب الشعرية مع السردية فيما يمكن أن يكون نواة لتداخل الأجناس الأدبية لدى الشاعرة، دون الإخلال بشروط الإبداع الشعري، خاصةً أن (أبو طوق) تحرص على الوزن، سواء كان تفعيلة أو أبحر، فإنها ترى خصوصية للوزن الشعري في ذلك، مما يمكنها من تقديم قصائدها على نحول غنائي مميز، لكن مع ذلك فالكثير من قصائدها يصلح لأن يكون نواة لقصة قصيرة، لها بداية وخاتمة منقلبة على البداية، وموضوع، وهو ما يعني أنها تسعى للتجريب، ولتطوير القصيدة ورفدها بروافد جديدة، ولكنه تطوير هادئ غير صاخب، ولا يولي محتوى التطوير أهمية عن شكله، وإنما ينبع من غايات جمالية، فيأتي مندمجاً متناغماً مع الرسالة المراد إيصالها.
لذا فبينما نتحدث عن تجريبيتها التي تضعها مع الشعراء الكبار الذين يسعون للتجديد وتطوير الشعر العربي، من الضروري أن نشير إلى قصيدة «نشاز»، ذلك أن بناء القصيدة على السلم الموسيقي، واستلهامه وتكوين بنية إيقاعية ونغمية وتعبيرية من خلاله، هو أمر جديد لم يخطر على بال كثيرين من قبل، تقول: «لهت …/ تختال فوق الـ{دو}/ بـ أنملها / فغار الـ {ري}/ وصاح الـ {مي}/ أنا أولى.. ونادى الـ{فا}/ تعالي عندي وانسكبي/ على طربي/ أيا امرأة…/ تهافت نبضنا ولها/ لبسمة ثغرها الأحلى/عتاب الـ {صول} صداح/ أنا للعشق مفتاح/ تحداهم كعادته/ وقال لها … أنا الأغلى/ تناهى الـ {لا}/ بنبرته التي تعلو» ص31-32.
هذا التجسيد «الإنسانوي» للسلم الموسيقي، والتأليف من درجاته قصيدة تتغزل في جمال المرأة هي قمة من قمم التجريب والتجديد في وقتنا الراهن في ظل شكوى البعض من قطيعة القصيدة المعاصرة مع متغيرات العصر، والترويج إلى أن النثرية هي فقط التي تملك استلهام روح العصر بداخلها، لتأتي هذه المحاولة إثباتاً لإمكانية بلوغ أفق بعيد في مدى التأليف الإبداعي، دون أن تمثل شروط الوزن وإيقاعيته عائقاً لشاعرية الشاعر، خاصة مع سلاسة الأسلوب وشفافيته عند شاعرتنا.
منذ القصيدة الحادية والعشرين في قصائد الديوان، والتي تلي قصيدة العنوان مباشرة، تتوجه الشاعرة للوزن الكامل، وتقدم مجموعة من القصائد التي تمتاز بقصرها من ناحية، وارتفاع نغميتها الإيقاعية من ناحية ثانية، مع صورة كلية تؤكد جوهر الوحدة العضوية من ناحية ثالثة، والوحدة العضوية سمة موجودة في قصائد الديوان كافةً، لكننا نشعر مع الإحدى عشرة قصيدة الأخيرة من الديوان وكأننا دخلنا مقاماً موسيقياً مُختلفاً، أو أننا إزاء حالة احترافية أعلى في طريقة وكيفية استخدام تفاصيل اللغة، بشكل يحقق ذروة شعرية، ونغمية خطابية، شديدة التأثير.
نرصد من ذلك مثلاً نغمة الفخر في قصيدة: «هدايا العيد»؛ فتقول:
«يراني كوكباً ويخاف صدي / فطبعي في الهوى حذراً يصدُ
ويخشى إن تمادى في التداني/ جفلت عنيدة والنأي حدُ
ولا يدري بأن العطر يندي/ على نفحاته ويميس وردُ»ص127
هنا وكأننا إزاء نقلة نوعية من القدرة على التحكم في اللغة، ومن التلاعب بالأصوات مع المعاني، أو بتعبيرٍ حداثي: القدرة على تضام الدوال بشكلٍ إيقاعيّ يتناسب مع المدلولات اللغوية، وفي اعتقادي أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من تحقق الشاعرية الفريدة عند (ربا أبو طوق)، فهي على امتداد قصائد الديوان تقدم لنا تجريباً وترميزاً وإيقاعاً وتنغيماً وايحاءاتٍ ودلالاتٍ تؤكد أنه لا يزال في جعبتها الكثير لتقدمه، فضلاً عن قدرتها على بلوغ آفاقٍ بعيدة في الخطاب الشعري، تجعل منها صوتاً متفرداً شديد الخصوصية بين شعراء جيلها، وهو ما يجعلني أطرح سؤالاً راودني طويلاً: لماذا تأخرت هذه الموهبة الشعرية الكبيرة المتحققة فنياً في الظهور والحضور في مشهد الشعر العربي المعاصر؟
……………………………………
[1] – مايكل هامبورغ: حقيقة الشعر، مجلة الآداب الأجنبية، اتحاد الكتاب العرب، ترجمة: محمد عدنان حسين، السنة السابعة، عدد 24، 1980، سوريا، ص9
[2] – ميشيل فوكو: حفريات المعرفة، ترجمة: سالم يفوت، ط3، المركز الثقافي العربي، 1987م، الدار البيضاء – بيروت، ص23
[3] – نبيلة الخطيب: اللغة والأدب والحضارة العربية واقع وآفاق، دار النهضة، 2013، بيروت، ص 157
[4] – خالدة سعيد: حركية الإبداع: دراسات في الأدب العربي الحديث، ط3، دار الفكر، 1968م، بيروت، ص 187