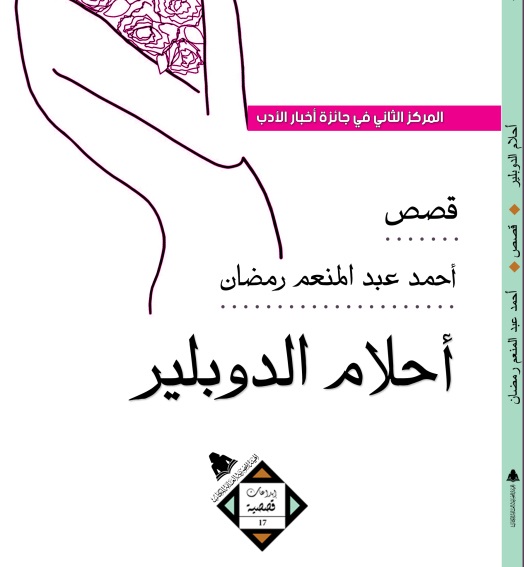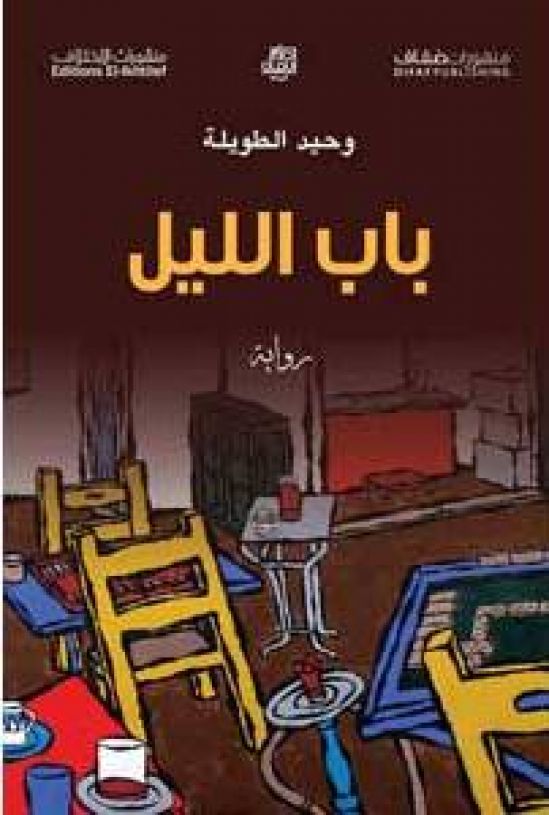د. إبراهيم منصور
عاش محمد عناني عمرا باذخا، بلغ ٨٤عاما، فقد ولد في رشيد في ٤ يناير ١٩٣٩ورحل عن دنيانا في مدينة القاهرة يوم ٣ يناير ٢٠٢٣م، فحقق خبر وفاته نوعا من الشعبية Trend
لكن المدققين لاحظوا سطحية ما كتب عنه غداة وفاته، ففي كتيب أصدره ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، صدر في يونيو ٢٠٢٢، وجدت فيه السيرة الذاتية للدكتور محمد عناني، وقد وضع المحررون صورة غلافين لكتاب في الأدب الأندلسي وآخر عن الموشحات لمؤلف آخر، فأسهموا في وثيقة مكتوبة مصورة في الخلط والتزوير كما يسهم الفيس بوك وسواه من الصحف السيارة، تلك السطحية، التي لاحظها الكاتب د. شريف صالح، بلغت حد الخلط بين صورة الدكتور عناني وصورة ممثل يشبهه في الاسم. ولكن مسألة الصورة هذه جعلتني أتأمل فيما جرى لجسد هذا الأستاذ العملاق، من حيث مآل ما كان من طول وانتصاب قامة وفتوة في الجسم ظاهرة، تحولت في السنوات الأخيرة إلى ما يشبه صورة الشبح، والرجل لم يكن معنيا بإخفاء شيء من تغيرات جسده، بل بالعكس كان يسمح بالتقاط الصور وهو بالبيجامة في بيته، وهو متكور على ذاته وآثار المرض بادية عليه لسنوات لا تقل عن عشرة، وقد وجدت في هذا الملمح علامة فارقة في تفسير عمل الدكتور محمد عناني وأثره الذي تركه لنا، حين رحل الأسبوع الماضي.
كتب محمد عناني سيرة ذاتية، نشرها في ثلاثة أجزاء، عنوانها “واحات العمر” وفيها يرصد مراحل حياته من أول طفولته في رشيد، مع أهله الفلاحين، مرورا بمراحل التعليم في الاسكندرية ثم في القاهرة، وانتقل في الجزء الثاني إلى “واحات الغربة” حيث رصد زمن البعثة الدراسية في لندن التي امتدت من ١٩٦٥- ١٩٧٥، وأخيرا الجزء الثالث الذي عالج فيه مرحلة العمل الأكاديمي والعمل في التأليف المسرحي والترجمة. هي سيرة ممتعة جدا، لكن ملمحا من ملامح السرد فيها يلفت النظر هو عناية الكاتب باللغة، من حيث الصياغة والأسلوب وتتبع تطور الكلمات، وملمح آخر هو الوفاء للزوجة والحبيبة نهاد صليحة (١٩٤٥- ٢٠١٧) وللأصدقاء وأخصهم سمير سرحان (١٩٤١- ٢٠٠٦) أما الأساتذة فلهم نصيب وافر من التبجيل والاحترام، وأهمهم ثلاثة.
كتب محمد عناني في النقد الأدبي، والشعر، والمسرح، والسيرة الذاتية، ومعاجم المصطلحات، ونظرية الترجمة، كما رأس تحرير مجلة المسرح، وشارك في تحرير مجلة سطور، ورأس تحرير سلسلة “الألف كتاب” المترجمة، أما إنتاجه الأكبر فكان في حقل الترجمة من الإنجليزية إلى العربية، وقد بلغ عددها عشرات المجلدات، أهمها أعمال شكسبير بدأها ب”تاجر البندقية” (١٩٨٨) ثم “يوليوس قيصر” (١٩٩١) و”حلم ليلة صيف” (١٩٩٣) و”روميو وجولييت” (١٩٩٣) و”الملك لير” ترجمة شعرية (١٩٩٦) و”هنري الثامن” (١٩٩٧) “مأساة الملك ريتشارد الثاني” (١٩٩٨) و”العاصفة” (٢٠٠٤) و”مأساة هاملت” ترجمها نظما (٢٠٠٤) و “مكبث” (٢٠٠٥) و”عطيل” (٢٠٠٥) و”ريتشارد الثالث” ترجمها نظما (٢٠٠٧) و”الليلة الثانية عشرة” (٢٠٠٧) بذلك يكون قد ترجم لشكسبير ثلاث عشرة مسرحية، في عشرين عاما، لكنه خلال تلك المدة ترجم كتبا أخرى منها “ملحمة دون جوان” للورد بايرون (٢٠٠٣) وكان قد انتهى من ترجمة ملحمة “الفردوس المفقود” للشاعر جون ميلتون (١٩٨١- ٢٠٠٢) وهذا يبين أنه قد تعهد بترجمة الدراما الشعرية لأعلام الأدب الإنجليزي، ولكنه ألزم نفسه أيضا بأن يترجم كل أعمال الشاعر والكاتب البريطاني “هارولد بنتر” الحائز على جائزة نوبل، فترجم أعماله في ثلاث مجلدات (٢٠٠٧- ٢٠٠٩) وترجم للمفكر والناقد الفلسطيني “إدوارد سعيد” ثلاثة كتب، كما ترجم موسوعة فلسفية عن “الهرمنيوطيقا” في ثلاث مجلدات أنجزها في عام واحد كما ذكر د. أنور مغيث في مقال نشره قبل وفاة الدكتور عناني ببضعة أشهر.
ولم يبخل عناني بوقته ومجهوده في تقديم الأدب العربي إلى اللغة الإنجليزية، وقد أنجز ١٨ كتابا، قد نأخذ عليه أنها لم تكن اختيارات جيدة، مثل كتاب الدكتور مصطفى محمود “القرآن محاولة لفهم عصري” (١٩٨٥) وهو كتاب كان موضع انتقاد شديد، وردت عليه بنت الشاطئ بكتاب “القرآن والتفسير العصري، هذا بلاغ للناس” كان ذلك قبل شيوع ما سمي بالتفسير العلمي للقرآن. أيضا من تلك الترجمات التي تثير التساؤل مجموعات لشعراء لا يمثلون اتجاها شعريا مصريا أصيلا.
أما في التأليف فله مسرحيات قدمت على المسرح منها “ميت حلاوة” و”البر الغربي” التي قدمت على المسرح مبكرا جدا (١٩٦٣) ومن المسرحيات الشعرية “الغربان” (قدمت على المسرح ١٩٨٨) و”جاسوس في قصر السلطان” (قدمت على المسرح ١٩٩٢) وله مسرحيات من فصل واحد، أما الموسوعات ومعاجم المصطلحات فله منها “معجم المصطلحات الأدبية الحديثة” و”معجم مصطلحات هايدجر الفلسفية” وفي عام ٢٠٢٠ أصدر ديوانا شعريا بعنوان “أغنيات الخريف”
وفي نظرية الترجمة وتعليم الترجمة واللغة الإنجليزية قدم عناني “معجم إلياس الأساسي لتعليم الإنجليزية” و”فن الترجمة” و”مختارات للترجمة” و”مرشد المترجم” و”نظرية الترجمة” وهو في هذا لم يكن كاتبا أو مؤلفا نظريا، بل كان معلما يتهافت التلاميذ للاستماع إليه، كما أوضح أنور مغيث المدير السابق للمركز القومي للترجمة إذ يقول “في يوم أعلنت عن ندوة للدكتور عناني يوجه فيها نصائح لشباب المترجمين، ولم أرَ أثناء عملي بالمركز حضورا من الجمهور بمثل هذه الكثافة والازدحام .. لقد أتى الشباب من مختلف محافظات مصر للاستماع للأستاذ الكبير”
ينتمي محمد عناني إلى المدرسة المصرية في الترجمة، وهي مدرسة لم يؤسسها المصريون وحدهم وإن تأسست على أرض مصر في القرن التاسع عشر، فمؤسسوها أقباط ومسلمون ومارونيون، ومن أعلامها المارونيين فارس الشدياق (١٨٠٤- ١٨٨٧) الذي لم يُعرف عمله في الترجمة، لأنه اختفى في تلافيف العمل الجماعي لترجمة الكتاب المقدس، لكن يظل عمل رفاعة الطهطاوي (١٨٠١- ١٨٧٣) وتلاميذه أساسا مكينا لتلك المدرسة، وقد كان أول كتاب ترجمه محمد عناني بعنوان “الرجل الأبيض في مفترق الطرق” نشرته له جمعية الوعي القومي بالقاهرة وهو معيد عام ١٩٦١.
لقد أشرت في بداية المقال إلى ما وصلت إليه الحال الجسدية للدكتور عناني، ولن ندهش إذا عرفنا كيف كان يعمل، ولقد وجدت في “التصدير” الذي كتبه لترجمته لكتاب إدوارد سعيد “الاستشراق” (صادرة في القاهرة ٢٠٠٦) علامة فارقة ودليلا دامغا، على الأسلوب المتفاني الذي سلكه هذا المترجم الفذّ في عمله، فهو يقول “رأيت مثلما رأى الناشر أن من حق القارئ العربي أن يطلع على آخر صورة للكتاب الذي وضعه هذا العبقري، ولا شك أنه يهم كل عربي في هذه الأيام، بعد أن خصصت له مئات الدراسات في الغرب وفي الشرق، وهي التي تتفاوت ما بين الدراسات الأكاديمية المتخصصة التي اتخذت صورة الرسائل العلمية الجامعية، وما بين الدراسات الثقافية العامة، في صورة الكتب والدراسات المتفرقة، وقد أمدتني الباحثة وفية حمودة، من جامعة طنطا، بعدد هائل من هذه وتلك، عكفت عليها في الشهور الأخيرة أقرأها وأحاول استيعابها قبل الترجمة، واثناءها وبعدها، ويكفي أن أذكر أن ملخصاتها وحدها تملأ مجلدا كاملا”
إن عناني قد أقدم على ترجمة “الاستشراق” بعد مرور ربع قرن على الترجمة العربية التي أنجزها الدكتور “كمال أبو ديب” وصدرت في بيروت عام ١٩٨١، لكنه برر ذلك بتبرير مباين لما كان يصنعه المترجمون دائما حين يعيدون ترجمة كتاب، وهو القول بأن الترجمة الأولى ناقصة أو وقعت فيها أخطا، هنا شرح آخر يقول “إن من حق كل جيل أن يترجم آثار الماضي إلى لغة يفهمها.. وكان تعريف الماضي ينحصر يوما ما في الأزمنة السحيقة، ولكنه أصبح يشمل الآن أعمالا لم يمضِ عليها سوى نصف قرن أو ربع قرن. ولكي لا تظهر أية شبهة في حكم سلبي على الترجمة السابقة قال: تعددت المفاهيم أو “التفاسير” التي قدمها القراء والنقاد لكتاب الاستشراق .. ولذلك فقد اشتكى قراء العربية (مثل قراء الإنجليزية) من صعوبة نصوص إدوارد سعيد. ثم يستطرد قائلا وكأنما كنت أحس أنني صائر إلى ترجمة الاستشراق يوما ما، بدأت اهتمامي بترجمة إدوارد سعيد بعد ترجماتي لشكسبير وميلتون وبايرون .. وعندما أقبل القراء العرب على ترجمتي لكتابي “تغطية الإسلام” و”المثقف والسلطة” أحسست أنني وجدت السبيل الصحيح لمعالجة الاستشراق فتوفرت على ترجمته بإخلاص ودأب، مؤمنا بأنني أخاطب القارئ العربي اليوم.
إنني أعلم أننا نملك الآن عددا من المترجمين المصريين والعرب يبلغ عشرات أضعاف ما كان منهم لدينا في عام ١٩٦٣ حين اشترك محمد عناني المعيد بآداب القاهرة مع أستاذه “مجدي وهبة” في ترجمة كتاب “درايدن والشعر المسرحي” فقد مرت ستون عاما، أنشئت فيها الكليات والمعاهد ومراكز الترجمة، بل الجامعات الكثيرة جدا في كثير من بقاع العالم العربي، وصرفت الملايين على جوائز للترجمة يبلغ بعضها حد البذخ ولا أقول السفه، لكني أشك في أن الجامعات المصرية والعربية تعنّي نفسها الآن بالبحث عن “خامات” من معدن عناني، ذلك أنها لم تعد تملك “أساطين” وكدت أكتبها “أسطوات”، من مستوى أساتذته الثلاثة: مجدي وهبة ولويس عوض، أو حتى رشاد رشدي الذي لم يكن مترجما محترفا لكنه كان منظّرا وهو الأستاذ المباشر لعناني في اللغة وفي المسرح.
من ناحية القراء فإنني أعبر عن رضائي عن أعمال عناني كما كنت دائما راضيا عن أعمال أعلام المدرسة المصرية في الترجمة ومنهم أساتذة عناني نفسه، لكننا يجب أن نستمع إلى رأي المتخصصين في نظرية الترجمة ويمثلهم الدكتور “سامح حنا” أستاذ الترجمة في الجامعات الغربية، وقد كتب في منشور يوم وفاة الدكتور عناني يقول “إن المترجم أمام خيارين: إما أن يأتي بالقارئ إلى المؤلف أو بالمؤلف إلى القارئ؛ وبحسب صياغة فينوتي، فالخيار بين “التغريب” و”التوطين”. لم أجد أفضل من نموذجين لترجمتين عربيتين لكتاب الاستشراق لإدوارد سعيد أشرح بهما هذه الثنائية قبل أن أضعها موضع النقد والفحص. .. منهج عناني (مع حفظ كل الألقاب) في الوضوح والسلاسة والانتصار للقارئ لا يحتاج شرحًا؛ ومنهج أبو ديب، الذي يفصّله في مقدمة لافتة لترجمته، واضحٌ أيضًا. المنهجان لهما وجاهتهما، وإن كان ظني أن منهج عناني ربما أبلغ في توصيله للمعنى وأبقى أثرًا وأكثر قدرةً على توصيل سعيد وفكره لقارئ العربية. أما الدكتور هاني حلمي (وهو مترجم قدير وإن كان مقلا) فيقول “أهم ملمحين يميزان ترجمات عناني هما: المقدمات الوافية الضافية للترجمات وخاصة شكسبير، وحرصه على ترجمة شعرية عربية جزلة، رغم أني لا أستمتع بها، ذكاء وبراعة غير عادية في صياغة جمل معقدة بالإنجليزية”
لقد أُطلقت على عناني ألقاب منها “شيخ المترجمين” و”عميد المترجمين” ثم وجدتُ لقب “الإمام” أطلقه عليه الدكتور أنور مغيث، وهو لقب دقيق، لأن عناني كان مرشدا ودليلا، في طريقته التعليمية الفذة المتواضعة، كما في دقته ودأبه، ليس ذلك فحسب، بل في إخلاصه وتفانيه، ويكفي أن ننظر في المقدمات الضافية الشارحة التي وضعها في صدر ترجماته لأعمال شكسبير لكي ندرك قيمة العمل الذي كان يقوم به. وإننا إذ ندعو للثقافة العربية والثقافة المصرية بالصبر على الشدائد والصمود للمحن، فليكن لنا قدوة ودرس من حياة هذا العَلَم الفذّ الأستاذ الراحل محمد عناني، رحمه الله وأحسن إليه كما أحسن هو لوطنه ولغته وأمته.