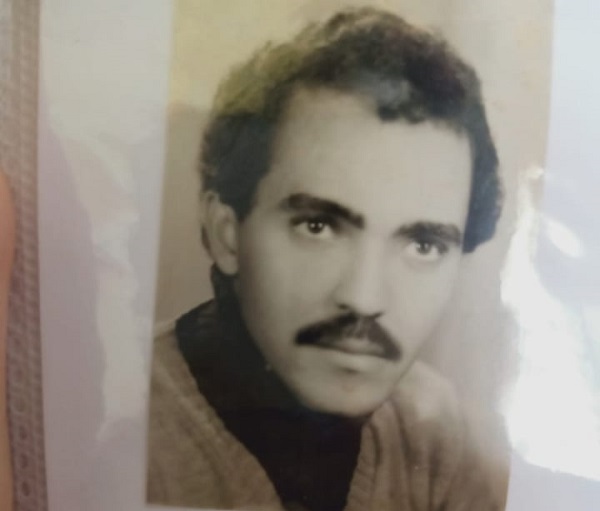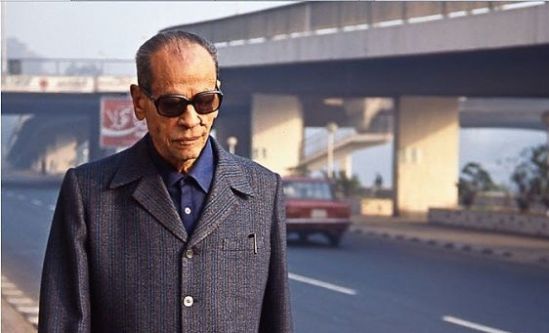حوار: إلينا بونياتوسكا
ترجمة: مارك جمال
الطفولة والخيال، الفقر والقواميس، الترجمة والعُزلة، الثورة، هي الموضوعات المطروحة خلال اللقاءات التي أجرتها الكاتبة والصحفية إلينا بونياتوسكا مع خوليو كورتاثار، والتي لم نكن نعرف منها سوى شذرات. حوار متنوع وجدير بالاهتمام، شأن كتابات صاحب “كل النيران النار”.
(1)
ذكريات الطفولة والمراهقة
* هل لديك أخبار عن لويس سارديني؟
– لا أعرف عنه أي شيء. أليس ممثلًا كوميديًا توفي منذ زمن؟
في مقرّ دار نشر “سيجلو 21″، خلف الأبواب الزجاجية، يقف رجل أصلع في انتظار الحصول على أوتوجراف، متأبطًا كومة من الكتب. عندما يستعد خوليو للتوقيع، يهمس الأصلع بشيء عن لويس سارديني. فأسأل خوليو:
– وما علاقتك بـ لويس سارديني؟
– لا شيء على الإطلاق. دائمًا ما تحدث لي أشياء غريبة. أذكر سيدة غارقة في عرقها، متدفقة المشاعر، لاحقتني بقصد تهنئتي: «أنا أعشق قصصك، أنا وابني مفتونان بها. ألا تريد أن تكتب قصّة بطلها يُدعى هاري المزيّت؟» أعتقد أنها كانت تريد إدخال السرور إلى نفس ابنها. سأعترف إليكِ بشيء يا إلينا، حاولت بالفعل أن أكتب قصّة عن “هاري المزيّت”.
– وما الإغواءات الأخرى التي تستسلم لها؟
– إغواءات كثيرة.
يضحكُ، وأسنانه (الأمامية المتباعدة) أسنان طفل. لو لم تكُن آثار النيكوتين عليها بادية، لقلت إنها أسنان لبنيّة. بالتفكير جيدًا، أجد أن خوليو بأكمله لبنيّ، مغذّ، طيب، يُدفِّئ النفس ويسمح لكل من اقترب بأن ينهل منه. لا يحافظ على أي مسافات، ليس فيه من النجومية شيء. يتقبّل جهلنا، ضعفنا. يعانق. من المستحيل أن يستاء المرء برفقته. للنساء عذرهن إذا أغرقنه بالرسائل.
– ما الإغواءات الأخرى التي استسلمت لها طفلًا؟
– ذكريات الطفولة والمراهقة خادعة. كان ينتابني شعور سيء وأنا طفل.
– لماذا؟ هل كان الواقع يثقل عليك؟
– نعم، أعتقد أنني كنت حيوانًا ميتافيزيقيًا منذ عمر السادسة أو السابعة. أذكر بكل وضوح أن أمّي وخالاتي (تركنا أبي أنا وأختي في سن صغيرة للغاية) وباختصار، أولئك الذين عرفوني صغيرًا، كانوا يشعرون بالقلق بسبب شرودي واستغراقي في الخيال. كنت دائم التحليق في عالمي. لم يكن الواقع المحيط بي يثير اهتمامي. كنت أرى الفجوات، كالمسافة التي تفصل بين كرسيين، دون أن أرى الكرسيين، لو أمكن استخدام تلك الصورة. ولذا، فقد اجتذبني الأدب الفانتازي منذ نعومة أظفاري. في فصل بعنوان “الإحساس بالخيالي”، حكيت أن واحدًا من الآلام الأشد وقعًا في نفسي كان حين أعطيت لصديق لي قصة “الرجل الخفي”، التي أخذها “ويلز” عن جول فيرن، فألقى بها.
– هل رفضها؟
– كنتُ رقيق الصحة خجولًا، وبي ميلٌ للسحري والاستثنائي، ما جعل مني ضحية طبيعية لرفاقي الأكثر مني واقعية. قضيت طفولتي في ضباب يسكنه الجان والأقزام، وكان إحساسي بالمكان والزمان مختلف عن الآخرين. وهو ما أحكيه في “حول اليوم في ثمانين عالمًا”. عرضت كتابتي على أعز أصدقائي، فألقى بها في وجهي: «لا، هذا فانتازي أكثر مما ينبغي».
* ألم تساورك أحلام بأن تصبح عالمًا ذات يوم، أن تكتشف الـ “لماذا” وراء الأشياء؟
– كلا. ساورتني أحلام بأن أكون بحارًا. قرأت جول فيرن كالمجنون وكلّ ما أردته تكرار المغامرات التي خاضتها شخصياته: أن أصعد على ظهر سفينة، أصل إلى القطب الشمالي، وأصطدم بجبال الجليد. ولكن كما ترين لم أصبح بحارًا، صرت معلمًا.
* إذن، هل كانت طفولتك قاسية؟
– لا، لم تكُن قاسية. كنت طفلًا محبوبًا للغاية، حتى أولئك الرفاق الذين لم يقبلوا برؤيتي للعالم، كانوا يشعرون بالإعجاب نحو شخص يمكنه قراءة كتب لا يقوون على حملها. ولكني كنت ممزقًا، لم أشعر بالراحة داخل جلدي. وقبل عمر الثانية عشرة، جاءت مرحلة البلوغ وبدأت أكبر كثيرًا.
* خوليو، دائمًا ما تصِف أطفالًا ومراهقين محبوبين، ومعذبين فوق كلّ شيء.
– كنتُ سعيدًا في طفولتي، ما ترك في نفسي أثرًا بالغًا. ومن هنا جاء اهتمامي بالأطفال، بعالمهم. إنه ولع. أنا رجل يحب الأطفال كثيرًا رغم أنه لم ينجب. أعتقد أنني طفولي جدًا، بمعنى أنني لا أقبل بالواقع. أحكي للأطفال أشياء خيالية، وفي الحال تقوم علاقة طيبة بيني وبينهم. أما الأطفال حديثو الولادة، فلا يروقون لي إطلاقًا؛ لا أقربهم حتى يصبحوا بشرًا.
* أعتقد أن الأطفال في قصصك يحركون المشاعر بسبب أصالتهم.
– نعم، لأن ثمة أطفالًا مصطنعين جدًا في الأدب. واحدة من القصص التي أحبّها كثيرًا قصّة “الآنسة كورا”؛ لقد عشت الحالة التي يمرّ بها ذلك المراهق المريض، وكما قلتُ لكِ مررت بتجارب هائلة في الحب بلا أمل وأنا بعمر السادسة عشرة، حين كنت أعتبر الفتيات في عمر الثامنة عشر أو العشرين نساء مكتملات الأنوثة. حينئذ كنّ في نظري مثالًا بعيد المنال. “الآنسة كورا” قصّة عانيت معها كثيرًا.
– ألا تعتقد أن كلّ هذا ينطوي على رثاء للذات؟
– بل أعتقد أنه ينطوي بالأحرى على مقدرة أكيدة للعودة إلى رؤية العالم من خلال عيني الطفل، فأشعر بسرور غامر لكتابة تلك العودة، ويغمرني شعور طيب عندما أعود إلى طفولتي.
(2)
أشعر بحبّ لانهائي نحو القواميس
– ومن ذلك الولع بالطفولة جاءت الكتب المُجسمة، أو كتب القُصاصات؟
– نعم، أحبّ اللعب كثيرًا، اللعب الذكيّة التي تُحرّك وتفعل؛ أحبّها كمتاجر الأدوات المكتبية، المفكرة، سنّ القلم الرصاص، الممحاة، والحبر الصيني. كنت أتنشّق رائحة قاموس “لاروس”: كانت له رائحة عطرية ما زالت تبلغني. أشعر بحب لا نهائي نحو القواميس. قضيت فترات نقاهة طويلة واضعًا القاموس فوق ركبتيّ، وأنا أبحث بين صفحاته. كانت أمّي تطلّ على غرفة النوم لتسألني: “ماذا تجد في القاموس؟”.
– خوليو، هل كانت أمّك ذات خيال خصب؟
– كانت أمّي ذات رؤية غريبة للعالم. لم تكُن على قدر كبير من الثقافة، ولكنها كانت مصابة بداء الرومانسية المزمن. وضعت قدمي على أول طريق روايات الرحلات، ومعها قرأت “جول فيرن”. شيء غريب، لأن النساء لا يقرأن جول فيرن. كانت أمّي تقرأ أدبًا رديئًا، ولكن خيالها الهائل فتح لي أبوابًا أخرى. كانت لنا بعض الألعاب: فكنا نتطلع إلى السماء باحثين عن أشكال السحاب، ونؤلّف قصصًا عظيمة. كان هذا يحدث في بانفيلد. لم يتمتع أصدقائي بهذا الحظ، فلم تكُن لهم أمهات يتطلعن إلى السماء. كان في بيتي ثمة مكتبة وثقافة.
* هل تعتقد أن معيشتك في السابق وسط أبناء عمال وفقراء لها الأثر في انشغالك الآن بالبؤس والظلم بأمريكا اللاتينية، ومشاركتك في المحكمة المعنية بجرائم الحرب التي ارتكبها المجلس العسكري في تشيلي، على سبيل المثال؟
– لا أظنّ أنها أثّرت في على نحوٍ مباشر، ولكني أعتقد أن طفولتي الفقيرة التي عشتها مع أطفال فقراء كانت بمثابة حُسن حظّ لا شعوري، لأنني دخلت طبقة برجوازية صغيرة مُحددة للغاية في وقت لاحق.
– لماذا تقول إن العيش بين الفقراء كان بمثابة حسن حظّ لاشعوري؟
– لأنه ترك بصمة إيجابية في نفسي.
– بوصفك كاتب؟
– هذا أيضًا، فما هي المشكلة التي تنعكس على الكثيرين من كُتّاب أمريكا اللاتينية؟ ليس من عادتي ولا يروق لي ذكر الأسماء، ولكن إدواردو مايّا، على سبيل المثال، لم يتواصل على نحوٍ مباشر مع شعبه، وعندما يدور الحديث على لسان شخصياته الشعبية، فإن رؤيته مصطنعة وتُبيّن جهله التام بأسلوب حياة أولئك الناس. هذا مثال جزئي، ولكن ثمّة عدد كبير من كتاب أمريكا اللاتينية من أمثال مايّا، لم يساعدهم تعليمهم الابتدائي على أن يُحسنوا فهم أشياء ستمتنع على فهمهم تمامًا في وقت لاحق.
* واقع بلادهم؟
– نعم. أعتقد أن جزءًا كبيرًا من معرفتي بواقع أمريكا اللاتينية، وتمرّدها، والإهمال الذي تشهده، أدين به لأصدقائي من أبناء العمال.
* وماذا عن شغفك بأوروبا، متى ظهر؟ متى قررت الاستقرار في فرنسا؟ هل كنت تتشبه بالأوروبيين شأن كل أرجنتيني؟ وهل كنت واسع الثقافة كعادة المفكرين؟
– أعتقد أنني كُنت محبًا للفن والجمال.
– هل أنت…
– نعم. أغلقت على نفسي طوال سنوات قضيتها في القراءة، لم أكُن أتحدث مع أحد؛ كنت كارهًا للبشر في شبابي، دخلت عالم الثقافة والجماليات. وقد دام هذا طويلًا، أعوامًا كثيرة. كنت أقرأ، أقرأ فحسب، وأكتب فلا أنشر، مدفوعًا بكبريائي، لمعرفتي بأن كتاباتي جيدة.
– جيدة مثل كتابات “بورخس”؟
– مختلفة. بورخس يدعو للإعجاب.
– هل كتبت القصّة سيرًا على خُطى بورخس، متأثرًا به؟
– بل كتبتها بالأحرى سيرًا على خطى إدجار آلن پو.
– ألهذا ترجمته؟
– تقريبًا، قُدِّر لي أن أترجمه. فلقد استيقظ الأدب الحديث بداخلي حين قرأت في طفولتي قصص بو، والتي صنعت بي خيرًا كثيرًا وشرًا كثيرًا في الوقت ذاته. قرأت قصصه في التاسعة من عمري، وبسببه عشت في فزع، وعانيت من الرعب الليلي حتى بلغت مرحلة المراهقة. غير أنه علّمني معنى الأدب العظيم والقصة. انشغلت كثيرًا بالانتهاء من قراءة پو، أقصد قراءة مقالاته التي قلّما تُقرأ بوجه عام، باستثناء المقالين أو الثلاثة مقالات المعروفة (حول فلسفة التأليف)، ثمّ تذكّر صديقي العزيز فرانثيسكو آيالا، من جامعة بويرتو ريكو، الأحاديث التي دارت بيننا، فكتب إلي سائلًا إذا كنت أريد القيام بالترجمة. أتممت أول ترجمة لكتاب بو (قصص ومقالات) الذي لم يكُن قد ترجم بدوره. كان عملًا ضخمًا، واستمر زمنًا طويلًا، إلّا أنه كان رائعًا. كم تعلمت من اللغة الإنجليزية وأنا أترجم پو!
– هل قمت بذلك في الأرجنتين؟
– لا، وأنا في باريس. تركت الأرجنتين عام 1951، واستقريت في باريس بشكل نهائي. كنت في السادسة والثلاثين؛ وكان قدّ مرّ شطر كبير من حياتي في بوينوس آيرس، فحملت بيتي فوق ظهري: الأرجنتين. خلال العام الذي رحلت فيه تحديدًا، ترجمت مارجريت يورسنار. ذهبت إلى أوروبا سعيًا وراء المغامرة، بلا نقود، وبالطبع كنت في حاجة إلى السعي وراء كل سبل العيش الممكنة. كانت لدي الخبرة الكافية كمترجم، وترجمت أعمالًا جيدة للغاية. ترجمت شيسترتون، وأندريه جيد، وكذلك حياة ورسائل كيتس، باختصار، كنت أمتلك خلفية جيدة كمترجم. دائمًا ما أحببت الترجمة، لذا سعيت لإتمام ترجمات في أوروبا وإرسالها إلى بوينوس آيرس. ونظرًا لأن دار نشر سودأمريكانا كانت قد نشرت بالفعل كتابي الصغير Bestiario في نفس الوقت الذي رحلت فيه عن الأرجنتين، فقد سمحوا لي بالاختيار من بين أربعة كتب؛ رأيت كتاب “مذكرات أدريان” الذي كنت قد قرأته بالفرنسية وفتنت به، فطلبت من دار النشر مهلة طويلة لإتمامه، إذ كنت أعرف أن هذا الكتاب يجب ترجمته جيدًا. بل وبدأت العمل عليه في المركب الذي حملني من بوينوس آيرس إلى مارسيليا، فأعدت قراءة الكتاب، وجرّبت مقاربات مختلفة للترجمة. أتممت ترجمة “مذكرات أدريانو” في باريس، ثمّ نُشرت. دائمًا ما يشيد بها النقاد.
– خوليو، بينما كنت تترجم، ألم تشعر بأنك تقتطع من الوقت الخاص بأعمالك الشخصية؟
– لا، لم أشعر بذلك قط، فقد كان لدي الكثير من الوقت حينئذ، ولي قدرة عظيمة على العمل عندما أرغب في القيام بشيء. كُنت مجهولًا تمامًا وقتئذ، فلا كنتِ أنتِ أو غيرك تحضرون لإجراء المقابلات معي وتصويري وطلب أوتوجراف، وما كنت أتلقى مترًا مربعًا من الرسائل أسبوعيًا. أقصد أنني كنت بحق شخصًا يعيش الحياة التي أحببتها دائمًا، حياة المنعزل، عندما كنت أكرّس نصف يومي لكسب العيش عن طريق الترجمة لليونسكو، ثمّ يكفيني ويزيد الوقت المتبقي للقراءة والكتابة.
– كتب أحد شعراء المكسيك، أليخاندرو أورا، منتقدًا المنعزلين: «عزلة المنعزلين محض هراء». كما قال: «يبتسمون بغتةً بدون سبب واضح، ونظرة الحملان على وجوههم تدقّ كأجراس مرضى الجذام التي تُبعد الآخرين».
– رغمًا عن صديقك، سأظلّ منعزلًا.
– إن سمحوا لك.
– إن سمحوا لي. وهو ما أصبح عسيرًا الآن، ولكني حين أريد الاختلاء بنفسي أستقل القطار إلى لندن (حيث لا يعرفونني) وأعيش وحدي تمامًا ما احتجت من الوقت. أحبّ الحديث إلى الناس يا إلينا، واكتشفت تلك البهجة في وقت متأخر للغاية. قضيت خمس سنوات أعمل معلمًا للمرحلة الإعدادية بإحدى القرى، في الريف؛ ثمّ رحلت إلى “مندوثا”، إلى جامعة “كويو”؛ لتدريس المرحلة الجامعية.
– ولكن ماذا درست؟
– قلتُ لكِ، أنا معلم، تخرّجت من مدرسة “ماريانو أكوستا” في “بوينوس آيرس”، ودرست بكليّة الآداب، ثمّ التحقت بكليّة الفلسفة والآداب، غير أنني تركتها بعد مرور عام ورحلت إلى القرية الريفية التي حدثتكِ عنها. كانت تلك هي أعوام عزلتي، وكنت واسع الإطلاع. التجارب التي عشتها كانت أدبية دائمًا. عشت قراءاتي، ولم أعِش حياتي. قرأت الآلاف من الكتب، حبيس البنسيون؛ درستُ وترجمت. اكتشفت الآخرين في وقت متأخر للغاية.
– والآن، لماذا تكرّس كل هذا الوقت للناس؟
– لأنني لا أستطيع تجنب ذلك. أنا لا أعرف إلى أيّ مدى يعرف المرء ذاته، قليلًا جدًا على الأرجح. رغم ذلك أنا مقتنع بأنني لو كنت قد بقيت في الأرجنتين وقطعت مشوارًا يعادل ذلك الذي قطعته في أوروبا، لأصبحت بعد ذلك ما أنا عليه. منذ طفولتي شعرت بإحساس شديد العمق بالآخرين بوصفهم أشخاصًا. أما الشيء الذي كنت أفتقر إليه فهو الإحساس بالآخرين بوصفهم مجموعة، بوصفهم قصة؛ وقد تعلمت هذا مع الكوبيين، ولكن على المستوى الفردي، فالحزن الذي يشعر به شخص قريب مني كالحزن الذي يشعر به حيوان، أفعل أيّ شيء لتخفيف حزنه. لا أستطيع رؤية قط أو كلب يتألّم، لا أقبل بذلك. فما بالك برجل أو امرأة…
– ألا تشعر بضياع الوقت؟ أرجو أن تعذر إلحاحي في مسألة الوقت، ولكنها قد استحوذت عليّ مؤخرًا.
– ضاع مني وقت طويل في حياتي، إلى درجة يصبح معها من النفاق اعتبار أن تخفيف ألم أو مرض مضيعة للوقت. كلا، كلا، كلا. أعرف أن هناك أشياء تضيع وقتي. في باريس، على سبيل المثال، في هذه اللحظة، هناك المشاكل اليومية التي تواجه أشخاصًا من تشيلي والأرجنتين وأروجواي، إذ يصلون من بلادهم مطرودين، بلا نقود، مرتبكين، ودون معرفة باللغة في الكثير من الأحيان، في بلد يبدو لهم معاديًا لأنهم لم يكوّنوا بعد العلاقات اللازمة؛ حينئذ أفعل المستحيل لإعطائهم أصدقاء، وتوضيح وضعهم، ومرافقتهم. لا أعتبرها مضيعة للوقت. بل إنها كما لو كنت أؤلف كتابًا.
– حقًا؟
– بالطبع! إنه كتاب لن يصدر، ولكن هذا ليس له أدنى أهمية. أفتقرُ إلى رد فعل الكاتب المهني، الذي يتّسم بالأنانية بوجه عام، وإن اعترفت بأن هذا ضروري في بعض المواقف. أثناء عملي على قصّة، وعندما أجد نفسي مستغرقًا في تلك القصّة وفي كيفيّة حلّها، حينئذ أغلق بابي بإحكام ولا أقابل أحدًا. لا أردّ على الهاتف. ولكن على كل حال، بابي مفتوح بقدر الإمكان.
– الشعار الذي اتخذه جييرمو آرو هو: «الموت للضعفاء والخائبين، فلنساعدهم على الاختفاء، وليكُن هذا أول مبادئ حبّ الآخر».
– فيما يخصّ الضعفاء، لا يمكنني أن أرّد بالمثل، فليس لهم ذنب في كونهم ضعفاء. الأسباب المؤدية لذلك كثيرة. تخيّلي ميكانيكيًا من تشيلي رحل عن بلده ووصل إلى باريس. هذا الرجل ضعيف بالنسبة للمجتمع الفرنسي الذي يدخله، رغم أنه مفعم بالقوة. ضعيف لأنه أعزل تمامًا: لا يعرف الفرنسية، ليس هناك من يمنحه فرصة عمل، ستقابله مشاكل مع النقابات. أساعد هذا الشخص لأنه ليس ضعيفًا بحق. لو منحته فرصة، وساعدته في التواصل مع ورشة، لو عمل ميكانيكيًا وبدأ في إظهار معرفته بالعمل، خلال خمسة عشر يومًا لن يعود ضعيفًا؛ فهو رجل له راتب وغرفة، ويبدأ في الحياة. كيف لا أفعل له شيئًا؟
– خوليو، هل ما زالت قدرتك على العمل استثنائية بنفس القدر؟
– لا، فهي تقلّ بمرور الزمن. عندما أبدأ كتابًا – لنتحدث عن الرواية لأنها عمل متواصل بدرجة أكبر- وأكون في حاجة ماسّة لكتابته، أستغرق وقتًا طويلًا للغاية في اتخاذ قرار بدء الكتاب، فأدور كما يدور الكلب حول جذع شجرة، لأسابيع وشهور في بعض الأحيان، وصولًا إلى البداية أخيرًا؛ هذا أمرٌ واضح، أعرفه بالخبرة، فدائمًا ما يحدث لي نفس الشيء. خلال الثلث الأول من الكتاب يتقدّم سير العمل على نحوٍ متقطّع، ثمّ أدخل مرحلة العمل المتواصل، وصولًا إلى مرحلة نسيان النوم والطعام في النهاية. أذكر بكل وضوح عندما كتبت “لعبة الحجلة”، كنت في حالة من الاستغراق لم أكُن أستطيع معها مفارقة المكتب.
– وهل ما زلت محتفظًا بتلك القدرة على الجنون؟
– نعم، نعم. أنهيت الخمسين أو الستين صفحة الأواخر من “كتاب مانويل” دفعةً واحدة، حتّى النهاية. هكذا، كتبتها وأنا أحتسي الكثير من الخمر، وحيدًا تمامًا. في جلسة واحدة.
– وبالنسبة لك، هل الكثير من الخمر يعني احتساء زجاجة ويسكي يوميًا؟
– لا، إطلاقًا، بل يعني احتساء ستة كؤوس من الويسكي (إذا أردتِ الدقّة)، ولكنها ليست عادة منتظمة، هي أبعد ما تكون عن ذلك.
– وفقًا لتصريحات أدليت بها في إحدى المناسبات، بدأ كتاب “الرابحون” كقصّة. هل صنعت رواية انطلاقًا من القصّة؟ هل حدث نفس الشيء في حالات أخرى، وبنيت عملًا على نحوٍ عشوائي؟
– لم أدلِ بهذا التصريح قط! إنه زائف تمامًا. لو أن هناك كتابًا بدأ كرواية فهو “الرابحون”، رغم أن هذا قيل بطريقة ما في ملاحظة صغيرة في بداية الكتاب أو نهايته. كنت أقوم برحلة على ظهر سفينة من مارسيليا حتّى بوينوس آيرس؛ واحد وعشرون يومًا في الدرجة الثالثة، وهو ما لم يكُن مريحًا جدًا. على كلّ حال، نزلت وزوجتي في كابينة. لم يكُن المسافرون لطفاء على الإطلاق. كما تعرفين، هذه مسألة حظّ؛ في بعض الرحلات يكون المرء في غاية السعادة لمقابلة أربعة أو خمسة أشخاص يتفاهم معهم، ولكن تلك المرة لم يكُن ثمّة أحد. انصرفت زوجتي إلى القراءة والتشمُّس، أمّا أنا فكانت لدي رغبة لكتابة تلك الرواية التي جاءت تتجول، وكانت اللحظة مثالية، نظرًا لكون الكابينة منعزلة. كانت معي آلة كاتبة محمولة فبدأت، وأعتقد أنني كنت قد كتبت ما يقرب من مائة صفحة بوصولنا إلى بوينوس آيرس.
(3)
الثورة تبدأ من الفرد
* خوليو، فكرتك عن الثورة فريدة، فقد ناديت دائمًا بثورة فردية، تلك التي يبدأها المرء بنفسه، ومن الواضح أنك تمثّلها، وهو ما لا تقبله الأحزاب الشيوعية التقليدية. صرّحت في عدّة مناسبات بأنه ينبغي على الإنسان أن يولد من جديد، وينبغي على الثورة أن تنجب إنسانًا جديدًا، أليس كذلك؟
– بالطبع. ما أؤمن به، وما سعيت لقوله في “كتاب مانويل”، هو أن إحساسي بالثورة الاشتراكية حسب فهمي لها في أمريكا اللاتينية، ينطوي على عملية مزدوجة، بالتزامن وليس على التوالي. هناك من يفكر أنه، بادئ ذي بدء، ينبغي القيام بالثورة؛ بمعنى القضاء على الإمبريالية الأمريكية، والرجعيين، والعسكر، ثمّ تولي زمام الحكم، وإرساء الاشتراكية في البلاد، ومن ثمّ سيكون هناك وقت للبدء في الخطط الثقافية والتنمية البشرية. أشكّ في ذلك. في اعتقادي، ما لم تكُن في نفوس أولئك الثوار رغبة في أن يُطلب، بالتزامن، من كل فرد إعطاء أفضل ما لديه، والبحث عن ذاته، واستكشافها، واتخاذ الثورة وسيلة للتخلص من ثيابه البالية بدلًا من السير نحوها محمّلًا بالأحكام المسبقة، ستفشل تلك الثورة. في الواقع، كانت رؤية الرجل الجديد تلك إحدى أفكار جيفارا. وهي ليست بفكرة عن مستقبل بعيد مجردة ونظرية، بل ينبغي لها أن تنشأ بالتزامن. دعيني أعبّر عن ذلك بصورة: دائمًا ما قلتُ بضرورة القيام بالثورة من الخارج إلى الداخل، ومن الداخل إلى الخارج، على جميع المستويات. يجب القضاء على أعدائنا، وكذلك الأعداء الذين بداخلنا. تأمّلي ما يحدث لثورة اشتراكية. فبعد عمل شاق لانهائي، وعناء رهيب يقاسيه أبطال ضحوا بأرواحهم، يكون الوصول إلى السلطة. ولمجرد أن أربعة أو خمسة أو ستة من القادة لم يمارسوا نقد الذات ينشأ في السلطة، على سبيل المثال، تحفّظ وتزمّت في التقاليد (ولنقُل من المنظور الجنسي). أنا لا أقبل بهذا، فهذه تبدو لي ثورة فاشلة. سيظل الإنسان سجين الوازع والتابوهات والمستحيلات التي يصنعها. بأيّ جحيمٍ تنفعه الاشتراكية؟ بلا شيء.
أعتقد أن عمل المُفكّر هو الوقوف في الصفوف الأولى للمعركة، بمعنى ألّا يسمح بأن ينام ذلك الإحساس بضرورة خوض المعركة كلّ يوم، بضرورة أن يتساءل كلّ فرد يعدّ نفسه ثائرًا، عند استيقاظه كلّ يوم: «تُرى، هل أمتلك الحقّ في أن أسلك هذا السلوك مع زوجتي؟ هل أمتلك الحقّ في ممارسة ذلك التمييز؟ هل أمتلك الحق في تطبيق أفكار بائدة، حاربتُها وشقيت بسببها؟ بما ينفع انتصار الثورة؟»
بتلك الطريقة لا ينفع بشيء، لا أعرف إن كنت قد أوضحت مقصدي.