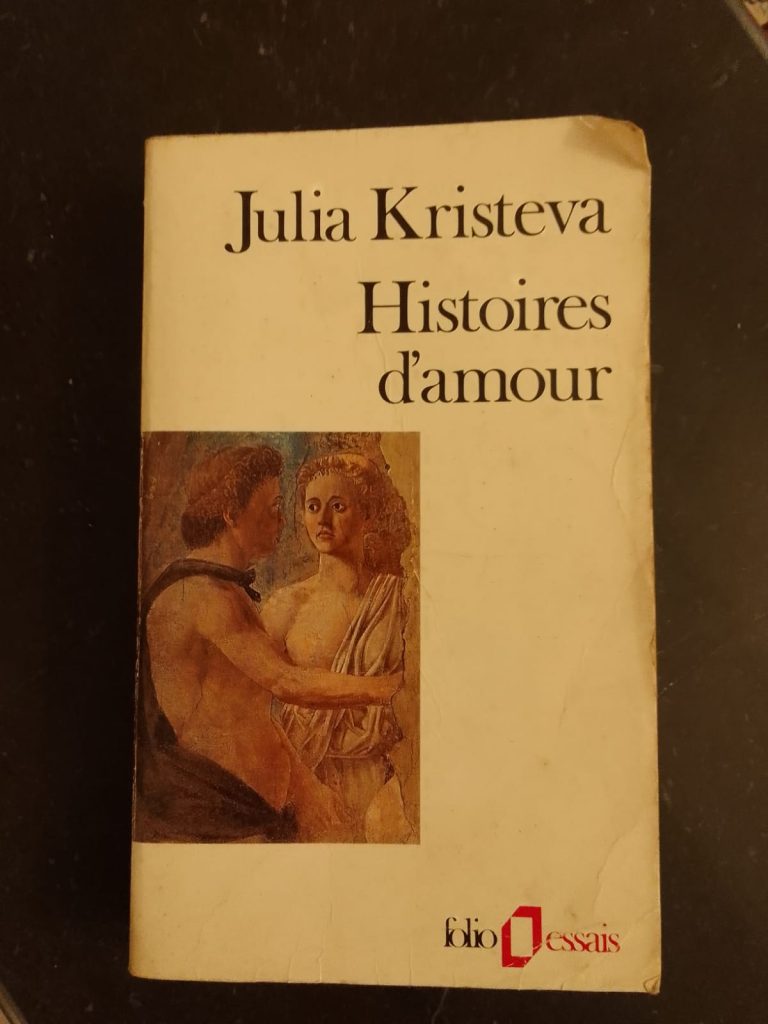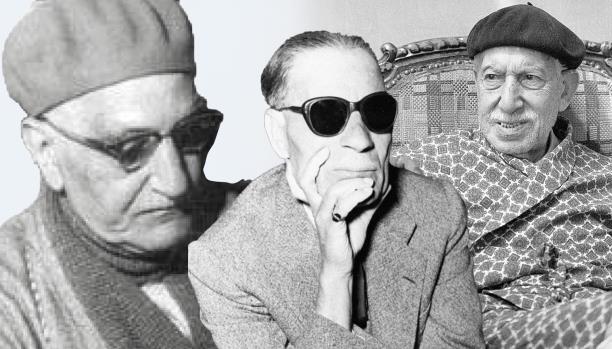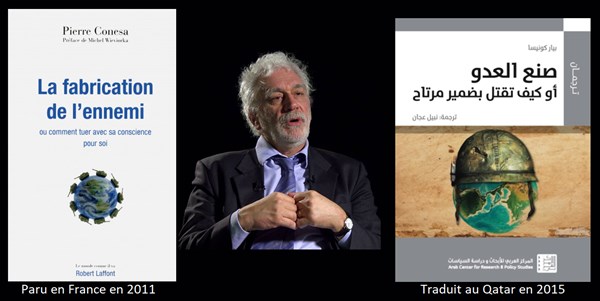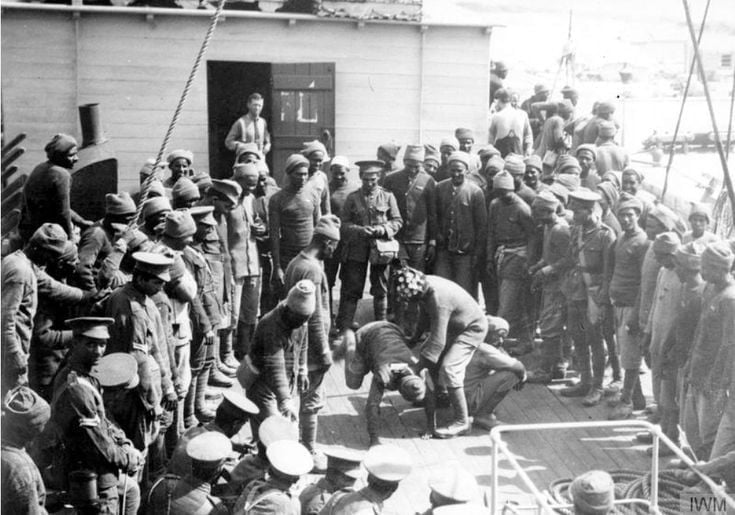عثمان بن شقرون
تمهيد:
شكل الحب في ثقافتنا العربية أحد الثيمات الكبرى التي تشغل الخيال الفردي وتؤسس للمخيال الجمعي. لكنه نادرًا ما كان سؤالًا معرفيًا صريحًا. لقد حضر كقوة شعرية وأسطورية، لا كبنية قابلة للتفكيك أو كمسألة فكرية تقتضي أدوات مفهومية دقيقة. لقد ظل الحب في المتخيل العربي، من مجنون ليلى إلى ابن حزم، ومن الغزل العذري إلى العشق الصوفي، إما حالة وجدانية تُهذَّب بالرمز والتعفّف، أو مقامًا روحيًا يسعى فيه العاشق إلى الفناء في المحبوب، الذي يتجاوز الجسد إلى صورة متعالية، غالبًا ما تتماهى مع الله. لكن هذا الحضور الكثيف لم يكن دائمًا مصحوبًا بوعي نظري يُسائل الحب بوصفه ظاهرة ثقافية ونفسية تخضع لشروط اجتماعية وتاريخية. ظل الخطاب الغزلي، سواء أكان شعريًا أو نثريًا، أسير ثنائية التمجيد أو التقديس، دون أن يُخضع لمشرط التحليل، أو يُقرأ باعتباره بناءً لغويًا مشروطًا بأعراف السلطة والقبيلة والجندر.
الاستثناء الأبرز، في هذا السياق، يبقى الدراسة الفريدة التي أنجزها المفكر التونسي طاهر لبيب في كتابه سوسيولوجيا الغزل العربي. لم ينظر لبيب إلى الحب كحالة وجدانية أو حالة تأملية تخص فردًا معزولًا، بل كفعل اجتماعي وخطاب ثقافي. لقد قرأ الغزل العربي بوصفه بنية لها قوانينها، ورأى في القصيدة الغزلية القديمة، سواء العذرية منها أو الإباحية، تجليًا لصراع عميق بين الرغبة والبنية الاجتماعية، بين الجسد والنظام، بين القول والمنع. لقد أبرز لبيب بمهارة كيف أن ما يبدو تعبيرًا عن شعور داخلي خاص، هو في الحقيقة شكل من أشكال التفاوض الرمزي مع السلطة الاجتماعية والثقافية. وهكذا، أضاء الزوايا المنسية من هذا الميراث، ومنح الحب بعدًا سوسيولوجيًا ظل مهمّشًا في الدراسات العربية الكلاسيكية، بل وحتى المعاصرة.
لكن الدخول إلى كتاب “حكايات حب” لجوليا كريستيفا، الذي أُعيد قراءته في حر هذا الصيف، لا يشبه تصفّح كتاب في الغزل أو الرواية العاطفية. إنه ليس تأريخًا لعلاقات عاطفية، ولا تأملاً وجدانيًا في مسارات القلب، بل هو اقتحام لمنطقة معتمة من الذات واللغة، تُفكك فيها العاطفة كما يُفكك النص، وتُساءَل الرغبة كما تُساءَل البنية. تذهب كريستيفا إلى أبعد من الاعتراف بالتجربة العاطفية، فهي تحاول فهمها، لا من الخارج، بل من الداخل المعقّد للغة والجسد واللاوعي. ولهذا، فإن كل قراءة عربية لهذا العمل، إن أرادت أن تكون خصبة وناجعة، عليها ألا تكتفي بما تقوله كريستيفا، بل أن تنصت في الآن ذاته إلى ما تسكت عنه ثقافتنا حين يتعلق الأمر بالحب والرغبة، وبالمجهول الذي نسرع في تسميته، خوفًا أو إنكارًا، بكلمة واحدة هي: “العشق”.
“حكايات حب”: استكشاف عميق للعواطف الإنسانية
يشكل كتاب حكايات حب لجوليا كريستيفا، الصادر في فرنسا سنة 1983، علامة فارقة في فهم التجربة العاطفية، ليس بوصفه بحثًا في الحب كمجرد انفعال أو شغف، بل كاستقصاء أنطولوجي للذات وهي تواجه أقصى درجات الانكشاف: الرغبة. تنجز كريستيفا المفكرة متعددة الأوجه، التي تتحرك بين تخوم التحليل النفسي والسيميولوجيا والفلسفة المعاصرة، في هذا العمل قراءة نادرة في خريطة العاطفة الإنسانية، حيث تتقاطع اللغة بالجسد، والرغبة بالهوية، والآخر بالأنا. لا تكتفي كريستيفا بوصف الحب كموضوع سهل أو كعاطفة خالصة، بل تتعامل معه كـمعمار داخلي، تتشابك فيه القوى اللاواعية بالبنيات الرمزية التي تحكم تعبيرنا العاطفي، وتحجب أو تكشف في الآن ذاته رغباتنا الأكثر خفاء. فهي تغوص في طبقات الإيروس من أعمق جذوره التحليلية، حيث تشكل الطفولة والخيال والحرمان والتماهي أساسات العاطفة، إلى أرقى تجلياته الثقافية، سواء في الفن أو الميتافيزيقا أو الممارسات الصوفية.
هذا الحفر المعرفي، الذي لا يقف عند حدّ، يجري وفق منهجية مركّبة تنصهر فيها أدوات التحليل النفسي بنظريات الأدب واللغة والفكر اللاهوتي. وهو ما يمنح الكتاب طابعًا موسوعيًا، دون أن يفقده كثافته الفلسفية. الحب، عند كريستيفا، ليس موضوعًا جاهزًا للشرح، بل معضلة وجودية تُختبر من خلال مفاهيم مثل الغيرية والتسامي والذوبان والهوس والنرجسية والألم والجنون.
تكمن أهمية هذا الطرح في أنه يُخرج الحب من نطاق التفسير السطحي أو الرومانسي، ليضعه داخل تجربة حدودية، حيث تكون الذات مهددة بالتحول وبالضياع، أو بالتسامي. إن كريستيفا لا تكتب عن الحب من الخارج، بل تتسلل إلى قلبه، إلى تلك اللحظة التي تنكسر فيها اللغة أمام العاطفة، أو تُضطر إلى خلق مجازاتها الأكثر كثافة كي تقول ما لا يُقال. وفي كل هذا، لا تقدم كريستيفا خلاصات، بل أسئلة. فهي لا تُطمئن القارئ، بل تهز يقينه: ما الحب؟ من نحب؟ ولماذا نحتاج إلى الآخر بهذا الشكل الذي يلامس العنف أحيانًا؟ وهل الحب خلاص أم لعنة؟ عبور أم انهيار؟ هكذا يتحول حكايات حب من كتاب في العاطفة إلى مرآة فكرية معقدة، تعكس تمزقات الذات وهي تحاول أن تفهم ما يُربكها ويغمرها في آن.
التحليل النفسي كأساس لتفكيك الحب
منذ الصفحات الأولى من “حكايات حب”، وتحديدًا في الفصل الافتتاحي المعنون بـ”فرويد والحب: الانزعاج في العلاج”، تُعلن جوليا كريستيفا انحيازها إلى التقاليد التحليلية النفسية، لا بوصفها ميراثًا مغلقًا، بل كمجال حيّ وخصب للمساءلة والتجديد. إنها تنطلق من الإرث الفرويدي، لكنها لا تقف عنده، بل تستخدمه كنقطة ارتكاز أولى للغوص في أعماق التجربة الإيروسية. في قراءتها لفرويد، تضع كريستيفا الحب في صلب التوتر المؤسس بين الرغبة الفردية والمدنية المقيدة، بين مبدأ اللذة ومبدأ الواقع. فالحب، من هذا المنظور، ليس نعمة أو نشوة بريئة، بل عملية نفسية محفوفة بـ”الانزعاج”، أو لنقل: بالقلق البنيوي الناتج عن استحالة التوفيق بين شهوة الانطلاق والضبط الاجتماعي. وهو ما عبّر عنه فرويد حين ربط بين الحب والعصاب، وبين الرغبة والحرمان، وبين الإيروس وثقافة الكبت التي تنتج “أنا” خاضعة.
لكن كريستيفا، على طريقتها، لا تكتفي بإعادة تدوير المفاهيم الفرويدية. بل تتجاوزها، تنقدها وتعيد رسمها على ضوء معطيات جديدة جمعتها من الفلسفة واللغة والأنثروبولوجيا والتاريخ الديني. فالحب، كما تقترح، ليس مجرد صراع بين الرغبة والناموس، بل بنية لغوية لا واعية تتجلى من خلال الصور والرموز والمجازات والذكريات والتمثيلات المتوارثة. وفي فصول لاحقة تحمل عناوين مثل: “الإيروس الهوسي، والإيروس السامي: عن الذكورة الجنسية” و”جنون مقدس: هي وهو”، تشرّح كريستيفا هذا الانقسام الجوهري في طبيعة الحب. إنه اندفاعٌ هوسي، قاهر، قد يسلك سبل التملك والتدمير، ولكنه أيضًا، في حالات معينة، يتحوّل إلى طاقة تسامي وخلق فني وروحي. الإيروس ليس وجهًا واحدًا، بل هو قوة ذات حدّين: يمكنها أن تنحدر بالذات إلى الهوّة، كما يمكنها أن ترفعها إلى أفق من التأمل والخلق والانفتاح.
هذا التمييز الجوهري بين الإيروس الهوسي والإيروس السامي ليس فقط تفريقًا نظريًا، بل هو مفتاح تأويلي لفهم تجارب الحب كما نعيشها في الواقع. فكم من علاقة تبدأ بوعد الاندماج والتكامل، وتنتهي بالخراب أو الجنون؟ وكم من عشق مفرط يتحول إلى عبء على الهوية، أو إلى شكل من أشكال العنف الناعم؟ في المقابل، هناك تجارب حب تنقل الفرد من حال إلى حال، تفتح له نوافذ جديدة على اللغة والوجود والآخر وعلى ذاته العميقة التي كانت مطمورة تحت ركام اليومي والامتثال. تؤكد كريستيفا أن هذا الانقسام ليس عرضيًا، بل كامن في جوهر العاطفة نفسها، ويشكّل مأزق الإنسان المعاصر: هل الحب خلاص أم عبودية؟ هل هو مساحة تعبير أم فخ إسقاطي؟ ولعل أعظم ما تُحسن كريستيفا فعله هنا، هو أنها لا تُبسّط هذه التوترات، بل تجعلنا نقيم فيها، نستشعر ثقلها، ونتأمل آثارها في تكوين الذوات وتمزيقها.
النرجسية بين التحليل والتقويم
من بين المفاهيم التحليلية النفسية التي تنكب جوليا كريستيفا على تفكيكها بحدّة وإبداع، تبرز النرجسية، لا باعتبارها مجرد اضطراب نفسي، بل كبنية معقدة متأصلة في تكوين الذات الحديثة. تصف كريستيفا النرجسية بأنها “الجنون الجديد”، في إشارة إلى تحوّلها من ميل طبيعي نحو حب الذات، إلى شكل مرضي من الانغلاق على الأنا، حيث تغدو الذات سجنًا، ويُلغى الآخر أو يُختزل إلى مرآة تعكس صورة مُحببة، لا ذاتًا قائمة بحد ذاتها.
إن حب الذات، كما تعترف كريستيفا، ضروري ولا غنى عنه لتوازن النفس وتماسك الهوية. فلا يمكن للإنسان أن يخرج إلى العالم أو يبني علاقة عاطفية ما لم يكن متصالحًا مع نفسه إلى حد ما. غير أن هذا التوازن هشّ، وسرعان ما يتحول إلى خلل حين تُصبح الذات غير قادرة على تجاوز ذاتها، أو حين تفقد القدرة على استقبال الغيرية، أي المختلف، والمغاير، والمفاجئ. وهنا تبدأ النرجسية المرضية، حيث تُعاش العلاقة مع الآخر من منطلق الامتلاك أو الانعكاس، لا من منطلق اللقاء الحقيقي.
تربط كريستيفا هذه الحالة المرضية بالتحولات المجتمعية المعاصرة، حيث الفردانية المفرطة، والثقافة الرقمية، والذوات المتضخمة، تصنع نوعًا من الذات المتورمة، المحصورة في صورة ذاتها، والتي تخشى التعرّض للغير بقدر ما تشتاق إليه. فالعلاقة العاطفية في هذا السياق تتحول إلى عرض نرجسي، لا حوارًا بين ذاتين. كل طرف يريد أن يُحَبّ دون أن يحب، أن يُعترف به دون أن يعترف، أن يُحتفى به دون أن ينفتح على هشاشته أو يتخلى عن مركزه.
لكن كريستيفا لا تقف عند التشخيص، بل تعود إلى الجذور اللاواعية لهذه البنية. فهي تُظهر كيف تنشأ النرجسية من مناطق الطفولة المبكرة، حيث يتشكل تصور الذات من خلال نظرة الأم أو البديل الأمومي. حين تُحب الذات وهي لا تزال في طور التشكل، تكون النرجسية شرطًا للنمو. لكن حين يحدث خلل في هذه المرحلة — بالإفراط في التماهي أو في الإهمال — تنشأ نواة نرجسية لا تقوى على تقبّل الانفصال، ولا على التمايز. ومن هنا تصبح العلاقة بالآخر معطوبة، مسكونة بالإنكار أو الإسقاط أو التشويه.
ومن خلال هذا التفكيك، يكشف حكايات حب كيف تُشكّل النرجسية العائق الأكبر أمام الحب الحقيقي، ذاك الذي يقتضي الخروج من الأنا، والاعتراف بالآخر بوصفه كيانًا مستقلًا، له رغباته وعمقه وظلاله. إنه حب لا يتحقق إلا حين نتعلم، كما تقول كريستيفا، القبول بالاختلاف، بل وبتفكك بعض أوهامنا حول أنفسنا.
بهذا المعنى، تصبح النرجسية في فكر كريستيفا مأزقًا وجوديًا قبل أن تكون اضطرابًا نفسيًا. إنها اللحظة التي تتوقف فيها الذات عن النمو لأنها ترفض كل ما لا يشبهها. وفي زمن يقدّس الصورة، ويشجّع التمركز حول الأنا، يبدو أن الحب، أكثر من أي وقت مضى، صار مهددًا بهذا “الجنون الجديد” الذي لا دواء له إلا في الانفتاح، والتفكك الخلاق، والاعتراف بالغيري في صميم الذات.
الحب في وجوهه وشخصياته المتعددة
من بين أبرز إسهامات حكايات حب لجوليا كريستيفا، قدرتها الفريدة على تحويل الحب من مجرد تجربة ذاتية إلى خريطة رمزية معقّدة، تُستقرأ من خلال وجوه وشخصيات تمثّل تجلياته القصوى والمتناقضة. لا تبحث كريستيفا عن تعريف جامع مانع للحب، بل تتعمّد تفكيكه إلى مجرى من الأصوات والسرديات والرموز، كأنها تقول: الحب ليس وحدة، بل تعددية، ليس انسجامًا، بل صراع متواصل بين القوى النفسية والثقافية واللغوية. تستعين كريستيفا بجملة من الشخصيات الرمزية — أدبية، أسطورية، دينية وتاريخية — لفهم أنماط الحب وسيروراته، ليس بوصفها نماذج مثالية، بل ككائنات تمثّل أشكالًا من التوتر، التوق، الفقد، التملك، والتجاوز.
في فصلها عن دون جوان –Don Juan ، تقدم كريستيفا صورة للحب المتلبّس بالقوة، حب لا يعرف الاعتراف بالآخر، بل يتغذى على الغزو والإخضاع. في هذا النموذج، لا يكون المحبوب ذاتًا مستقلة، بل أداة في مشروع نرجسي لا نهائي، حيث تُراكم الفتوحات العاطفية كأرقام أو انتصارات رمزية، لا كعلاقات. إن حب دون جوان هو أقرب إلى الاستهلاك العاطفي، يُخفي في جوهره فزعًا من الثبات، ومن الالتقاء الحقيقي، لأنه يتطلب الاعتراف بالهشاشة، وهذا ما يرفضه دون جوان: أن يكون محبوبًا، لا فقط مُحبًّا مُتسلطًا.
على النقيض من ذلك، تأخذنا كريستيفا في فصل روميو وجولييت إلى عالم العاطفة الرومانسية المتطرفة، حيث يمتزج الحب بالكراهية، والرغبة بالموت. إنها لا تحتفي بهذا الثنائي كرمز للبراءة، بل تسلط الضوء على التناقض البنيوي في العاطفة: فالحب في أقصى درجاته يمكن أن يتماهى مع الدمار، لأن التماهي الكلّي مع الآخر قد يعني ضياع الذات أو حتى فناؤها. هنا لا تكون الغيرة عرضًا، بل بنية داخلية تحكم العلاقة العاطفية. وهكذا، يصبح الموت نهاية منطقية لعلاقة لم تُبنَ على التمايز، بل على الذوبان الفادح في الآخر.
هذا الاستقصاء العميق لمفارقات الحب/ الكراهية، الحضور/الغياب، التملك/ الخسارة، يمثل ثابتًا في فكر كريستيفا. إنها ترفض بحزم كل قراءة مثالية للعاطفة، كل تبسيط يحوّل الحب إلى فردوس مفقود أو لحظة نور خالصة. فالعاطفة، كما تفهمها، هي مزيج من النور والظل، من الحنين والعنف، من الأمل واليأس. الحب ليس فقط ما نريده، بل أيضًا ما يقاوم أن يُقال، أن يُفهم، أن يُملك.
تستفيد كريستيفا هنا من تراث غني من السرديات الغربية، ولكنها تُعيد تدويرها داخل مشروع فكري أوسع، تسائل فيه ليس فقط الشخصيات، بل أنماط النظر إلى الحب عبر التاريخ: من الإيروس السلطوي إلى الإيروس المأسوي، من الاستهلاك إلى الفناء، من السلطة إلى التضحية، من الحنين إلى الانفصال. وهكذا، تتحول كل شخصية إلى مختبر رمزي لاختبار حدود الحب: أين يبدأ؟ ما الذي يخفيه؟ وما الثمن الذي نؤديه حين نحِب أو نُحَبّ؟
أبعاد قدسية وروحية للحب
لا تقتصر مقاربة جوليا كريستيفا للحب على تمثلاته الدنيوية والنفسية فقط، بل تمتد إلى مستوياته الروحية والقدسية، حيث يتداخل الحب مع التجربة الدينية، لا بوصفها إيمانًا بالغيْبيِّ، بل كعلاقة بالآخر المطلق، ذلك الذي يفوق إدراكنا لكنه يحفز رغبتنا ويشكل هويتنا.
في مقاربتها للقديس أوغسطين مثلاً، تستنطق كريستيفا تجربة الحب الإلهي كحالة من التحول الداخلي العميق، حيث تتحول الرغبة من افتتان بالجسد إلى شوق إلى المطلق، إلى المطهَّر وغير المرئي. إنه حب لا يسعى إلى امتلاك الآخر، بل إلى الاندماج في حضوره، والتلاشي في رحم الغياب الإلهي. بهذا المعنى، الحب الديني ليس نقيضًا للشهوة، بل هو تساميها وانقلابها على ذاتها، كما نجد عند أوغسطين في الاعترافات، حين يصور تحوله من حياة المتعة إلى حياة العشق الإلهي بوصفه تحريرًا للرغبة لا كبتًا لها.
وفي حالة العذراء مريم، تستعيد كريستيفا صورة الأنثى التي تحتضن المطلق داخل جسدها، وتجسد في آن واحد الحب الرحِمي والحب الإلهي. الجسد هنا لا يُقصى، بل يتحول إلى وسيط للقداسة والأمومة، في هذا السياق، تصبح استعارةً كبرى للحب الذي يهب ذاته دون مقابل، الحب الذي يستبطن التضحية والغياب، ويفسح المجال للآخر كي يكون، لا كي يُحتوَى. ولهذا، تعتبر كريستيفا أن صورة مريم ليست مجرد رمز ديني، بل هي بنية خيالية-عاطفية عميقة تُكوِّن لاشعور الثقافة الغربية، وتُعيد تشكيل تصوراتنا عن الحب والطهارة والتقبل والعطاء.
في هذا الإطار، لا تفصل كريستيفا بين الحب الروحي والتجربة الجمالية، بل تراهما امتدادين لنفس الظمأ الوجودي. فكما أن المحب ينشد الآخر ويتوق إلى حضوره، يفعل المتصوف ذلك عبر اللغة، عبر الشعر، عبر التأمل. الحب إذن ليس فقط علاقة بين ذات وموضوع، بل هو تجربة حدودية تمتحن الكينونة نفسها، وتطرح سؤالا: من أكون أمام الآخر؟ أمام المطلق؟ أمام الفراغ؟
هذا التصعيد الروحي للحب لا ينفصل عن تحليلات كريستيفا السابقة للذات والنرجسية والجسد والعلاقة بالأم. بل هو استكمال لمسار يظهر فيه الحب كتجربة مزدوجة: جسدية ورمزية، دنيوية ومتعالية، حسية ولاشعورية. وبذلك، تقدم كريستيفا قراءة للحب لا تستبعد المقدس، بل تُعيد إدراجه ضمن مسرح النفس، باعتباره حاجة أنطولوجية لا تكتمل إلا بالآخر، سواء أكان إنسانًا أو إلهًا، حضورًا أو فراغًا. وهي في هذا تضيف بعدًا جديدًا إلى التحليل النفسي، يجعل من العاطفة مجالاً لتأمل فلسفي – ديني – جمالي، ينفتح على ما هو أبعد من “العرض” أو “العقدة” نحو الرهبة الكامنة في التجربة الإنسانية ذاتها.
الحب واللغة والتسامي.
بوصفها محللة نفسية وعالمة سيميولوجيا، ترى جوليا كريستيفا أن الحب لا يوجد خارج اللغة، بل يتشكل من خلالها ويتخذ فيها هيئة ممكنة للوجود. فالتجربة العاطفية، بقدر ما هي جسدية ولاواعية، تحتاج إلى وسيط رمزي يمنحها شكلاً ومعنى. من هنا، يصبح الاشتغال على اللغة في كتاب حكايات حب محورًا جوهريًا في بناء مفهوم الحب وتفكيكه.
في فصل “آلام الحب: حقل الاستعارة”، تبرز كريستيفا كيف أن الحب، عندما يبلغ أقصى توتره العاطفي والوجداني، يعجز عن أن يُقال بشكل مباشر. إذ يصبح القول المحايد والوصفي قاصرًا عن حمل شحنة العاطفة، فتضطر الذات العاشقة إلى اللجوء إلى الاستعارة والخيال والشعر. هكذا، لا تعبر اللغة عن الحب فحسب، بل تخلقه وتؤطره، وتعيد إنتاجه داخل نسيج المعنى.
وتتجلى هذه الرؤية بشكل لافت في تحليل كريستيفا لتقليد التروبادور، في فصل “من النشيد الغرامي الكبير إلى السرد الرمزي”. فالحب، كما تعكسه أشعارهم، ليس اندفاعًا فوضويًا أو تفريغًا غريزيًا، بل هو طقس رمزي معقد، تُعاد فيه صياغة الرغبة ضمن نظام شعري صارم، حيث تُحوَّل الرغبة البدائية إلى خطاب، والعنف العاطفي إلى جمال لغوي.
بهذا المعنى، يتجاوز الحب الجسد، لا بإلغائه، بل بتحويله إلى علامة، صورة، وأداء رمزي. ليست اللغة هنا مرآة تعكس الحب، بل مختبرٌ لتشكيله وتحويره، حيث يتم التسامي—بتعبير فرويد—عبر عملية شبه فنية تُستثمر فيها الطاقة النفسية في إنتاج دلالات جديدة. وكأن الحب لا يبلغ كماله إلا حين يتحول إلى نص، و إلى نشيد وحكاية.
وبما أن اللغة هي حقل اللاوعي بامتياز، فإن ما تقترحه كريستيفا هو أن التعبير العاطفي ليس فقط قولًا لما نشعر به، بل هو بنية دفاعية وتحويلية في الآن ذاته. فالذات لا تعبر عن الحب فقط لتُفصح، بل لتحتمي وتعيد ترتيب الألم، وتنتج ذاتًا جديدة داخل اللعبة الرمزية. من هنا تتقاطع مفاهيم كريستيفا مع الموروث الفرويدي واللاكانية، ولكنها تضيف بُعدًا جماليًا وأدبيًا مميزًا، حيث يصبح القول الشعري عن الحب شكلًا من أشكال النجاة، وسبيلاً للتماهي دون التلاشي، وللتعبير دون التدمير.
الظلال المظلمة للتسامي
رغم أن التسامي عادة ما يُفهم بوصفه عملية ارتقاء روحي أو فكري تتجاوز الرغبة البدائية، فإن جوليا كريستيفا لا تغفل عن الجوانب الأكثر قتامة وتعقيدًا لهذه العملية. ففي كتابها حكايات حب، تكشف عن أن التسامي ليس مسارًا خطيًا إلى النور والسمو، بل غالبًا ما يكون مسرحًا للصراعات العميقة، والانتهاكات، والانحرافات التي تثيرها طاقات الحب المكبوتة أو غير المندمجة. تستعين كريستيفا بتحليلاتها لشعراء مثل بودلير وفلاسفة مثل جورج باتاي، حيث يُعرض الحب في أوجهه القصوى كقوة متقلبة تجمع بين الرعب والجمال، وبين الانحطاط والقداسة، وبين الانفجار والتطهر. في فصل “بودلير، أو اللانهائي، العطر والبانك/ Punk “، يتجلى الحب في صورة تقاطع مع الموت والانحطاط؛ حيث لا يعود الحب مجرد مشاعر حانية، بل يصبح مسعى نحو المطلق من خلال التجاوز، و فضح المحرمات، ومواجهة الفضيحة. الحب عند بودلير يتماهى مع تجربة اللاحدود، لكنه تجربة محفوفة بالخطر، إنها تحدِّي للذات وللمجتمع، وكأنها رقصة على حافة الهاوية.
أما في فصل “معركة شمسية، أو النص المذنب”، يستحضر باتاي الإيروس كقوة شمسية عنيفة، تتعدى المفاهيم التقليدية للحب والرغبة لتصبح طاقة مدمرة وتحريرية في آن واحد. الإيروس عند باتاي لا ينفصل عن الموت أو المقدس، بل يتشابك معهما ليكشف عن رعبٍ مقدس، حيث تتلاشى الحدود بين الجسد والروح، وبين الخطيئة والتطهير، وبين الوحشية والتسامح.
هذه القراءات توضح أن التسامي، في منظور كريستيفا، ليس مجرد عملية ارتقاء فحسب، بل هو مواجهة صادمة مع أعمق وأشد جوانب النفس البشرية إثارة للقلق. إنه كشف للغموض الكامن في الذات، وإمعان في تمزقاتها، وتجربة حدودها مع القبح والشر والعنف. من هنا، يتحول الحب إلى تجربة وجودية معقدة، لا تخلو من الانزلاق في مظاهر الهوس والانحراف، أو حتى الانهيار الذاتي، ولكنه أيضًا نقطة انطلاق ضرورية نحو إعادة خلق الذات. فالتسامي هنا ليس حريصًا على نزع الغرائز أو كبتها، بل على تحويلها، ومواجهتها في أعمق مستوياتها، بما يتيح للحب أن يُحفر في الذاكرة اللاواعية ويترك أثرًا لا يُمحى.
وبهذا، تقدم كريستيفا رؤية متوازنة لا تغفل عن ظلال الحب الداكنة، لكنها في الوقت نفسه تفتح فضاء للتفكير في كيفية استثمار هذه الظلال كجزء من تجربة الحب، وليس كاستثناء أو عطب.
إشكالية الذات والغيرية في الحب
في صلب فكر جوليا كريستيفا، تنبثق إشكالية الذات العاشقة وعلاقتها بالغيرية كإحدى أكثر المسائل تعقيدًا وحيوية في تجربة الحب. فالحب، في رؤيتها، ليس مجرد لقاء بين ذاتين متجاورتين، بل هو تفاعل معقد يخلخل البناء النفسي والوجودي للذات، ويقلب هويتها رأسًا على عقب، إذ يدفعها إلى إعادة تعريف نفسها باستمرار في مواجهة الآخر المختلف، والغريب، والمستقل.
العناوين مثل “الأنا هي العاطفة” و”نسبة المحبة أو انتصار الذات” تسلط الضوء على هذا التوتر الدائم بين الانفتاح على الآخر والحاجة إلى الحفاظ على وحدة الذات واستمراريتها. فالحب، بدوره المزدوج، هو بناء للعلاقة العاطفية، لكنه أيضًا محطة اختبار حاسمة لهوية الذات وحدودها.
يرتبط هذا الوعي بآلية “المظهر” التي تناقشها كريستيفا في فصل “ديننا: المظهر”، إذ يعتبر الحب، سواء أكان مقدسًا أم دنيويًا، مجموعة من البنى الرمزية والتصورات المثالية التي تحمل في طياتها غالبًا إسقاطات ذاتية، حيث لا يكون الحديث عن الحب سوى مظهر خارجي أو قناع لرغباتنا، ونواقصنا، وأوهامنا الداخلية. بهذا المعنى، يتحول الحب أحيانًا إلى وهم مشترك، أكثر منه إلى لقاء حقيقي بين ذاتين.
يتوسع هذا الأفق النقدي في فصل “كائنات فضائية في ضائقة الحب”، الذي يعبر بشكل شعري عن شعور الاغتراب العميق الذي يعيشه الإنسان المعاصر في علاقاته العاطفية في عصر تفككت فيه الروابط الاجتماعية، وصار الفرد محورًا وحيدًا في عالمه، يصبح الحب والتواصل الحقيقي مع الآخر مهمة صعبة وشاقة، بل يتحول إلى ما يمكن اعتباره مرضًا وجوديًا يعاني منه الإنسان الحديث، الذي يكتشف أن حواجز الذات لا تُنزع بسهولة، وأن الآخر، رغم الحميمية المأمولة، يظل دائمًا بعيدًا في بعض جوانبه.
هذه الصورة الشعرية المؤثرة تختزل إشكالية الحب في العصر الحديث: طموح أزلي للاتحاد والتواصل، يصطدم بعقبات تاريخية واجتماعية ونفسية معقدة، تجعل من كل محاولة للحب تجربة محفوفة بالتوترات والخيبات. في نهاية المطاف، ترسم كريستيفا من خلال هذه الإشكالية مشهدًا يعكس التحدي الكبير الذي يواجهه الحب المعاصر: كيف يمكن للذات أن تحافظ على وحدتها وهي تنفتح على الآخر المختلف؟ كيف يمكن أن يكون الحب علاقة حقيقية متبادلة، لا مجرد تصور أو وهم؟ وكيف يمكن تجاوز العزلة الوجودية التي تفرضها تحولات الزمن؟
الحب بصفته مقاومة
في صلب التفكير الكريستيفي، ثمة توتر خفي بين نظام السلطة الرمزية الذي ينتظم الذات داخل اللغة والدين والهوية، وبين فعل الحب الذي، وإن بدا منضبطًا لهذا النظام، يحمل في جوهره قوة خلخلته. فالحب، حين يتحقق كخبرة وجودية خارج المنفعة، يصبح تمردًا على النموذج الأبوي الذي يريد ضبط الرغبة، وتأميم العاطفة، وتحديد ما يجب وما لا يجب. إنه يقفز خارج الخطاطة، خارج القانون، وخارج الخضوع التام لمبدأ الواقع. في الحب، كما تشير كريستيفا، تبرز إمكانية إعادة صياغة الذات عبر الآخر، لا بوصفه كائنًا ممتلكًا، بل بوصفه استعصاءً مستمرًا على التملك. هذا التوق المستمر نحو الآخر، نحو “غير المُدرَك تمامًا”، هو ما يجعل الحب مقاومة: مقاومة للتماثل و للتكرار وللإخضاع.
وإذا كان النظام الرمزي يحاول تثبيت المعنى وتحديده، فإن الحب – بما هو تجربة تعارض الثبات – يُعيد المعنى إلى حالته السائلة و المفارقة، المفتوحة على التناقض. بذلك، يصبح الحب لحظة اختلال في منطق الهوية، وتحررًا من امتثال الذات للمخيال الاجتماعي. إنه، في أقصى تجلياته، فعل سياسي – لا لأنه يحمل شعارات، بل لأنه يُربك الجهاز الرمزي الذي يصوغ الإنسان المعاصر، ويجعله أكثر عرضة للقولبة والانضباط. الحب، هنا، يوقظ الهشاشة لا ليدمّرها، بل ليُعيد من خلالها صياغة ممكنات الذات خارج أنماط الاستهلاك والهيمنة.
خاتمة
إن كتاب حكايات حب لجوليا كريستيفا ليس مجرد دراسة تقليدية عن الحب كعاطفة أو تجربة رومانسية، بل هو محاولة جريئة وعميقة لتفكيك الحب وتحليل أبعاده النفسية والثقافية واللغوية والوجودية في آن واحد. من خلال توظيفها المتقن لمناهج التحليل النفسي والسيميولوجيا والفلسفة، والأدب، تقدم كريستيفا رؤية متعددة الأوجه للعاطفة الإنسانية التي طالما بقيت غامضة وصعبة الفهم.
بدأت رحلتها من الكشف عن التوترات الداخلية في الحب، بين الرغبة الفردية وقيود المجتمع، بين النرجسية والغيرية، وصولًا إلى التعقيدات الرمزية التي تكمن في التعبير اللغوي عنه. تتبع الحب عبر تجلياته المتنوعة، من الهوس المدمر إلى التسامي الروحي، من الوجوه المقدسة إلى ظلال الانحراف والعنف النفسي، مما يبرز أن الحب ليس ظاهرة أحادية البعد، بل هو تجربة معقدة تتصارع فيها القوى المتناقضة داخل النفس البشرية.
كما تكشف كريستيفا عن إشكالية الذات في مواجهة الآخر، وعجز اللغة المباشر عن التعبير عن شدة العاطفة، مما يدفعنا إلى التفكير في الحب بوصفه مساحة رمزية متجددة، حيث يتم تحويل الغريزة إلى معنى، والذات إلى كيان يتشكل في العلاقة بالغير. ومع هذا، لا تخلو هذه المساحة من الاضطرابات والاضطرابات الوجودية، خصوصًا في عالم معاصر يعاني من تفكك الروابط الاجتماعية وصراعات الهوية.
هكذا، يتجاوز كتاب “حكايات حب” حدود الدراسات العاطفية أو الأدبية التقليدية، ليكون مدونة فلسفية ونفسية وثقافية في آن، تدعو القارئ إلى إعادة التفكير في تجربة الحب بكل تناقضاتها وألمها وجمالها وإبداعها. إنه عمل يدفعنا إلى مواجهة أنفسنا وأعماق رغباتنا، لنفهم كيف يصنع الحب، في نهاية المطاف، ما نحن عليه كبشر. في زمن باتت فيه العلاقات الإنسانية أكثر تعقيدًا واغترابًا، يبقى هذا الكتاب دعوة إلى استكشاف الحب ليس فقط كعاطفة شخصية، بل كقوة ثقافية ونفسية تحكم بنيتنا الذاتية والاجتماعية، وتحفزنا على البحث عن معنى اللقاء الحقيقي في عالم يغلب عليه الانفصال والتمزق.
………………………………..
فهرس مفصل بالمصطلحات والشخصيات الأدبية والفكرية الواردة في النص
شخصيات أدبية ورمزية
– دون جوان بطل: مسرحية El burlador de Sevilla y convidado de piedra لـ تيريز دي مولين ا (حوالي 1630) ويشكل نموذج الحب المتسلط والنرجسي في النصوص الأدبية.
– روميو وجولييت بطلا مسرحية Roméo et Juliette لويليام شكسبير (1597) وهي قصة حب مأساوية تمزج العاطفة والكراهية.
– العذراء مريم (La Vierge Marie)الرمز المسيحي للطهارة، والأمومة المقدسة، والحب الإلهي.
مفكرون وفلاسفة
– جوليا كريستيفا (Julia Kristeva) مفكرة فرنسية-بلغارية، ولدت 1941. تخصص: التحليل النفسي، السيميولوجيا، الفلسفة.
– طاهر لبيب مفكر تونسي. صاحب كتاب : (سوسيولوجيا الغزل العربي). الذي كتبه في الأصل بالفرنسية وترجمه بنفسه إلى العربية.
– سيغموند فرويد (Sigmund Freud)مؤسس التحليل النفسي، 1856-1939. – مؤلفات مهمة: Trois essais sur la théorie sexuelle (1905).
– جورج باتاي (Georges Bataille)فيلسوف فرنسي، 1897-1962. صاحب كتاب Éros (1957).
– شارل بودلير (Charles Baudelaire)شاعر فرنسي، 1821-1867. صاحب ديوان أزهار الشر Les Fleurs du mal 1857.
– القديس أوغسطينوس (Saint Augustin)فيلسوف ولاهوتي مسيحي، 354-430. – es Confessions (الاعترافات).
– تقليد التروبادور Troubadours، أولئك الشعراء الغنائيين الذين ظهروا في جنوب فرنسا (أوكسيتانيا) في القرن الثاني عشر، والذين يُعدّون من أوائل من ابتكروا خطابًا غزليًا مكرّسًا للحب المثالي أو العذري (amour courtois).
مصطلحات معرفية وفكرية
– الإيروس (Éros)إله الحب والرغبة اليوناني. مبدأ الرغبة، الذي تتوافق طاقته مع الرغبة الجنسية (غالبًا ما يعارض مبدأ الموت “ثاناتوس”).
– تقسيم كريستيفا: Éros hystérique (الإيروس الهوسي) وÉros sublime (الإيروس السامي)
– النرجسية (Narcissisme)حب الذات المفرط، معناه الطبيعي والمرضي.
– التسامي (Sublimation)في التحليل النفسي، تحويل الغرائز إلى أشكال رمزية أو فنية.
– الذات (Le Sujet) الكيان النفسي أو الوعي الذي يختبر التجربة.
– الغيرية (L’Altérité) الآخر المختلف، المختلف عن الذات، والذي يشكل تحديًا لهويتها.
– الرغبة (Le Désir) الدافع النفسي العميق الذي يحرّك الإنسان نحو الآخر أو الشيء.
– الجنون (La Folie) حالة انفصال عن الواقع، في التحليل النفسي تعبير عن تعقيدات داخلية.
– المظهر (Le Semblant) القناع أو الواجهة التي يقدمها الفرد أو المجتمع، خاصة في التحليل النفسي.
– السيميولوجيا (Sémiologie)علم العلامات والرموز.
– التحليل النفسي (Psychanalyse)دراسة النفس البشرية والتركيز على اللاوعي والرغبات المكبوتة.
– اللغة (Le Langage) الوسيط الرمزي الذي يشكل التجربة ويحولها إلى معنى.
– اللاكانية هي تيار في التحليل النفسي أسسه جاك لاكان (1901–1981)، أعاد فيه قراءة فرويد بلغة البنيوية، مركزًا على اللغة كبنية تشكّل اللاوعي، وعلى الرغبة كقوة محرّكة للذات.
– “البانك” (Punk) هو تيار موسيقي وثقافي ظهر في السبعينيات، ارتبط بالتمرد والعنف والفوضى والسخرية من القيم السائدة، والتشظي الهوياتي والجمالي. يمثل رفضًا للسلطة وللنظام وللجماليات الكلاسيكية.
– المعركة الشمسية: تعود إلى رمزية الشمس في فكر باتاي التي لا تشكل مصدرا للحياة فقط بل أيضًا مصدرا للحرق والإفراط والفناء