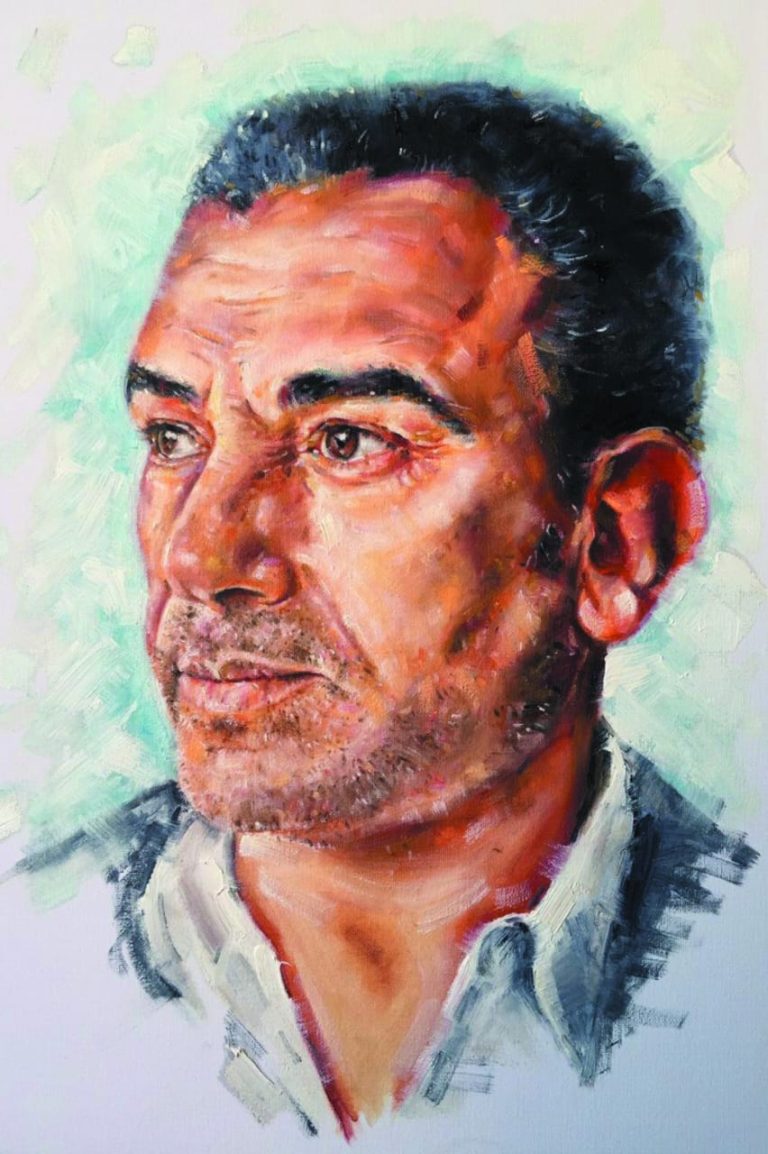حوار أجراه أ.د. عصام شحادة مع الكاتب والناقد المصرى ممدوح رزق لصفحة قسم اللغة الانجليزبة بجامعة الأقصى حول قصة وليام فوكنر “وردة الى اميلى “، و كيف شكلت القصة علامة بارزة فى الوعى الأمريكى الأدبى.
لماذا اخترت هذه القصة للكتابة عنها؟
ـ لجدارتها بالتحليل ضمن مشروعي النقدي عن كلاسيكيات القصة القصيرة سواء بالنسبة لكتابات وليام فوكنر أو لتاريخ القصة بشكل عام .. تكمن هذه الجدارة بشكل أقوى في التوعّد الخفي للغة الذي دبّره فوكنر حتى يصل بالقصة إلى مشهد اقتحام غرفة أميلي بعد موتها .. هو واحد من أروع مشاهد القصة القصيرة بالنسبة لي، ولا يرجع هذا إلى مكوّناته الصادمة فحسب، وإنما أيضًا إلى ما يمكن تسميته بالغفلة الخبيثة المصطنعة التي جهّزت منذ بداية السرد لاكتشافه.
كيف وجدت أسلوب وليام فوكنر؟
ـ يعتمد أسلوب فوكنر على المراكمة الكاشفة للمعطيات السردية، ولكنها ليست مجرد تمرير عفوي لمعرفة واضحة من التفاصيل والأحداث الضرورية، وإنما تتميز هذه المراكمة بخاصيتين أساسيتين .. الأولى: إنها تقوم على التكوين الوصفي الذي يخلق إيقاعًا متزنًا من النبرات المحايدة .. يدمج هذا الإيقاع بين الملامح المتنامية للقصة وإحالات مخاتلة، غير معلنة، تتصاعد تدريجيًا في توحّد صامت، كأنما تشيّد بنية سرية من الصراخ المكتوم داخل الفراغات، لن تكشف عن نفسها إلا عند اقتحام حجرة أميلي بعد دفنها واكتشاف ما تبقى من جثة هومر بارون في سريرها، ولهذا فالقصة ليست رصدًا مجرّدًا لمشاهد انتقائية بل بديلا إيحائيًا للواقعية المفترضة لهذه المشاهد .. الخاصية الثانية: إن هذه المراكمة لا تعتمد على التعاقب المنطقي للأحداث، وهذا يؤدي إلى التداخل بين الأزمنة، حيث تستدعي اللحظة ما تنطوي عليه من لحظات أخرى باعتبارها مساهمة في تشكيلها أي مستمرة في الحدوث، لا ينقطع وجودها، ومستشرفة لما تنشأ عنه ولما تمتد إليه، وهذا ما يمنح القصة طابع الحلم، أي ذلك الزمن الداخلي الذي يمتلك ترتيبه الخاص أو مشيئته الذاتية داخل التاريخ.
وردة الى أميلى تعبر عن روح عصر الاعمار بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية ما هو منظورك؟
ـ حسنًا؛ إذا كان من الممكن قراءة القصة ـ كما يحدث أحيانًا ـ في ضوء المقاومة الاستعلائية “القاتلة” للبيض الجنوبيين لمتغيرات ما بعد الحرب، وتمسّكهم الانتقامي بالسيادة الزائلة أمام الحقوق والحريات التي حصل عليها السود في حماية الشمال، وإذا كان من الممكن قراءتها على نحو مناقض في إطار التعاطف مع الجنوبيين البيض بعد تضاعف المأساة الاجتماعية نتيجة “الخيانة السوداء”، فإنني أعتبر القصة متخطية لذلك .. إن الأمر لا يتعلق بالازدراء أو الشفقة تجاه أثر سياسي ما أو تحولات طبقية معيّنة، بقدر ما يرتبط بالكيفية الغامضة التي تنتج بها الأوهام أجسادنا عبر الزمن، ومن ثمّ تحدد المسارات الحتمية لخطواتنا المخذولة، غير المتوقعة، حتى أثناء ما نفترضه صراعًا مع بداهتها .. الأكاذيب القهرية، الأشبه بالقبور ـ التي تتخذ أحيانًا شكل البيوت الأرستقراطية ـ حيث تتعفّن الأرواح في ظلامها الذي لا يمكن انتهاكه .. يتعلق الأمر بأن الثمن يُدفع دائمًا، مهما حدث، كحياة كاملة دون نقصان.
كيف تعقب على قصة وردة إلى اميلى كعمل فنى يتراوح بين الرمزية والحداثة والحنين الى الماضى و التطلع القلق نحو المستقبل؟
ـ أود الإشارة أولًا بصورة مختصرة إلى أن “الكلاسيكية” المقصودة في مشروعي النقدي الذي تضمن تحليل قصة “وردة إلى أميلي” ليست حكمًا جماليًا، أو تصنيفًا ثقافيًا، وإنما رؤية ذاتية للتاريخ، غير متورطة في الاختزال أو التقييم أو الانحياز، لكنها لا تستبعد الاشتباك مع ما يُنظر لها أحيانًا كسمات للأدب الكلاسيكي .. لهذا لا أجد مانعًا في منح صفة “الحداثة” إلى القصة من زاويتين: الأولى تتعلّق بالأسلوب نفسه، حيث الاقتصار على الضرورات اللغوية، الإشارية، المقتضبة، التي تتجنب الاستطرادات الحكمية الشارحة، أو التبريرات المقحمة، أو الفضح التقريري للدوافع والأحكام والانفعالات الوصفية، بمعنى آخر ثمة استبدال لليقين البلاغي بالتكتّم المراوغ الذي يتودد إلى كل الاحتمالات .. الزاوية ثانية ترتبط بمقاربة فوكنر لموضوع “الحنين إلى الماضي”؛ فهو يضعه في نطاق التشريح والاستجواب، لا التأكيد على مفهوم مطلق، وما يبرهن على ذلك طبيعة الاستخدام الرمزي في القصة: التكوين الجسدي لأميلي .. متعلقاتها الشخصية .. منزل العائلة من الداخل والخارج .. اللوحة التي تناولتها في قراءتي للقصة، والتي يمكن لهذه السطور التي أستعيرها منها الآن أن تضيء تجاوز الحنين لقالبه الرومانسي المجرّد إلى محاكمته، لا كوعد مهدر فحسب، بل كمستقبل مغدور به أيضًا:
“كانت (الآنسة أميلي) طوال هذه السنوات تعانق جثة (بارون)، وجثث أبيها، والحبيب الذي هجرها، والرجال الذين لم يُسمح لهم أن يدخلوا حياتها .. علينا استعادة كيف رفضت (الآنسة أميلي) تصديق موت أبيها .. ربما معالجة للذاكرة أي تصحيح الماضي بما يدفع الحياة للحدوث مرة أخرى بطريقة مغايرة .. ربما تقديراً لذكرى (القوة الذكورية) التي حاولت (الآنسة أميلي) أن تمتلكها ـ لنسترجع كيف كانت تعامل الآخرين بجفاء أعمق من كونه راجعاً لغرور ارستقراطي يتمسك برفاهية مجد زائل ـ بعد أن أخفقت في الحصول على الرحمة من هذه القوة .. الاندماج مع فحولة راضخة بفنائها في غرفة معدة لليلة (عُرس) .. امتلاك سوط أبيها بعد أن أصبح خامداً .. ربما النوم مع جثة الرجل هو الرغبة في الامتزاج مع ظلام الذاكرة .. الاحتفال به كعالم حقيقي، سري، يخص (الآنسة أميلي) وحدها رغم كل شيء، ومنفصل عن الحياة التي تصورها البشر .. الناس الذين سيعودون بعد ترك غرفة الطابق العلوي لنسج الأفكار والعواطف والاستفهامات التي تخلق أزمنة ـ يقينية ـ عن آخرين لا علاقة لهم بها”.
هل تعتقد بموت اميلى ماتت حقبة تاريخية تتمثل بقيم الجنوب وانتصار العلم على التقاليد؟
ـ موت إميلي هو محرّض للتفكير في القيم نفسها بشكل عام .. في سرها الغيبي الذي يسبق تاريخ ما، أي في وجوبها المتغيّر الذي يستعمل حيواتنا كتدليل للموت .. أيضًا فكرة “انتصار العلم” لا تعادل دائمًا بالنسبة لي انتصارًا “بشريًا”، ولكنها ملهمة للتساؤل عن كلمات كالهيمنة أو الأخلاق أو الخلاص مثلًا .. حول الفروق الممكنة بين “التقاليد” و”العلم” .. هل هذه الفروق حقيقية بالفعل أم أنها ظنون لغوية تستهلك ما تُصدّقه، ولا تتوقف عن رسم وجوه متبدّلة للسلطة القيمية بحسب تعريفها الفردي أو لدى جماعة ما في حقبة محددة.
ماذا نتعلم من قصة وليام فوكنر، وكيف نستطيع أن نعمل مقاربة مع واقعنا؟
ـ ربما تلخص هذه الفقرة من مقالي عن القصة ما يمكن أن يجيب على هذا السؤال: “لا يشكّل البشر يقيناً عن الآخر ـ خصوصاً غير المتورط في خطواتهم الجماعية ـ من الأفكار والعواطف والاستفهامات فحسب بل إننا نراقب مع (فوكنر) كيف تشيد تلك الركائز موضوع الزمن عند هذا الآخر: كيفية مرور الوقت داخل عزلته، وتأثير الذاكرة في حركة الانتقال عبر مراحل العمر المختلفة، والنتائج المحسومة التي لابد أن ينتهي إليها مصيره .. لكن هناك زمن آخر تُشكّله ركائز أخرى مغلقة على نفسها .. وجود كامن في نطاق من العماء، مستغرق في حقيقته غير المكتشفة .. الوقت الآخر، الذي تحكمه ذاكرة معادية، وحركة بعيدة عن التصورات والقرارات المتطفلة، التي تحفر في الخارج معرفة زائفة عن أجسادنا”.