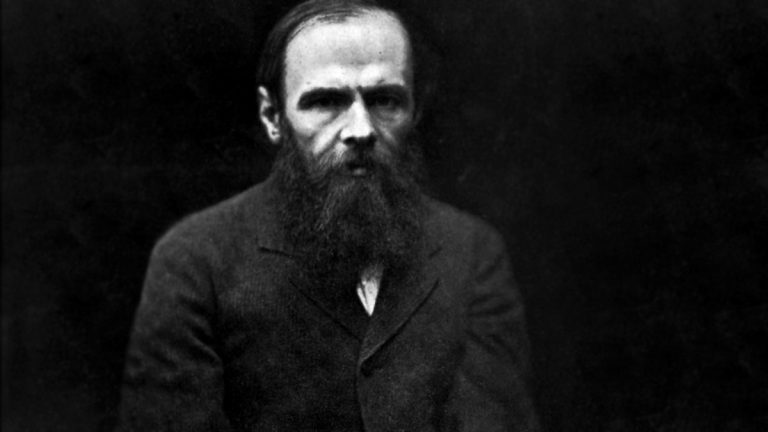أندر محتويات حقيبة أبي بالنسبة له رفيقته الوفية أبدا في كل أسفاره ” مسجلة ” بحجم كف اليد ذات لون طماطمي أحمر، دون أن يترك ظله وابتسامته العميقة التي قل أن تأفل عن تقاطيعه المريحة ، أما عن تجارته فلم نكن نفقه بشأنها شيئا ، لم يكن يناقش أمرها مع أحد ، ولم يفكر قط أن يكيل المهمة حتى حين شاخت سنواته إلى أحد من ذكوره ، كان هذا التاجر يقدس عمله وكأنه شأن خاص به ، والأهم إنه سيد نفسه ، الآمر والناهي لها ، وحيث تشاء مشيئته يعزم أو يركن ، كان فقط يحدثنا حين يعود من السفر عن الأجانب الأوروبيين الذين صادفهم في جولاته ودخل معهم في حوارات بانكليزيته وكانوا يفهمون عليه ويفهم عليهم ، يعود مع حكاياته التي تبهر عوالمنا الضئيلة دون أن تفوته الهدايا المتنوعة التي يحضرها كل على اسمه وما يناسب عمره الزمني ، دمى متنوعة للفتياته الصغيرات ولعب من السيارات بتشكيلة ألوان مختلفة لصبيته الأشقياء ، وحيثما أطوالنا مع الأيام كانت الهدايا تتشكل في أشياء أخرى يغري ذوات أطفال مع أبيهم الدائم السفر..
وجعلنا نسافر بطريقة أخرى ، بالانتقال من مسكن إلى آخر ، نحزم أمتعتنا وطريق طال أم قصر يحمل على كتفيه حقائبنا الكبيرة، الصغيرة، المربعة، المستطيلة.. واللاحقائب، كان سفرا ذا لذة غريبة، فكل مسكن وطئنا عالمه كان لسقوفه وجدرانه وأبوابه وممراته حكايات معجونة بالغرابة والدهشة المفرطة ، كل مسكن كان يعني بالنسبة لنا نحن الصغار مدرسة جديدة وحافلة جديدة وأصدقاء جدد ، وحي غامض في البدء ليكون الأقرب من حبل الوريد في النهاية ، بينما الكبار منا فكان هذا الانتقال يعني جيران جدد ومستشفيات وبقالات ..إلى لا آخر من تلك التفاصيل الفضفاضة التي تكتظ بها اهتماماتهم..
في الليل حين موعد النوم ، كان لأول ليلة من كل انتقال إلى بيت جديد له وهجه الخاص ، وسحره، وربما خوفه المستتر عن أمنيات تتسلق الجدران المحيطة بنا ، أو عن أحلام موردة تتوهج روح الحياة في أوصالها في فسحة هذا البيت الكبير، هكذا كانت أفكاري تتداعى ، الطفلة القلقلة من مغبة مغادرة أشياء قد لا نملكها يوما قط إلى أشياء أخرى تحتمل في أعماقها السحيقة ما لا يمكن إدراكه ، دون أي مبالغة أو غلو في التباهي كانت ثمة روح تسبر أعماقي بدفء لذيذ عن أيام رائقة لا تخلو من حس الفرح ، حس زئبقي لا يمكن سبره ، لكنه كان يضخ دم العنفوان في روح تلكم الطفلة المشوشة غالبا من ضجة حياة أخرى هائلة جدا بالنسبة لها ..!
كانت بيوتنا كبيرة ؛ والأب كبير العائلة كان شديد الحرص على انتقاء بيوت ذات مساحات واسعة ؛ لتتسع ضجة صغار أشقياء ينبههم الديك الشرس منذ صرخة الفجر الأول ، وتظل حواسهم مدركة حتى تتخدر تدريجيا وبفوضى كل في فرشته كيفما كان ، لتمتد يد رؤوم فتغطي تعبهم البارد في مساء صقيعي استدعاء لأحلام دافئة ..
الغاية في الإمتاع هي تفاصيل تلك الحكايات التي كنا نحن الصغار نستدعيها من عقولنا الغضة ، فكل بيت كنا نغادره لا يفوتنا أن نلطخ جدرانه بأسمائنا وهي عادة كانت سيئة – كما كان يراها الكبار – من حولنا وتحتمل عواقب لا تحمد عقباه إن وقع أعينهم على فعلنا المشين ، لكن قطع الفحم مع جدار مصقل نقي الطلاء كان يغرينا بالخربشة ، وتلك الخربشات كانت لها أهميتها الأشمل في دواخلنا ، فمن جانب كانت حربا خفية على أطفال أسرة جديدة تستولي على منزل كنا فيه قبلهم لنبرهن لهم أننا أشداء ولا نخافهم مطلقا ، وأن هذا البيت يظل لنا وإن غادرناه ، فهو يحمل كم ذكرياتنا الحميمة ، والتي لم نكن نسمح لأي كان قط أن يشوهها أو يلغيها ، لهذا كان البعض منا يكتب اسمه بطريقة توحي بأنه سيد المكان وزعيمه والبعض الآخر لا يفوته رسم أشكال هزلية ، كنا فقط نسمح للمطر بشطب ذكرياتنا من على الجدران ، وعندما كانت تمر غيمات من على أسطح بيوتنا الجديدة ، كنا ندرك أن المطر قد أذنّ لغيماته بمسحها وكنا نرضخ للأمر فلا حيلة لنا أمام جبروتها.. !
يقال : إن الغيمة لا أصدقاء لها..!
وكان لانتقالنا من مكان إلى آخر يعني أصدقاء ، وجوه وتقاطيع وخلفيات وقيم وأفكار وشقاوة متباينة ، ربما غدت صداقاتنا كالسحب ولكنها لم تغيب يوما قائمة تلكم الأصدقاء من حفنة من الذكريات تخللتنا معهم في فترة من الصداقة ، حيز الأصدقاء كان كبيرا ؛ ففي الفترة الصباحية كنا نتبادل المرح مع الذين نلتقي بهم في سقف مدرسي واحد ، ونكاد نتشاطر في اهتمامات جمة ، تضمنا تفاصيل مماثلة كالكتب المدرسية ، والملابس ، والحصص الدراسية ، وقائمة المعلمين ، والفروض المدرسية المضنية التي لا تنتهي أبدا هذا ما كنا نعتقده..!
بينما أطفال الحي فعصريات أيامنا كانت تخصص لهم ، نتحاور ونمرح ونتجادل وكل يصنع متعته في هيئة رفيق واحد أو شلة ، ومعظم المغامرات كانت تشتمل الذكور مع الإناث جنبا إلى جنب ، نادرا ما كانت متعنا في اللهو تفترق إلا في بعض مناسبات كحق الليلة..
كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل
للمنزل الأول في حياة المرء خصوصيته ، فالخطوات التفكير الأولى وانفعالات الحواس من دهشة وحب ومغامرة وفرح وبكاء وصرخة وشقاوة ووجوه الأشياء ومعالم المكان والزمان كلها تستعر في جدران البيت الأول ، تفاصيله لا تختلف عن تفاصيل البيوت الأخرى التي خلفناها وراءنا ،لكن أكثر ما كان يميز هذا البيت الوسيع هم الآخرون الذين كانوا يتنفسون معنا ، مع مراعاة اختلاف الأوقات ، فإذا ما كنا نتنفس في أطراف النهار كان تنفسهم في آناء الليل..!
كنا على علاقة ودية نوعا ما ، فما كانوا يؤذوننا ولا كنا نؤذيهم ، اتفاق ضمني على الحياة تحت سقف واحد مع المحافظة على حدود الفاصلة ما بين عالمينا ، عالم الإنس وعالم آخر من الجن..
كنا نحن الصغار نشعر بوجودهم ، يتماهى دبيب خيالاتهم إلى مستوى شعورنا خاصة حين يستدل الظلام غشاوته ، في ليلة لها حيز من الذاكرة الشيء الكثير ، اذكر تنبهي على أصوات هامسة والكل من حولي نيام ، اصطخب الفضول في أعوامي الست ، ولم تجد روح المغامرة في الطفلة نير يقينها سوى في قدمين يسبقان الظلمة وراء الأصوات الخافتة ، وقرب المطبخ حيث كانت اجتماعات تحفل في كل ليلة – فيما عرفت بعد ذلك من إخوتي الذين فعل الفضول فيهم فعله –ارتسمت صورة زعيمهم ليس فقط في مخيلتي الغضة بل على حائط المطبخ ، في ظل على هيئة تنين ضخم ، مع أشكال أخرى كان يعبر فيهم الآخرون عن وجودهم الظليي ، لكن وحده زعيمهم كان أعظم تلك الظلال وأصخبها همسا ..
لم يكن المنزل الأول وحده مسكونا بكرنفالات ليلية بل حتى المدرسة الأولى ..العالم في المطبخ كان احتفاليا صاخبا ؛ كل شيء فيه كان مقلوبا رأسا على فوضى، وكنتني أخاطب نفسي بوجل وأنا أتأمل صخبهم من أن أمي لن تسكت حيال هذه الفوضى العارمة مطلقا ، لكن ما كان يحدث أن تلكم الحاشية كانت تعيد الوضع على ما هو عليه عند بزوغ الشمس ، وتنأى إلى عالمها الغامض عند هجمة النهار وتنفشي رائحة البشر ..!
لكن على ما يبدو أن الحرب الدائرة ما بين الكبار وهؤلاء كان حاميا ؛ وهو السبب الفعلي الذي جعلنا نحمل أمتعنا إلى سقف آخر..!
لم تكن فكرة شراء منزل والاستقرار فيه أمرا ذا أهمية عند كثير من الآباء في تلك الفترة ، ولعل بخس الإجارات هي السبب الفعلي ، ولكن أهم الأسباب حبا ضمنيا سبر أفراد عائلتي يقوده حب التغيير والمغامرة بالدرجة الأولى..
لكن لم يكن ضمن هذه الأسباب شيء وارد يدعى ” هروب ” ،فقد كنا من ذاك النمط الذي يهرب إلى المغامرة وليس منها .. وفكرة القفز مع الأمتعة من مسكن إلى آخر ، بغرض الهروب من أشخاص ، أو من أزمة ما ، أو شبح الماضي الخانق غير واردة مطلقا كما حدث مع بطلة فيلم كنت قد سبق وشاهدته عن أم عازبة مع ابنتيها..!
وقد دأبت الأم في الفيلم بعد كل علاقة زواج فاشلة مع رجال تلتقيهم بقطع كل الصلات التي تواصلها معهم من خلال الهرب من مدينة إلى أخرى ومن سقف إلى حارة إلى رجل إلى تفاصيل متغيرة تماما ؛ كي تسقط ماضيها المؤلم من ذاكرة تأبى النسيان .. من ذاكرة لا تلغيها المسافات ..!
وقد استهلك هذا الانتقال المستمر مشاعر ابنتيها ، لتقرر في النهاية أن تغامر هذه المرة بالبقاء في المكان والمسكن نفسه ومواجهة الواقع ، ضوء من الجسارة انبثق في وعيها الحر ؛ كي تواجه قدرا كانت علاقتهما أشبه بمطاردة توم وجيري ، أجل البقاء في كثير من الأحيان يعد بحد ذاته مغامرة تستحق التجريب ، وبوابة لحياة أخرى لها تقاطيعها، ولعلها تجد نفسها بعد ذلك في حضن قدر لذيذ ..!
عندما تعرفت بعقلي على الكاتبة اليوغوسلافية ” إلما راكوزا ” في روايتها المنكّهة بسيرتها الذاتية ” بحر وأكثر ” .. وجدت ثمة روح واحدة ولكن على نقيض تتواصل بيننا، فطفولتنا كانت دائمة الترحيل والسفر ، هي من موطن إلى آخر .. بينما سفري كان روحيا بالمعنى الأقرب ، سفر في دائرة وطن واحد تنبهت تفاصيل الحياة فيه ، كانت لذاكرتها عقدة من حقائب السفر ، وكانت ذاكرتي تلتذ بحقائب تحوي زخم ذكرياتها من مغامرة إلى مغامرة ، ألبس هذا حيزي الطفولي متعة قلّ أن أتابع مشواري في درب الحياة دونها .. !
والوجه المضاد الآخر أن ” إلما ” اكتشفت لذة السفر في شبابها ، فغدت كل مدينة هي متع من حياة افتقدت لذتها في سن مبكرة ، وغدا السفر اختيارا وقرارا ذاتيا ، ولعل هذا ما جعل للسفر وحقائبه أهميته الاستثنائية ..
بينما أجدني في أعوامي الشابة هذه ، مشوبةب التوجس من فكرة الرحيل ، ترك كل ما يمت عالمي الخاص بصلة إلى وطن آخر ، ولسان خوفي : ” هل سيحتويني كما احتواني موطني الأول ” ..؟ وعالمي لم يكن كعالم ” إلما راكوزا ” : ” دفعتني التنقلات الكثيرة إلى الاعتماد على الذات ، الذي كان الخوف وجهه الآخر . الأب ، الأم ، الحقائب وأنا – ها كان عالمي ..”
فالتنقلات العديدة أحالتني غيمة ، عرفت جيدا أن مرورها عابر أبدا … فالمكان مستقر للجسد وحده ، بينما للروح أسفارها ، وروحي سندباد كروح أبي التي حلقت قبل غيمتي إلى سماء مضيئة بنجمة على خدها…
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ليلى البلوشي
كاتبة – عمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلا عن موقع البلد