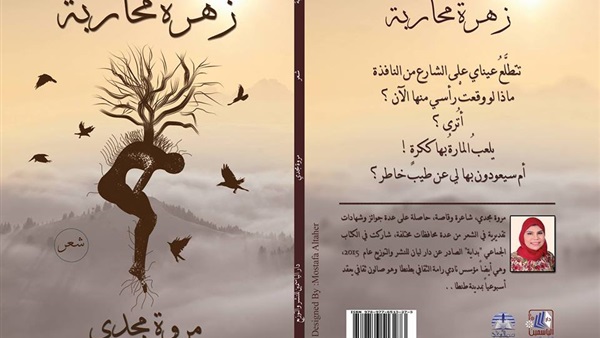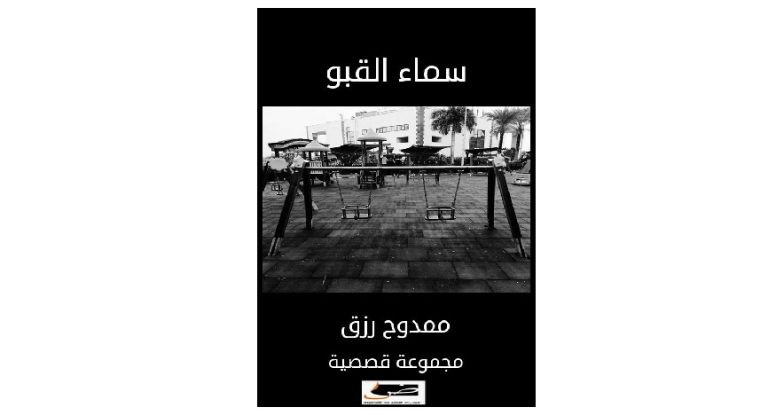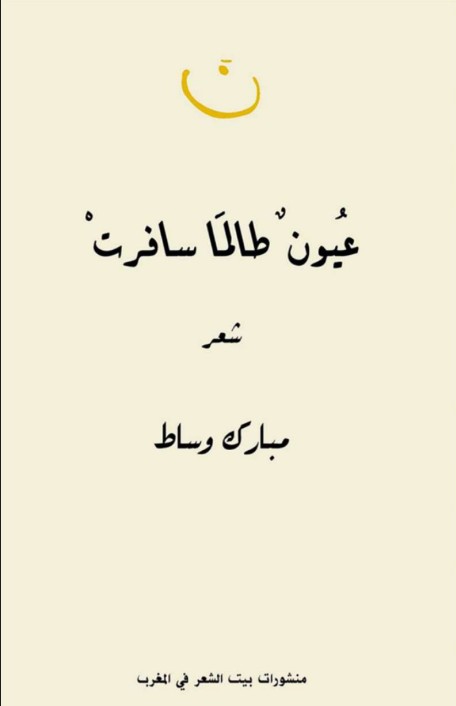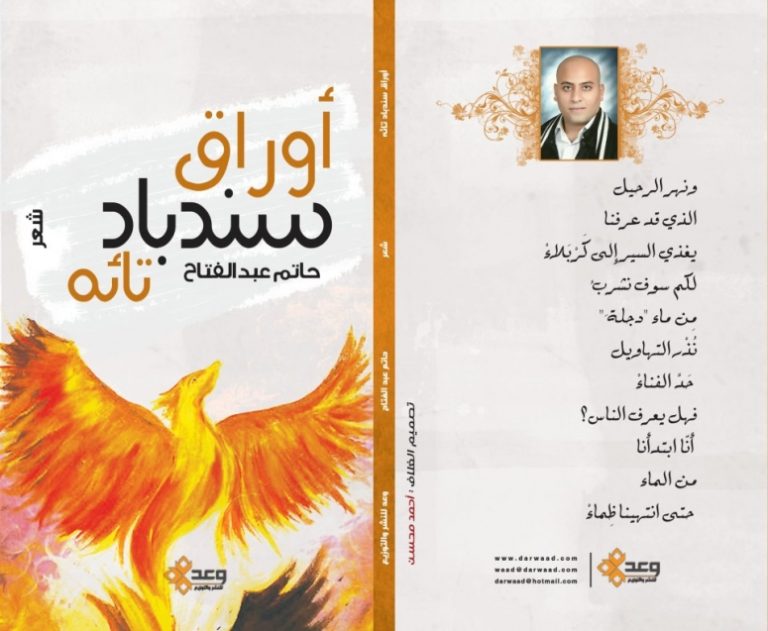تأتي روايته “جبال الكحل” (2001 ) والصادرة مؤخرا عن سلسلة كتاب اليوم (2013 )، محاولة لاستجماع الخطوط المتوارية لخصوصية ذلك التراث، وكشف المسكوت عنه في الحكاية القديمة، ومعاناة أهل النوبة من التهجير. وكما يقول الكاتب في مقدمته أنها “رواية نوبية، تحكي فصلا من تاريخ النوبة. عاشه جيل من أبنائها وترسب في وجدانهم بكل أبعاده ودلالاته”.
يستخدم الكاتب المذكرات الشخصية إطارا عاما للرواية، مما يتيح له سرد الوقائع التاريخية وبث رؤيته وشجونه الخاصة. يدور السرد من منظور الراوي “على محمود”، الذي عمل بالتدريس في مدرسة “عنيبة” منذ تخرجه في جامعة فؤاد الأول، إلى أن جاء التهجير عام 1964 لبناء السد. وقد أوصى قبل وفاته بأن تكون مذكراته بين يدي ابن خاله “محمد المارودي”. على مدى تسعة عشرة فقرة سردية، في مئة وخمسة وثلاثين صفحة من القطع الصغير، يستجمع الكاتب خطوط التاريخ، ويستنطق المسكوت عنه في معانة أهل النوبة. إلى جانب الراوي الرئيس، صاحب المذكرات، هناك راو آخر متضمن، الخال المسن “جعفر جنينة” الذي عايش أجواء التعلية الألى لخزان الأسوان. وبذلك يتمكن الكاتب من التحرك بعيدا في الزمان والغوص عميقا نحو بداية المعاناة. مع انتشار الأخبار والأحاديث عن بناء السد العالي في منتصف الخمسينيات شاع التوجس والقلق بين أهل القرى والنجوع وخيمت عليهم أجواء التعلية الثانية لخزان أسوان. يحكي الراوي:
(وقت التعلية الثانية كان عمري ثماني سنوات ومازالت تطوف بي ذكرى تلك الأيام في نوبات كابوسية، ورؤى مشوشة في أغلبها ولكن بعضها حاد الوضوح، كأن وهجا من الشمس مسلط عليها. لا أنسى مشهد المياه وهي تتدفق، ترتفع في خطوط متعرجة سريعة.. ومصرة وحاسمة.. لا شئ يقف في طريقها، تلتف وتحاصرها من كل جانب وتظل ترتفع وترتفع حتى تبتلعها، وتواصل مسيرتها كالقدر، كانسة “الغنجريبات” والأبراش وصغار الماعز مقلوبة على ظهورها يجرفها التيار. لتضيع في صخبه مأمأتها المروعة.. جدران الدور تتشقق وتتهاوى مدوية في صوت رعدي مكتوم. النداءات والعويل.. لطم الخدود وشق الجيوب والسباحة وسط التيار، الجري والصياح وصخب المياه، أصوات مازالت تسكن أذني.)
ومع صوت الراوي الرئيس يلتقي صوت الراوي المتضمن، الخال جعفر جنينة: (…سماه البعض، وعلى رأسهم خالي جعفر جنينة ب “عام الطوفان”. لا يمل خالي الحديث عن تلك الأيام، يخلق المناسبة ويشرع في الحكي. وعندما ترددت الأنباء عن السد العالي، واتته الفرصة ليحكي لي هذه المرة عن التعلية الأولى عام 1912).
رغم سرد تفاصيل المعاناة، لا ينزلق الكاتب إلى ميلودراما الرثاء للذات، إنما يؤكد على مدى ارتباط أهل النوبة بوطنهم مصر وتضحيتهم في سبيل كل ما يعود على الوطن بالخير والرخاء. تأتي الرواية صرخة ألم في وجه البيوقراطية التي حرمت أهل النوبة من التعويض اللائق، كما تطلق صرختها أيضا في وجه الجهلاء الذين لم يدركوا الخصوصية الإنسانية والثقافية لهذا الجزء الأصيل من شعب مصر. جاءتهم الوعود بالنوبة الجديدة وكأنها نموذج يحتذي في حداثة البناء ورفاهة العيش، قالوا لهم: (إذا دقت ساعة الرحيل قوموا في رعاية الله.. إلى بيوت حديثة ومزارع ناضرة، ومصانع شامخة، وخدمات لا تحصى، وأمل يعززه العمل، من أجل بناء مجتمع الكفاية والعدل، إن كل أجهزة الدولة تعمل من أجل إقامة النوبة الجديدة، من طراز نموذجي لبناء مجتمع اشتراكي سعيد...) لم تخدع نبرة المسئولين العالية الأهالي البسطاء، ويعبر الراوي عن توجسه من الإغراق في الوعود البراقة: (إن الكلمات التي تقال وتنشر، المؤتمرات والنشرات ومن يزعقون فينا من خلال محطات اللإذاعة بعبارات مفخمة، نبراتها عالية.. تزعق فينا لنصدقها، ما حاجتهم لكل ذلك، الأهالي في دخيلة نفوسهم فرحون بالهجرة، سعداء بأنهم سيكونون أفضل حالا مما هم عليه هنا مهما كانت متاعب الحياة هناك، فلم نكن في حاجة لكل هذا الضجيج، وكل هذه الأكاذيب، التهجير في حاجة إلى شئ آخر.. فهم مختلف وصادق، ليس في خاطر أحدهم الآن الذكريات ومسقط الرأس والفردوس المفقود، التراث والأجداد والآثار، هذه أمور تشغل المثقفين وبعض المتعلمين.. أهالينا تشغلهم الحياة..) وعندما حانت ساعة الرحيل وعانى الأهالي حتى وصلوا إلى النوبة الجديدة، وفيها لم تكن تنتظرهم الجنة الموعودة، وجدوا ما ذكره لهم أحد أبناء القرية (عن الدور الجديدة، وكيف أنها بيوت كالعلب.. أسمنت وحجارة.. صغيرة وقبيحة، واطئة وشكلها مقبض، وفوق ذلك فهي بعيدة عن النهر.) لم ينتبه المسئولون إلى خصوصية الثقافة التي تربط أهل النوبة القديمة بالنهر. ففي قراهم العريقة الطيبة نبتت أولى بذور الحياة البشرية، الماء والناس والحيوانات والنباتات… تزاوجت الطبيعة والبشر فدبت الخطوة الأولى للتحضر في العالم.)
…………………..
يمكنكم تحميل الرواية >> من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من مقال عن الرواية نُشر بمجلة الإذاعة والتلفزيون