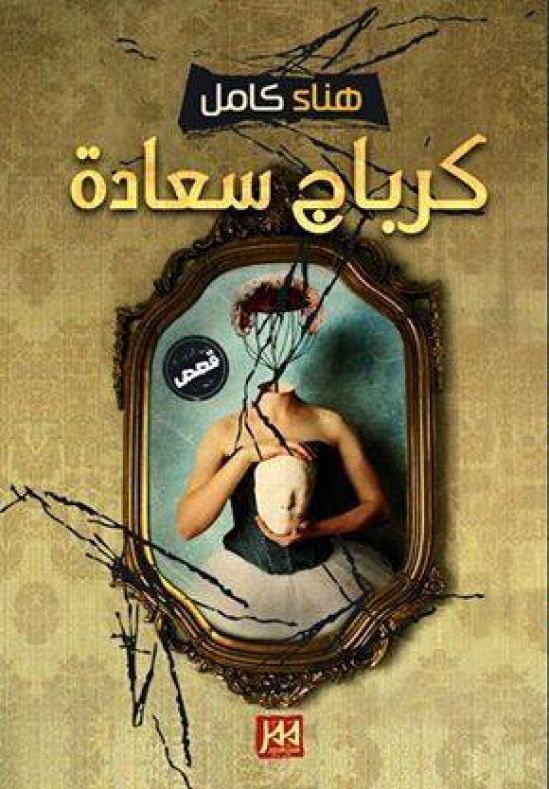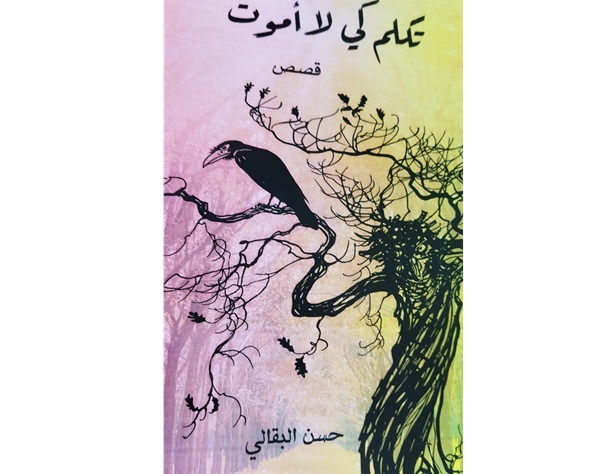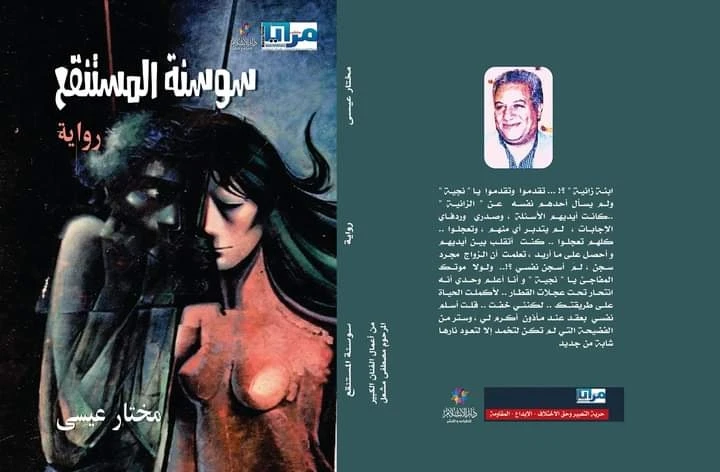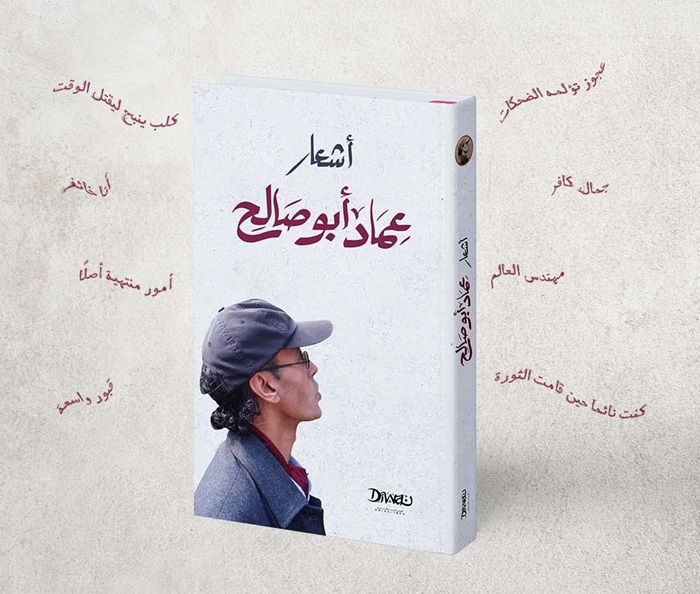(1)
يستيقظ “الرقيب” من نومه ذات صباح، بعد أحلامٍ مزعجة، ليجد نفسه وقد تحوّل في فِراشه إلى قارئٍ عملاق. ليست هذه حرفياً صيغة العبارة الأولى في رواية بثينة العيسى الجديدة “حارس سطح العالم” (الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات تكوين، ومكتبة تنمية للطبعة المصرية)، لكنها ليست بعيدة بحال عن العبارة التي اعتمدتها العيسى، مُعارِضةً افتتاحية المسخ الكافكاوي فيما تقدم مسخها، في خطابٍ روائي يستعير من كافكا ما يتجاوز العتبة: فضاءات القمع وذوبان الفرد المطارَد في آلة العالم الهائلة. لن يكون هذا، رغم ذلك، أكثر من مرجع أوّلي لـ”رواية روايات”، مرجعها النصوص وواقعها المخيّلة.
مجدداً، تطرح بثينة العيسى علاقة الفرد بالسلطة، وهو السؤال الذي سيطر على روايتها السابقة “كل الأشياء”. هذه المرة، تُستبدل الرقابة على الإنسان بنظيرتها على الإنساني، وتُقلّب العيسى السؤال في سماء الفانتازيا بعد أن اختبرته في تربة الواقع، مُغرّبةً، بخلاف نصّها السابق، المكان والزمن وحتى أسماء الشخوص، لتنطلق إلى الوجودي، وحيث “عمومية” العالم تُوازي شمولية السلطة.
ثمة الرقيب، بطلُ النص وضحيته، الذي سيتحول إلى قارئ، ثم حارس مكتبة، ثم مفتش مكتبات، وهو في كل ذلك أبٌ لطفلة. خمسُ هوياتٍ ليس بينها الاسم، تتحرك بين خمسة مفاصل، هي عدد الفصول التي يتوزع عليها جسدُ الخطاب الروائي، والتي، للمفارقة، تحظى بأسماء. تترى الفصول دون أن يتصل الترقيم بينها، لتستقل كل وحدةٍ بترقيمها كمحكيةٍ تحظى بقدرٍ من الاستقلال. هل قصدت بثينة أن تكون لكل وحدة مرويتها حتى وهي تُكمل سابقتها وتمهد لتاليتها؟
هو بالفعل نصُ تحوّلات، في حركةٍ سردية موّارة بين انفصامٍ واتصال. بين كل وحدةٍ وتاليتها نقلة، نفق، يشبه ذلك الذي يسقط فيه الرقيب في أحلامه، إذ يأتي كلُ تحوّل سردي مشفوعاً بحلم، وبكتاب، وكأن كل فصلٍ “تأويل” متجسد لمنام بقدر ما هو استعادةٍ مبدعة لنصٍ في الذاكرة، استعادة جوهرها المعارضة لا المحاكاة.
تقدم رواية العيسى نفسها كخطابٍ قائمٍ في المستقبل. للمفارقة، فإن ذلك المستقبل يُمثِّل بالكاد ردةً عنيفة لماضٍ شرس في بدائيته، يثور على عصر المعلومات مُرتداً إلى أدبيات ما قبل التدوين. هنا ديستوبيا تنهشها السخرية، مسرحها “العالم الجديد”. العالم الجديد: تعريفٌ يُرجِّع بدوره عنواناً ومناخاً روائياً لألدوس هكسلي، في رواية ديستوبيا أيضاً هي “عالم جديد شجاع”، لن تعدم قدراً من الحضور هنا.
ثمة ثورة تطهير، أنهت الديمقراطية وأفنت “الفوضى الرقمية”، يقودها حزب وسْمُه “الواقع”. ثمة عالمٌ بات يملك وزارة لاحتكار الحقيقة وفقهاءُ علمٍ وسلاح، يوحّد بيوته وملابس قاطنيه وألوان منشآته وفوق ذلك رؤية مواطنيه للعالم. لم يعد من جنة أو جحيم. الحياة، كاللغة، محض سطح، وما بعد سطح الحياة يساوي ما تحت سطح اللغة: تُمحى الآخرة رفقة المعنى، والتأويل مستبعدٌ في سماء العالم مثلما هو مستبعدٌ في سماوات الكتب. ليس ثمة مطلق، يموت الإله نفسه ولا يعود خلقه بحاجةٍ لبعث. ثمة حاضرٌ فقط، بعدما التهمت نيرانُ مَحرَقةٍ أطراف ثوبَ الماضي وفحّمت جثته، لتحتفل بتذكاره يوماً وحيداً في السنة، في متحفٍ مفتوح للتمثيل بالذاكرة وبالذكرى. وثمة الكتب: شواهد ذاك العالم القديم وهي تدل على رفات مقبرته الجماعية، غير أنها تُطل بعينٍ ناجيةٍ على الحياة، تتسلل عبر فتوق السطح أو ثقوب الإسفنجة عابرةً الجثامين للأجساد، والتراب للّحم والدم. كتبٌ تنجح في استنطاق خلاياها النائمة لتصبح شخوصها سرطاناتِ الجسد الهائل متسق البنية، مزيلةً الفارق بين دالين: السرطان كمرض تواريه الخلايا والسرطان ككائن تواريه الرمال الناعمة، رمال الطبيعة واللغة معاً. ينهض كلاهما ليقاوم، للمفارقة، سلامَ الجثمان وسلامته، وقد تجرّد من الخيال والمعنى. ومثل “دون كيشوت وتابعه سانشو”، ثمة “السكرتير والرقيب”: فارسٌ شاخ في حربه الأخيرة محتمياً بجنونه النهائي، يعاونه آخر يكره أكثر ما يكره أن يكون بطلاً، مغدوراً أو منتصراً. جواد العصور الوسطى يتحول إلى أرنب العالم الجديد، وصهيلُ احتضار ذؤابة الفروسية الأخيرة في برية طواحين هواء ما قبل التنوير يستحيل بقايا بعرات منثورة في ممرات طواحين هواء ما بعد الحداثة.
التغريب هنا صنو التعميم. تُنزع الأسماء، اسم الدولة ومن بعدها المدينة وصولاً للذوات المختزلة في أدوارها أو وظائفها: رقيب، سكرتير، رئيس قسم، مفتش، طفلة، زوجة، ورّاقة. ذواتٌ مشفوعة بلافتات لا أسماء، والافتقار للاسم صنو افتقاد الهوية. تعميمٌ يؤكد على انتفاء التباينات “الهوياتية” بدءاً من التوطئة: “تدور أحداث هذه القصة في زمنٍ ما في المستقبل، في مكانٍ لا يُحدث ذكره أي فرق، لأنه يُشبه كلَّ مكانٍ آخر”.
تنفي الروايةُ تاريخانيتها بنفي التاريخ نفسه وبتعميم السياق، أو بتوحيده بنفس منطق توحيد الزي حيث الحاضر يرتديه الجميع بالتساوي. لكن التاريخ المقصي ما يلبث أن يفعل العكس بالضبط، منقلباً على مبتغى مُصادريه، إذ يأتي بالعالم القديم عبر “نصوصه” بالذات، ليجعل المتخيل هو التاريخ، وقد اتحدا أخيراً على شرف المنفىَ نفسه، ففي العالم الجديد “دراسة التاريخ، مثل قراءة الأدب، تثير الخيالَ غير الضروري”.
يُمحى التاريخُ فيعود على هيئة نصوصه: إنه بالضبط ما يحدث لبطل الرواية إذا ما حاولنا تجريد البنية السطحية للفعل الدرامي إلى عمق دلالاتها المجردة، فهو إذ يُنفى وقد أصبح قارئاً لا رقيباً، يتحوّلُ للأبد من شخصٍ في حياة إلى شخصيةٍ في قصة.
(2)
الرقيب/أداة منع التخييل، يحلم/نشاط إتاحة التخييل. تأسيسٌ نموذجي لتناقض البطل الذي يعاني “التفكير الازدواجي” في الصحو ويتصالح معه في المنام.
إنه أيضاً تأسيسٌ نموذجي لنظرة هذه الرواية لفكرة لثنائيات. بلا هوادة، تنقض “حارس سطح العالم” ثنائياتٍ تصنيفية قارة، بين أدب الكبار وأدب الناشئة، بين الأدب الرفيع ونظيره الشعبي، بين “الثقل” و”الخفة”، وفي الأخير، بين “سطح اللغة” و”المعنى”.
ثمة “الديستوبيا”، ممثلةً في نصين رئيسيين: 1984 لجورج أورويل، (تحضر جمهورية الأخ الكبير، هناك وهنا) حيث المستقبل هو الشمولية في أشد أشكالها قمعاً وكاريكاتورية في الوقت ذاته، وحيث يتجاوز الكُفرُ سلطةً ملحدةً بالإله، نحو سلطةٍ ملحدة بالمعنى. هناك أيضاً 451 فهرنهايت، لراي برادبري، ديستوبيا المكارثية التي تقارب مصير مطفئ حرائق “مونتياغ”، شأن الرقيب الموكل إليه إطفاء حرائق المخيلة، ليجد الاثنان نفسيهما قارئين ومقاومين. على جانبٍ آخر، ثمة “ألِيس في بلاد العجائب” و”بينوكيو”، نصّا الطفولة الكبيران، وبينهما حكايات طفولةٍ أخرى، فيما يستظل النص كله بـ “زوربا”، نص الحرية، برقصته، منتشياً وذبيحاً.
ديستوبيا النهايات السوداء، طفولة النهايات السعيدة، ووجودية النهايات المفتوحة. ثلاثة اقتراحات متباينة للطريقة التي بها تنتهي الروايات، تراوح بينها الرواية أيضاً إذ تتقدم نحو نهايتها.
بالاقتراب من ثنائية “سطح اللغة” و”المعنى” ينهض سؤال: ما الفارق بين اللغة كسطح صلب (حسب تعريف رقباء العالم الجديد) واللغة كإسفنجةٍ لدنة (بتعريف الرقيب المنشق)؟ الفارق أن الأول يحيل لعمق مختلف في طبيعته عن سطحه، أما الثانية فأعماقها مصنوعة من نفس مادة سطحها، ما يعني أن الدال ملتبس بالضرورة بالمدلول أي المعنى ولا سبيل للفصل بينهما. إنها أيضاً المفارقة بين الاعتداد بالثنائيات (وكل ثنائية تنهض بالضرورة بضدية قيمية، أيديولوجية، أو أخلاقية) وهدم هذه الثنائيات، حيث تلتبس القيم دون القدرة على العثور على جوهر “نقي”.
بعزل الدال عن مدلوله لن يغدو الدال منتمياً للكتابة، فسؤال الكتابة هو سؤال الدلالة. يتحول الدالُ المعزول لمحض شكل، “صورة”، مؤلفة من أحرف ليست أكثر من علامات بصرية عند التدوين وصوتية عند التلفظ، تُرى كتشكيل لكن لا تُعى كدلالة. يقف عمل الرقيب عند السطح، (حيث العبرة في الملافظ والمباني) أي عند الشكل، رغم أن فعل “القراءة” يغدو مستحيلاً دون رد الشكل لمدلول (الأفكار والمعاني) يحيل بدوره لمرجع، حتى لو كان الهدف هو المنع. إذا كان كل مرجع هو “تاريخ” ما، فنحن في عالمٍ فقد المرجع، لكنه ما يزال عاجزاً عن مقاومة الدلالة.
“التورط في المعنى” و”السقوط في التأويل”: إنهما المحظوران الرئيسيان في “حارس سطح العالم”. إن كلا مفردتي “التورط” و”السقوط” يحملان دلالة أخلاقية، تتجاوز صيغة الاتهام لتصبح شاهداً على الوصم. يسقط الرقيب في الحلم قبل حتى سقوطه في التأويل. السقوط في الحلم لا يختلف عن السقوط في المعنى، وكلاهما يصبح “سقطة”: “عندما فتحت زوجته باب الغرفة، كان ما يزال على الأرض بعد تلك السقطة الطويلة جداً”.
لكن، أليس الحلم نفسه تأويلاً للواقع؟ وماذا تفعل سلطة العالم الجديد أمام خطرٍ كهذا؟ كيف من شأنها أن تمنع نشاطاً غير واعٍ فضلاً عن كونه يستحيل الكشف عنه؟
“المعنى” و”التأويل” كلاهما ينتميان لعالم المداليل لا عالم الدوال، والمفارقة أن السلطة تحتكر النشاط التأويلي، رغم أن التأويل، بالضرورة، هو نشاطٌ على يسار السلطة: سلطة اللغة وسلطة المقدس، وفي حال اللغة العربية، فإن اللغة هي نفسها المقدس. التأويل هو فعل المعارضة المعرفي وباستحواذ السلطة عليه فإنها لا تضمن مخاطره كما تحلم، بل تفقد هي نفسها، معناها.
هل نحن، وفق “تأويلي” هذا، أمام سلطة تدميرٍ ذاتي؟ هل تريد أن تستأثر، في تأويلٍ أبعد، ليس فقط بالحفاظ على بقائها، لكن أيضاً بمزية القضاء على نفسها بتحويل نفسها لمنتج وقارئ معاً لخطابها؟ تطمح السلطة بالانتقام من الكتب بمحاكاة عملها بالضبط، فالكتب الحقيقية، حسب الرواية “ذات تأثيرٍ كارثي، قادرة على الخلق والتدمير معاً”. تصنع الحكومة محرقةً رمزية لدمى كتب فارغة الصفحات، فيما تنهض المحرقة الفعلية في خلاءٍ بعيد. أليس هذا توظيفاً للاستعارة، الآلية نفسها التي تنهض السلطة لوأدها؟: “إنه يعود دائماً إلى قدرة النظام المذهلة على خلق المجازات، والتصرف باعتبارها واقعا. ولما بلغ بأفكاره هذا الحد تساءل إن كانت الحكومة، في حقيقتها، تؤمن بقوى المخيلة أكثر من المعارضة؟”
ربما هنا تكمن إجابة محتملة لتساؤل الرقيب عن السبب في امتلاك “رئيس القسم” هذه المكتبة التي تضم كل كتب العالم، ما يعني أنه، للمفارقة، أكثر شخصٍ بالعالم قرأ كتباً. لن نلبث أن نكتشف أن المدينة تملك متاهة كتبٍ تتجاوز ما يملكه رئيس القسم، منذورة للإعدام. إنه تمثيلٌ للتناقض الجوهري الذي تتوفرُ عليه أدبيات النظام، وهو في العميق تمثيلٌ عميق لعمله، تمثيلٍ ليس ببعيدٍ أبداً، على فانتازيته، عن أنظمة قمعٍ نحياها، تقوّض فيها الأنظمة نفسها دون حاجةٍ لإسهام خارجي، ليحتكر “النظام” الحقيقي، الخلق والتدمير معاً.
نحن إذاً أمام سؤالٍ يتجاوز الوظيفة الكاريكوتورية لرقيبٍ، يتجاوز حتى الانتقام من المعنى وتحاشي “التأويل”، نحن أمام تغريبٍ للغة بحيث لا تغدو بعد الآن نظاماً “تواصلياً” أو “تداولياً”. ما الذي سيحدث عندما تفقد اللغة تلك الوظيفة؟ سيمتد الانقطاع للواقع بحيث نغدو أمام لغات تشترك ظاهرياً في دوالها غير أن كلاً منها تحيل لدلالات مختلفة، ومع غياب التاريخ المشترك، لن تصبح اللغة مشتركاً إنسانياً بعد الآن، بل تبادُل عزلات.
هكذا يغدو خطاب الطفلة (ابنة الرقيب) مشتركاً مع خطاب الأهل على مستوى “السطح” أيضاً، مستوى التلفظ، غير أنه مغترب على مستوى الإحالة لخبرة مشتركة، ومن ثم الاتصال. إخفاء الأب لعيني الطفلة كلما فزعت ليس حجباً مؤقتاً لحاسةٍ هي الرؤية، لكنه إبطالٌ للدلالة. إنه ارتدادٌ لما قبل اللغة أي ما قبل الإنسانية. هكذا ستكتسب الطفلة ذيلاً، حتى لو كان استعارياً، لتصبح موجوداً “غريزياً” يوازي “الأرنب”، وكلاهما قادمٌ من واقعٍ آخر هو واقع المخيلة.
في هذه الحالة، فإن مهنة الرقيب لن تكون فقط نفي المعنى، بل نفي التاريخ، إذ لا وجود لتاريخ إلا بوصفه خبرة مشتركة، تمر، كشرط، عبر الذاكرة الجمعية. إنه، مجدداً، “العالم الجديد” وهو يطمح للتخلص من ذاكرته.
إن التكوين الأشمل لـبنية “حارس سطح العالم” الشكلانية هو أيضاً نقضٌ شكلاني (ودلالي بالضرورة) لفكرة الثنائية، إذ يهجَّن النص المكتوب بمرادفه البصري الذي اضطلع به رسام هو “محمد المهنا” لم يُغفل الكتاب وضع اسمه على الغلاف كشريك. النص التخييلي أيضاً مُهجَّن بجداول هيئة الرقابة، نماذجها وتقاريرها، في سمتها الأصم، وفضائها البصري الذي تعكسه جداول خانقة كالزنازين أو صف طباعي جاف. يشتبك البصري بالكتابي قدر ما يغزو التسجيلي التخييلي ليُشكِّل بنيةٌ مراوحة لنصٍ لا يملك دليلاً، ولا يريد، على نقاء هويته، المؤلفة بدورها من جماع نصوصٍ أخرى.
يشير هذا ضمن ما يشير لرؤية هذا النص لأدبية الأدب نفسها، فهو يزيل الفواصل الواهية بين التصنيفات متململاً من “طبقية” الأدب، قدر ما يزيح الهوات التاريخية التي تفصل حقب هذه النصوص المتباعدة وسياقاتها المتباينة ليجعل من النص الأدبي حضوراً دائماً، هنا والآن، وكأن الأدب يحيا زمناً واحداً هو الحاضر. إنه “تاريخ المخيلة” وهو يعيد تأسيس نفسه في عالمٍ محا التاريخ الرسمي، وعبر هذه الآلية، فإن “حارس سطح العالم” تعيد تقليب سؤالٍ يراه البعض مبذولاً ولا أراه كذلك، هو سؤال “دور الأدب”.
(3)
واقع “حارس سطح العالم” هو نفسه المتخيل. المتخيل هو واقع اللغة، فيما الحقيقة هي لغة الواقع.
في تربة الأدب، تغرس الرواية ساقيها عميقاً، لتبتعث الواقع من النصوص، وليس العكس. وهي في ذلك السبيل، تستحضر خمسة كتب رئيسية تُختبر في خمسة تقاطعات، تجعل من النص الإبداعي نفسه فعل قراءة، حيث الكتابة موضوع للكتابة، وحيث “حارس سطح العالم” نفسها رواية داخل رواية، مثلما هي رواية فوق الرواية.
نحن أمام “ميتا رواية”، تعكس موروثها بوعي ذاتي على صفحتها، تعي نفسها مُراوِحةً بين الإيهام وكسر الإيهام. هكذا تبدأ “حارس سطح العالم” من ذات توهم بمعقوليتها وفق الواقع النصي، وتنتهي بالاعتراف بأنها محض شخصية متخيلة: “كأنه لم يوجد قط. كأنه شخصية في رواية”.
إنه “الواقع” وهو يُعيد تعريف نفسه، مُختَزَلاً بالكامل، ليس فقط في نصوصه، بل في تلك التخييلية بالتحديد، (والتي تحصل على الأولوية في مهمة الإنقاذ لدى المقاومة). داخل هذه النصوص، وبطريقة الماتريوشكا، تنهض نصوص أخرى، “استقدمها العمل وحاورها، دون وعي” كما تؤكد العيسى في تحيتها الأخيرة لمنابعها النصيَّة.
“ماذا لو ابتلعه كتاب؟”، أكادُ أكمل: “على غرار ما حدث في رواية “الكتب التي ابتلعت أبي” لأفونسو كروش”، “إنها ليست مكتبة، بقدر ما هي مقبرة”، أُكمل: “مثل مقبرة الكتب المنسية في ظل الريح لثافون”، “وفكر بأنه على مقربةٍ من مركز الأرض”، أُكمل: “كبطل جولي فيرن”. العبارات من هذا القبيل عديدة، هي إحالات، في روايةٍ لا تكف عن الإحالة لأصدائها، وكأن العيسى نفسها، وليس فقط “الورّاقة” صاحبة المكتبة الآخذة في كتابة رواية داخل الرواية، هي “الطفلة التي تلعب بالصدى”.
حتى لو اعترف البطل “أنا أكره المرايا”، وحتى لو نقض، هو نفسه، اعترافه بتساؤل: “إذا كان فعلاً يكره المرايا، لماذا يهيم بالروايات إلى هذا الحد؟” فإن المرايا هي المفهوم العميق لهذا النص، حيث يعكس كل نصٍ سالف نفسه على سطح “الرواية الجديدة” التي لا تتنكر لماضيها شأن “العالم الجديد”.
أمام كل حكايةٍ مضمنة، من تراث الطفولة، ثمة مقابلة مرآوية تحولها من محكية مختزلة مستعادة في الذاكرة التخييلية إلى محكية متجسدة في الواقع الروائي. إنها، بالضبط، المقابلة المرآوية بين لا وعي هذا النص ووعيه. ثمة المرآة في يد الأميرة، التي تشترط فيمن ستقبله زوجاً ألا تنعكس صورته على صفحتها. في سبيل ذلك تنهض مذبحة لكل من يخسر الرهان، ووحده من يختبئ في غرفتها يربح لأنه، في واقع الأمر، اختبأ حيث لم يكن يجب أن يفعل. إنه المجاز الكبير لهذه الرواية في ظني، وهو ربما مجاز الأدب الرفيع كله. جميع المحكيات التي انعكست على مرآة هذه الرواية طالتها المذبحة، اعتُقل السكرتير (جيبيتو) المستعار من بينوكيو، اختفت الأرانب المتسللة من بلاد العجائب، احتُجِزت الطفلة (ألِيس هذا النص) في مركز التأهيل، اقتيدت الوراقة (ملكة ثلج بلاد العجائب) التي تبيع الكتب الممنوعة سراً للسجن، ووَضَع الرقيبُ (مونتياغ برادبري، وربما بينوكيو كارلو كولودي معاً) جسده في محرقة.
أي نصٍ اختبأ إذاً في غرفة “العيسى” لينجو؟ إنه نصٌ يسمى “حارس سطح العالم”، نجا لأنه، كالشاب الناجي في الحكاية، أدرك القانون الحاكم لإخفاقات سابقيه فخلق حلاً آخر، هو مدين فيه لجميع من سبقوه، هو جماعهم، هو خلاصة تجاربهم دون أن يكون شخصاً أخر غير نفسه، لينهض هذا النص كمحكيةٍ متسقة، تشبه نفسها.
بالآلية نفسها ستجد حكاية مثل “الليمونات الثلاث” امتدادها. ثمة ليمونات سحرية بكسرها تخرج فتيات جميلات عطشى، غير أن السهو عن تقديم الماء لهن يميتهن. ينسى بطل الحكاية النصيحة مرتين، محدقاً في الجمال، ويتداركها في الليمونة الأخيرة، فيشيح بوجهه مقدِّماً لصاحبتها الماء. الحكاية يسمعها الرقيب من السكرتير، وينفذ حكمتها حين ينتبه لجمال “الورّاقة”، التي تنتمي لـ”النوع الذي يهرب من جماله”. في هذه اللحظة يدير لها وجهه، لينقذها. ثمة أيضاً حكاية الملك الملعون الذي يحول كل ما تقع عليه عيناه إلى ذهب، حتى ابنته. حكايةٌ تعكس نفسها على أبٍ لعن ابنته بامتداد الرواية بتحويلها إلى معدنٍ نادر ولذلك منبوذ.
تُعمِّق لعبة المرايا فلسفتها بمحكياتٍ متقابلة من داخل الحبكة أيضاً، تعكس إحداها الأخرى. لا يختلف مأزق الرقيب كثيراً عن مأزق طفلته ابنة الخامسة. ليست وحدها المحبوسة في دولاب المخيلة لتمارس جنون التخييل بمنأى عن أعين السلطة/الأم ومن بعدها المدرسة. هو أيضاً محبوسٌ في دولاب المنطق، وبالتقدم في السرد سيملك دولابه النقيض، السري والمحرّم على الزوجة ومن بعدها الهيئة، بالضبط كدولاب الابنة، حيث يزج في عتمته بكائنات خياله: الكتب. الفارق بين الأب والابنة أن الخيال في حالته متجسدٌ في فعل “التدوين” الذي يترجمه الوجود المادي الصلب للكتاب، فيما لا تزال الطفلة تحيا حقبة “الشفاهة”. للسبب نفسه تتمتع الطفلة بحرية “التحريف”، حيث كل شفاهة، بالضرورة، تأويل، حذف وإضافة، فيما هو “يسترجع” إن أراد أن يبقى في الخيال. بينهما زوجة، تلخصها عبارة، هي قناعتها: “الواقعُ شيءٌ لا يمكن إزاحته، ولا بمليون كتاب”.
في تحولٍ تالٍ للعبة المرآة، لن يلبث ضلع الزوجة أن يخفت في المثلث السردي التأسيسي، ليحل محله ضلعٌ آخر، هو “السكرتير”. إنه عجوزٌ بما يجعله تمثيلاً لـ”الماضي”، ماضٍ تمثله حرفة منقرضة هي النجارة، وهو مستبعدٌ في الحاضر بما يجعله تمثيلاً بديهياً للمقاومة. هو نفسه سرطانٌ يرفع كلّابيه، وهو الرمز الذي تنثره المقاومة على حوائط الضواحي المتخففة من قبضة السلطة. عبْر الطفلة، إذ يحكي لها السكرتير الحكايات في مستودع كتب بهيئة الرقابة، (ولن يلبث أن يحكي الحكايات لأبيها نفسه، ليرده إلى طفولته) يكتشف الرقيب العالم السري للمدينة، حيث الكتب التي تنتظر الإعدام، في “مقبرة كتب منسية”، ثافونية، لن تلبث أن تحيل إلى “مكتبة بابل”، متاهية بورخيسية. بغياب السكرتير كضلع تحل “الوراقة”، انعكاساً جديداً له وتعويضاً للضلع المتحرك في ثالوث المحكية.
في جميع تلك التحوّلات، يتحوّل الرقيب لأداة إحالةٍ لا نهائية لنصوصٍ، ليس شرطاً أن ترد جميعها بالاسم، فلاوعي التخييل هو الشراكة الحقيقية بين نصوصٍ كالمرايا، و”الحكاية نفسها منذ الأزل وإلى الأبد، تُعيد ولادة نفسها كل يومٍ بتجليات جديدة”.
إلام يحيل ذلك؟ أن لغة الرقيب صارت نفسها لغة النصوص. إننا نستدعي اللغة، في الحياة اليومية، بشكل غريزي من حصيلتنا اللفظية التجريبية وليس من صياغاتنا القرائية. ليس بيننا من يُعبِّر عن خوف بعبارة مجتزأةٍ من رواية، أو يخوض مشاجرة بمقتبس من قصيدة، لكن الرقيب يفعل ذلك، وقد صارت خبرته التجريبية هي نفسها مرجعيته النصية، ما يعني أن الكتب أصبحت واقعه الوحيد، وهو يستدعيها بداهةً دون أن يكون مضطراً حتى لإيراد أسمائها أو سياقاتها التي اجتُزأت منها، كأنها صارت شفاهته.
(4)
يتوفر المتخيل في “حارس سطح العالم” على مزية فارقة، هي قدرته على تحويل نفسه لموجودٍ حسي.
الأرانب التي تملأ جنبات “هيئة الرقابة” لا تهبّ من الحديقة (تمثيل الواقع) مثلما يؤكد الرقباء (أبناء الواقع) بل من “بلاد العجائب” (تمثيل المخيلة). إنها تحتل جنبات هيئة الرقابة بالذات، التي منعت الكتاب، فانتقم عبرها بالتبرز في جميع جنباتها عبر صورته “الغريزية” التي تقدم بصقتها على آلة “الثقافة”. لذلك، وحده “السكرتير” (المنشق) من تقف عنده الأرانب وتسمح له بإطعامها، (تناول الطعام لدى السكرتير مقبل التغوط لدى الرقيب)، وحده “المستبعد” هو “بيتها”، وهو “المكان الذي تنتهي إليه الأرانب”. وللمفارقة، فإن أول كتاب يقرأه السكرتير في الزمن الروائي هو “ألِيس في بلاد العجائب بالذات”.
تؤرق المخيلة أنف الرقابة بفضلاتها، وهي الرائحة الوحيدة في مكانٍ لا يفرز أي رائحة، سواء على مستوى موجوداته أو مستخدميه. تخلق المخيلة “الحسي”، في أكثر مفارقات هذه الرواية فداحةً وذكاءً، حد أنها تشعل الرغبة في أوصال الرقيب تجاه زوجته كلما تذكر “زوربا”. بل إنها تذهب أبعد من ذلك حتى تغدو قادرة على بعث ذاتٍ إنسانية مكتملة، هي الطفلة: “لم يستطع منع نفسه من تخيَل ابنته تذرع ممرات الهيئة، مثل شخصية هاربة من كتابٍ مُصوّر”. الطفلة هاربةٌ كالأرانب من وسيطٍ آخر، وكل منهما يصفع الواقع بطريقته.. فالاستغراب من شكلها يكاد لا يختلف عن الاستغراب من حضور الأرانب، كلاهما عبر من ثقوب الإسفنجة متجسداً.
(5)
هل كان يجدر بالرقيب، أن يسرد نصه بالضمير الأول؟ أم أن هذا الإله كان بحاجةٍ لسارد عليم (رقيب أعلى) ينوب عنه بالضمير الثالث؟ نعم، كان بحاجةٍ إلى ذلك السارد العليم في ظني، ذلك أنه بهذه الطريقة، صار موضوعاً لقراءة ساردٍ خارجي، صار مادةً للتلقي، صار (بالضبط كالكتب) مرهوناً بقراءة شخصٍ آخر وبالتالي بتحققه عبر وعيٍ يتلقاه ليعيد إنتاجه. الرقيب العليم يتجول داخل وعي الرقيب الذي، بالكاد، يكتشف نفسه في زمن النص. يستبطنه، ويحلله، ويسمح لندفٍ من صوته الخاص بالتسلل عبر مونولوجات متسائلة بصيغة المخاطب، تكشف انقسامه إلى ذاتين، ليكشف عن صوته الخاص.
تتباين الصيغة الطباعية للحوار بين منحيين، أحدهما رأسي تُرص فيه الحواريات كعبارات متوالية، وآخر تترى فيه العبارات الحوارية متجاورة، سائلة، داخل المتن السردي دون فصل، حد التباس الضمائر. هذا “الشكل” هو نفسه “دلالة”، بين انفصالٍ، يسم الحوارية البراجماتية الغائية، واتصالٍ يؤكد حميمية الحوارية المتجانسة أو التي ينتمي طرفاها للخندق نفسه.
الرقيب، أو القارئ، مفتش المكتبة أو حارسها، يُشار له مع اقتراب نهاية الرواية ونهايته معاً بـ”الرجل”، كأنما استرد أخيراً قدراً من تمثُّله الإنساني. بالتقاطع، يسترد شيئاً آخر، إذ يطأ مكانَ حلمه، ليصبح الحلم هو الواقع والواقع هو الحلم. إنها ربما، مقولة الرواية الأعمق، وحيث كل حكاية، بتعبير البطل، ومن خلفه السارد، ومن خلفهما بثينة العيسى نفسها: “عملية استعادة لحكايات كتبت، واستدعاء لحكايات لم تكتب”.
سيعاقبُ جميع الحالمين في هذه الرواية. ليس من نهايةٍ سعيدة لمن تمناها، لكن ثمة عزاء لمن يقبل العزاء: أننا كنا في الحكاية لا الحياة، حيث لا ذوات بل “شخصيات”، قابلةً دائماً لأن تُبعث من رمادها، ففي أرض المُخيّلة لا مكان للمقبرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*نقلاً عن موقع ضفة ثالثة