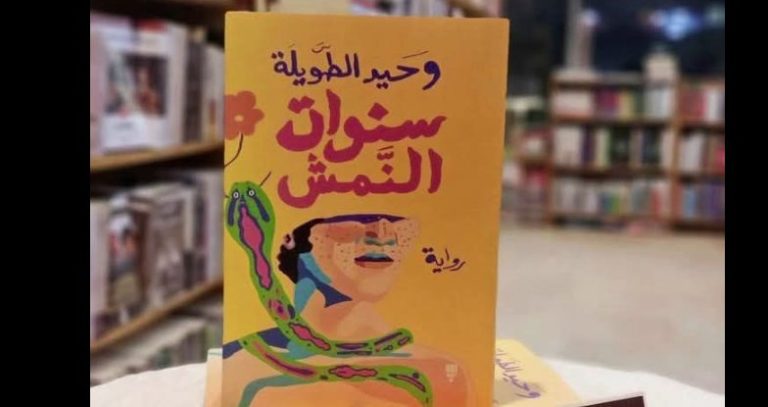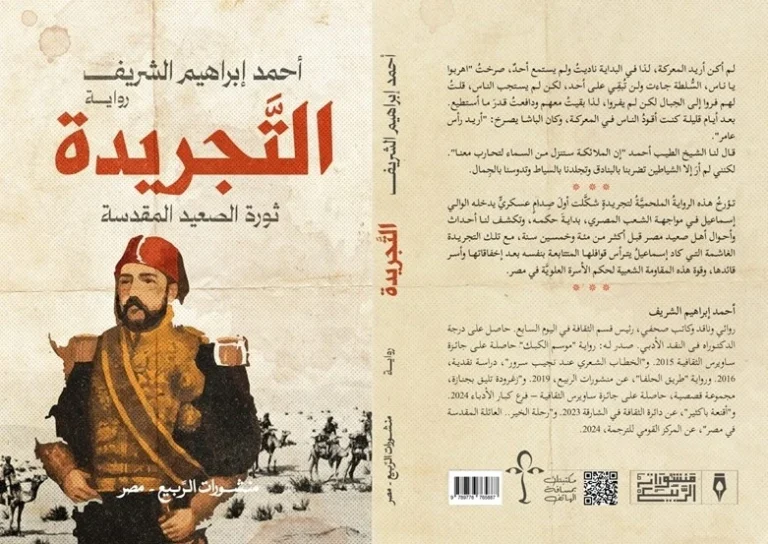شوقى عبد الحميد يحيى
من الأسباب العديدة التى جعلت من الرواية “ديوان العصر” أنها تُسجل حياة البشر، وعلاقتهم بالسلطة، وهى الحركة الأهم فى حياة الإنسان فى أى مكان الآن. فالمتابع للرواية الحالية، خاصة فى مجتمعاتنا العربية، سيلحظ أنها تتحدث –كلها تقريبا- عن الهم العام، وتأثيره على الهم الخاص، بعد أن طالت أزمنة كبت الحريات، وانسحاق الفرد تحت سطوة السلطات الحاكمة من جانب، والنسق الثقافى الممتد عبر أجيال وأجيال، مكبلا لانطلاقة الفرد نحو التفتح والانطلاق، ليثبت ذاته، ومن ثم يُبدع، يبتكر، ويُصبح مسؤلا عن أفعاله. فضلا عن محاولات التوافق مع الأوضاع المجتمعية، ليثور التساؤل، هل المواطن هنا مُدان على أنه متواطئ، ام أنه ضحية السُلطات صاحبة السلطة، والسلطان؟. ذلك ما يمكن أن نعيشه فى رواية “جنازة جديدة لعماد حمدى”[1] للمبدع المهروس وسط الناس، والمُتشرب لحياتهم، والمتأمل فى كيفية معيشتهم، وحيد الطويلة، الذى نستطيع أن نجد تلك الهموم فى كل رواياته، وليست فى هذه وحدها. وإن كان فى هذه الرواية قد تخير عنوانا يجذب الكثير من القراء، لشيوع اسم “عماد حمدى”، الممثل القدير، كما يخبئ للقارى المدقق، خلف الاسم، عوالم كثيرة تستدعى حياة “عماد حمدى” وعالمه الفنى الواسع، خاصة أنه أحد أعمدة فن التمثيل، فى زمن كان للفن فيه دور كبير، والذى تشير حياته إلى أنه اصيب بالعمى التام، وتدهورت حالته النفسية، بعد موت توأمه، وبعد أن كان فتى الشاشة الأول. وهى النهاية التى تصف المجتمع المصرى، بعد ثورة حملت الأمل والفرحة للناس. ولنتأمل عملية التحول من التألق والإبداع، إلى فقد العلاقة – المباشرة- مع المجتمع من حوله، والتقوقع مع الحسرة، والخيبة، فكانت الحياة الخاصة مشيرا إلى الحياة العامة للمجتمع. غير أن الكاتب تخير مشهدا معيننا لذلك الفنان، فى فيلم “ثرثرة فوق النيل” والذى بدوره يستدعى زمنا، أصابت المجتمعات العربية – لا مصر وحدها- بالكثير من الياس وخيبة الأمل، والثورة على الأوضاع، وإن كانت نسبة كبيرة قد هجرت الحياة، معنويا، او بالموت، بالخسارة الفاضحة أمام العدو التقليدى، إسرائيل، فى العام 1967، فقالت الرواية {تفاجئك على الحائط صورة عماد حمدي وهو يحمل الجوزة، يدخن بشراهة والدخان يندفع من أنفه في فيلم ثرثرة فوق النيل، الصورة التي تشبه نهايته رغم آلاف الصور، تبتسم له كأنه أمامك وتدعو له بالرحمة}ً. وهى الفقرة التى تضع القارئ فى بؤرة الرواية، وكأنها تُحيل إلى، لا الزمن فحسب، وإنما إلى الأجواء التى تضعنا –كقراء- فى نفس الظرف النفسى، المنبثق من رؤية الهم العام، والمؤثر بالضرورة على منهج حياة الأفراد فيه، وكأن الزمن لم يتغير، او كأننا نعيش نفس الحالة التى أداها عماد حمدى، كأبرع ما يكون الأداء، فى الفيلم المشار إليه، الضياع، والامبالاة، ومحاولة النسيان. ولكن الظرف التاريخى، الذى كتبت فيه الرواية”جنازة جديدة لعماد حمدى”، يفرض نفسه، فإذا كانت الرواية قد صدرت فى العام 2019، أى أنها كُتبت قبل هذا التاريخ، بعام أو عامين على الأقل، حتى أن الأمور –فى مصر- كانت قد استقرت، وعرفت البلاد أنها قد تجاوزت مرحلة الثورة التى حدثت فى يناير 2011، والتى قامت بالأساس، كاحتجاج على تجوزات الشرطة، خاصة إذا ما تذكرنا ما وقع للبوعزيزى فى تونس، ولخالد سعيد فى مصر، مفجرا تلك الثورات، المتقاربة فى الزمن – تونس فى 17 ديسمبر 2010، ومصر فى 25 يناير 2011- والمتشابهة فى الوقع. حيث كانت الشرطة وغضب الشعب عليها فى كلا البلدين، فما كان من وحيد الطويلة، الذى يعيش بين الناس، ويلتقط أنفاسهم، إلا ان يسجل ذلك الغضب المكنون داخل النفوس، وكأنه يعيش واقعه، وكأن الزمن لم يبرح مكانه. خاصة أنه لم يكن استدعاء “عماد حمدى” هو فقط الذى يجعلنا نعيش فى تلك الأجواء النفسية، وإنما أيضا (جنازة جديدة”، وكأننا نخرج من الماضى، تلك الجنازة التى كانت، لنقيم جنازة جديدة، وكأن “عماد حمدى، ودوره فى رائعة نجيب محفوظ “ثرثرة فوق النيل”، لا يزال حيا بيننا، واليوم فقط توفاه الله. فالعنوان الذى اختاره الكاتب بعناية فائقة، ينقلنا من الزمن الحاضر، لنعيش أجواء الزمن الماضى، فلا أيام مرت ولا سنوات.
إلا أن العنوان وحده لم يكن هو المفجر لتلك الأحاسيس، وما إختاره الكاتب من النماذج المحركة للمشاعر- وفقا للدور الحقيقى للعمل الإبداعى عامة- وإن كانت تلك النماذج من الكثرة التى توحى بالتجميع، والعمل الجاد من قبل الكاتب، إلا ان ما يملكه من قدرة على جذب القارئ للمشاهدة، بما صنعه من حركة وفيضان وتدفق فى السرد، لم يترك للقارئ فرصة التنصل قبل الانتهاء من صفحات الرواية، التى يأسف –بالتأكيد- لأنها انتهت، وكانه- القارئ-يعيش حالة من التشفى، أو الثورة الصامتة. إلى جانب تلك المعايشة التى يشعر بها القارئ، قبل أن يصل إلى نهاية الرواية، ويكتشف ان الكاتب كتبها فى المقاهى العديدة، ورصدها كما لو أنها مراجعه فى جمع مادته. فنشعر وكأن شعار الشرطة-الذى كان- (الشرطة فى خدمة الشعب) قد تغير وأصبح (الشعب فى خدمة الشرطة). حيث نجد أن كل طوائف الشعب قد تحولت إلى الارتماء فى أحضان السلطة، المتمثلة فى الشعب، حتى بات حلم الإلتحاق بالشرطة، أمنية العديد من أفراد الشعب، حتى ذلك الأب “اللواء” قد أصر على إلتحاق أبنائه بالشرطة، فهرب الإبن الكبير إلى خارج البلاد، ولم يعد أمامه إلا الإبن الثانى، رغم أنه لا يرحب بذلك، ولكنها أوامر اللواء، فهذا الإبن فنان تشكيلى، يحب الفن، بجماله وحساسيته، وحبه للحرية. فهو يخاطب نفسه {تُكلِم نفسك، الكره لا يليق بك يا مولانا، لكنك تمقُتْ أكثر ما تمقُت أن تكون تابعًا، دخولك لهذه الوظيفة وانسياقك، رغما عن أنفك جعلك تكره فكرة التابع، صارت ردود فعلك عنيفة على غير عادتك وتكوينك، كأنك تردُّ على انجرارك ككلب أعمى وراء رغبات أبيك، والأمر على رغبات محيطك ولمعة عيونهم، يحبون الضابط أكثر من الفنان، يُقدسون الضابط ويهزأون بالفن كله، حتى لو تَسمَّروا ساعات أمامه}. فإن تأمل جملة { صارت ردود فعلك عنيفة على غير عادتك وتكوينك} ستأكد إختيار الكاتب لكلماته وفقراته، حيث تفتح هذه الجملة العابرة وسط غيرها، تفتح آفاق تاثير المجتمع، والبيئة المحيطة، على سلوك الفرد، حتى لو كانت علا خلاف لما هو عليه من تكوين وطبيعة شخصية. فالنان – بطبعه- يميل إلى الهدوء والتأمل، بينما فى الشرطة، بحكم تعاملها مع الخرجين، تميل إلى العنف، والحدة فى التعامل، ومن هنا يأتى التناقض، والاقتناع بأن هذا الضابط استثناء، أو أنه فى غير موضعه. فنحن إذا وعضنا نقطة من الزيت مثلا،على جردل من الماء، فغن الزيت لا يندمج فى الماء، ويظل أعماقه محتفظة بطبيعتها، غير أنه يظل يشعر أنه فى بيئة لاتناسبه. وهو الأمر الذى يضع أولياء الأمور عند جنايتهم عندما يُصرون على إرتداء أبنائهم، البدلة الميرى.
فيخبر الأب الضابط الكبير الذى هرب أحد أبنائه من الجندية إلى الخارج ولم يبق سوى خريج المدارس الفرنسية ليزرع فى وجدانه: لو ترك أبناء الضباط المهنة للرعاع سيتسلل الأوباش إلى حياتنا ولن نستطيع أن نعيش، ثم إنَّ الزمن القادم زمن الضباط، وأنا أعرف أكثر منك. غير أن الإبن يهوى الفن، فيحتد عليه الأب “اللواء” عليه، ويامره بالانعزال عن “الرعاع” {حتى في المصيف؟
ـ وفي الحمَّام إنْ أمكن، الجرابيع في المصايف الأخرى، وحذار أن تتهور ويعرف أحد أنك زِفْت، رسَّام}. حيث يحدد هذا الحوار القصير، رؤية الضابط للمدنى، وهى الرؤية التى انعكست على امجتمع عامة، وكان من نتيجتها، ما حدث فى 1967، وما حدث فى يناير 2011.
وإزاء تلك الصورة التى انطبعت فى أذهان العامة عن الشرطة {ليس هناك ضابط يرسم، إلا إذا كان يرسم على النسوان}. ولما عرف الجميع، خاصة فى الشرطة، أصبح للضابط الفنان، اسم يجمع بين الفن والجنون “فجنون” واصبح هو اسم الشهرة له، فهو يُعتبر فى نظر الشرطة مجنونا { اسم سعادتك فجنون باشا”.لَقَب لم تَخْتَرْه، ووظيفة لم تَخْتَرْها. فن وجنون}.
وأمام تلك الصورة، تم خروجه من الشرطة بعد أن تصيدوا له مكيدة، هم من زرعوها فى عقيدته، الاتصال بمسجل خطر. فعندما واجهوه بتلك التهمة، اخبرهم بأنها تعليمات من هم أعلى منه رتبة، فطالبوه بالإتيان بها.. غير أنها لم تكن إلا (شفوية) { أنت متهم بإقامة علاقة مع مسجل خطر. كانت أول جملة وجهَّهَا لك مُحَقق أعلى منك رتبة. فكان رده:
{هذا المُسَجَّل لا ذنب له ولا ذنب لي، كل ما في الأمر أن الأوامر كانت صريحة أن أقابله”.
“لماذا؟ وما هي الأوامر التي كانت موجهة لك؟”
“يا باشا، هذا الرجل هو المصنف رقم واحد في عالم المرشدين، وهو مُسَجَّل خطر عتيد، عنده كتالوج كل المجرمين والمنطقة كلها، وهو قبل ذلك مرشد الحكومة، يعرف مواعيد ولادة النساءة وأحيا نا ميعاد الحمل”.
“نعم! حمل وولادة، انتبه لما تقول”.
“ما أقصده، أن له سلطة وقيمة بين أبناء المنطقة، صاحب مقام كبير بينهم، ومن الآخر يستطيع أن يجمعهم خلفه بالرضا أو الإجبار.
“زعيم تقصد؟”
“نعم “أن أجلس معه في قهوته وسط ناسه لتزيد مكانته بينهم، أستميله، أضغط عليه من طرف واضح أو خفي لصف المرشح الذي اختارته الحكومة وأمن الدولة في انتخابات البرلمان بعد أن أصبح عظمة كبيرة واسمًا كالأسطورة}.
و{بعد أسبوع كنتُ خارج البوليس}. ليخاطب نفسه بعد التقاعد {فقعتك الحكومة الخابور رغم أنك ابنها حبيبها، ساعتها فقط اكتشفتَ أنها عقيمة لا تنجب وحتى إن أنجبت فلا تعترف بغير أولاد الحرام، ليست حبيبة أحد ولا حتى حبيبة نفسها، وسكينها حاضرة وإن أخفتها، وراء ظهرها أو ظهرك}. وليصبح هذا المسجل الخطر “ناجح” والذى اُشتهر بالسم “دكتور ناجح” هو سيد المنطقة، والمهيمن على كل الخطرين بها، خاصة ابنه الذى اشتُهر أيضا باسم “هوجان” هو الذى مات، دون أن يعرف والده، أو القارئ، من وراء موته، وهو الذى يقام له الصوان الآن والفجنون، يقف فى حيرة من أمره، أيذهب إلى الصوان للعزاء، أم لا. ويظل مترددا لا يدخله إلا فى آخر الرواية، فيقابل كضابط خارج الخدمة، فلا يقوم له أحد، ويعامل معاملة الفرد العادى. غير أنه يجد صوانا يليق بزعيم المنطقة، وحاميها، وصديق البوليس{العزاء ما زال في نصفه الأول، ليس هناك مكان شاغر، والليل طويل. سرادق مهول، عزاء كبير المنطقة، لكن ناجح ليس كأي كبير، هو كبير الحاضرين والغائبين والذين يحلمون، العاشقين والطامحين وأولي العزم من النشالين، صبيان المخدرات وحريفة البانجو، والذين يحملون مشارط في جيوبهم الخلفية، والذين يدفنون الأمواس بين اللثة والشفاه .وربما جاء بعضهم ليتفرج عليه في أصعب موقف قلب حياته بأكملها، وربما دمرها كلها بضربة واحدة ستقضي عليه}.
ولم يكن “ناجح” –الذى له من اسمه نصيب كبير- لم يكن يعمل بالطبع وحده، فقد كان وراءه العديد من الأشخاص، حين إلتحاقهم “كمرشدين” للسطلة، أو يعلم مدى علاقتهم بها، زمنهم:
أبو شمس: {لكن لكل كبير أعداء حتى ولو كان رئيس جمهورية المسجلين، هكذا تقضي حكمة الأيام والزمن هو اللاعب الأكبر لا يترك أحداً دون أن يبيض عليه، ظهر أبو شمس في المنطقة فجأة، راحت شمسه تطلع ليل نهار، تاجر مخدرات قديم من أيام عز الباطنية}.
أسعد قشطة: {لص ثقافة من طراز فريد، حين يواجهه أحدهم بذلك يقول ما سمعه أيضا منهم: عبد الحليم حافظ كان لص ثقافة، لم يكن مثقفا من قريب أو بعيد، لكنه شرب من صلاح جاهين وإحسان عبد القدوس وغيرهما طوال الوقت، تعلم منهم ونجح أكثر منهم وأنتم فقط من تتهمونه بترديد هذه الأقاويل}.
خنوفة: أقرب خُدّام الدكتور ناجح، وطوع أمره.
شحتة: القادم من الصعيد.. وادمن حرفة السجن بدلا من المستحقين.
مدام شمة: المرأة التي تبيع البودرة في عبوات صغيرة جدا، مدام شمة، اسمها هكذا، مناسب تماما لعملها، لا تعرف أيهما اكتسب صفته من الآخر.
دنيا: المرأة التى انتهكها خالها وهى صغير، فهربت للقاهرة وعملت فى البغاء.
عماد والألتراس: { المشكلة أن هؤلاء الأولاد الجدد في الكار بدأت السياسة تجرفهم، ولا بد من السيطرة عليهم وهذا مستحيل، لكن وجود عماد وفريقه يستطيع أن يعرف النوايا والاتجاهات، وهو ما يجب أن نحصل عليه ونقدمه للبوليس الذي سيدخل على الخط بكل قوة، وقد يحصل عليه من أحد غيرنا}.
ومن خلال كل أؤلئك كانت الشرطة تواصل عملها، وكأنهم من أفرادها.. حتى خصصت مرتبات للكثير منهم.
ففى المواصلات، عُرف من اشتهر باسم “خالد إركب” {مرة قال ضابط يفتي في كل شيء: إنهم ينقلون نصف ركاب القاهرة ومن حق السائقين أن يشعروا بالزهو، عرفت فيما بعد أن هذا الضابط لديه سيارتان تعملان على أحد الخطوط، تناوب على قيادتها أحياناً أمناء شرطة يعملون لزيادة دخلهم، لا تدفع مخالفات ولا يوقفها أحد مهما ارتكبت من أخطاء، قال آخر: إنها لعبة القوة، من يملكها ينتصر ويدوس القانون، من الأصغر حتى الراس الكبيرة قانون واحد}.
والمسجلون فى الانتخابات {أغمض هوجان عينا عن اللصوص وأبقى الأخرى مفتوحة، المرحلة القادمة تحتاج لهذا الفريق القادر على تجريس أي مرشح أو مرشحة وسحقه بكل الوسائل ولو وصل الأمر لتقطيع ملابسه الداخلية}.
و فى المرور، حيث مواكب الزوار بالساعات، تنغلق المدينة على نفسها، لا تعرف إلى أين تمضي، كأننا في بيت جحا، في ساقية العفريت، مدينة مقفلة أخذ مدير المرور مفتاحها معه إلى أن يطمئن أن الضيف غسل أسنانه ودخل مخدعه.
وفى المباحث وعند أية مأمورية يحط أمناء المباحث على موقف السيارات، في لمح البصر يأخذون أول سيارة عليها الدور، لنصف يوم، ليومين، وأحياناً أسبوع، لا أحد يجرؤ أن يفتح فمه، نداء الوطن، يقوم شيخ الموقف من نفسه باقتطاع أجرتها من السيارات الأخرى التي تعمل ليعطيها للسائق حين عودته.
التقنية الروائية
استخدام الضمائر
يعتبر وحيد الطويلة أحد أهم من استخدوا الضمائر فى أعمالهم. فلم يأت ضمير فى غير محله، بل كانت له ضرورة فنية فى استخدام هذا الضمير تحديدا.. حيث استعمل ضمير المخاطب عندما يتحدث الضابط (السابق). اولا لأنه اصبح خارج الخدمة، فيتحدث عن أشياء يراها، لا تجارب عاشها، وهو الأمر الذى يصنع الفارق بين الضابط، وافنسان العادى خارج الشرطة، وكأنها طبقة مختلفة عن باقى الشعب. فاستخدام هذا الضمير يخلق المسافة بين الراوى والمشاهد. وثانيا لأن ضمير المخاطب، يصنع تواصلا بين المتحدث والقارئ، حيث تضع كل منهما فى المواجهة، وكأن المتحدث يوجه خطابه إلى القارئ مباشرة، ودون مواربه، كما تعتبر جمله كلها تقريرية، أو مباشرة، أو إخبارية، وكأنه يقول للقارئ، هذه حقائق وليست إدعاء، اقول لك معلومة وليست رأيا، فلا تحتاج إلى تأويل. حتى وإن حاول –الكاتب- فى نهاية الرواية، بتلك الحيل الفنية أن يتنصل من ذلك، وليوقع القارئ فى دوامة التفكير، وكأنه يلعب معه لعبة القط والفأر، حيث يتدخل كثيرا بالحديث المباشر للقارئ، وكانه شاعر الربابة فى الجرن، فنراه يقول {صدقني، وأنت حر طبعا،ً ربما لم يحدث كل ما سبق، وربما حدث}، خاصة بعد أن سبق فى بدايات الرواية قائلا:
{احترس أيها القارئ.
قف مكانك.
ثِبتْ قدميك في الأرض جيداً، اِسحَب نفسا عميقا،ً املأ رئتيك عن آخرهما كما يفعل الهنود حين يأخذون أنفاسا طويلة كي تعمل المناطق النائمة غير المستعملة في رئاتهم. الأمر يستحق، أنت مُقدِ م على تجربة تستحق المخاطرة، لن تتكرر في حياتك}. وكأن الكاتب يقول للقارئ، معك كل الحق فى أن تقوم بما قمت به. حتى لو جاءت الرسالة متأخرة بعض الوقت، لكنها تظل درسا للتاريخ، او انتبه أيها القارئ، وخذ حذرك.
أما الضمير الآخر فهو ضمير المتكلم، وهو ما يُمكّن الشخصية من إخراج ما يعتمل بداخلها، وتتضح بصورة أكبر، فى الأوقات التى يتحدث فيها “ناجح” مع نفسه، ويناقشها، بحثا عن من يمكن أن يكون قاتل ابنه، او انهيار مملكته، فيصبح استخدام الضمير هنا أقرب إلى البوح، أو الحديث مع النفس، ولا يريد مستخدمه أن يسمعه أحد. ولنصبح هنا أمام مواجهة بين الشخصيتين الأوليين فى العمل، فيتحدث الضابط الفنان، وكأنه يقذف بحديثه إلى داخل المسجل خطر الأول “ناجح”، وكانه يخبره بأن اللعبة قد أصبحت على المكشوف، ولم تعد مستترا مثلما كنتَ، وتدور طواحين-ناجح- لهضم التجربة بكاملها فى الداخل، ويبحث عن حيل أخرى ليستمر بها ناجح، كما هو، أو ان المملكة قد انهارت. ولكن المعادلة تظل كما هى، فهى عقيدة، ودستور، أن يظل الضابط فاعلا، والمسجل مفعول به. لكن قول صلاح عبد الصبور فى إحدى مسرحياته، يظل باقيا { ومن يربط الكلب العقور ببابه، فكل بلاء الناس من رابط الكلب}. وهو ما تؤكده الرواية فى {لعلك وعيت الآن جيداً بعد دهر ونهر، ما الذي يريده الناس بتزلفهم للسلطة، كيف يتسلقونها وينجحون!، كنت دائما تصد هؤلاء الساقطين عشقا وهياما بها، لم يدخلوها صدفة، لم تتعب مراكبهم ولا خشوا الغرق} وكان ذلك غاية ما يتمناه أؤلئك المرشدون، فهم بشر من بين البشر الطامع دوما للسلطة، تحقيقا لغرض فى أنفسهم، وتحقيقا لرغبة علو القدر بالتسيد على غيرهم، وهو ما تؤكده الرواية {ليس طامحا لسلطة، أية سلطة وإن لم يخل الأمر أحيانا من حسرة على لسانه، ورغم أنك تعرف أن الناس تكره البوليس أكثر من المجرمين، إلا أنهم يتمسحون بالسلطة بل يقفزون في قلبها إن واتتهم فرصة بل نصف فرصة}. ولتظل الشرطة مطمعا للكثيرين، رغم علهم بما فيها، غلا انها رغبة تُغلف الرغبة فى السلطة والتسيد، فلم يكن أة من هؤلاء المرشدين إلا {مثله مثل معظم الطلاب في بلادنا، يفكرون أول ما يفكرون في دخول كلية الشرطة، إرث قاس تستطيع أن تعرفه بسهولة من أعداد الطلاب الملطوعين أمام بوابات التقديم، أهاليهم تتملكهم نفس اللهفة، ورغم أن العالم اتسع إلا أن لعاب الناس مازال يسيل مدراراً أمامها}.
كما كان رسم الشخصية الأولى “فجنون” رائعا، عندما دخل البوليس على غير إرادته، لأن ذلك منحه الفرصة، والموضوعية، أن يبوح بكل دواخلها، حيث يعتبر هو السارد فى الرواية. فضلا عن اختيار حبه للفن، وللفنون التشكيلية تحديدا أى انه متخصص فى رسم الشخصيات، فأضفى عليها الكثير من أساليب الإبداع السردى، والكثير من الوصف المنحوت من داخل الشخصية، وهو ما اكده بذاته حين التقى صديقه الفنان صاحب الصوت الجيد{ حين رأى رسومك راح يضحك من قلبه: لماذا رسمتَ كل الوجوه حادة؟ حاذر أن يراك أحدهم”.
تضحك، يتوقف عند صورة جماعيَّة بوجوه وبطون ومؤخرات منتفخة، تعلو صيحته:
العسكرية الوارمة؟
قلتُ: “كنتُ أحاول أن اصطاد الروح}.
التشويق
إلى جانب اللغة العادية جدا، والتى تميز بها الكاتب، والتى تبدو كما لو أن الكاتب يجلس على المقهى، ويتندر بين أصدقائه، الأمر الذى يمسك بتلابيب القارئ، الذى يحب الحكايات، ويستهويه البساطة فى اللغة. وإلى جانب اللغة المستعارة من ذلك العالم الخفى المعلوم، والتى تشير ببحث الكاتب بين تلك الطبقات ومعايشتها، فضلا عن تلك الثقافة الفنية التى تنضح بها الرواية، فقد استخدم الكاتب- ايضا- سياسة التشويق التى تجعل القارئ متمسك بالمتابعة، لمعرفة مصير الشخوص. فمثلا بدأت الرواية بوقوف الضابط المثقف، والفنان، عند التفكير فى الذهاب لعزاء ابن أكبر المرشدين، او أكبر المسجلين خطر، ثم انصرف السرد يمينا ويسارا، شمالا وجنوبا، ولكنا لم نعلم قرار الضابط بالذهاب من عدمه، إلى ان وجدناه داخل صوان العزاء فى نهايات الرواية، والقارئ يتحرق لمعرفة القرار الذى سيتخذه. بينما يواصل ذكرياته التى يخاطب بها نفسه {تقوم من مقعدك ثانية، تقف أمام صورة عماد حمدي وتقول بصوت تكاد تسمعه:
“لا بد من جنازة أخرى لعماد حمدي}.” وإن كان يعنى عماد قائد الألتراس، بينما أنت موقن أنه يعنى عماد حمدى الأصل، لا الصورة.
كذلك ظل الضابط “فجنون” يتحدث عن الشرطة، وكأنه داخلها، ولم نتعرف أنه قد تم إحالته للمعاش، بعد أن كان قد تم التحقيق معه إلا فى نهاية الرواية أيضا، ليعترف فى مرارة {تقدم ليخدمك حتى لو كان يخدم نفسه، وأنت تقدمت لتخدم الحكومة حتى لو كنت تمارس عملك، وهي من أعطتك الخازوق المتين، دسته لك في وضح النهار وباعتك، أمسكتك متلبسا بالبضاعة رغم أنها صاحبة البضاعة}.
كما دارت الرواية من البداية حول جنازة “هوجان” أو ابن المسجل خطر.. ولم نتعرف على القاتل رغم انتهاء الرواية، ليترك الكاتب الأمر مفتوحا، وكأن شيئا لم يتغير، فما زالت الأمور تحدث، ومازالت الحالة النفسية، لم تغادر. فقال “فنجون” {مخطئ من يتخيل أن المسجلين لا يحبون الحكومة، هم يعرفون نظرية المقص جيداً، إذا ما انفتح وجرح رؤوسا ستعود أطرافه لتتجاور، ولو بمسافة، كلاهما يحتاج الآخر مع أن كل طرف ينظر في طرف آخر}.
السخرية
من الأمور التى يمكن متابعتها فى كل أعمال وحيد الطويلة، تلك السخرية التى يطلقها ابن البلد فى جلسة بين الصحاب، يضحك الآخرون، بينما هو لا يضحك، وكأنه يتحدث بكل الجدية، وكأننا نستحضر قول أبو الطيب المتنبى حين قال:
(ضحكت فصرت مع القوم أبكي وتبكي علينا عيون السماء وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء). فنراه يسخر من ناجح، وتمسحه بالشيوخ والأديان، مثلما يفعل الكثيرون عندما يسعون للتقرب من الناس، باستخدام الدين الذى يقفون أمامه مستسلمين {إذا كنت تتوهم أن المسجلين خطراً بلا شيوخ فأنت واهم، جديد في الكار، ناجح نفسه طبع كروتا كتب عليها: الشريف ناجح وعندما أخطأ البعض ونادوه باسم شريف أو المعلم شريف قام بتغييرها بنصيحة من مستشاره الثقافي لشئون حشيش الأناقة وكتب: ناجح، من الأشراف. لا تعرف هذا الهوس الذي ضرب مخ الناس- أي مهبول أو واحد مسه شيطانه أو من معه قرشان- ليدعي أنه من الأشراف، حين يصادفك يخرج لك ورقة مثقوبة في مواضع كثيرة، مهترئة توحي بالقدم، تؤكد على نسله حتى النبي أو أبو طالب، ولا يمتد أحد لأبو جهل أبداً رغم كل هذا السواد}. وإذا كانت دولة الإخوان قد قامت بعد تلك الثورة التى زرعت الأمل فى النفوس، فإنهم (الإخوان) لم يسلموا من سخرية الكاتب، وما يتشدقون به، أو يحولون به خداع الناس وصرفهم عن الغرض الأساسي، الذى يتسلحون به، فنراه بعد جلسة حشيش {بعد أول عشرة أحجار يترنم أحدهم:
الحمد لله الذي جعل الحشيش لنا خير قوت، وجعل النار من حوله كالزمرد والياقوت.
ويرد آخر: عن أبي موتسيان الذي داخت المباحث خلفه: اللهم ارزق الحشاشين والحشاشات، الأحياء منهم والأموات، المسجونين منهم والمسجونات، وامنع عنهم رجال المباحث والشبهات، وارزقهم بجوزة لطيفة وقعدة خفيفة، إنك سميع مجيب الدعوات، ثم يطلع بصوت جهوري: إخوتي الحشاشين، أقيموا الحشيش}.
الجمهوريات الثلاث
وإذا كان الضابط الفنان “فجنون” قد كشف لعبة البوليس، بأنها من أوزعت إليه بالصداقة مع “ناجح”، فإن ابن ناجح –أيضا- لعب ذات اللعبة مع أبناء الكار معه، ليقنعهم ، بأنه هو المخلص، وعلاقاته واسعة، حيث إن الأولاد الذين يمشون خلف عماد صاروا يسمون أنفسهم ألتراس “هوجان”، هو من فك قيودهم من البوليس بعد أن أبلغ عنهم دون أن يعرفوا. قرصة أذن من معلم، أطلق عليهم ضابطا،ً ثم عاد وتدخل بنفسه للإفراج عنهم، فيضمن ولاءهم له، وانقيادهم وراءه. لنصبح أمام ثلاث من الاتجاهات، المتعاونىن، بهدف واحد، وإن اختلفت الأغراض: الضابط، والمرشد والغاوى. وما يمكن تسميتهما بالجمهوريات الثلاث، فالمصلحة واحدة، وإن اختلفت الأهداف. فالضابط يريد أن يربح القضية، وعبقرينو يريد أن يحقق حلمه الشخصى، وناجح قضيته الزعامة، على طريقته. حيث كان عبقرينو هو حلال القضايا بالنسبة للبوليس، لا يطمع فى مال أو زعامة، فقط أن يحقق حلمه الذى فشل فى تحقيقه، دخول كلية الشرطة. و الثلاثة، يسعون، كل إلى مصلحته الشخصية. ويستخدمون نفس الأسلحة. حتى قال الفنان أن الله قد خلق الناس ذكوراً وإناثا،ً لكن الناس حولوها إلى ذكور وإناث ومرشدين للحكومة. ومرشدات أيضا.
عالم مزدوج ، عاشه وتعيشه السلطة الظاهرة، وازدواجية لا تتناسب وشفافية الفنان، الذى يرى الحياة اتجاه واحد، ورؤية جمالية ، خالية من المؤامرات والسعى لتحقيق المآرب. فكان حتما أن يهرب منه “فجنون”، أو أن تؤدى تلك الحياة إلى طرده من جنتها، ليوجه له وحيد الطويلة، عبر روايته الشديدة الإبداع، حتى وإن كانت “جنازة جديدة لعماد حمدى”، يدعوه فيها إلى {ومنهم من يريد أن يحقق القصص البوليسية التي قرأها في الواقع، أكثرهم صياحا هؤلاء الذين دخلوا الكلية بمجموع خمسين بالمائة. هؤلاء حياتهم وراءهم، وأنت حياتك أمامك. امسك ريشتك، هي سلاحك وريشتك، اصنع حياتك أنت.
اصنع حياتك بيدك وإن لم تستطع فأنت أحببت وحاولت، وعلى الأقل اصنع جنازتك. اصنعها بالألوان}. حيث يؤكد أن الشرطة مثلها مثل غيرها، ولا يجد الإنسان نفسه، إلا وفق ما اختاره لنفسه، ولتظل الحرية، هى أغلى ما يطمح إليه الإنسان.
………………………..
[1] – وحيد الطويلة – جنازة جديدة لعماد حمدى- دار الشروق- ط1 2019.