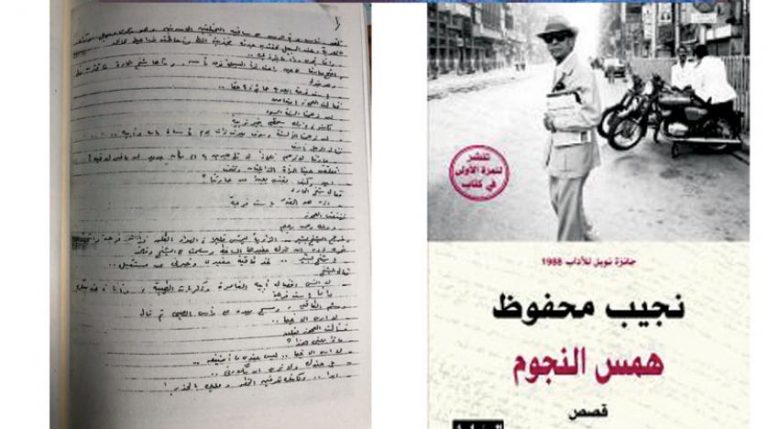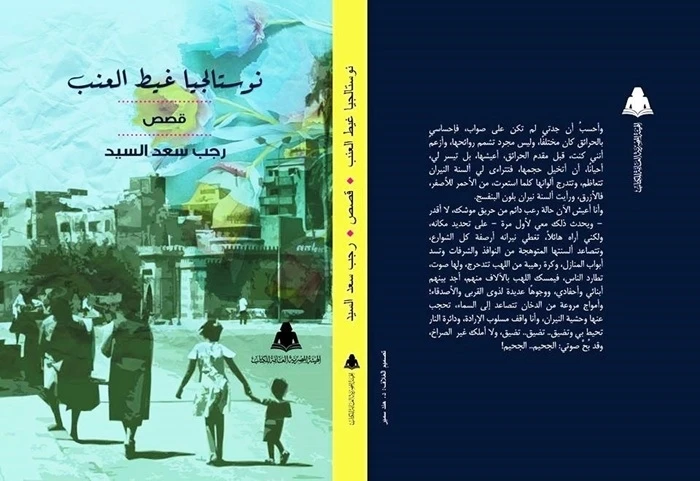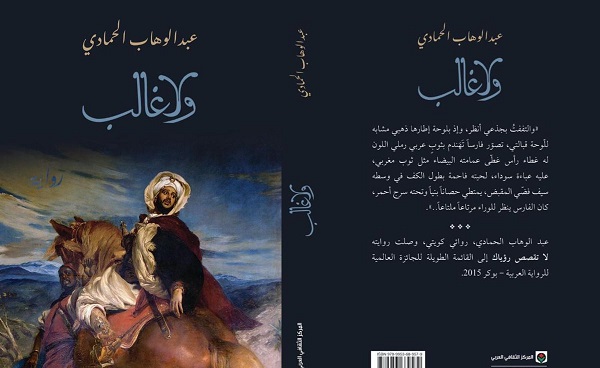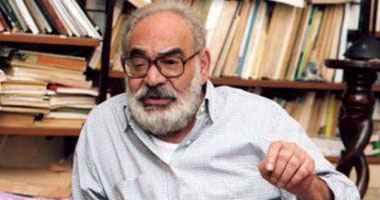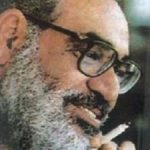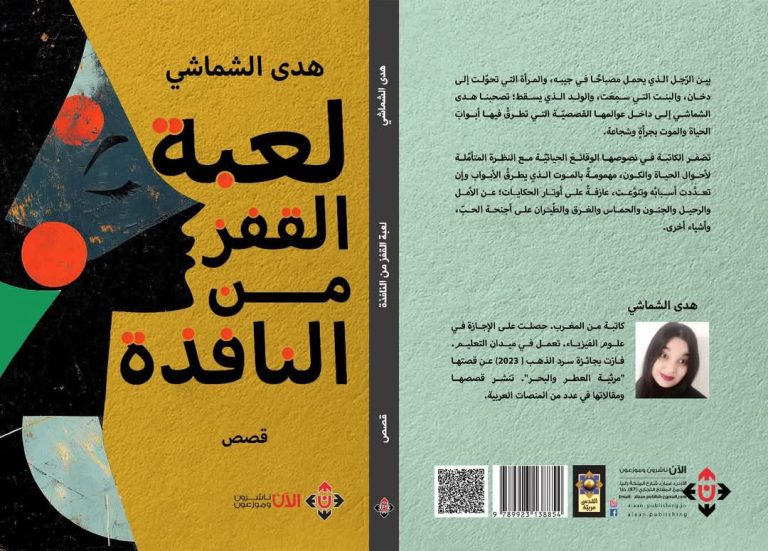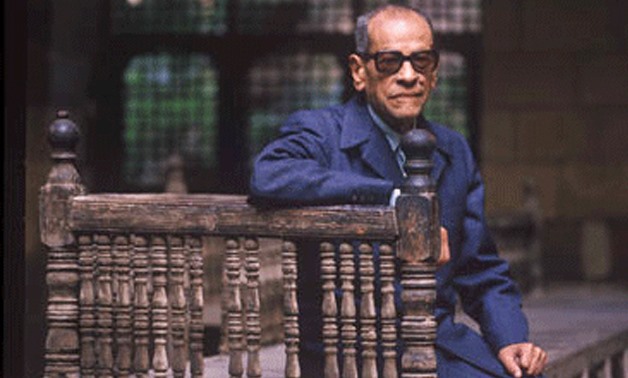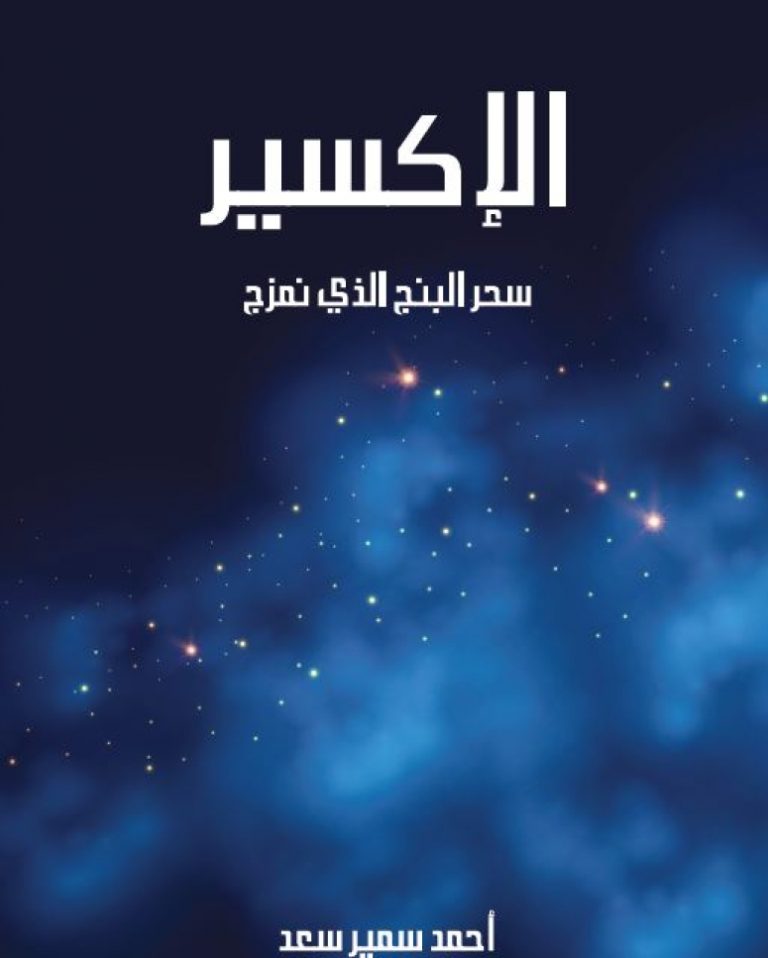مفرح كريم
يقول الشاعر سمير درويش: “إننا نضع حدودًا ومفاهيم جمالية جديدة لنوع أدبي بكر، يحتمل أن نجرب، ونطور، ونضيف معارفنا وتجاربنا الشخصية ونتاج قراءاتنا وثقافاتنا البيئية.. الخ”. إذًا، نحن أمام كائن جديد، ليس شعرًا (بالمفهوم الكلاسيكي) وليس نثرًا، (بالمفهوم الكلاسيكي أيضًا) وليس تزاوجًا بين الشعر والنثر، وإنما هو كائن جديد ليست له ملامح مسبقة، ولا نعرف عنه شيئًا قبل ذلك، وهو آت من المجهول، غير المحدد الهوية، المجهول الموغل فى قارات الذات العميقة التى يحاول الفنانون الأصلاء الولوج إلى عوالمها، محملين أنفسهم سحر الكشف، وقدرة المغامرة غير مأمونة العواقب، لا دليل معهم إلا الشعور الذاتي وحده، وهو –فى غالب الأحيان- ليس كافيًا، وليس دليلًا على الوصول إلى شيء، وفى محاولة للتعرف على ملامح هذا الكائن، أخوض مغامرة البحث، والتعرف، والكشف. مخاطرًا بالإقدام على نظرية (المحاولة والخطأ) أي معرضًا أدواتي المعرفية (وليست النقدية فقط) لنيران التجربة، أي للإقدام على عمل من شأنه أن يجعلني أفوز بكأس الصواب، أو أبوء بعار الفشل، لذلك، سوف أقدم على هذا العمل متسلحًا بالقدرة الشاعرية ذاتها، باعتبار أنني شاعر في المقام الأول، ولي تجارب هامة على طول تجربتي الشعرية، تمنحنى امتياز تملك أدوات الخلق الفني، ولست ناقدًا محترفًا، وربما كان في ذلك ميزة لي، إذ تجعلنى أقدر على التواصل مع التجربة من الداخل، بعيدًا عن برودة العقل التى يتميز بها الناقد الحصيف. مع أن الشاعر نفسه يجعل مهمتي هذه شديدة الصعوبة لأنه قال فى حوار مع أحمد الجمال عن تجربته الشعرية “أتصور أن تجربتي كلها واقعة خارج السياق، من دون تعمد، لأنها ترتكز على كشف الذات والآخر/ الأنثوي، وفي سبيلي إلى إنتاج القصيدة لا أتوقف أبدًا عند التعليمات المسبقة التي تمليها علينا ثقافتنا العربية، والتي تتمثل في المحظورات الثلاثة الشهيرة: الدين والجنس والسياسة”. فكيف أستطيع أن أمسك ما هو خارج السياق، وغير خاضع لثقافتنا العربية؟ ولا بد لي في البداية أن أعترف بأنني منحاز لتلك التجربة الفنية الراقية التى تتزيا برداء الحقيقة وحده، فلا هدف لها إلا البحث، والكشف، والإعلان؛ فالبحث هو عملنا الذي لا قدرة لنا في التمسك به أو الابتعاد عنه، وهو قرين لصفاتنا الأصلية التي جبلنا الله عليها، منذ بداية الخلق الأول. فهو من الصفات الأولى والأساسية التي نتصف بها، شئنا أم أبينا، فنحن (ديوجين) الباحث عن الحقيقة في عمق ظلام الجهالة، نتلمسها في كل مكان، وداخل كل الصدور، سواء اتفقت مع المألوف السائد أو ابتعدت عنه. وكانت في عمق الخوف والمجهول واللاموصوف، واللامعروف، والموافق للأعراف أو المتصادم معها. لا شيء يمنعنا عن مغامرة البحث هذه، فهي موهبتنا الكبرى التي فطر الله عليها الفنانين والأدباء والفلاسفة الأصلاء. وأما الكشف، فيعني القدرة على صياغة هذه الحقيقة في عمل من شأنه أن يؤثر في مشاعر الناس، حتى ينفعلوا بها، أى بهذه الحقيقة التي أفنينا أعمارنا فى البحث عنها، ووجدناها، وها نحن نخرج على الناس عرايا من كل شيء غيرها، صائحين بأعلى الصوت: وجدتها.. وجدتها.. وجدتها. هذا ما يعرِّفه المتصوفة باسم الكشف.. أي أننا لم نطق صبرًا على معرفة الحقيقة، وإنما خرجنا من فورنا للكشف عنها للناس كافة، علهم يرون فيها ما رأينا. أما مرحلة الإعلان التي ننبه فيها الغافي والنائم وغير المنتبه والجاهل فهي ما نقوم به من نشر للحقيقة التي وجدناها، وصحنا من شدة الفرح بها، وقمنا بالكشف عنها، ولأننا –كالأنبياء– نريد الخير والحقيقة المطلقة لكل الناس، فإننا نطبع هذه الحقيقة على أوراق، ونعقد اجتماعات في كل مكان، دون أجر، فإن أجري إلا على الله، لنعلنها للناس كافة، مبشرين غير منذرين.
وأول ما يقابلنا فى الديوان، كلمات عن الزمن، ففي الزمن تتخلق الأشياء، وتولد العوالم المختلفة، أو تموت العوالم أيضًا، ونحن الآن موتى –بحسب ما جاء فى القصيدة الأولى– أقصد القصيدة رقم واحد، فلا يوجد فى هذا الديوان أسماء للقصائد، وإنما يوجد أرقام، وكأنها فقدت هوياتها، أو أنها مجرد تكرار لكائن ما، لا خصوصية له، ونحن نعلم أن أول إهانة توجه لللخارجين على النظام الاجتماعي العام، هي أن يتم التنازل عن أسمائهم، أو بالأحرى انتزاعها منهم، واستبدالها بأرقام، إمعانًا في التجهيل، ومسخًا للهوية البشرية، واحتقارًا لذواتهم المريضة، وتحويل هذا المجرم إلى مجرد رقم، فالأرقام لا دلالة لها، وإنما هي تدل فقط على التكرار، أما الأسماء فهي الهوية، هي نبض الكائن الذاتي، هي علمه بنفسه، ولذلك نجد أن الله العلى القدير قال فى القرآن الكريم –في معرض تكريمه لبنى آدم– (وعلم آدمَ الأسماءَ كلها) فالأسماء هي المعاني والذوات. المهم، أن القصيدة بهذا المعنى، تأخذ فكرة النغمة في الجملة الموسيقية، فالنغمة الواحدة الوحيدة ليست موسيقى، ولكن تكرار النغمات هو الذي يصنع الموسيقى، تلك التي تخلق المعنى، وتؤثر في النفوس، والقصيدة هنا تعلن تلك الكلمات:
ليس للسنوات من معنى الآن
تلك التى تمر، مخلفة خطوطًا على الوجه،
وثلوجًا تتخلل الأحاسيس وشعر الرأس
فهذه السنوات التى نعيشها الآن ليس لها من تأثير إلا تدمير الكائن، وذلك عن طريق حفر الخطوط على الوجه، أي أن الزمن يرسم علاماته علينا، يدمغنا بما مر من أعمارنا، كما تدمغ الماشية باسم صاحبها، فكذلك الزمن، يحفر تأثيره على صفحة الوجه، فلا مجال للزيف، أو الإنكار، فهذا الزمن سجل سنواته التي أثرت فى أعمارنا على صفحة بارزة ظاهرة تصبح هي هوية الكائن في نفس الوقـت، وهو لا يكتفى بذلك وإنما يضع الثلوج بين الأحاسيس فتنعكس علينا بلادة لا نعرف طريق الفكاك منها، والزمن أكثر من ذلك، يسمنا بلونه الأبيض الثلجي راية على شعرنا، نرفعها دون أن ندري، لتكشف عن أعمارنا وعجزنا، واقتراب الموت منَّا.
ويكون الشيء الوحيد الباقي من السنوات التي مرت هو الحب، فالشاعر ينسى كل شيء.. كل شيء.. ماعدا الحب، ما عدا:
ربما لحظة لمست أصابع ابنة الجيران
أو تلصصت على نهديها العابثين
خلف قماش ثوبها المنزلى
أو دقيقة شربت فيها ماء الأرض
من كف حبيبتى
التى غافلتنى وماتت.
ولنلاحظ هنا، أن الزمن هو الذي يقف للشاعر بالمرصاد، فهو يغافله ليسرق منه حبيبته على هيئة الموت الذي لا راد له، فالموت هو في واقع الأمر الجزء الأخير من الزمن الأرضي، أو معرفتنا بالزمن. ولكن الزمن قد ينسى أن الشاعر ما زال يذكر ساعة معينة:
ساعة تسبق نطق اسمى منغما
قبل أن تنطلق العصافير الساخنة مغردة.
ففي هذه الساعة كان الشاعر يترقب سماع اسمه، أي ذاتيته، أي كينونته، من فم محبوبته، ومن فم الكون كله، ذلك الكون الذي ينطق بالاسم منغَّمًا، ويجعل مخلوقات الطبيعة البريئة هي التي تنطق به، فها هي العصافير تنطق الاسم، قبل أن تنطلق ساخنة مغردة، ونلاحظ أن العصافير ساخنة، لأنها كانت تعاين فعل الخلق، الذي هو في واقع الأمر فعل الحب أو العشق أو النطق باسم الشاعر مجلجلًا بين الأكوان.
ويقرر الشاعر بعد ذلك، أن:
ليس للسنوات من معنى
حين أقرر أن أموت.
لأن الموت هو في حقيقة الأمر إلغاء للزمن، أو توقيف له، أو وضع نهاية لهذا الزمن الذي لا يأتي بمعنى يخلب لب الشاعر، فالمعاني مكررة، هي ذاتها في كل مكان، وكأنها معانى الجاحظ الملقاة على قارعة الطريق، بحيث يقصد إليها القاصي والداني. هذا الزمن هو -كما قال شاعرنا الكبير صلاح عبد الصبور- هو زمن السأم. كما أن للزمن قدرة هائلة مؤثرة على الشاعر الإنسان، فلنرى ماهية تلك القدرة، يقول الشاعر:
بعدَ عشرِ سنواتٍ،
حينَ أعتادُ لقاءَ خيوطِ شمسِ الصباحِ
التِي تدخلُ مائلةً منْ بابِ المقهَى
مراقبًا الشارعَ الذِي يعجُّ بالناسِ والسياراتِ،
والقَصَصِ التِي صُنِعَتْ بليلٍ،
ستضحكُ لِي فتاةٌ فِي الخامسةِ والثلاثينِ
لمْ يطلبْ رجلٌ اقتناءَهَا في بيتِهِ
رغمَ مبالغتِهَا في لفِّ طرحةٍ حولَ رأسِهَا،
تشحنُ صوتَهَا بكلِّ مَا تستطيعُ منْ إغواءٍ
تلمَسُ جلدَ يديَّ الذابلَ، وتقولُ: إنَّ الوحدةَ تشقِّقُ الجسدَ،
وإنَّ الملاءاتِ تشتاقُ لعَرَقٍ يغمرُهَا،
وإنَّ نظرتِي المربكةَ، تجعلُ سوائلَ الأنوثةِ تطفُرُ
كسيلٍ ينهمِرُ حينَ يفتحُ اللهُ قبضتَهُ،
وإنَّ طفلةً بملامحِي تخايلُ بطنَهَا
الذِي لنْ يتعرَّى لسوايَ.
القحبةُ.. لماذَا لا تأتينِي الآنَ
وأنَا لا أزالُ قادرًا علَى العدْوِ خلفَ الباصاتْ؟! (الديوان ص 15)
فالزمن يهلك الناس، ويسلبهم قدرات الشباب، ويرمي المخاوف في ظن الشاعر عجزا عن القيام بواجباته الجنسية، مع هذه الأنثى التى تتمنع (لا تزال) عليه، على الرغم من أنها عجوز، أصابها الزمن بما يصيب به العجائز من عجز، ولكنها مع ذلك تستمر في أن تتمنع، وتنتظر، وهي لا تدري أن سيف الزمن جبار، يأخذ من الشاعر قدراته بحده الرهيف، كما فعل القاضي بالنسبة لرطل اللحم من جسد شايلوك المرابى.
ولأن اللغة هي مادة الشعر الغفل، هي مادته وجوهره، فإنها تأتى في مكان شديد الأهمية بالنسبة للشاعر، وبالطبع لغة الشعر ليست كبقية اللغات، ربما تشبهها في الظاهر، ولكنها في واقع الأمر تختلف عنها اختلافًا جذريًّا، فاللغة في القصيدة كائنٌ حيٌّ متحرك، نامٍ، متطوِّرٌ حساسٌ:
الكلامُ ملقًى عَلَى قارعةِ الطريقِ
(حسبِ المَنَاطِقَةِ)
لكنَّنَا لا نحتاجُ كتابةَ قصيدةٍ مشتركةٍ،
بلْ صناعةَ تاريخٍ غائرٍ
عَلَى صَفَحاتِ أجسادِنَا.
أحتاجُ امرأةً، لا ديوانَ شِعْرٍ،
وتحتاجينَ رجلاً،
فكفِّي عن محاولةِ استخراجِ كلامٍ مريحٍ
منْ باطنِ معجمِ العشقِ
فالكلامُ لا يريحُ العاشقينَ!
علينَا أنْ نخترعَ طرقًا توصِّلُنَا إليْنَا
دونَ كثيرِ كلامٍ..
ودونَ منٍّ..
ودونَ نزفِ مشاعرِنَا معًا. (الديوان ص22)
فاللغة الشعرية تحتاج إلى المشترك الإنساني، المحفور على أجسادنا، فالشعر يحتاج إلى لغة حقيقية، تشتبك معه، تعاركه، وتشاكسه، وتنزف معه الوجع الإنساني الحميم، وهي ليست لغة أليفة بالمرة، ولكنها سرشة، على الشاعر ترويضها كالنمرة الجائعة لممارسة الحياة، والشاعر يشتبك معها حين يشاركها آلام الولادة، وهي لغة متماسكة، وأنا في حيرة شديدة من أمري لأنني أضطر إلى استدعاء القصيدة كلها مرة واحدة عند كل استشهاد، وإذا ما جربت أن أجتزئ منها جملةً أو سطرًا شعريًّا أو صورة بذاتها، فإنها لا تلبث أن تخرج إليَّ بكل كيانها، تعاركني، لأنني قسمتها أشلاء ممزقة، وتصرخ، وتحتج، وتستدعى لي شرطة الفن والشعر، لأنني جرؤت على تقطيعها إربًا إربًا، ولا عذر لي عندها، حتى لو تمسكت بكل معاذير المناطقة والفلاسفة والنقاد، من أنني إنما ما فعلت ذلك إلا بغرض الدراسة والتوضيح، فاللغة في هذا الديوان شديدة التماسك، لا تترك للدارس رفاهية الاجتزاء، وكأنها تقول له، خذنى كلي أو اتركني كلي، فلا معنى لجزء مقتطع ميت، تم قتل القصيدة من أجل دراسته. ومع ذلك سوف أكون فدائيًّا حين أقدم على اقتطاع بعض الجمل لنفس الغرض الذى سقته قبل قليل، وأقول إن اللغة عند سمير درويس أنثى، لعوب، ماكرة، تمارس كل حيل الأنثى، وترسم على نفسها صورة الأفعى الناعمة القاتلة فى نفس الوقت:
اللغةُ التِي استوتْ أنثَى بفعلِ الرِّياحِ
تتحرَّكُ بينَ حروفِهَا الحُبْلَى بتثاقلٍ
تتحسَّسُ الماءَ بأصابعِ قدميْهَا هاتينْ
الغارقتينِ في دمِ الرَّغْبَةِ. (ص21)