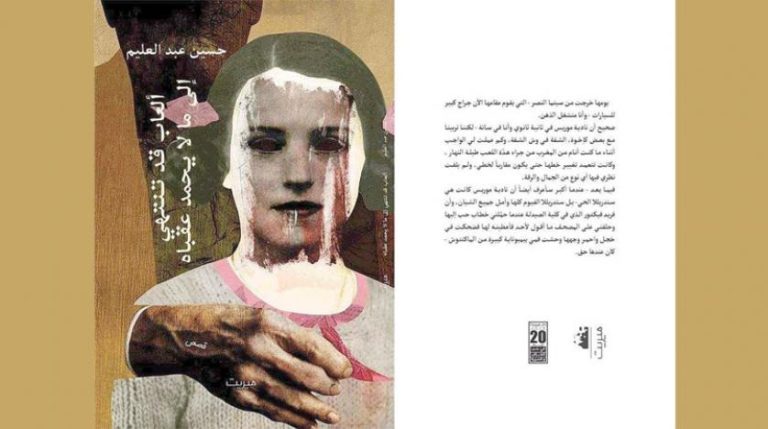معظم السكان هاجروا إلى معسكرات يحرسها الجيش في شمال البلاد حول العاصمة.
لقد هممنا بالهجرة مع من هاجر لكننا خفنا من المجازفة، فمن يضمن لنا سلامة الطريق حتى أقرب نقطة يؤمنها الجيش.
منذ بداية الكارثة أولوا العاصمة والمدن الكبرى كل الاهتمام أما نحن أهل القرى فلنا الله.
لم يطل الأمر كثيراً، ما هي إلا أيام حتى أمست أضواء المدينة لا تضيء أفق قريتنا ليلاً، شعرنا بالوحشة والعزلة، بأن الرعب قادم إلينا لا محالة، وأن ما حدث في المدينة سيصيبنا مهما طال الزمان أو قصر، كنا نشعر بشعور فئران المصيدة، وأصبحت الهجرة أمراً محتوماً.
اخترنا حلاً وسطياً، نرسل أحدنا ليستكشف حال الطرق حول قريتنا قبل المجازفة، وإن أمكن أن يجلب بعض البنزين للسيارات استعداداً للهجرة الجماعية.
أجرينا قرعة، وقعت علي.
أصر أخي بإصرار طفولي أن يأتي معي، حاولنا ثنيه عن ذلك، وأمام اصرارنا أوهمنا أنه سيمتثل لأمرنا، وبينما نحن نبحث عن جالونات فارغة لملئها بالبنزين من محطة بين قريتنا والمدينة، تسلل إلى السيارة، وجلس في الكرسي المجاور لمقعد السائق، وربط حزام الأمان، ثم صرخ صرخته المعهودة عندما يكون سعيداً.
التفت إليه فتبسم مزهواً كأنه يقول لي “لقد خدعتك، لقد انتصرت عليك”، تبسمت في وجهه رغم كل شيء، وقلت لهم “لن أكسر بخاطره، سآخذه معي“.
أخي يكبرني بعامين، أصم منذ الولادة، لطالما كنت أشفق عليه، كنت حقيقة بمثابة الأخ الأكبر له، لكن في تلك الأيام كم كنت أحسده، كان الوحيد من بيننا الذي لم يدري حقيقة الرعب المحدق بنا، حتى الأطفال كانوا يعرفون كل شيء رغم جهودنا في عزلهم عما يحدث، منعنا فتح الراديو التلفزيون إلا في جلسات مغلقة، ومع ذلك يبكون خوفاً نهاراً، ويستيقظون مفزوعين ليلاً، أما أخي فلم يعلم بشيء، يستيقظ ككل أيامنا الآمنات المطمئنات في الصباح الباكر، ويقصد حقلنا للعمل، وكأن شيء لم يتغير!
تحركنا في وضح النهار، كان الطريق إلى محطة البنزين خالياً تماماً وآمناً، لم نرى لا زومبي ولا إنس.
في المحطة بمجرد وصولنا نزل أخي مستغرباً خلو المحطة الغير مبرر له من الناس، لم يفكر أن يسألني عن سبب ذلك، واكتفى بهز رأسه مبتسماً وهو يتجول فيها مقلباً نظره في خوائها على عروشها، وأشار أن المحطة الآن أصبحت لنا، كرر الأمر أكثر من مرة، وفي كل مرة كان يقوله بنفس الزهو الطفولي، ونفس الابتسامة مرسومة على وجهه.
اختفى مني وأنا منشغل بملء الجالونات سارحاً بتخيل سيناريوهات هجرتنا، لم أنتبه لاختفائه في بادئ الأمر، ولما افتقدته رأيته عاد يحمل كيساً ضخماً من الشيبسي يأكل منه جلبه من متجر المحطة، وفي معصمه تعلق كيس آخر مليء بالعصائر والشكولاته، وذات النظرة الطفولية المزهوة على وجهه.
لم أفكر أن ألومه على مجازفته الغير مدروسة، وشاركته غنائمه، ولما ملأنا الجالونات قصدت معه المتجر مرة أخرى، ولم نترك في السيارة مكاناً لم نضع به معلبات وزجاجات ماء اعتقدت أننا قد نحتاجها أثناء هجرتنا.
هممت بعد ذلك بالعودة إلى القرية، لكن كل هذا الوقت الذي قضيناه خارجها بأمان مغاير لما توقعناه منحني جرأة لم أتوقعها بأن أتوغل أكثر نحو المدينة، والاقتراب لبؤرة الأحداث بأكبر قدر ممكن، وكان الطريق مثل الطريق من القرية إلى المحطة خالياً تماماً وآمناً.
وصلت حدود المدينة، وشيئاً فشيئاً وجدت نفسي أتجول في أحيائها الجنوبية إلى أن وصلنا قلب المدينة في دقائق! كان كل شيء هادئاً، لا شيء يدعو للخوف أو التوجس.
طوال الطريق كانت أبواب معظم البيوت والمتاجر مفتوحة، لم يملك أصحابها وقتاً حتى لاغلاقها، أو ربما لم يعودوا يهتمون لأمرها، ومؤسسات الدولة كذلك، الدوائر الحكومية ونقاط الشرطة متروكة هكذا بلا حراسة، وعربات الأمن مهجورة بجوار سيارات المدنيين!
وبينما نحن كذلك، وفي لحظة تلقائية لا واعية وجدتني فتحت راديو السيارة، ربما بحثاً عن بعض الونس الذي يبدد الهدوء الرتيب، أو على الأغلب فتحته بفعل العادة، فقلما قدت دون أن أفتح الراديو أو المسجل.
كان التردد مضبوطاً على إذاعة اخبارية انتظمت على سماعها منذ بداية الكارثة، وأول ما سمعته خبر عاجل عن مجموعات من الزومبيز قتلت أب وابنه من المتخلفين عن الهجرة في جنوب المدينة.
استمعت للخبر شاكراً القدر الذي ساقني إلى فتح الراديو في تلك اللحظة!
كان الأب وابنه قد لقيا حتفهما أثناء محاولة جلبهما للطعام من متجر مهجور قريب، من روى القصة شاهد عيان يقطن في شقة على الدور الثالث في بناية قريب يقول أنه لم يأكل لأيام ويخاف مغادرة الشقة.
غيرت طريق عودتي للقرية -بعد ما سمعته- متحاشياً الأحياء الجنوبية التي دخلت عبرها، وتوجهت نحو الشرق قاصداً الطريق الدائري، بينما تابع الراديو حديثه، فنقل لنا رواية أم منكوبة اقتحم الزومبيز بيتها بداية الأحداث وهي نائمة مع أولادها وأكلوهم جميعاً أمام أعينها، إلا واحد منهم، لما أغلق الزومبيز جميع منافذ الخروج من شقتهم اضطرت أن تقفز وإياه من الشرفة، فأصيب إصابة بالغة بينما حماها سقوطه فوقه، أغمي عليه، فحملته وسارت به حتى إلتقطهم الجيش ليموت فيما بعد في مشفى المخيم الميداني.
تلى تلك الرواية حديث مطول لخبير في الأوبئة يتحدث عن احصائيات انتشار العدوى، تحدث كثيراً، وفي النهاية وضع تاريخاً معيناً بعد عدة أسابيع يتوقع أن البلاد كلها ستصبح فيه مصابة بالعدوى إذا ما استمر الوضع على حاله.
بالكاد استطعت وصول القرية، أعصابي كانت مدمرة تماماً، وملابسي تغرق في العرق رغم ربيعية الجو، أذكر ما قلته وقتها أول نزولي من السيارة “الموت حولنا يجب أن نغادر القرية بأسرع وقت“.
قسمنا أنفسنا والبنزين والطعام على السيارات، واصطففنا على أول الطريق الخارج من قريتنا نتلقى التعليمات من أمير سفرنا.
تحدث عن أن نسير مصطفين سيارة تلو الأخرى، ونسير كمجموعة، وإذا توقف أو تخلف أحدنا لأي سبب كان تتوقف السيارات كلها، ومن أراد التوقف لأي ظرف طارئ فكل ما عليه أن يرسل إشارات بضوء سيارته للسائق أمامه الذي سينقل الإشارة لمن هو أمامه لنتوقف كلنا.
كان الخوف هو الجو السائد، تراه في وجوه الجميع، في انصات بعضهم الصامت، وفي أسئلة بعضهم عن تفاصيل دقيقة في رحلتنا، وفي كلام أميرنا رابط الجأش.
كنت ممن التزم الصمت، واكتفيت بالنظر إلى الطريق الذي سرتها منذ ساعات، رأيت في امتدادها اللامنتهي هلاكنا، ولكنني كنت خائر القوى أمام القدر الذي رأيته يتربص بنا.
وبينما نحن كذلك علت صرخة من إحدى النساء انهارت لها أعصابنا المنهارة، إلتفتنا اتجاه مصدر الصوت خلفنا، ورأيناه.
زومبي وحيد يقف كالمشدوه بين السيارات.
بعض من في السيارات خرج هارباً منها، وبعض من كان خارجها دخلها واحتمى بها، البعض الركض، والبعض هرب بالسيارة، والبعض تجمد في مكانه أو سقط مغشياً عليه.
أخذ الزومبي يعرج ببطء صوب إحدى السيارات، اصطدم وجهه في زجاجها ثم ارتد إلى الخلف، أعاد الكرة فاصطدم وجهه من جديد كأنه لا يرى الزجاج!
الأطفال داخل السيارة يبكون بهيستيريا، والسيدات يشاركنهم الصراخ، ورب تلك الأسرة بعد تجمد طويل ركض صوب باب السيارة من الطرف البعيد عن الزومبي في محاولة لانقاذهم، وفي ثوان بدت خارجة عن سياق ما حدث، رأينا أخي يحمل جاروفاً متجهاً صوب الزومبي، ومن خلفه شج رأسه، ليسقط صريعاً، وينتهي كل شيء، ينتهي بضربة جاروف، ويعود الهدوء والأمان.
ــــــــــــــــــــــــ
*كاتب فلسطيني