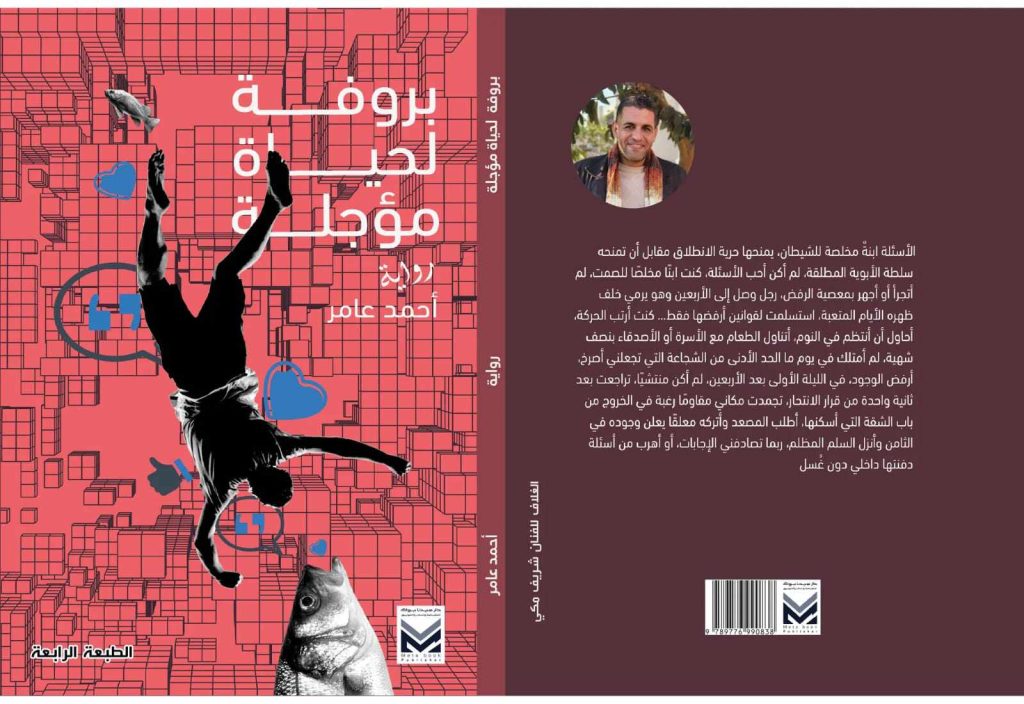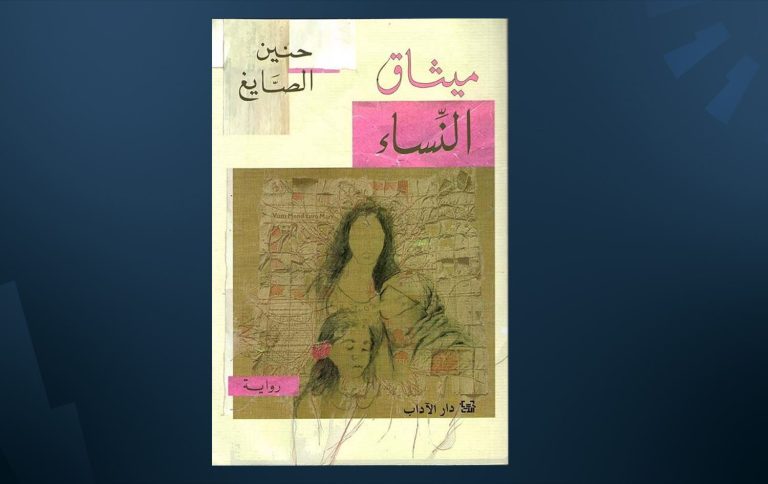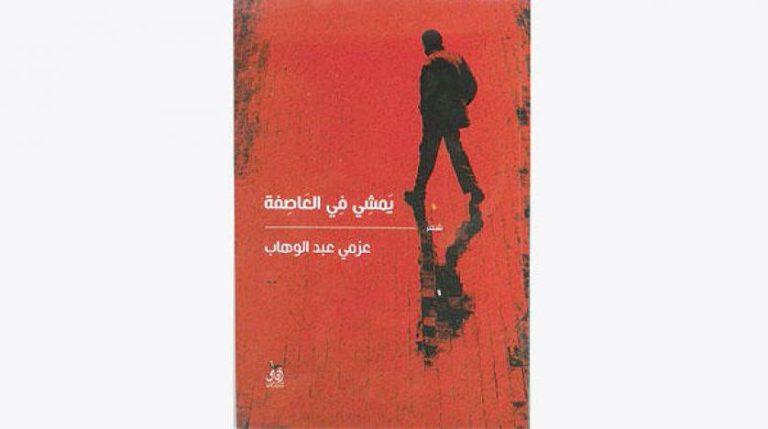منال يوسف
هل كان عالم النفس والفيلسوف الأمريكي “وليام جيمس” واضع مصطلح “تيار الوعي” Stream of consciousness ” على حق حين قال مؤكًدا بأن كل مؤلفي تيار الوعي كانوا على معرفة بنظريات التحليل النفسي وتحليل الشخصية، وأنهم متأثرين بشكل ما بعلم النفس؟ يعني؛ هل كان جيمس جويس ووليم فوكنر وغيرهما متأثرين بنظريات التحليل النفسي في كتابتهما؟ وهل كانت فرجينيا وولف في كتابتها متأثرة بعلم النفس أم بمرضها ومعاناتها في فوضاها الطبيعية أو تداعيها الحر، وأنهما ربما أثرا على اختياراتها-أو انجرافاتها- في تقنية الكتابة؟ حيث يكون مجال الكتابة كما ذكر “روبرت همفري” في كتابه{“تيار الوعي في الرواية الحديثة” ترجمة د.محمود الربيعي} هو التجربة العقلية والروحية من جانبيها المتصلين بالماهية(أنواع التجارب..الأحاسيس والذكريات والتخيلات) والكيفية(ألوان الرمز والمشاعر وعمليات التداعي)، وحيث يهتم الكاتب بالمستويات غير الكاملة أكثر مما يهتم بمستويات التعبير الذهني، تلك أسئلة ربما ليس في وسعنا الإجابة عنها، لكن ربما أمكننا التكهن فيما يخص الكتاب الذي بين أيدينا”بروفة لحياة مؤجلة” للكاتب أحمد عامر، وهو رواية تقع في 133 صفحة من القطع المتوسط، آثر الكاتب أن يقسم فصولها من تحت الصفر بعشر درجات إلى ما فوق الصفر بخمس درجات(-10،-9،…..،صفر،+1….،+5) في نسق غير مألوف ولا بد له من منطق لدى الكاتب، لكنه حين بدأ في السرد اختار تيار الوعي الحر وترك القلم مغموسًا في حبر الذكريات والتخيل والرمز في تجربة كان فيها من الفوضى الطبيعية في أحداثها وما جلبته من مشاعر متضاربة وصراعات نفسية ومواجهة مع الذات قبل الآخرين، أحسب أنه كتب في مستوى ما قبل الكلام؛ ذلك الذي لا يخضع للمراقبة والسيطرة والتنظيم على نحو منطقي، وعلى مستوى السرد والحكاية أيضًا؛ أنت تجمع تفاصيل الحكاية من أول سطر في الرواية حتى آخرها، كذلك طبيعة الشخصيات ومفردات كينونتها وصراعاتها مع ذاتها والآخرين ليتجمع لك في النهاية قطع البازل مرصوصة في خيالك فقط؛ لا تريد أن تعيد ترتيبها على الطاولة، وإنما تكتفي بها هكذا بفوضاها وإدراكك لها، على نحو يتماهى مع معاصرتك للأحداث في تلك الفترة إن كنت قد عاصرتها، تُعد تأريخًا لفترة صعبة بظروفها السياسية الاجتماعية والثقافية وتوابعها، وهي فترة ما بعد ثورة يناير 2011 في مصر.
ولكي يكمل الكاتب حالة الفوضى والعبث الفني، أنشأ عالمين متوازيين في روايته؛ عالم الفيس بوك وأطلق عليه: مملكة الهاربين، والعالم الواقعي الذي يعيشه أبطال الرواية بعد فشل الثورة في تحقيق أهدافها؛ يهرب الأشخاص من عالمهم الواقعي{عالم يزدحم بكل المفقودين، عالم يعج بضحايا الشعارات الكبرى والأحلام الكبرى، ينتمي لعالم يبغضه ويتمسك به}ص64، إلى عالم الهاربين متخذًا إسمًا مستعارًا”الغارق في بحر الحياة” حيث يقدم كل عضو نفسه في مجموعة الفيس بوك بما يريد أن يكون عليه أمام أفراد المجموعة، ربما بما يحلم أن يكون؛ هنالك”المكتفية بالصمت””راجية الفردوس””أمير الحكايات” و”ساحرة القلوب”وغيرهم من أعضاء مجموعة”مملكة الهاربين” هؤلاء الهاربون جميعهم على اختلاف مشاربهم اشتركوا في رغبة واحدة جعلتهم ينتمون معًا إلى تلك المجموعة، وهي الهروب، حتى مدير المجموعة الذي أسمى نفسه”الهارب وحدي” هو في الحقيقة لم يهرب وحده وإنما أنشأ تلك المجموعة لكل من أراد الهرب، واتخذ لها صورة ولد وحيد خارج من خط النار وعلى البعد منه ينظر إلى مجموعة تقف على بعد كافٍ من خط النار وأجساد أخرى استسلمت تمامًا، يبدو أنه أراد أن يأخذهم معه في الموضع الذي ظن أنه المنقذ له ولهم، صنع لهم مملكة، في عالم افتراضي ربما يحقق فيه ما لم يستطع في عالمه الواقعي، أو ما يتمناه؛ لا شك أنك تتوقع ما يمكن أن تعلق به “راجية الفردوس” على أحد المنشورات، أو ماذا سوف يكون موقف “المعتصم بالله” من أحد القضايا المطروحة في المجموعة، الجميع يعلم أنها لعبة، لعبة الهروب أو الموت أو الزيف، الكل يعلم لكنه مستمر لأنه في الخارج موت أكبر، يهربون من هزيمة بالغصب إلى هزيمة بالاختيار.
لكن العالم الافتراضي في حقيقة الأمر ليس مثاليًا، ولا يصلح أن يكون بديلًا للواقع بكل ما فيه من سلبيات وهزائم وشرور وخيانات وألم؛ تنبئ الأسماء والصور عن موقف أصحابها من الحياة والناس والأفكار، فصورة”مسعد” النائم على مفرش الدانتيلا صريحة وواضحة لا لبس فيها، أما صورة”راجية الفردوس” فتاة متشحة بالسواد ميزت نفسها بغطاء رأس أخضر وتعمل مضيفة في بار، صورة مراوغة تُكمل فهمها من تعليقاتها أو منشوراتها، أما”شجرة مخلصة للخريف” فهي مديحة التي تعطي من لا يستحق على الفيس وهي المرأة المحرومة، لكنها تبخل عليهم وتستغني عنهم لتكتفي بمحادثة محمد حسين كامل بطل الرواية الذي دخل إلى عالم مملكة الهاربين بإسم”غارق في بحر الحياة” يحاول أن يصطاد سمكة( رمز جعله الكاتب حقيقة بمشهدية مراوغة يمتزج فيها الواقع بالخيال، ويتماهى فيه حين يجلس البطل في المقهى ويحكي لأصحابه كيف أمسك بالسمكة وكيف وضع الطُعم، ويُمثِّل لهم كيف شد الخيط والمعافرة حتى الفوز باصطيادها) حركة اصبعيه حال شرحه لهم توهمك بوجود سمكة بالفعل، وإن كانت الحقيقة أنه لا سمكة ولا صيَّاد؛ حتى إن محسن رفيق جلسة المقهى حين يحاول أن يأخذ تلك السمكة منه فإنه يذهب إلى رأسه ويحاول أن يسرقها، ليس هنا إلا رجل محزون، يعاني آلامًا نفسية، له تاريخ من التجارب الحياتية تظهر آثارها في حياته وهيئته، جلسته ، مشيته، اختياره-أو جنوحه- النزول على السلم على الرغم من وجود السلم الكهربائي جاهزًا، بل إنه أحيانًا يستدعيه بنفسه، ثم يتركه قاصدًا السلم، رجل موتور بالمأساة، مأساته الخاصة التي سببت له انكسارًا، ومأساة الهزيمة التي لحقت بالوطن حين لم يحقق أهداف ثورته، والتي ربما كان يعوِّل عليها بشكل خاص الذين يئسوا من تحقيق أحلامهم الخاصة، وحين انهار حلمهم العام، لم يبق لهم شيئًا، قرر أن يخلص لجسده كما قال، راح يبحث عن سمكة، ربما امرأة ما في الوقت الذي تعاني فيه امرأته الوحدة والهجر وعدم قدرته على اسعادها، درجة أنه لا يجد فيما قالته المرأة التي قطعت زوجها ووضعته في أكياس لأنه لا يُشبعها، لا يجد في نفسه أي لوم تجاهها، تقول زوجته الخجولة التي صدقته، فتزوجها وهو الرجل الوسيم، حين وصلت العلاقة بينهما إلى تلك الحالة من التوتر، وطالبته بـ”شاشة ثلاثية الأبعاد” لمشاهدة الأفلام التركية؛ تقول: {على الأقل أتفرج على ناس بتحقق أحلامي}ص64، تخبَّط في الحياة دون أن يحقق حلمًا، أن يشبع امرأته، لكنه لا يعدم وسيلة يشبع بها نفسه وأخريات، تلك الحالة من الانقسام التي يحياها ليست حاله فقط وإنما حال ممكلة الهاربين، يقول أحدهم بأن لا أحد يتم اصطياده، بل إن هناك من يكون جاهزًا لتقديم نفسه. شخصيات الرواية سلَّمت للكاتب باطمئنان مفاتيح رماديتها، أنت لا تملك إلا أن تتعاطف مع الصياد، كل صياد، وتعذُر السمكة.
في التداعي الحر خلخلة الروح وتشظِّي الحكاية:
نعرف أن الطفل محمد حسين كامل، كان يسكن بيتًا آيلًا للسقوط، لم يستطع أبوه أن يجمع مالًا لإعادة بنائه، أو اقناع الدائنين بجدولة ديونه، مات والداه وتركاه وحيدًا(ص46)، نعلم أن له ولدًا في صفحة 78 حين تتصل به زوجته:{أنا في المستشفى، رجل الولد اتكسرت، اتصرف في فلوس وتعالى}، في صفحة 129 نعلم أن ابنته تُدعى هناء حين يناديها باسمها بعد أن تناول القهوة التي أعدتها له منذ قليل، يناديها وقد فاجأته الرجفة التي تنتابه أحيانًا حتى سقط على أرض الشرفة غائبًا عن الوعي، نعرف أن أول سقطة كانت في حادثة أمام سيارة “غير مسرعة” وهكذا يسرِّب لنا معلومة اثر أخرى، لا يهتم بـ(متى) يدفعها إلى القارئ حتى لو قاربت صفحات الرواية على الانتهاء، حتى قبل أسطر أخيرة تنتهي عندها الرواية ما زال لديه معلومة هناك يخبر القارئ بها، وأخرى لن يخبره عنها، لأنها ليست رواية الحكاية-على أهميتها بالطبع-لكنها رواية التجربة النفسية العقلية والروحية، إنها تجربة جماعية لها أبطال هم ظلال بطل يُدعى محمد حسين كامل، عاشوا تجربة ثورة يناير 2011، نزلوا إلى الميدان، شاركوا في التظاهرات، رفعوا شعار العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، تعرضوا للضرب، للسحل، للقنابل المسيلة للدمع، للأحجار المتشظية، لقناصة العيون، ثورة شاركت بها كلها الفصائل على اختلافهم الطبقي والأيدلوجي، انتهت بانتزاع فصيل واحد-الإخوان- عند تنحي الرئيس محمد حسني مبارك- أول مكتسبات الثورة- إذ استطاع هذا الفصيل فرض وجوده السياسي، ومن ثم ممارسة شيفونيته، وما تلى ذلك من تداعٍ مفاده أن لا شئ تحقق من المبادئ الثلاث التي مات من أجلها شباب آمنوا بالثورة، ومن بقى بجسمه هو ميت، أو كما أطلقت عليهم “أروى صالح” في كتابها منذ عقود المُعنون بـ”المبتسرون”: المبتسرين؛ إنهم هؤلاء الذين لم ينجوا من الحياة بعد ثورة سُرقت وتركت أبناؤها يعانون الفقد؛ حتى إن “مسعد” الذي كان يشارك في الميدان، ويتقدم الصفوف والهتاف زار السفارة الإسرائيلية وطلب منهم فرصة الحصول على عمل{كان يريد أن يصفعنا جميعًا}ص120، يفكر محمد حسين كامل في الانتحار ولا يجد الشجاعة الكافية.
إنها ليست رواية الحكاية {لا أريد أن أخدعكم أكثر من ذلك، فأنا لا أملك حكايات مدهشة، نعم أملك حكايات متداخلة عن النار، عن الدم، عن الوجع، عن الخيانة، عن الخوف، عن الهزيمة…. قبل أن أبدأ معكم، انهارت الحياة}ص 132، هكذا أطلَّت الرواية بفوضى مُحكمة كدمعة لا تجد سبيلًا ولا تأمُل في أثر، لكنها تحتفظ لنفسها بحقها في الوجود، ربما يأتي أحدهم ذات نهار فيعرف أنه كانت هنا يومًا ما دمعة.
هل هناك علاقة بين الفص الأيمن من الدماغ وتيار الوعي في السرد:
هل اختبر “وليام جيمس” فكرته بأن كل الكُتاب الذين أنجزوا رواياتهم في تيار الوعي “لا شك على معرفة بنظريات التحليل النفسي وتحليل الشخصية” وأنهم متأثرين بشكل ما بعلم النفس؟ لو أن “لا شك”=”مؤكد” يستلزم الأمر دراسات واحصاءت على كل من التزم تلك التقنية في إبداعه ليتم استخلاص مثل تلك النتائج. وماذا لو أن بعض نظريات التحليل النفسي ذاتها تم تخطأتها أو تجاوزها أو إعادة بناء أفكار جديدة من قبل دارسين آخرين أو من قبل أصحاب النظريات نفسهم، حتى إن “فرويد” نفسه خطَّأ نفسه في بعض أفكاره، بدَّلها وأعاد طرح غيرها، ولنا في كتابه” ما فوق مبدأ اللذة” دليل.
وعلى هذا سوف نسمح لأنفسنا باختبار فكرة سيطرة أحد فصي الدماغ على الإنسان،-حتى ولو اختُلف عليها في وقت ما- وقد فرضت نفسها علينا، ووجدنا بها وجاهة في رواية “أحمد عامر”-بروفة لحياة مؤجلة؛ في كتاب “الإنسان وعلم النفس” من سلسلة عالم الكتاب، يجري الحديث عن مخ الإنسان وفصي الدماغ الأيمن والأيسر، وأنه في بعض الأشخاص يسيطر أحد الفصين عن الآخر في سلوك شخص بعينه، وقد يكونا متساويين في السيطرة عند البعض الآخر، وأن الجزء الأيمن يستثيره النشاط العاطفي والإبداع والتذكر، بينما يرتبط الجانب الأيسر بالمنطق والتحليل، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يسيطر فيهم الجزء الأيمن هم شخصيات تميل إلى العاطفة والحدس، وأكثر من ذلك يقول الكتاب بأنه لو سألت أحدهم عن مسألة حسابية أو أمر يحتاج إلى تفكير منطقي لاتجه برأسه إلى اليمين ما يعني أن الجزء الذي ينهض للنشاط هو الأيسر، بينما لو كان الكلام عن المشاعر والأحاسيس لاتجه برأسه جهة اليسار، ما يعني أن الجانب الأيمن بدأ في السيطرة للتذكر أو الشعور. في فترة متقدمة تم عمل اختبارات على أعداد كبيرة من الناس، وبدأ القول بخطأ الفكرة،. وقد تتبعت-أو قل فرض عليَّ السرد- طغيان الجانب الأيمن لدى الكاتب في تجربته بتلك الرواية، وهو ما أجده مناسبًا تمامًا مع أسلوب تيار الوعي كتقنية؛ لقد اتجه الكاتب في 90% من حركة البطل في الرواية ناحية اليسار، ما يعني بحسب الدراسات التي ذكرناها آنفًا سيطرة الفص الأيمن من الدماغ المعنِي بالمشاعر والعواطف والحدس، حيث الذكريات والتخيلات والرموز والأحلام، حتى إنه حين أراد الكاتب أن يعرض الجانب المنطقي الفلسفي الذي يمثل وجهة نظر البطل وبعض الشخوص، قام بلعبة الملاحظات التي يكتبها بطل الرواية أو أحدهم في صفحته، وميزها باللون الثقيل {لكي تعود إلى الحياة يجب أن تشتعل}ص40، {أغلق جميع النوافذ أمام أعينهم ولا تجعلهم يرون حزنك، تأن وأنت تطرز كفنك؛ فالأموات لا يشعرون بألمك، لكنهم سيتحدون لقتل سعادتك حين تستدير محولًا الفرار من فخ الموت}ص101، وكأنه الوقت المستقطع الذي يعود بعده سريعًا إلى ملعب التداعي. وإن كانت تلك الملاحظات المباشرة بما فيها من أسلوب تقريري وآراء قاطعة لم تُشعر القارئ بصوت المؤلف إلا أن الكاتب وضع في الخاتمة وبعد انتهاء السرد الأصلي للرواية، وضع كلامًا مباشرًا موجهًا إلى القارئ، كنت أفضِّل على ما به من أهمية لو ضمَّنه المتن دون تخصيصه كنهاية للكتاب.
وهنا بعض الأمثلة القليلة من كثير، والتي تعزز فكرة طغيان الجانب الأيمن لدى الكاتب وقت العمل على سرديته، والتي لا أظنه تعمَّدها، وفي الوقت نفسه لم تكن مجرد مصادفات حسب ظني:
- يسمح لنصف ابتسامة بأن تقفز في الركن الأيسر.
- يترك لعينيه اليسرى مسافة كافية لمراقبة وجوه الأصدقاء.
- يرفع رأسه ويسمح لطرف عينه اليسرى بالبحث عن عيونهم المتربصة بجسده.
- يترنح قبل أن يدرك أنه في حاجة لصفعة قوية على وجهه من يده اليسرى.
- في المستشفى، في غيبوبته،كانت يده اليسرى مربوطة بالسرير الحديدي.
- الشيخ ذو اللحية الذي يقيم علاقة غير شرعية مع امرأة يقطع وجهه الأسمر أثر جرح قديم بطول وجهه من جهة اليسار.
- يقصد الركن البعيد من ناحية اليسار والذي تقصده قلة من زوار “مملكة الهاربين”.
- قدَّم قلبه فدية للتحرر من سجن يمنعه من الانطلاق لحياة بعيدة عنه، حياة يراها في مرآة اليسار لسيارة مسرعة.
- مال برأسه ناحية اليسار قليلًا، كأنه يبحث عن هواء ضال…. .
- محاولًا أن يوقف الزحف، أن يصد العيون التي بدأت تتابع منضدة عرجاء مائلة ناحية اليسار قليلًا.
- الساق اليسرى تهتز في حركة غير منتظمة- مقابل الساق اليمنى التي تشبثت بالأرض المتسخة.
وغيرها… حتى إن لافتة الحزب المفترض أنه معارض لكنه يؤيد نظام الحكم {لافتة مقره كبيرة تجبر المار من الباب على الاستدارة نحو اليسار ليحشر جسده ويمر}( وإن كان اليسار هنا يبدو فكرة ورمزًا تواطآ مع الحالة السردية الطاغية).
إنها ليست رواية الحكاية، إنها الرواية التي تبحث في الحالة النفسية، ترصد كل الدلائل الجسدية الناتجة عن المعاناة والصراع النفسي، المرض والهزيمة والانكسار؛ أنت تستطيع أن تلمس الهزيمة بعينيك وأنت تقرأ صورة:
مثل حال البطل بعد سن الأربعين وضياع الأمل في استعادة الثورة{كل ما عليه الآن هو أن يجلس كمتسول ويفتح الكيس المربوط بقطعة قماش متسخة قليلًا وملونة؛ ليضع اليوم المنقضي فوق الأيام النائمة في صمت، ويسجل في ذاكرته الرقم الجديد، لن يستخدم الحاسبة، يضيف كل ليلة-بعد الثانية عشرة-رقمًا واحدًا،”14601″ يومًا وبعض ابتسامة هربت من فوضى الحزن المرتب}ص61.
وتستطيع أن تلمسها أيضًا وأنت تتابع التفاتة، وانحناءة، وابتسامة، واهتزاز، وسقوط، ورجفة؛ كأن يسند ظهره وينام جالسًا، وعندما تلمس زوجته كتفه عند الفجر يفزع ويمدد جسده على السرير، هذا الذي{يغوص في حضن الكرسي}.
وقد تأتي الهزيمة رمزًا؛ في محاولة الهروب بلعب كرة القدم كل خميس، ولكن {جميع المباريات تنتهي بالتعادل السلبي أو بالانسحاب الصامت}.
الابتسامات وانعكاسات التجربة الروحية والعقلية:
إنها ليست رواية الحكاية، هي رواية التجربة العقلية والروحية من ناحية الكيفية، حيث ألوان الرمز والمشاعر؛ لكل ابتسامة لون وطعم وأثر ينعكس من المشاعر ويُبَئِّر عليها، ابتسامة أغوتها متاهة المرأة، ابتسامة بِكر في الطفولة، ابتسامة رجاء مهزومة لامرأة تدعو زوجها أن يعود من الغربة، ابتسامة لصد هجوم الأفكار، ابتسامة ممصوصة لطفلته في انهياره يقابلها ابتسامتها الصافية، ابتسامة مجابهة بلا روح في مواجهة العيون المتربصة، ابتسامة يضيعها في الفراغ بين أجساد المارة متلافيًا الحوار، ابتسامة مجهدة وهو يتأمل الرسائل في هاتفه، ابتسامة باتساع فنجان قهوة، ابتسامة معتقَلة في لحظة ما فضَّل ألا يسمح لها بالفرار، نصف ابتسامة لم تستطع صاحبتها أن تكملها في لقاء سريع، ابتسامة جبرية مع وجه جامد يقابل به الشارع في الصباح، ابتسامة يهزم بها مع روحه خيبات الأمل التي لم تمل من ملاحقته، ابتسامة يخالطها ثلاث ملاعق أرز يهرب بها من ابتسامة ابنته الكبرى، ثم ابتسامة تهرب من فوضى الحزن المرتب بعد أن يضيف يومًا لعمره، وابتسامة يرسمها فقط ليكمل مشهد الاحتفال بعيد الثورة حاملًا مثلهم الورد رافضًا مُعبِّرًا {النصب التذكاري لاستشهاد الثورة}، وغيرها من الابتسامات التي تحمل الفكر والمشاعر والرؤى والحل البديل لما يجب أن يُفعل، أو ما لا يجب أن يُقال، أو يُقال، ابتسامات تحدثك، تعرض عليك الفكرة، تجذبك من رأسك أو قلبك، تسحبك إليها سحبًا هيِّنًا، أو تدفعك معها إلى البكاء!.
لنذكر أبطال الحكاية ونسميهم بأسمائهم..
نحن الذين عشناها. في عدد من الروايات والقصص التي أرَّخت لثورة يناير 2011، فقدت معنى التأريخ في تجاوز الأحداث بتواريخها وتفاصيلها، في تجاوز أسماء شخصيات حقيقية عاشت بيننا، شهداء ماتوا؛ كما في روايتنا التي ذكرت عن الشاعرة”شيماء الصباغ” دون أن تذكر إسمها، وهي التي راحت تحتفل في الميدان بعيد الثورة وهي تحمل الورد، قُتِلت، وتركت طفلها الصغير بلا أم، أسماء الرؤساء، محمد حسني مبارك الذي تم ذكره بـ”الرئيس المتنحي” والرئيس “محمد مرسي” الذي يمثل الإخوان المسلمون والذي جاء بالإنتخاب، وغيرهم من شخصيات عاصرناهم وعاصرنا الثورة وأحسب أنه علينا أن نذكرهم للتاريخ، لأن القارئ في زمن ما لن يستطيع التكهن بماهية الشخصيات المشار إليها؛ تلك القصة حقيقية مهما اتخذ الكاتب فيها من وسيلة للسرد أو جنوح شبه فنتازي أحيانًا لأحداث في حقيقتها واقعية، لأن الذين هزمهم انكسار الثورة وعودة الناس للتَّرحم على أيام الرئيس المتنحي الذين ثاروا عليه، لأن المشارك فيها تم تخوينه وحبسه ومحاسبته، لأن الصداع أصبح لا يغيب بسبب راتب الشهر، لأنه يريد أن ينكمش ليصبح{مثل حبة عدس ليمر من عالمه إلى عالم اختاره ليحيا بقايا عمر تسرب من بين أصابعه} لأنه لا يستطيع أن ينام إلا جالسًا، لأن هناك شيئًا يرجرجه حتى يظنون به الجنون أو أن جنًا يتلبسه فيعرضونه للضرب على يد أحد الشيوخ، لأنه يريد أن ينتحر بوسيلة غير مؤلمة لأنه لا جرأة لديه على التنفيذ، ينتهي الأمر بدخوله إلى غيبوبة وهو يستسلم لها في مشهد النهاية لينفض عنه كل الشروخ التي عذبته وحرمته النوم.
أو كما يقول الكاتب بعد أن عذَّب قارئه، في الصفحات ما بعد نهاية الرواية، والمعنونة: “خاتمة لا بد منها” أن الحياة ليست بروفة مؤجلة، وأنه:
{المهم أن تُجرب، أن تكتشف الدور الذي يناسبك، فإذا وصلت إلى النهر، فيجب أن ترتوي، أو تترك لجسدك حرية السقوط في القاع}.
وربما كانت تلك الخاتمة إلى جانب ترقيم الفصول من – 10 إلى +5، هي علامات ايجابية، حيث تمثل أرقام الفصول تصاعدًا حتى وإن بدأت بالسلب، وتمثل الخاتمة دعوة إلى التجريب، دعوة إلى الحياة.