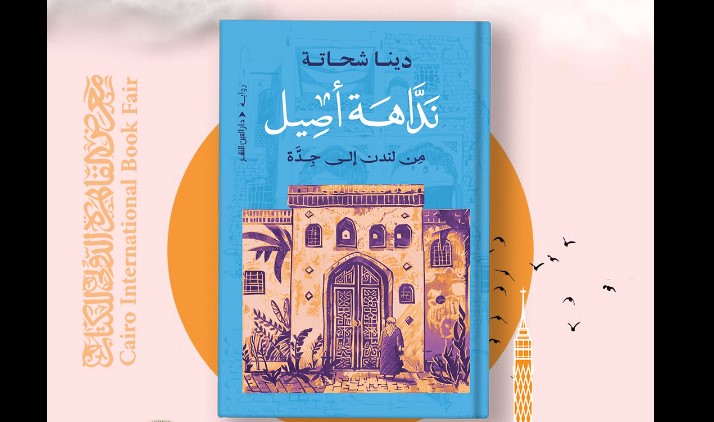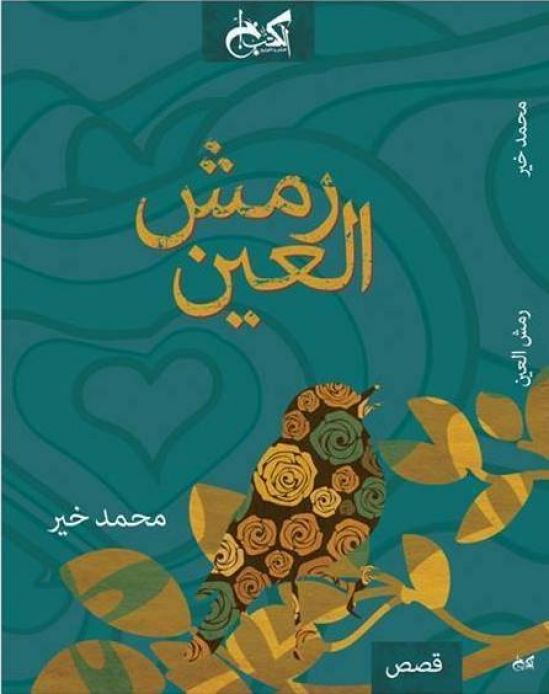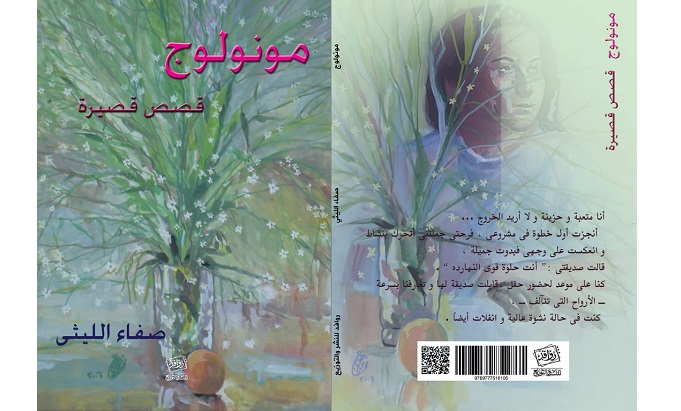أسماء محمد
عادة ً أذهب أنا وصاحبتى “سعاد” لزيارة العم “كرم” فى الإجازات الأسبوعية، فهو قريب لى من الدرجة الثانية يبلغ ستون عامًا، عمل كنحات طوال حياته.
فى بيته الصغير نحت تماثيل لكبار وبهوات القرية، كان يحب أن يدعبس فى ذاكرته ويحكى لنا عما يجده بداخلها مكتملا لم يطله الخرف والنسيان. كثيرًا ما يمدح يديه، يؤكد لنا أن الله أنعم عليه بيد صادقة تشكل من الرخام الحقيقة المتدارية. لطالما كانت “سعاد” منصتة جيدة لحكايات العم أكثر منى، شخصية رومانسية حالمة.
أول أمس أثناء انشغالهما فى المطبخ لتحضير الشاى، كنت جالسة فى غرفة المنحت وحدى أدندن مع الراديو وأفر فى مجلات قديمة، ثم سمعت همسًا، ثبتُّ يدى وتوقفت عن الفر. عَلَت نبرة الهمس. نظرت حولى، أنا وحدى، نظرت من النافذة إلى الخارج لعل أحد الأولاد يختبئ فى حقل الذرة، لم أجد شيئًا. تجاهلت هواجسى وأمسكت المجلة من جديد، سمعت الهمس مجددًا، هذه المرة محدد. همس ذكورى “فريدة.. أنا هنا..افتحى عينيك وانظرى إلي”. صُعقت واستغربت بالفعل عيناى مفتوحتان على آخرهما، يلفان الغرفة ومازلت لا أجد مصدر الهمس.
رحت أتحرك بين التماثيل فى استهزاء مخلوط ببعض الريبة. وجدت ما لم يكن على البال أو الخاطر. تمثال من تماثيل العم “كرم” هو الذى أصدر الصوت. وقفت أمامه جامدةً غير قادرة على الحِراك، برودة سَرت فى جسدى كله رغم حرارة العصرية. سألت التمثال إذا كان يتحدث وأنا مستنكرة فعلى هذا، رد علىّ بالإيجاب. كان تمثال لوجه شاب فلاح. أنف دقيق عينان متسعتان ومسحوبتان، شفاه حادة رفيعة. أول الأمر رجانى ألا أهلع، أو أُحدث جلبة تأتى بالآخرين إلينا. قليل ما يعلم حينها، لم يكن لسانى يستجيب لإشارات مخى بالنجدة. أخبرنى منذ تم نحته والإنتهاء منه، وهو يستمع إلى أحاديثنا، وحاضرَا لكل نقاش، كوّن عنى ما جعله يتأكد إنى الشخص المناسب ليكشف له عن ماهيته. أخبرنى أن روحه سكنت الجبل الذى استخرج منه قطعة الرخام المشكل بها، مات على هذا الجبل قص علىّ حياته السابقة. لم يكن له أبوين حسب ما أخبرته به السيدة التى تبنته، وجدته على جذع الشجرة الكبيرة جانب البحيرة المتطرفة آخر قريتنا. حيث كانت أمه بالتبنى تعمل كنفر ضمن مجموعة بنات فى حقل عنب وكانت بعد انتهاء عملها تقصد البحيرة لتغتسل فيها. وفى يوم بعد إنتهائها من تلك العملية وجدته يتدلى من على جذع الشجرة كثمرة تفاح شديدة الحمار. أخذته وتولت رعايته.
بينما أصغى بكل حواسى منتبهة كحيوان برى. انتبهت إلى وقع أقدام عم “كرم” و “سعاد” تقترب. همس لى أنه سينتظرنى غدًا. دخل العم و”سعاد” يحملان صينية الشاى وأطباق العسل والفطير. لاحظت “سعاد” تغير لون وجهى وشرودى، سألتنى ما بى، أخبرتها إنى متوعكة قليلاً وأصابنى الصداع. مرت علىّ الساعة التالية كأنها سنة. أفرك عينى المحملقة فى التمثال منتظرة أى حركة، ولكنه خالٍ من أى روح. أكان هذا حقيقى أم حلم. ولكنى لم أكن أبدًا بالشخص الخيالى حتى إنى لا أهوى القصص والحواديت. الشيء الوحيد الذى أحبه ومهتمة به هو الموسيقى، كنت مستمعة جيدة، والجميع يشهد لى بذلك. أحب جميع الآلات وأقدرها، أحفظ كل تقسيمة ومقام قى كل قطعة فنية أحبها.
كالعادة عند الغروب غادرنا، قطعت الطريق شاردة، أهز رأسى ل”سعاد” بشكل آلى لما كانت تقول والذى لم ألق بالاً له. حتى وصلت إلى البيت، وطلبت من أمى أن تتركنى أنام حتى الصباح ولا يزعجنى أحد فأنا متوعكة. نمت ساعات كثيرة أحلم بهذا الشيء الذى أفاق من ثباته وخرج عن جموده، وتذكرت أنه لم يخبرنى عن اسمه. هو يعلم عنى الكثير وأنا لا اعلم عنه شيئًا بعد. اتصلت ب”سعاد” طلبت منها أن نَمُر على العم “كرم” اليوم، كنت متوترة للغاية ومهزوزة أحاول أن أبدو طبيعية. استغربت، لم نكن معتادين على زيارته يومين متتاليين، ولكنها وافقت. ل
م يكن الباب الخارجى موصدًا، فأطمأننت لوجوده بالداخل، دلفنا إلى الداخل ننادى عليه، كان يقف أمام طاولة مطبخه. فوجئ لزيارتنا. اقتربت منه أحييِّه، وأضع من يدى ما جلبت من طعام، قبل أن أفوت على “سعاد” حرصت على شراء ما يكفي ليضمن لى غيابهم فى المطبخ أطول وقت ممكن. حيّانا بحماس كعادته، دخل بنا إلى الغرفة، نظرتي تسبقنى نحو التمثال، جلسنا ونظر إلينا بابتسامة متكلفة قليلًا. فهمت أنه لا إراديَا فى انتظار تفسير ل سبب مجيئنا على غير عادتنا. بادرت بالثرثرة، عن أى كلام حقيقة. التعليم، الطقس، والملل الذى يتسلل إلى الإجازة الصيفية، خصوصًا وأنه بالكاد يوجد فى القرية أنشطة تصلح لتعبئة هذا الوقت. بتلقائية استلمت منى ” سعاد” زمام الكلام، إذ كانت ثرثارة بطبعها، تبدى رأيها حول كل أمر التافه منها قبل الجلىّ. بعد مرور بعض الوقت قمت بتشغيل الراديو وتظاهرت بالاستماع وأنا أدور حول التمثال، آملة في أى شيء.
توجه العم إلى المطبخ، اقتربت منى “ سعاد” وسألتنى بحرج حول زيارتنا المفاجئة، مؤكدة ضرورة إبلاغه قبلها. أكدت لها أنه سعيد بنا فهو شخص وحيد، ولطيف منا أن نبدى إهتمامًا به. طلبت منها أن تذهب وتساعده بينما أرتب الغرفة. خرجت، فحولت عينىّ نحو التمثال فورًا، انحنيت فوقه وهمست “أنا هنا، أتسمعنى؟” ، جائءى الجواب بالإيجاب فى لحظتها. سرت رعشة خفيفة فى جسدى إذ أن يوم أمس كان حقيقة وحدث. لانت الشفاه الجامدة للحديث، عزمت وسألته ما اسمك، “جاد” رد. ناشدته أن يستأنف حديث الأمس عنه. حكى أنه ظهرت عليه بعض الكرامات بعد بلوغه. يشفى المعلول، يهب الدراويش والمحرومين سجناء الفقر المدقع. لم أكذب حرفا قاله، لم أتهمه بالدجل والزيف. إذا كانت روحه آوت الحجارة، وشقت طريقها نحو البعث، ترقبت فى سكون وجلد وقت صحوتها، إذًا فهى ذات أهلية بالمعجزات.
سكت للحظة كأنه يحاول استدعاء ذكرى، لاحق صمته نبرة موهنة مُغتمّة ينطق بها بما استدعى. ذكرى موته. انتشرت أخبار كراماته كالنار فى الهشيم، توافد عليه الناس من كل حدب ٍ وصوب يقصدون بركاته. لم يرد أحدًا خائبًا. شفاهم من سقمِهم، بسط دروبهم حتى بنوا له مقاما زرعوا حوله الريحان والزعتر. لم يعد فى الحسبان النواميس تبددت العادات والتقاليد السرمدية .عبدوه، الرجال قبل النساء اللاتى عرضن عليه أنفسهن فى هوس وتوق، تنافسن عليه فى غليان، أصابتهن حمى الاهتياج. هدى من جسده وروحه لهم ولهن، زادت حاجات الناس، جوعهم، ظمأهم، شهوتهم. أعطاهم كل شيء ومازالوا يتوقون للمزيد من “كل شئ”. كفروا بالحدود والحواف، يبتلعونه كالموج الهائم الزخم. قرر الهروب، أراد الخلاص من كراماته وبداية جديدة فى بلد آخر، ولكن فُضحت نواياه فى اللحظات الأخيرة.
سمع أصواتهم من بعيد تتكالب من كل جانب تنادى باسمه، أصوات مفزعة آتية من الجحيم، جحيم كراماته. جرى نحو الجبال وهم فى أثره، رجال تحمل البنادق والفؤوس، ورجال تحمل الأموال والذهب، ونساء تهرول بأجسادهن عاريات، كلٌ بسلاحه. أى شئ مقابل بقاء “جاد”. ولكنه أَبى. أصابته طلقة فى صدره فخرّ على الصخور، غطت دماؤه الجبل كسته بحمرة ثائرة. من هول المشهد خافوا الاقتراب من الجبل، خافوا لعنة “جاد”. لعنات حاكوها ظلمًا وبهتانًا، وتُرك جسده حتى ذاب وانصهر.
مرت علىّ تلك اللحظات سنوات عجاف، حفرت دموعى أخاديد على وجنتىّ. عندما دخل العم “كرم” و “سعاد” إلى الغرفة أجزعتهم ررؤيتى، ألقيت أسفًا مرتبك وتجاوزتهم إلى الخارج. جريت وسقطت أكثر من مرة، ونهضت أجرى أكثر وأبكى العجز والمرارة. وصلت منزلى، قطعت غرفتى ذهابًا وإيابًا، كنت قد أخذت قرارى. يجب أن أذهب إليه غدًا. يجب أن يتم هذا فى غياب العم “كرم” فأنا أملك تبريرا منطقيا لكل ما بدر منى. لم أنم، ظلت جميع حواسى متقدة، خيل لى أنى أشعر حتى بأقدام حشرات الحقل متناهية الصغر، إدراك العالم ثقيل علىّ. كنت أفكر لماذا قتلوه وهو المحب الواهب، أهذا خطأه أم خطأهم. أكان عقلانيًا عطاؤه ، أكان مردودًا طبيعيًا جشعهم. ذهنى يعصف “جاد! جاد! جاد!” حتى بزغ الفجر.
تسللت إلى الخارج، انطلقت مسرعة كغزال مطارد، أبطئ من طبعات أقدامى على الطريق كلما مررت بمجموعة من الفلاحين أو العاملين. وصلت لبيت العم تصنّتُ على حوائط البيت، اختلست النظر من النافذة الأمامية. كما اِتكلت على حدسى وجدت، غير موجود. الباب الخارجى موصد، توجهت إلى النافذة المطلة على حقل الذرة لحسن حظى كانت مفتوحة، تذكرت أن العم يعمل على قطعة جديدة فربما ترك النافذة لها تجف. أدركتها بعد محاولات من النط والقفز، جرحت معصمى، كشط بشدة ضد الحائط تركت دمائى علامة عليه. بلغت الغرفة مسرعة إلى “جاد”. حرك عينيه نحوى فى تأثر، سألته بانفعال جلى، ماذا على أن أفعل من أجلك؟ أى شيء؟. جاوبنى فى تلهف شديد، يريد شيئاً واحدا فقط، فرصة آخرى للحياة. سألته كيف ذلك؟ “البحيرة” رد. البحيرة الواقعة على طرف القرية التى وجد على جذع الشجرة النامية على شطها.البحيرة غذّت الشجرة التى أثمرته. أرادنى أن آخذه إلى هناك وأن أضعه – التمثال – فيها، حينها فقط يبعث من جديد فى جسده البشرى. لم أفكر لحظة، ذهبت إلى غرفة نوم العم “كرم” سحبت غطاء السرير، لففته حول “جاد” ربطته بحبل نبشت عنه فى المطبخ، وأنزلته بحرص من النافذة، ووثبت إلى الخارج. حملته فى يدى كان ثقيلًا ولكن يداى لم تخورا.
كنت فى أوجّ عزيمتى ونشاطى. وقفت على الطريق أبحث عن وسيلة تحدف بنا نحو آخر القرية. وجدت مجموعة من الفلاحين متجهين نحو القرية المجاورة على عربتهم الكارو. أوقفتهم ثم استأذنتهم فى الركوب معهم. كانت أعينهم تتفحص الملفوف بين يدىّ، ولكن لم يكن إهتمامًا كافيًا للسؤال بِشأنه. بلغنا طرف القرية، نزلت وانتظرت حتى ابتعدوا. عرجت نحو الغرب مهرولة كالمجنونة قاصدة البحيرة حتى بلغتها. رأيت الشجرة لأول مرة عن قرب، عظيمة وشامخة. وقع أشعة الفجر رؤوم على مياه البحيرة جعلها تتلألأ بخفة. نزعت عن “جاد” الغطاء، تنفست عميقًا وخطوت بقدمىّ فى المياه، ابتسمت له، نظرت مطولاً لعينيه الحجريتين هذه قد تكون آخر مرة أراهما على هذه الشاكلة ودنوت به حتى غطته المياه. حركات المياه الخفيفة أخذته بعيدًا عنى قليلاً، غاصت به إلى العمق البسيط. تراجعت إلى الشط، فكرت إنى لا أنتمى إلى داخلها الآن. فقط هو والبحيرة.
ثوان مرت ثم نهض من قلب البحيرة، يا إلهى كم كان جميلًا، أسمر وبديعا، كاملاً إلى حد يجعل استيعاب الكون بعظمته ممكنًا. ابتسم أرق إبتسامة رأتها عينى، بينما يشير إلى بالإقتراب، عينين بنيتان واسعتان ومسحوبتان، أنف دقيق، شفاه حادة، وشعر مجعد فاحم. نسخة حية من أول شكل عرفته به. تراقصت على جسده النحيف قطرات المياه اللامعة. أمسك بيدى، تفحص جلد معصمى المكشوط. مسح عليه بيده فشفاه، ثم رفعه إلى فمه قبّله فى حنان بالغ.
ألح علىّ أن أطلب منه شيئًا، فطلبت ضاحكة أن يهبنى صوتا جميلا. لطالما حلمت بإمتلاك حنجرة قوية ناعمة تشدو فى مرح وصخب. لمس بأطراف أصابعه رقبتى ونظر إلى عينىّ وابتسم وقال “غنِ” غنيت لساعات كل ما أعرفه من أغان وأناشيد، دندنت كل لحن أحفظه، له. كان جمهورى الوحيد. هو والشجرة والبحيرة. أعارنى انتباهه لساعات، لم تتحول عيناه الصافيتان عنى للحظة.