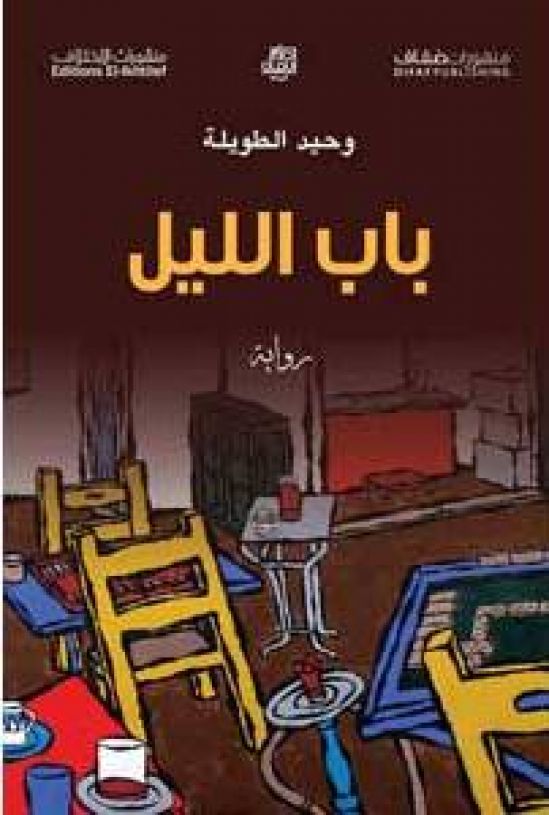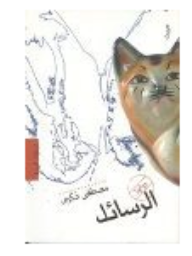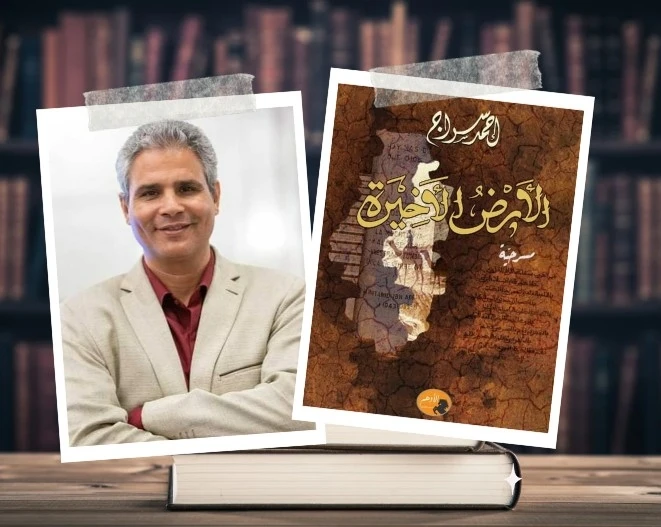بولص آدم
لم يعد الصوت الذي يصدر عن الأدب الطبقي اليوم هو ذاته الصوت المجلجل الذي عرفناه في النصف الثاني من القرن العشرين، ذلك الذي كان يتغذّى على الشعارات الكبرى والبيانات الثورية. لقد تغيّر العالم، وتبدّل موقع الكاتب، واختفت الجموع التي كانت تمثلها الرواية الواقعية الاشتراكية، وبالنبرات المتنوعة، ولم تعد هناك طبقة عاملة منظمة تحمل مشروعًا تاريخيًا واضحًا. بعد سقوط جدار برلين وبداية “انتصار الرأسمالية” الرمزي في مطلع التسعينيات، دخل الأدب الطبقي مرحلة جديدة، أكثر التباسًا، لكنها أيضًا أكثر صدقًا، إذ تحوّل من خطاب تغييري جمعي إلى تجربة معيشة فردية، ومن “أداة وعي” إلى “صوتٍ للنجاة”.
الكتابة الطبقية في صيغتها الراهنة لم تعد تسعى إلى تمثيل “الطبقة” أو الدفاع عنها بوصفها مفهوماً تاريخياً، صارت تُكتب من داخلها مباشرة. لم تعد هناك مسافة بين التجربة ونصّها، بين العامل الذي يكتب والكاتب الذي يتخيله. صارت الكتابة اليومية على دفتر مهترئ أو على هاتف محمول وسيلة لتسمية ما لا يُسمّى: القلق، الجوع، انكسار الكرامة، الوحدة. تحوّل الأدب من “أنا أفهم الطبقة” إلى “أنا أعيش في الطبقة”، من النظر من الخارج إلى الاعتراف من الداخل، من التحليل إلى التجسّد.
هذه الكتابة الجديدة، التي تنمو على حواف المدن الكبرى، في الشقق العتيقة، قليلة التهوية، أو المقاهي الرخيصة، تتحدث من داخل الجسد المرهق، والنفس المتعبة، والجوع المزدوج: للطعام وللكرامة. اختفت اللغة النظرية والزخرفة البلاغية أمام همسٍ يومي متعب يصف الحياة كما تُعاش. تكتب عن امرأة تنهار في نهاية ورديتها الليلية، عن عامل تنظيفات ينام بثيابه لأنه لا يملك سريرًا، عن أمّ تسجّل رسالة صوتية لابنها المهاجر في هاتف مكسور. لا رموز ولا استعارات كبرى، انما تفاصيل حقيقية تُعاد إلى مركز الأدب.
الشارع في هذه النصوص لم يعد مجرد خلفية مسرحية للمعاناة كما في الرواية الواقعية القديمة، فعلياً أصبح مكان السكن المؤقت، مسرحًا للحياة اليومية نفسها. والشقة الخانقة لم تعد مجازًا للحصار الاجتماعي، بلا شك، صارت المكان الذي يُكتب فيه الأدب ويُعاش فيه الفقر في آن واحد. هنا، تتقدم رائحة العرق وأصوات الجيران وتفاصيل البقاء على أي خطابٍ عن “الطبقة الكادحة”. بهذا المعنى، لم تعد الكتابة الطبقية المعاصرة تقدّم “شخصيات رمزية” تمثل الطبقة العاملة، بل شخصيات هشّة متفرقة، لا تجد معنى في الانتماء إلى جماعة أو حزب. كل نصّ شهادة حيّة على الانكسار، وكل جملة اعترافٌ بالهشاشة. قد يراها بعض النقاد “فقيرة أدبيًا”، لكنها غنية بالصدق الإنساني، بالنبض اليومي الذي يُعيد للأدب صلته بالحياة.
في الماضي، كان الأدب الطبقي يتوسّل التلميح ليعبر الرقابة أو يزخرف خطابه بالمجاز كي يُسمع. أما اليوم، فالتلميح ترفٌ لا وقت له. الخوف ذاته صار مادةً يومية، والمعاناة لم تعد حدثًا استثنائيًا، بل شرطًا وجوديًا. لذلك تحوّلت الكتابة إلى مواجهة مباشرة، حزينة ومكسورة في آن، تفتح جرحها منذ السطر الأول: “أنا مديون”، “أعمل عشر ساعات دون عقد”، “لا أنام من الجوع”. صارت اللغة امتدادًا للجسد، تحمل وجعه وتعبه بدل أن تخفيه. ومن هنا جاء التحوّل الجمالي الأوضح: جماليات الصدام حلّت محلّ الصياغة الملتوية. الأدب الجديد لا يختبئ خلف الرموز، بل يضع التجربة في مركز المشهد. لم تعد هناك حاجة للمسافة النقدية التي كانت تُحتفى بها في الماضي، بل انصهار تام بين الذات والموضوع، بين الكاتب والمكتوب. هذا ما يمنح النصوص الحديثة صدقها العارم، لكنه أيضًا ما يجعلها عسيرة التلقي على من يبحث عن “الأدب المصقول جيدًا”. هي كتابة تنبض بالحياة نفسها، عفوية كأنها نَفَس، غير مصمّمة مسبقًا، ولكنها شديدة الأثر.
في العالم العربي، تظهر هذه التحولات بحدة أكبر، إذ تنبع الكتابة الطبقية من خيبة جماعية تراكمت عبر عقود. بعد انكسار الأحلام الكبرى، تراجع الكتّاب عن الخطاب الجمعي نحو مساحة أكثر حميمية، يكتبون من الأزقة والمقاهي عن الخسارة اليومية، عن الصمت الذي أعقب الضجيج. غاب المثقف العضوي الذي كان يرفع الراية، وبرزت بدلاً منه أصوات متفرقة: عامل توصيل يدون خواطره في الليل، فتاة تكتب قبل دوامها في محل تجميل، عاطل يكتب على هاتف مستعار لأنه لا يملك حاسوبًا.
النصوص التي تولد من هذه التجارب تُكتب بالعربية كما تُسمع في الشارع: جمل قصيرة، مشغولة بصدقها لا بتزيينها. اللغة هنا وسيلة بقاء. الجمال يكمن في الفكرة التي تقول الحقيقة بوضوح، في الفقر وهو يتحوّل إلى وعي، في التعب وهو يتحوّل إلى كتابة. إنها كتابة تُفضّل الملموس على النظري، اليومي على الرمزي، وتعطي الأولوية لما هو قابل للحياة على ما هو قابل للتأويل. ورغم غياب التنظيم أو الخطاب الموحّد، يلوح في هذه الكتابات تيار إنساني جديد بلا اسم، لا بيانات له ولا مؤتمرات. إنه إحساس جماعي بأن الأدب لم يعد ترفًا ولا وسيلة تنوير، بل مساحة للتنفس، محاولة للقول وسط عالم لا يسمع سوى الصاخبين. من يكتب بهذه الروح لا ينتظر الجوائز، ولا يخاطب المؤسسات، وإنما يكتب كي يظل حاضرًا في مواجهة المحو اليومي.
لقد تحوّل الأدب الطبقي في العقود الأخيرة من مشروع سياسي إلى فعل وعي حياتي، من خطاب جماعي إلى تجربة شخصية، من المراقبة إلى المشاركة، من التحليل إلى العيش الفعلي للتجربة. لم يعد الفقر موضوعًا يُحلَّل، بل تجربة تُحسّ وتُسجَّل بصدقٍ مؤلم. هذا الأدب لا يتخذ مسافة عن الواقع، بل يغوص فيه حتى النهاية. لا ينشد التغيير عبر الشعارات، بل عبر الإنصات لما يجري الآن، هنا، في الغرفة الصغيرة، أو على الرصيف المرهق. في جوهره، يعبّر هذا التحول عن انتقالٍ من أدب الوعي إلى أدب الوجود، من اللغة التي تشرح العالم إلى اللغة التي تنجو فيه. ما يميز هذا الجيل من الكتّاب هو قدرته على صياغة الألم دون ادّعاء البطولة، على البقاء في قلب الهشاشة دون ادّعاء الخلاص. وهنا تكمن القيمة الكبرى لهذا الأدب الجديد: أنه يُنصت للحياة كما هي، لا كما يُفترض أن تكون. إنه الأدب الذي يهمس بدلاً من أن يصرخ، لكنه يترك في الصمت أثرًا لا يُمحى.
إنها الرحلة الطويلة التي انتقل فيها الأدب الطبقي من شعارات الوعي إلى همسات العيش، من الخارج إلى الداخل، من الحلم الجمعي إلى التجربة الفردية، ومن الرغبة في التغيير إلى الرغبة في البقاء. ومع ذلك، فإن هذا البقاء نفسه فعل مقاومة خفي، صادق، عنيد، يذكّرنا بأن الكتابة ما تزال قادرة على أن تقول الحياة كما هي، وأن تمنح الضعف معنى القوة.