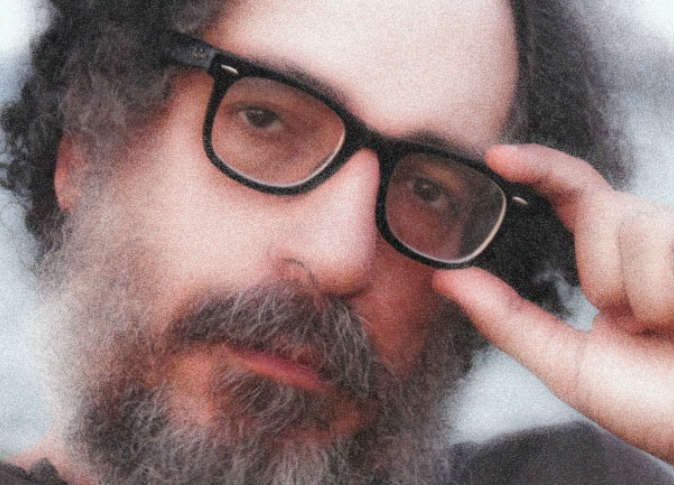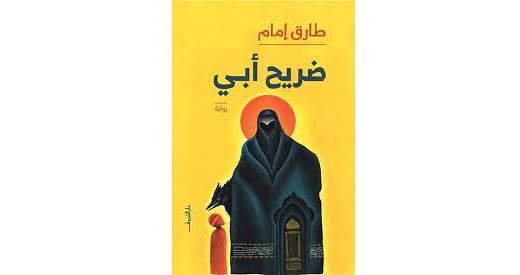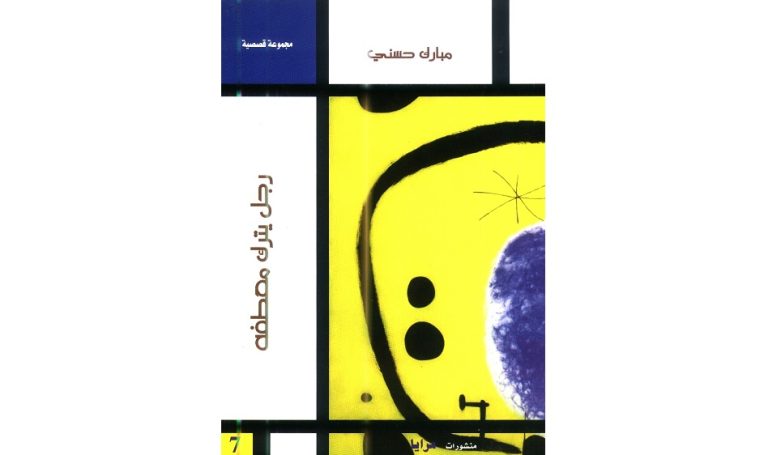أمجـد ريان
تختلف الحداثة المصرية في السبعينيات عن الحداثة التي طرحتها مجلة «شعر» اللبنانية في الستينيات؛ فحداثة “شعر” كانت ذات مرجعية أوروبية بالأساس؛ أما حداثة المصريين في السبعينيات فقد استفادت من الإبداع الأوروبي، ومن تنظيرات ورؤى مجلة “شعر”، ومن إنجازات “يوسف الخال”؛ وعلاوة على ذلك كانت ذات مرجعية عربية إسلامية. وقد تفاعلت مع الموروث الفكري والإبداعي بكل أشكاله، واستفادت من التراث الشعبي، وسعت للانتماء له.
تجربة الحداثة المصرية في السبعينيات، والشاعر “رفعت سلام” أحد روادها، عملت على تفجير اللغة، لتنهي حالتها السكونية السائدة، وعلى تطوير الإيقاع والمستوى الصوتي في النص الشعري؛ وعملت كذلك على تأكيد وحدة التجربة. ورغم تنوعاتها الإبداعية فقد كانت تؤكد قضية محورية الإنسان.
وفيما يتعلق بالحداثة، بشكل عام، يقول “سلمان زين الدين”: إن تجربة الحداثة في كل توجهاتها لها طبيعة فكرية وجمالية ذات أسس خاصة[1]، وأن بعض هذه الأسس “خارج – نصي” يتعلَّق بثقافة الشاعر، وبعضها الآخر “داخل – نصي” يتعلَّق بمضمون القصيدة وتعابيرها وإيقاعها وبنيتها. وبالإشارة إلى دراسة “خالدة سعيد”، يعطف “سلمان” على ما سبق، محددًا مواصفات توجهات الشاعر الحداثي وحقل اهتمامه بأربع، هي: (أن يكون «معنيًّا بالإنسان والتجربة الإنسانية»، «معنيًّا بحضوره في زمانه»، «رافضًا كل خضوع للماضي وتقاليده»، «متحرِّرًا من كل سلطة موروثة أو شكل مسبق»[2]). وهكذا، فالشاعر الحداثي، في منظوره، هو الإنساني، المعاصر، الرافض، والمتحرر. ولعل تصدير “يوسف الخال” العدد الأول من مجلة «شعر» بمقالة للشاعر الأمريكي “أرشيبالد ماكليش”، يربط فيها بين الشعر والحياة، ويعتبره وسيلة للمعرفة، ومعرفة النفس، ويدعو إلى ممارسة فن الشعر، لأجل أغراضه مستخدمًا مستلزماته الخاصة، بمعزل عن السياسة. ويضيء “سلمان” بعض الخلفيات التي انطلق منها الخال، ويتوسع في شرحها[3].
ولقد سعى شعراء السبعينيات في مصر، منذ أطلقوا مشروعهم الحداثي، إلى إعادة تعريف الشعر، وإلى دفعه لمعانقة تراثنا العربي والمحلي، دون أن يتعارض ذلك مع الاستفادة من التراث الإنساني في كل مكان في الشرق والغرب.
يطرح الشاعر “رفعت سلام”، في نص “منية شبين“[4]، المعنى الشامل للوجود الإنساني، ومعنى حركة الإنسان وانتقاله وتجواله الأبدي الدائم بين معطيات الموت والحياة. وحركة السفر والعودة تعكس حالات من التوتر والقلق، بحثًا عن المصير والخلاص، في واقع قاهر، يقابله – لدى الإنسان – إحساس بالنقص الداخلي، وعدم قدرة على التكيّف مع العالم. والعالم ذاته محبوسٌ بين قطبي الانتظار والموت؛ متأرجحًا إلى ما لا نهاية بين تضادات لايمكن للشاعر أن يفلت منها، بين الحقيقة والخيال، بين الموجود والغائب، بين الحسِّي والمعنوي، بين ما نلمسه باليد، وما يدور في الوجدان. بل إن هذه الثنائيات إنما تنطوي في داخلها على معطيات عديدة دائمة التوالد والحركة؛ فهي لاتنتهي، ولا تستقر.
كان رفعت سلَّام أحد مؤسسي مجلة “إضاءة” الشعرية في السبعينيات، وشارك في إصدار أعدادها الأولى بداية من عام 1977، ثم استقل بمجلة “كتابات“، التي عاونه في إصدار بعض أعدادها زملاء له من جيل السبعينيات، وأصدر سبعة دواوين شعرية[*]، ومجموعة من الدراسات النقدية، وكتب عنه عدد من نقادنا الكبار من خلال دراسات ومقالات منشورة. ومن فعالياته الغزيرة، ونشاطاته المهمة قيامه بترجمة أعمال شعرية كثيرة، منها لـ”قسطنطين كفافيس”، و”بودلير” و”رامبو” و”والت ويتمان”؛وكذلك لبوشكين، وماياكوفسكي، ولغيرهم. كما قام بترجمة أعمال نقدية أيضًا. وقدحصل على جائزة كفافيسالدولية للشعر في عام 1993، وترجمت أعماله الشعرية إلى عدة لغات أجنبية.
قصيدة (منية شبين) هي من أولى قصائد الشاعر التي عرف بها بين المثقفين والشعراء المصريين؛ وهي تجسد الروح الشعبية حين تنقلنا إلى مكان شعبي بجدارة، وهو محطة القطار الريفية، بكل هيئتها، ومكوناتها، وتكوينها المادي والمعنوي الراسخ في ضمير كل إنسان. وهي توحي بالرحيل؛ وهو معنى آدمي مرتبط بالحياة، وملازم لها في كل زمن. انه نص إبداعي رفيع المستوى يجمع بين أجواء القرية من ناحية، وأجواء محطة القطار من ناحية أخرى. ومحطة القطار بطبيعتها كمكان رمزي تجمع بين القوة والضعف، والسفر والاستقرار، والضجيج والصمت، والحركة والسكون، وهكذا إلى مالا نهاية من المعانى المتراكبة المتفاعلة التي تشكل أحد معانى الوجود الحيّ. وامتدادًا للفكرة، فمحطة القطار في هذا النص هي الصورة الكلية التي تشكلها عناصر البناء المتفاعلة الخالقة للتيمة الكلية، من خلال لغة الوصف التي تجسد بتراكمها لوحة حركية ممتدة، تتراص فيها المشاهد والصور والأحداث. والقطار نفسه هنا هو معنى رمزي، وطبيعة الوصف في النص تتوازى مع حركية القطار نفسها، من خلال التقطيع المتتالي، عبر آليَّة الحدث ذي الإيقاع السريع، الموافق ليس لإيقاع القطار فقط، بل الموافق لإيقاع الحياة كلها.
ومن النظرة الأولى للنص، في شكله الطباعي، يتضح للمتلقي أن هناك صوتين متحاورين، ميز الشاعر بينهما من خلال سُمك البنط؛ الصوت الأول – الذي يتكرر بين الحين والحين – ينبئ عن رحيل القطارات نحو الشرق، وهو ما كتب بالبنط الثقيل:
تَرحَلُ القِطَارَاتُ لِلشَّرقِ بِالأبنَاء،
لَكِن.. لاَ تَعُود.
تَرحَلُ الفَتَيَاتُ نَحْوَ الشَّرقِ لِلأبنَاء،
لَكِن.. لاَ تَعُود..
وتكرار هذا المقطع يوحي بالرغبة في تأكيد المعنى، معنى القطيعة والانقطاع، والضياع الدائم للأحباب؛ وفي الوقت نفسه توحي معاودة المقطع كل حين، بحنين الشاعر الجديد لممارسة التكرار الذي يعوضه عن افتقاد تكرار القافية في النص العمودي التقليدي. ان العنصر الزمنيَّ غير محدد الفترة، ككل كتابة مجازية كبيرة وشاملة، لكنه يلح عبر هذا التتابع التكراري ليوحي بإيقاعات الحياة كلها.
والصوت الثاني يقدمه الشاعر بالبنط الأقل سُمكًا، وهو الذي يطرح كل قضايا هذا النص الشعري. ومن الوهلة الأولى نلاحظ – في نص “رفعت سلام” – هذا التداخل بين الفن الشعري من ناحية، وفن السرد القصصي أو الحكاية، من ناحية أخرى؛ وهذا طبيعي في مثل هذه التجربة الحداثية. ففي خضم الحداثة تفاعلت الأنواع الأدبية، بل وتفاعلت الفنون المختلفة وتداخلت كلها، وتمت الإضافة لكل نوع أدبي من خلال تجاوره مع أنواع أخرى، لتحدث حالة من الإثراء الأدبي من خلال تعدد الدلالات، وحوار المعطيات المتباينة[5].
وكما تشير “نجلاء علي مشعل”، فقد حدث تداخل كثيف بين النثر والشعر في العصور الحديثة حتى أصبحت “الحدود التي تفصل بينهما شديدة المراوغة”[6]، وتنقل أيضًا رأي “تودوروف” الذي طرح فكرة أن (الرواية هي قصيدة القصائد، أو هي تعبير راق عن امتزاج الأنواع الأدبية[7]).
وترى “نجلاء مشعل” أن هذا التلاقح بين الشعري والنثري أو السردي يحرِّر النص من الواقعية المباشرة، ويحرر اللغة من النثرية التقريرية، ويحرر خيال الكاتب من النماذج القبلية، كما يحرر اللغة بشكل عام من جهازية التلقي. وتقول في ذلك: (وإذا كان الشعر يعتمد على جمالية الكلمات لتفجير طاقاته الشعرية؛ فيعِجُّ بالانزياحات والانحرافات وفوضى الحواس، فضلًا عن إيقاعه، فإن شعرية لغة النثر يضاف إليها أمر خاص بطبيعة الجنس السردي خاصةً، يَزيدها ألقًا على ألقها، إذا انضافت شعريةُ الأشياء إلى شعرية اللغة، وذلك عبر الأسطوري أو العجائبي؛ فترتفع اللغة عن حيز الواقع، لتحلِّق في سماوات الخيال بلا حدود؛ لتكون جديرة بالتعبير عن ذلك الأسطوري أو العجائبي اللامحدود[8]).
و”جون كوين” من أهم المفكرين الجماليين الذين درسوا اللغة الشعرية في مرحلة الحداثة بتوسع، وأخذت تصوراته مكانة كبيرة لدى شعراء الحداثة، وبخاصة هؤلاء الذين يسعون لتضمين المعنى الأسطوري في كتاباتهم، وأن هذا يتأتى من خلال تفاعل معطيين متباينين من نوعين أدبيين مختلفين في نص واحد[9].
يدرك الشاعر – في هذا النص – أثر الصورة الكلية، ووقعها على الشعور والبصر والوجدان والعقل. وفيما يشبه المونتاج، من خلال التركيب الصوري، وفي إيقاع سريع متقطع، يطرح الشاعر مجموعة كبيرة من الكلمات المتتالية الممتزجة المتقاطعة، التي تشكل – في مجموعها – المشاعر الحميمة التي يحسها البشر بمجرد الاقتراب من محطة القطار: (القِطَارَاتُ– الرَّحِيلُ– اللَّوعَةُ– الأبنَاءُ لِلحَرب– مَنَادِيلُ الأمَّهَاتِ– الصِّبيَةُ– الفَتَيَاتُ– السَّوَادُ– الرَّصِيفُ المُقفِرُ الخَالِي– نَشِيجٌ– بَائِعُ الكُولاَ– مُوَاءُ القَطَّةِ الحَامِلِ– نَظرَةُ الدَّهشَةِ مِن عَينِ المَدِينَة– المِحَطَّةُ– الأورَاقُ طَائِرَةٌ مِن السَّلَّةِ لِلأسفَلتِ– صَوتُ الرِّيحِ يَأتِي مِن بَعِيدٍ– دَقَّةُ السَّاعَةِ– رُعبٌ– دَهشَةٌ– صُفَّارَةُ البَدءِ– صَوتُ العَجَلاَتِ– بُكَاء). انها مشاعر داخلية نابعة من الأعماق، ومشاعر خارجية هي رد فعل طبيعي للأشياء المتراصة المواجهة للعين. يطرح الشاعر مزيجًا من أحاسيس الحنين والوداع، ومشاهد السكك الحديدية، والمشاهد التقليدية لمحطات السفر: الأرصفة، ونداء البشر والباعة، وهيئات المسافرين وأزياءهم، وأصوات القطارات وصفاراتها، وانزلاق قضبانها على القضبان، ومعطيات الطبيعة المحيطة بالمكان: الرياح والغبار وأسراب الحمام المحلقة في السماوات. اما عبارة (الأبنَاءُ لِلحَرب)، فهي تكاد تحيل النص كله، بمختلف مضامينه ودلالاته وإيماءاته وإيحاءاته، إلى مرثية لشهدائنا في الحربين الكبيرتين: (1967)، (1973)؛ لأن كل ماورد في النص يتعلق بهذا المعنى؛ وهو المبرر الأدق لخروج أبناء القرية لمحطة القطارات.
وبعد كل هذا التفاعل بين ماهو داخلى وما هو خارجي، في محطة السكك الحديدية، تعود للقرية حيث يقام المأتم، فنستشعر هذه المناجاة الأسيانة، وكأن كل شىء ينتهي بالضرورة، وكأن الموت هو الحالة الأخيرة التي تلقف كل شيءوتبتلعه في أعماقها؛ فتمتد الصورة حتى تصل لهذا الخوف الكابوسي الرمزي الوجودي المتأصل في نفس الإنسان، متفاعلًا مع أحزان الطبيعة والحقول:
القِطَارَاتُ، الرَّحِيلُ، اللَّوعَةُ، الأبنَاءُ لِلحَرب، مَنَادِيلُ الأمَّهَاتِ، الصِّبيَةُ، الفَتَيَاتُ، السَّوَادُ، الرَّصِيفُ المُقفِرُ الخَالِي، نَشِيجٌ، بَائِعُ الكُولاَ، مُوَاءُ القَطَّةِ الحَامِلِ، نَظرَةُ الدَّهشَةِ مِن عَينِ المَدِينَة.
المِحَطَّةُ، الأورَاقُ طَائِرَةٌ مِن السَّلَّةِ لِلأسفَلتِ، صَوتُ الرِّيحِ يَأتِي مِن بَعِيدٍ، دَقَّةُ السَّاعَةِ، رُعبٌ، دَهشَةٌ، صُفَّارَةُ البَدءِ، صَوتُ العَجَلاَتِ، بُكَاء.
تَبدَأُ الرِّيحُ، بُكَاء؛
يَختَفِي الأصفَرُ خَلفَ النَّافِذَةِ الرَّاحِلَةِ، صُرَاخٌ وَنِدَاء.
الغُبَارُ، الجَلاَبِيبُ، الطَّوَاقِي، رِحلَةُ العَودَةِ، صَرخَةٌ مَكتُومَةٌ، سِربُ الحَمَامِ يَطِيرُ لِلشَّرقِ البَعِيدِ، سَنَابِلُ القَمحِ، الصِّغَارُ، حَوَائِطُ الطِّينِ، النَّخِيلُ، التُّوتُ، صَمتٌ صَارِخٌ، ظُلمَةُ القَريَةِ، الحَارَةُ، البَابُ الخَشَبِيُّ العَتِيقُ، الجَرَّةُ المَقلُوبَةُ، الصَّمتُ، السَّوَادُ، الطَّرحَةُ البَالِيَةُ، بَكَاء.
تَعبُرُ الرِّيحُ إلَى الدَّاخِلِ، صَمت.
يَختَفِي الأصفَرُ خَلفَ النَّافِذَةِ الرَّاحِلَةِ، الصَّمت.
وَالأبنَاءُ لِلمَوتِ البَعِيدِ، الصَّمت.
وَالأورَاقُ طَائِرَةٌ مِن السَّلَّةِ لِلأسفَلتِ، صَوتُ العَجَلاَتِ الآنَ يَبدَأ، دَمعَةٌ تَرحَلُ فِي النَّافِذَةِ الأُخرَى، اصطِفَاقُ البَابِ والشُّبَّاكِ، صَمت.
مَأتَمُ القَريَةِ، أفوَاجُ المُعَزِّينَ، انتِظَار.
تَكنُسُ الرِّيحُ الحَوَارِي وَالأزِقَّةَ، تَخلَعُ الفَتَيَاتُ أثوَابَ الزِّفَافِ، وَتَلبَسُ القَريَةُ أحزَانَ الحُقُول،
وَتَرحَلُ الآن.
ثم يرسم الشاعر صورة المخلِّص، المخلِّص الذي هو منَّا: يصعد من عالمنا، ومن أحوالنا؛ لأنه بذلك سيكون القادر على أن يحمينا وينصرنا؛ إنه الرمز الذي ناضل من أجله الشعبيون، وسلموه أبواب الفصول الأربعة؛ أي سلموه الزمن كله، أو الحياة كلها، وملَّكوه معطيين من معطيات العطاء، سر الكلمة ومفتاح الكتابة؛ لأنه هو الذي سيكتب الحقيقة، وسيجعل البشر جيادًا نافرة، جيادًا للثورة؛ ولكي يحيلهم – في زمن الجوع – ثمارًا ورغيفًا. انه المخلِّص الساحر البريء، الممتزج بطمي النيل ونسغ الشجر، وعليه أن يحقق للبشر أحلامهم ويمنحهم المطر، وتعويذة الخصب:
غَرَسنَاكَ فِي تُربَةِ الغَرَابَة.
سَلَّمنَاكَ أبوَابَ الفُصُولِ الأربَعَة.
وَوَهَبنَاكَ سِرَّ الكِلمَةِ الرُّمحِ، وَمفتَاحَ الكِتَابَة،
كَي تَكتُبَنَا فِي فَاتِحَةِ الرُّؤيَا جِيَادًا نَافِرَة؛
كَي تَكتُبَنَا فِي مَملَكَةِ الجُوعِ ثِمَارًا وَرَغِيف.
وَنَذَرنَاكَ لِشَمسِ الفَاجِعَة،
كَي تُعِيدَ الرُّعبَ لِلوَطَنِ الألِيف.
غَرَسنَاكَ فِي تُربَةِ البَرَاءَة.
سَقَينَاكَ طَميَ النَّيلِ، أرضَعنَاكَ نَسغَ الشَّجَر.
وَاحتَضَنَّا وَجهَكَ المُورِقَ رُعبًا وَهَدَاءَة.
وَمَنَحنَاكَ فُنُونَ السِّحرِ، أعطَينَاكَ أسفَارَ الهُطُول،
كَي تَمنَحَنَا طُقُوسَ الحُلمِ، تُعطِينَا مفَاتِيحَ المَطَر.
غَرَسنَاكَ فِي تُربَةِ البَرَاءَة.
أطعَمنَاكَ خُبزَ الألَمِ المُوحِشِ،
ألبَسنَاكَ ثَوبَ الأرض.
عَلَّمنَاكَ أسرَارَ الأسَاطِيرِ الخَفِيَّة.
عَلَّمنَاكَ لُغَةَ الطَّيرِ، وَأقوَالَ الرِّيَاحِ الوَثَنِيَّة،
كَي تَبدَأ الرِّحلَةَ فِي سِفرِ الهَنَاءَة.
كَي تَمنَحَنَا تَعوِيذَةَ الخِصبِ، تَرَاتِيلَ اللِّقَاحِ المُتَجَدِّد.
غَرَسنَاكَ فِي تُربَةِ البَرَاءَة.
غَرَسنَاكَ فِي تُربَةِ البَرَاءَة.
وفي المقطعين الباقيين، يقدم الشاعر أنشودتين بينهما نوع من التبادل؛ فالأنشودة الأولى تغني فيها الحبيبة للحبيب، فتمجده لأنه واحدها، فتمنحه الدفء والحنان، ولأنه هو الذي سيأتي لها كالفيضان والبرق والخيول الراكضة. تغني له، وهو الجدير بهذا الغناء؛ لأنه سيد الزرع والنبات، وهو خالقها العظيم. والأنشودة الثانية، يغني فيها الحبيب لحبيبته التي تأتيه في صورة احتفالية تشبه العُرس، أو المهرجان، تأتي كأنها عيد السنابل والثمار. ونحس في هذه اللحظة الفريدة بأن حقول الدلتا كلها قد تلاقت، ويجتمع الحبيبان كما لوكان اجتماعهما قد حدث للمرة الأولى، وكما لوكانت مصر تولد من جديد. انه حلم بالتحقق المصري القادم، التحقق الأسطوري الذي تعاد فيه صياغة الوجود في حلم الشاعر:
المَجدُ لَك.
وَأنتَ عَاشِقِي الطَّالِعُ مِن نَهدَيَّ.. وردَةً بَرِّيَّة؛
وَأنتَ خَالِقِي الطَّالِعُ مِن سُرَّتِي.. حمَامَةً
أو حَربَةً نَارِيَّة؛
وَأنتَ وَاحِدِي.. في جَسَدِي بَقَايَا مِنْك.
المَجدُ لَك.
تَأتِي إلَيَّ سَاخِنًا.. اعطِيك.
تَأتِي جَائِعًا.. اعطِيك.
تَأتِي ضَائِعًا.. اوِيكَ فِي صَدرِي الدَّفِيءِ، وَنَأكُل الخُبزَ الفَقِيرَ عَلَى سَرِيرِ اللَّيْلِ، تَترُكُ فَوقَ صَدرِي وَجهَكَ الجَامِحَ لِلدَّمِ البِكْرِ، تَترُكُ فَوقَ صَدرِي الحُلمَ بِالإخصَابِ وَالثَّمَرِ الألِيم.
تَأتِي إلَى جَسَدِي كَمَا الفَيَضَان، تَدخُلُنِي رَفِيقًا زَاعِقًا مِن كُلِّ بَابٍ: يُثمِرُ النَّوَّارُ، تَخضَرُّ الحُقُولُ، يَسِيلُ فِيَّ الفَرحُ وَالأضوَاءُ، أرقُصُ وأغَنِّي:
لَكَ المَجدُ يَا سَيِّدَ البَرقِ وَالرَّعدِ وَالزَّلزََلَة.
لَكَ المَجدُ يَا سَيِّدَ الرِّيحِ والسُّحُبِ الهَاطِلَة.
لَكَ المَجدُ يَا سَيِّدَ العُشْبِ والزَّرعِ وَالأفرُعِ المُثقَلَة.
وَالمَجدُ لَك.
دَمِيَ الآنَ انتِظَارٌ لِلخُيُولِ الرَّاكِضَة.
جَسَدِي اللَّيلَةَ صَرخَةُ جُوعٍ شَبَقِيَّة.
وَأنتَ سَنَابِلِي خَبَّأتُهَا لِلقَحْطِ،
فَامنَحْنِي هِبَةَ الحُقُولِ الدَّمَوِيَّة.
وَأنتَ خَالِقِي الطَّالِعُ مِن سُرَّتِي.. حمَامَةً،
أو حَربَةً نَارِيَّة.
وَأنتَ وَاحِدِي،
فِي جَسَدِي بَقَايَا مِنْك.
المَجدُ لَك.
المَجدُ لَك.
- •
تَأتِينَ فِي الحُلمِ اندِفَاقًا جَامِحًا كَرَصَاصَةٍ فِي الظَّهرِ، كَالطَّميِ المُقَدَّسِ، وَاحتِفَالاَتِ الحَصَادِ، وَمهرَجَانِ الحُلمِ بِالعُرسِ المُؤَجَّلِ، تُقبِلِين، وَأنتِ عِيدٌ لِلسَّنَابِلِ وَالثِّمَارِ وَمَوسِمِ الفَيَضَان.
وَتَحمِلِينَ، وَأنتِ عِيدٌ، كُلَّ تَارِيخِ السَّنَابِلِ وَالمَنَاجِلِ وَالنَّخِيلِ، وَمَوعِدَ العُشَّاقِ، مَا سَيَكُونُ أو مَا كَان.
تَأتِي الحُقُولُ إلَيَّ وَالدِّلْتَا، وَآلاَفُ الفُؤُوسِ، وأنتِ عَاشِقَةٌ، وَوَجهُكِ دَافِقٌ كَرَصَاصَةٍ فِي الظَّهرِ، كَالرَّفضِ المُفَاجِئ.
وَأنَا أرَاكِ، كَمَا لِلمَرَّةِ الأُولَى، أرَاكِ قَرِيبَةً مِنِّي، أرَاكِ بَعِيدَةً عَنِّي، وَتَختَرِقِينَ أسلاَكَ الحِصَارِ، وَتُشرِعِينَ ذِرَاعَكِ المَلهُوفَ، لَكِنِّي بَعِيدٌ، تُشرِعِينَ.. انَا بَعِيدٌ، تُشرِعِينَ.. انَا.. وتَلتَحِمُ الرَّصَاصَةُ فِي دَمِي بِالعِشقِ، تَنفَجِرُ السَّنَابِلُ وَالحُقُولُ، وَيَخرُجُ الفَيَضَانُ عَن مَجرَاه، تُسَافِرُ الدِّلتَا إلَيَّ، وَيَرحَلُ العُشَّاقُ، تَرتَحِلُ المَنَاجِلُ وَالنَّخِيلُ إلَى دَمِي، وأَنَا أرَاكِ كَمَا لِلمَرَّةِ الأُولَى، وَوَجهُكِ عَاشِقٌ كَالوَعدِ، كَالرَّفضِ المُفَاجِئ؛
وَجهُكِ الآنَ.. اختِصَارٌ لِلمَوَاسِمِ وَالفُصُول؛
وَأنتِ.. لي.
واللغة الشعرية في النص، وفي معظم قصائد “رفعت سلام “، هي لغة انزياحية استبدالية، تعتمد شحنة الاستعارة والمجاز اللغوي بشكل عضوي كجزء من تكوين اللغة: (غَرَسنَاكَ فِي تُربَةِ الغَرَابَة– سَلَّمنَاكَ أبوَابَ الفُصُولِ الأربَعَة). وكل كلمة في العبارتين السابقتين تصعد بنا درجة في سلم المجاز، فـ”غرسناك” تستعير رمز الغرس لرمز الخلاص الشعبي، ومكان الغرس هو تربة الغرابة. وهو معنى مدهش للغاية؛ لأن تربة الزراعة استعيرت لمعنى الغرابة والخروج على المألوف، وهو حلم شعبي للبسطاء المكبلين بقيود لا يمكن الخلاص منها، حتى تحول القيد إلى عادة مفروضة، وأصبح الناس لفرط التكرار والموات يحلمون بالخلاص وبالدهشة، التي سماها الشاعر (الغرابة). وفي العبارة الثانية تسير كلمة “سلَّمناك” في مسار كلمة غرسناك، ثم يتحول الزمن إلى الأبواب التي تم تسليمها. والعبارتان – بمضمونيهما، وبالهالة المجازية حولهما – يفيدان معنى إيمان الشعبيين وحبهم الجارف لرمز الخلاص الذي سيغير الحياة، وسيعيد للبشر كل الحقوق الضائعة.
[1]سلمان زين الدين:”الحداثة الشعرية بين النظرية والتطبيق (يوسف الخال إنموذجًا)”مجلة نزوى، عمان، العدد 86 (http: / /www. nizwa. com).
[2]خالدة سعيد: يوتوبيا المدينة المثقفة، دار الساقي، بيروت، الطبعة الأولى 2012، ص 132.
[3]سلمان زين العابدين، المرجع السابق.
[4]ديوان رفعت سلام، الجزء الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
[*]للشاعر رفعت سلام، الآن، تسعة دواوين [المحرر].
[5]خيري دومة: تداخل الأنواع في القصة المصرية القصيرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1998، ص33.
[6]نجلاء علي مشعل: “سحر الشعر في أفق السرد”، موقع الألوكة(. http: / /www. alukah. net /literature_language /0 /54478).
[7]تودوروف: المبدأ الحواري، ترجمة: فخري صالح، دار الشؤون الثقافية، بغداد 1992، ص113.
[8]نجلاء مشعل، المرجع السابق.
[9]جون كوين: بناء لغة الشعر، ترجمة: أحمد درويش، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1993، ص140.