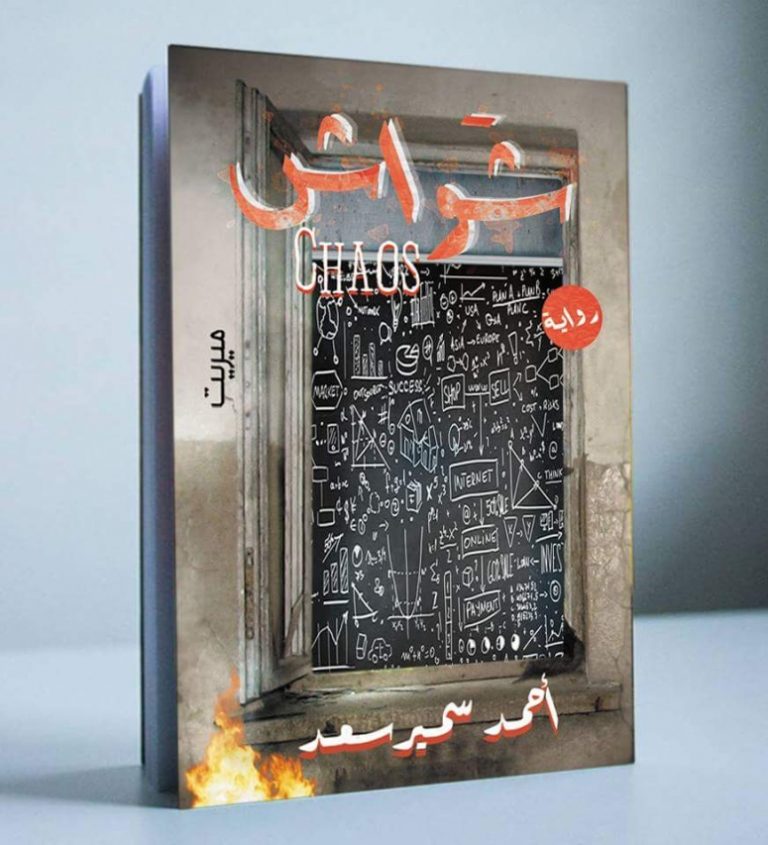علي حسن
حديثنا عن رائدين اثنين؛ الأول واحد من أعظم رواد الواقعية السحرية في الأدب العالمي ونال جائزة نوبل للآداب عام ١٩٨٢، وهو الكولومبي “جابرييل جارسيا ماركيز” والآخر فيلسوف تبنى الفلسفة الوجودية بل هو رأس هذه الفلسفة وأشد المخلصين لها، وهو الفرنسي ” جان بول سارتر”.
الحديث عن هذين العملاقين ليس سهلًا، رغم أن الكتابات عنهما لم يخبُ لهبها منذ أن ذاع صيتهما، وأصبح لهما أتباعٌ وعشاقٌ وتلاميذٌ في كل أنحاء العالم، لكن الحديث عنهما لن يكون إلا من خلال مذكراتهما، وكلاهما تحدث بعفوية وجرأة، وكشفا كل ما تنطوي عليه ذواتهما من أسرار وعقد وضعف بشري!
“ماركيز” في كتابه “عشت لأروي” والذي صدرت الطبعة الأولى من الترجمة العربية عن دار المدى عام ٢٠٠٥ ترجمة الأستاذ “صالح علماني” يتحدث عن سيرته منذ أن كان طفلًا فقيرًا ومعدمًا، وذلك في سبعمئة صفحة من القطع المتوسط، بينما “سارتر” الفيلسوف والأديب في كتابه “كلمات” الذي صدر بالفرنسية عام ١٩٦٣، وصدرت النسخة العربية منه عام ٢٠١٨ عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن سلسلة آفاق عالمية، ترجمة الأستاذ “محمد مندور” في مئتين وخمسة وعشرين صفحة من القطع المتوسط، يتحدث باستفاضة عن التسع سنوات الأولى من حياته، منذ مولده في ١٩٠٥ وحتى ١٩١٤، إذ هي السنوات الأهم التي كونت شخصيته.
ماركيز؛ صحفي وناشط سياسي، والأهم أنه روائي يكتب بشغف، تأخذه شهوة الحكي، في سبعمئة صفحة يروي لقارئه تفاصيل كل شيء، الابتسامة، العثرة في الطريق، تفاصيل مقالاته، وحتى لقاءاته داخل المصاعد، لهذا يقول “عشت لأروي” ورغم سحر السرد عنده، أجدني عندما أعبر نهره الهادئ لا أحتاج التشبث في شيء، فالنهر تسير مياهه بلطف منذ المنبع حتى المصب، ولا نجد اختلافًا في طعم المياه وإن كانت حلوة المذاق تبعث على التفاؤل، وأحيانًا تضحك بصوت عالٍ!
سارتر؛ روائي وكاتب مسرح والأهم أنه فيلسوف حكيم، يزن كلماته بميزان الذهب، ولهذا اختار لسيرته عنوانًا هو “كلمات” فإذا فاتتك كلمة من هذه الكلمات فاتك الكثير، ورجعت لتلملم ما فاتك من جديد، فمع “سارتر” لست تملك رفاهية الاختيار، أنت مزروع داخل هذه “الكلمات” فتصبح أحد حروفها، ورمزًا من رموزها الخلاقة الملهمة! مع “سارتر” أنت تخوض عباب نهر في مرحلة الشباب، وتجتاز شلالات هادرة، للمياه فيها طعوم متعددة لكن المذاق مر كالصبار!
ماركيز؛ الفقير، العربيد، الهارب من الخدمة العسكرية، والذي أصيب بالزهري والسيلان وهو شاب في العشرين! عاش مشردًا، لا ينام إلا مع فتيات الليل الفقيرات، إما في بيت تحولت كل غرفة من غرفاته الواسعة إلى حجرات ضيقة جدرانها من الورق المقوى، وجاراته عاهرات! أو يستأجر غرفة صغيرة في فندق حقير للعابرين، مقابل بيزو ونصف البيزو في الليلة الواحدة، ينام فيها وحيدًا أو تقتسمها معه فتاة ليل هزيلة.
أمه هي “لويسا سانتياجا”، أحبت عامل تلغراف فقير ومتكبر، وبعد قصة حب ملتهبة ورفض تام من أسرتها، تزوجته. عاشت أمه مئة عام تقريبًا، مع أحد عشر ابنًا، وأربع أبناء لزوجها، وخمسة وستين حفيدًا، وثمانية وثمانين ابن حفيد، وأربعة عشر من أحفاد أحفادها، دون عد لمن كان لدى زوجها عاشق النساء من أبناء لم يخبر عنهم! ولكن مع ذلك كانت قصة حبهما رائعة وسعيدة!
أبوه هو “جابرييل إليخيو” عامل تلغراف فقير، ابن سفاح، أنجبته أمه وهي في الرابعة عشر من عمرها من علاقة مع معلمها في المدرسة! وقد أنجبت غيره ستة أبناء وابنتين من ثلاثة آباء مختلفين، لم تتزوج أيًا منهم، ولم تعش مع أحد منهم تحت سقف واحد أبدًا، وكان الأب مثل أمه يعاشر النساء بغير حساب أو قوانين، وعلى سبيل التوبة من الخطيئة فقد اعترف لزوجته (والدة ماركيز) ليلة الزفاف بأنه منذ بلوغه السابعة عشرة قد عاشر من العشيقات خمسة!
ولد “ماركيز” الابن البكر في ٦ مارس ١٩٢٧، وأطلقوا عليه الاسم الأول لأبيه (جابرييل) يليه اسم (خوسيه) أما اللقب (ماركيز) فهو لقب أمه، الذي طلبت منه عند أول ظهور له في الإذاعة أن يضيفه، فصار بعد ذلك لقبه الذي اشتهر به. ويروي لنا “ماركيز” أحلك لحظات حياته وهو يبتسم، ولا يجد في الفقر والجوع غير ما يبعث على التفاؤل، إنه العاشق الرقيق حتى مع فتيات الليل، وهو الرجل الذي يحب والديه وأهله، ويعترف بالجميل، وليس مصابًا بعقد نفسية أو يعاني من نقص أو حقد. يقول لنا: “إنني مدين بجوهر طريقتي في الحياة والتفكير، لنساء الأسرة، وغيرهن من الخادمات اللواتي رعين طفولتي، لقد كن يتمتعن بقوة الشخصية وطيبة القلب، وكن يعاملنني بتلقائية الفردوس الأرضي”.
كان “ماركيز” يحب والده رغم قسوته، ورغم أنه لم يكن يتورع أبدًا في استخدام الحزام في جَلْدِ أولاده، خوفًا عليهم من الانحراف! ومع ذلك يقول ماركيز: “لقد كان والدي مسليًا في لحظات صفائه، ويسعده أن يروي دعابات على المائدة”. استغل “ماركيز” حكايات والده في كثير من رواياته، مما دعى الأب أن يقول قبل موته بقليل في أحد اللقاءات الصحفية حين سألوه: “هل رغبت يومًا في كتابة الروايات؟” فأجابهم: “نعم، لكنني تخليت عن الفكرة عندما اكتشفت أن ابني يكتب ما كنت أفكر في كتابته”!
أما جده لأمه؛ فقد منح حفيده الرعاية والاهتمام وكذلك التقدير، ومهما فعل كان يتجاوز عن أخطائه لأنه كما يقول عنه دائمًا: “يتمتع بكل الحقوق”! كان يأخذه في جولاته المسائية، ومن خلاله عشق “ماركيز” السينما، وعرف “سيمون بوليفار”، وجده هو الذي علمه وطلب منه ألّا ينسى أن هذا الرجل هو أعظم مَن ولد في تاريخ العالم. ورغم أن الجد لم يكمل تعليمه إلا أنه أول مَن حقق اتصال حفيده بالحرف والكتاب (وعلينا أن نتذكر هذا الأمر جيدًا حتى يصل بنا قطار الحديث إلى محطة “سارتر”)
كان “ماركيز” ابن خمس سنوات، يوم أخذه جده في جولة للتعرف على الحيوانات في السيرك، وبعد أن رجعا إلى البيت وضع الجد “معجمًا ضخمًا مصورًا” في حضن حفيده وقال له:
“هذا الكتاب لا يعرف كل شيء وحسب، وإنما هو الكتاب الوحيد الذي لا يخطئ أبدًا”، كان “ماركيز” حينها لا يعرف القراءة أو الكتابة، لكن معجمًا من ألفيّ صفحة كبيرة، مزين بالصور والرسوم البديعة، قد سحر الطفل، فسأل جده: “كم كلمة في المعجم؟” فأجابه جده: “كل الكلمات!”.
لم يتعلم “ماركيز” القراءة بسهولة، بل كلفته مشقة كبيرة جدًا، وظل فاشلًا في الإملاء، مما سبب معاناة ضخمة تكبدها المصححون أثناء تصحيح مسودات رواياته! أدمن “ماركيز” القراءة، وحفظ قصائد من الشعر الشعبي، وكذلك أجمل أشعار العصر الذهبي الأسباني، لكن الكتابة السليمة كانت تمثل له مأساة، كانت أمه تخفي عن والده رسائله كي لا يموت غمًا وحزنًا على ابنه! وقد أعلنها صراحة: “لا يمكنني أن أفهم أبدًا لماذا هناك حروف لا تنطق؟ لماذا يوجد حرفان مختلفان لهما المنطوق نفسه؟ لماذا الكثير من القواعد غير المجدية؟”
أول كتاب استطاع ماركيز أن يقرأه كان مفككًا وغير مكتمل لكنه جذبه بشده، وبعد سنوات علم أن هذا الكتاب هو “ألف ليلة وليلة” وكانت القصة التي أعجبته، هي أقصر وأبسط قصة، ويقول عنها أنها أفضل قصة قرأها في حياته، والقصة تقول: “وعد صياد جارته بأن يهدي إليها أول سمكة يصطادها، إذا ما قدمت له قطعة رصاص، من أجل شبكته، وعندما تشق المرأة السمكة لكي تقليها، تجد داخلها ماسة بحجم حبة لوز!”
لقد فجر “ماركيز” من الفقر، والجوع، والقمل، وصلابة أمه ينابيعًا من الفرح والضحكات الصاخبة، وأشاع جوًا من التفاؤل والبهجة في كل صفحة من صفحات كتابه الضخم.
بلغت أمه ذروة اليأس في إيجاد ما يسد رمق أولادها، فأرسلته إلى رجل ثري، معروف بإحسانه وسخائه، فيقول ماركيز: “حملتني أمي رسالة غم بلا مواربة، تطلب من الثري مساعدة مادية مستعجلة، ليس باسمها، لأنها قادرة على تحمل أي شيء، ولكن حبًا في أبنائها”. طرق ماركيز باب الرجل المحسن الطيب مرات ومرات، والرجل يتهرب، وبعد تكرار محاولات “ماركيز” لمدة ثلاث أسابيع، أمر الرجل إحدى خادماته أن تخبره بأن هذا البيت ليس بيت صدقات! تجول “ماركيز” في الشوارع الملتهبة، وبعد أن استجمع شجاعته، أخبر والدته أن المحسن الطيب مات! وظلت الأم تبكيه وتذكر كرمه وتدعو له بالراحة الأبدية، حتى سمعت في المذياع بعد خمس سنوات أن المحسن الثري توفى بالأمس! ظل “ماركيز” متيبسًا كالصنم ينتظر رد فعل أمه، لكن الأم سمعت الخبر باهتمام وتأثر شديدين، ثم تنهدت من أعماق قلبها وقالت: “فليحفظه الرب في ملكوته المقدس!”
لقد ظل “ماركيز” سنوات طويلة لا يملك سوى غيار واحد يغسله تحت “الدوش” وينتظره حتى يجف، لا يملك مالًا، ليس لديه سوى حقيبة جلدية فاخرة سرقها من صالة شاي راقية، كان يحملها أينما ذهب، ويضع فيها أصول كتاباته، وهي الأشياء الوحيدة التي يمكن أن يفقدها، ولهذا فقد كان لا يتركها أبدًا، ولا يأتمن عليها البنوك! الشخص الوحيد الذي استطاع “ماركيز” أن يأتمنه على هذه الحقيبة، هو بواب الفندق، الذي كان يأخذها كضمان لأجرة الغرفة، حيث عرف البواب ما فيها من قصاصات ورقية مكتوبة على الآلة الكاتبة، فحجزها عنده حتى يدفع ماركيز الأجرة، وبالفعل أحضر “ماركيز” الأجرة المطلوبة في صباح اليوم التالي.
كان “ماركيز” يستخدم هذه الحقيبة كرهن كلما عجز عن سداد إيجار الغرفة، والمضحك أن الأمر صار اتفاقًا ضمنيًا، فإذا لم يجد لديه مالًا، وضع الحقيبة أمام البواب على مكتب الاستقبال، ويذهب ليأخذ مفتاح غرفته من لوحة المفاتيح، ويصعد إلى حجرته في صمت! والعجيب أن هذا البواب كان يستشعر دائمًا حاجة “ماركيز” للمال، وأنه لا يجد مأوى لينام، فيضع في يده البيزو ونصف لكي يدفع أجرة السرير، ويتمكن من النوم! نسي “ماركيز” هذه الحقيبة ذات يوم داخل أحد سيارات الأجرة، ولولا أن صديقًا له أعلن من خلال أشهر جريدة في المدينة عن أن ماركيز الكاتب الذي يحبه القراء فقد حقيبته، ما استطاع الحصول على أوراقه التي بداخلها، فقد أعاد السائق الأوراق للجريدة، لكنه احتفظ لنفسه بالحقيبة السحرية!
هذا هو “ماركيز” المتفائل الضاحك، الذي يملك قلبًا لا يعرف كرهًا أو حقدًا، رجل يعيش في سلام نفسي، ويعرف مقدار ضعفة، لكنه يعشق الحياة، يحب هيئته التي هو عليها، وسعيد بصدقه وصراحته وجميع خصاله حتى القبيحة منها، فهو المتصالح مع ذاته.
على النقيض من ذلك يأتي “جان بول سارتر” الذي يفلسف كل شيء، ولا يرضى بملامح وجهه حين يشاهدها في المرآة، أو حين يراها ساكنة في أحداق من يقفون أمامه! يرى أن أقرب الناس إليه، لا يحبونه إلا لغرض!
ولد “سارتر” في باريس في ٢١/٦/١٩٠٥، ومن خلال كتابه “كلمات” نتعرف جيدًا على طفولته. كلمة السر عنده هو جده لأمه، وأمه هي مفتاح شخصيته، أمه، التي لا يعرف إن كان يحبها أو أنه يكرهها! حتى والده الذي لم تستمر رحلته في الحياة طويلًا، ومات تاركًا زوجة شابة وطفل لم يتجاوز عامه الأول، حين كبر هذا الطفل كان في شك من حب والده، وهل لو طالت به الحياة كان سيمارس سطوة الأب عليه ويضغط بحذائه على صدره ليقتله؟ أم سيكون أبًا رحيمًا؟
تزوج “شارل شوايتزر” معلم اللغة الألمانية من “لويز جيمان” التي كانت تكرهه، وتنفر منه، وتنام في غرفة مستقلة بعيدة عنه، ومع ذلك أنجبت طفلين هما جورج وإيميل والطفلة “آن ماري” التي ستصبح فيما بعد أمًا لفيلسوفنا! وكما اعتادت “لويز” ملازمة الفراش، والبعد عن الضوضاء، اعتادت طفلتها “آن ماري” الجلوس على مقعد كأنها فتاة كسيحة، ورغم نضارتها وجمالها، فقد علموها الضجر، كما علموها الخياطة، والبعد عن الناس، فلم تلحظ “آن ماري” أنها جميلة إلا بعد أن تصفحت صور الأسرة وهي في الخمسين من عمرها!
في الوقت نفسه تزوج الدكتور “سارتر” من ابنة أحد أصحاب الأملاك الأغنياء لعله يصبح غنيًا، وعند الزفاف اكتشف أن والد عروسه لا يملك شيئًا، ومن شدة غيظه، استمر مع زوجته أربعين سنة لا يوجه إليها كلامًا، ويكتفي بلغة الإشارة حتى على المائدة! ومع ذلك كان يشاركها الفراش، وينجب منها بين الحين والآخر، فأعطته ولدين هما “جان باتيست” وهو والد فيلسوفنا، وجوزيف، وابنة اسمها “هيلين”. ومع أن سارتر يتناول في كتابه الفترة التي قضاها في بيت جده لأمه، إلا أنه لم يذكر اسم جدته!
كان والد “جان بول سارتر” ضابطًا في البحرية، تزوج “آن ماري” وأنجب منها، وثم لجأ إلى الموت سريعًا ليختبئ من الرضيع الذي سيحير العالم بأفكاره التي لا سقف لها! بعد وفاة الزوج رجعت “آن ماري” إلى بيت والدها “شارل شوايتزر” تحمل ابنها الرضيع. أنهك السهر والهموم الأرملة الشابة، فجف لبنها، وعهدت إلى مرضعات ليكملن مع الطفل الضعيف مسيرة الرضاعة، وحاولت هي أن تلجأ إلى الموت لكنها فشلت! يقول سارتر: “ولما كنت مريضًا ومفطومًا بالقوة في شهري التاسع، فإن الحمى والتهافت الجسمي منعاني من الشعور بآخر حز للمقص الذي يقطع الروابط بين الأم والولد! لقد انغمست في عالم مشوش، تسكنه أوهام بسيطة وأصنام خشنة، وعند موت أبي استيقظت أنا وآن ماري من كابوس مشترك؛ وشُفيت. ولكننا وقعنا ضحية سوء تفاهم، لقد عادت من حب إلى ابن لم تكن قد تخلت عنه قط تخليًا حقيقيًا واستعدت أنا وعيي على ركبتي سيدة غريبة”
كانت آن ماري الأم الشابة تشعر في بيت أبيها بالغربة، وبتسلط أمها وغيرتها الشديدة، ولم يكن الأب فظًا غليظ القلب، ولكنه أيضًا لم يكن رحيمًا عليها، يقول سارتر عن جده لأمه: “لم يمنع عن أمي مصروفها الشخصي ولكن كان ينسى أن يعطيها هذا المصروف، لقد استعملت أمي ملابسها كلها حتى بُليت دون أن يفكر جدي في تجديدها، وبالكاد كان يجيز لها الخروج وحدها”.
كان سارتر شديد الحزن، مفرط في الكآبة والغم، بل كان يعد هذا الحزن من أعظم فضائله، وكانت رؤيته لكل المحيطين به شاذة وشديدة التعقيد! يقول عن أبيه: “لا يوجد أب طيب، تلك هي القاعدة؛ ويجب ألا نلوم الرجال على ذلك، بل نلوم رباط الأبوة المتعفن. ليس هناك أحسن من إنجاب الأطفال، ولكن يا له من ظلم حين نُرَزق بهم! ولو عاش أبي لرقد عليَّ بكل طوله وسحقني. وبالصدفة مات صغيرًا، وأنا في وسط الأبناء الذين يحملون آباءهم، أعبر من ضفة إلى أخرى بمفردي، كارهًا هؤلاء الآباء المحتجبين الراكبين على ظهور أولادهم مدى الحياة، لقد تركت خلفي شابًا ميتًا لم يمتد به الزمن ليكون أبي، وكان من الممكن أن يصبح اليوم ابني!”
هذا الأب الذي مات سريعًا، حرم ابنه من لذة التعرف عليه، فكف عنه بذلك مؤونة أن يذكره، ومؤونة أن ينساه! وعاش “سارتر” عمره كله مندهشًا من القدر الضئيل الذي يعلمه عن والده، فلم يهتم أحد من عائلة هذا الطفل “المختلف” بذكر أشياء ولو قليلة عن أبيه، فكان الأب عبارة عن صورة تم تعليقها فوق سريره، وعندما تزوجت أمه للمرة الثانية اختفت الصورة إلى الأبد!
أما العملاقة الشابة، والتي يقولون له أنها أمه، فلا يعتبرها هكذا! إن هذه العذراء الدنسة، والقاصرة المحددة إقامتها والخاضعة للكل يراها سارتر شقيقته الكبرى، ويراها أيضًا قد جاءت لتكون خادمته، يقول: “إني أحبها، ولكن كيف لي أن أحترمها، لا أحد يحترمها؟ توجد ثلاث غرف في منزلنا، غرفة جدي، وغرفة جدتي، وغرفة للأولاد، إن الأولاد هم “أنا وهي” فكلانا قاصر، وكلانا معال! ولكن كل الرعاية كانت موجهة لي”.
كان “سارتر” حائرًا بين الرب الذي أنكره، والأب الميت الذي لا يعرفه، والجد العجوز الذي وجده صدفةً وخالطه مرغمًا! يقول: “إن إله الغضب هذا كان يتغذى على دم أبنائه، ولكني ظهرت في نهاية حياته الطويلة، فقد ابيضت لحيته واصفرت من الدخان ولم تعد الأبوة تسليه، ومع ذلك فلو أني كنت ابنه فإني أعتقد جيدًا أنه لم يكن يتوانى عن استعبادي بحكم العادة. كذلك كان حظي أنني كنت مِلكًا لميت، ميت سكب بعض النقط من المني، هي الثمن العادي لطفل. وكنت قبسًا من الشمس، في استطاعة جدي أن يتمتع بي دون أن يمتلكني، كنت أعجوبته لأنه كان يتمنى أن ينهي أيامه شيخًا مذهولًا، وقرر أن يعتبرني مِنَةً فريدةً من القدر، هبة مجانية قابلة للإلغاء دائمًا!.. والحقيقة إن انسحاب والدي السريع قد وهبني أوديبًا متناهيًا في النقصان، صحيح أن عقدة “الأنا العليا” غير موجودة ولكن لا وجود لمركب العدوان أيضًا، فأمي كانت لي، ولم يكن أحد يعترض على ملكيتي الهادئة لها، كنت أجهل العنف والكراهية، وكفوني مؤونة التدرب القاسي على الغيرة!.. كنت أسمح بلطف بأن يلبسوني حذائي، ويضعوا نقطًا في أنفي، ويُفَرّشوا ملابسي، ويغسلوني، ويلبسوني الملابس، وينزعوها عني، ويزينونني، وينظفونني، فليس هناك ما يسلي أكثر من أن تلعب دور العقلاء، وأنا لا أبكي أبدًا وقلما أضحك، ولا أضج!.. أنا أرض جدباء للشر، ولما كنت أمثل الفضيلة، فإني لا أجهد نفسي ولا أقهرها قط، كنت أخترع، ولي حرية الممثل الواسعة، الذي يجذب جمهوره، وفرط في الاعتناء بدوره، إنهم يعبدونني، فأنا مستحق إذن للعبادة، ولا غرابة في ذلك، ما دام العالم قد أحسن صنعه!
يقولون لي إني جميل فأصدق، وقد ظهرت منذ بعض الوقت على عيني اليمنى الغشاوة التي سوف تجعلني أعور وأحول، لكن شيئًا من هذا لم يظهر بعد، إنهم يلتقطون لي مئة صورة تنقحها أمي بأقلام ملونة.. لا عجب إن كان للسعادة التافهة لسنواتي الأولى طعم الموت أحيانًا، إني أدين بحريتي لوفاة حدثت في الوقت المناسب (يقصد وفاة أبيه) وبأهميتي لوفاة ستحدث قريبًا (يقصد وفاة جده) كان جدي يحب مضايقة أولاده، لقد أمضى هذا الوالد المرعب حياته في سحقهم، كانوا يدخلون على أطراف أصابعهم، ويفاجئونه على ركبتي طفل.. إن لم تنجب فلترب كلبًا، ففي مدافن الكلاب حين كنت أزورها في العام الماضي (١٩٦٢) وفي الكلمة المأثورة التي تتتابع من قبر إلى قبر، عرفت حكم جدي، إن الكلاب تعرف كيف تحب، إنها أحن من الناس وأشد إخلاصًا منهم، إنها فَطِنة ولها غريزة بلا شوائب، تسمح لها بالتعرف على الخير، والتمييز بين الصالحين والطالحين، لقد كتبت إحدى الثكالى على قبر كلبها “أي بولونيوس أنت أحسن مني، فلم يكن في إمكانك أن تعيش بعدي، بينما أعيش أنا بعدك” وكان يصحبني صديق أمريكي، ركل من الغيظ كلبًا مصنوعًا من الأسمنت فكسر أذنه، لقد كان على حق، فإننا حين نبالغ في حبنا للأطفال والحيوانات فإننا نحبهم بدلًا من حبنا للناس!”
كلمات سارتر التي جعلها تصف الفترة التي عاشها بين ١٩٠٥ و ١٩١٤، يقول فيها: “ظللت وحيدًا بين رجل عجوز وامرأتين حتى العاشرة من عمري”! تلك الوحدة خلقت شخصيته التي لا تعرف الاستسلام لأي شيء، وبلورت تفكيره الرافض لكل موروث، ومع هذا يقول: “إن القبلة بدون شارب – كما كانوا يقولون آنئذ – كالبيضة بلا ملح؛ وأضيف: وكالخير بدون شر، كحياتي بين ١٩٠٥ و١٩١٤، وإن كنا لا نعرف أنفسنا إلا بالتضاد، فقد كنت “اللامُعرَّف” بلحمه وعظمه، وإن كان الحب والكراهية هما وجه النوط نفسه وظهره، فإني لم أكن أحب شيئًا ولا إنسانًا، كان ذلك حسنًا، فلا يمكن أن نكره ونكون موضع رضا الآخرين في وقت واحد، ولا أن نرضى ونحب، هل أنا نرجسي إذن؟ ولا حتى ذلك!.. إن حقيقتي وخلقي واسمي كانت في أيدي الكبار! فقد تعلمت أن أرى نفسي بعيونهم، كنت طفلًا، هذا المسخ الذي يصنعونه بتأسفاتهم، فإذا غابوا تركوا خلفهم نظرتهم الممزوجة بالضوء، كنت أجري وأقفز خلال هذه النظرة، التي كانت تحفظ لي طبيعة الحفيد النموذجي، والتي كانت تستمر في إهدائي لعبي والكون، في قمقمي الجميل، في روحي، كانت أفكاري تدور، كان كل واحد منهم يستطيع أن يتابع حيلها، فلا يوجد فيها ركن مظلم واحد.. ومع ذلك كنت دجالًا.. كنت مع جدي نقوم بتمثيل دور الحب الكبير.. كنت طفلًا مزورًا!”
أما رؤية “سارتر” للدين فيقول أن دينه هو “الكتاب” وليس لديه ما هو أهم من الكتاب، الذي يجد فيه معبده، ولأنه كان حفيد قسيس، فقد عاش على سقف العالم. إن الذي وضع الكتاب أمامه هو جده لأمه، وهو الذي حدثه عن المؤلفين، يقول: “علمني جدي أسماء هؤلاء الرجال العظام، من هزيود إلى فيكتور هوجو، وكان هؤلاء الرجال العظام هم القديسين والأنبياء، وكان جدي “شارل شفايتزر” يقول إنه يخصهم بنوع من العبادة.. إن جدي رجل من القرن التاسع عشر، يفرض على حفيده الأفكار التي سادت عصر الملك “لويس فيليب” وهكذا كما يقول الريفيون، الآباء يذهبون إلى الحقول تاركين أولادهم في أيدي الأجداد، لقد انطلقت متأخرًا ثمانين سنة، إن في مجتمعاتنا المتحركة يعطي التأخير أحيانًا بعض التقدم، لقد ألقى إليَّ بهذه العظمة لأقرضها، وقمت بقرضها جيدًا بحيث أصبحت أرى الضوء من خلالها، إن هؤلاء الناس الطيبين – الكُتاب – كانوا يشبهونني، حين كنت عاقلًا جدًا وحين كنت أتحمل بشجاعة آلامي، وكنت استحق أغصان الغار أو مكافأة، ولكن تلك كانت الطفولة! وهؤلاء الكتاب في نظري لم يموتوا، بل تحولوا إلى كُتب”
كان “سارتر” بنظرته السوداوية، يشعر دائمًا أن عائلته تستهلكه، وتستخدمه كي تستشعر السعادة وتستجلب البهجة لنفسها! يقول عن أقرب الناس إليه “جده وجدته وأمه”: “كنت أعكس لهم وحدة العائلة وتناقضاتها القديمة، في الوقت الذي كانت احتفالاتهم تقنعني بأن لا شيء يوجد بدون سبب، وأن لكل إنسان من الأكبر إلى الأصغر مكانه المعلوم في الكون، أما سبب وجودي أنا فإنه كان يتوارى، لقد اكتشفت فجأة أنني أساوي “الزبدة” وإنني خجل من وجودي غير العادي في هذا العالم المنظم، لو كان لي أب لأثقلني ببعض إصراره الدائم، وبصنعه مبادئي من أمزجته، ومعرفتي من جهله، وكبريائي من حقده، وقانوني من هوسه، ولاحتل نفسي وأعطاني هذا المستأجر احترامي لنفسي، وأسست على الاحترام حقي في الحياة، ولقرر من وهبني الحياة مستقبلي، ولو كنت مهندسًا بالولادة لنعمت بالًا مدى الحياة، ولكن لو فُرِضَ وعرف “جان باتيست سارتر” -والدي- مصيري لحمل سره معه، إن أمي تذكر فقط أنه قال: “إن ابني لن يدخل البحرية” ولعدم وجود معلومات أدق، لم يكن أحد يعرف ابتداءً مني ما الذي جئت أفعله على الأرض؟”.
أخيرًا وختامًا لكل ما في كلمات “جان بول سارتر” من سوداوية وعدمية، وشعور بالدونية والنقص، وعقد نفسية، يراها البعض أنها عبقرية، يقول سارتر عن نفسه: “ولما كنت حشرة طفيلية مشدوهة، بلا إيمان، وبلا قانون، وبلا عقل ولا مصير، كنت أهرب إلى المهزلة العائلية دائرًا، جاريًا وطائرًا، من خدعة إلى خدعة، وكنت أهرب من جسمي الذي لا مبرر له، ومن نجواه الضعيفة، وكالنحلة التي تصطدم بعقبة فتتوقف، فإن الممثل الصغير الشارد كان يسقط في الذهول الحيواني، قالت بعض الصديقات الطيبات لأمي أنني حزين، وأنهن فاجأنني وأنا أحلم، فضمتني أمي إليها وهي تضحك، وقالت لي: “أنت المَرِح الذي تغني دائمًا! مما تشكو؟ فلديك كل ما تريد”! كانت أمي على حق، فالطفل المدلل لا يكون حزينًا، إنه يضجر كالملك، كالكلب، أنا كلب، إني أتثاءب، والدموع تسيل، إني أشعر بها وهي تسيل! أنا شجرة، الريح تتعلق بأغصاني وتهزها بغموض، أنا ذبابة، أتسلق بزجاج الشباك، وأتدحرج وأعيد التسلق، وأحيانًا أشعر بملامسة الزمن الذي يمضي، وأحيانًا أخرى -وهي الأكثر- أشعر بأنه لا يمضي!
وأخيرًا وكما يؤمن سارتر: “إن الحياة أكثر لا معقولية والموت أقل مكابدة”.. “إن الموت هو التطرف في الجنون والغرق فيه”.. “إن القيادة والطاعة شيء واحد”.. “إن الحقيقة والخرافة شيء واحد”.. “إن الإنسان كائن مظهري، والعلاقات البشرية مزيفة، حيث خلقنا لكي نمثل على أنفسنا”!
لك أن تتخيل أن كل هذا الحزن وكل هذه الكآبة والعقد النفسية هي ما كابده طفل في التاسعة من عمره، منذ أن ولد في عام ١٩٠٥ وحتى ١٩١٤، يرويها لنا “جان بول سارتر” في مئتين وخمسة وعشرين صفحة، أطلق على هذه الأحزان “كلمات” تلك الكلمات التي شكلت شخصيته وخلقت منه فيلسوفًا يرفض أن يتسلم جائزة نوبل عام ١٩٦٤.