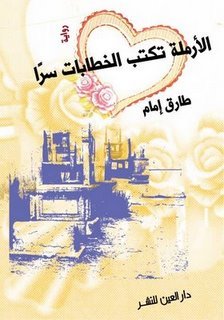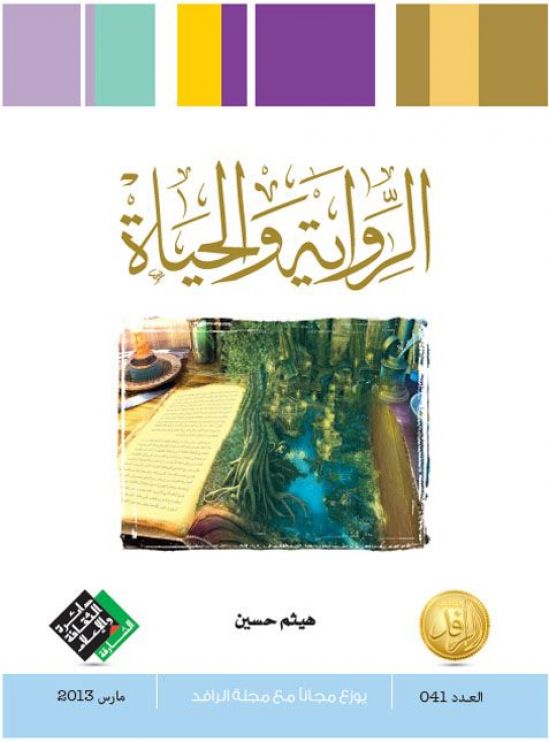إبراهيم فرغلي
قليلة هى الكتب التى تمثل قراءتها حالة خاصة وتجعل المرء يتعلق بها لدرجة أن تحفر فى ذاكرته ليس تفاصيل النص فقط، بل وأجواء قراءتها ومكانها، وربما الأثر الذى يتسرب إلى النفس من هذه القراءة.
بين هذه الكتب تأتى فى الصدارة مجموعة «بالأمس حلمت بك» للأستاذ بهاء طاهر، التى كانت أول الأعمال التى قرأتها له.وأعترف، أننى، مقارنة بغيره من جيل الستينيات تأخرت نسبياً فى التعرف على نصوصه الأدبية، حتى مطلع التسعينيات وربما كان عمرى آنذاك 22 عاماً.
استدعت قراءة هذا الكتاب الفاتن بعض كتابات محمد المخزنجى، الذى كنت قرأت كل ما كتبه آنذاك وتيمت بأعماله. كان فى نصوص بهاء طاهر هذا الهمس الذى ينتقل إليك عبر السرد، لكنه يعبر عن معان إنسانية عميقة ودلالات بالغة التكثيف. سرد يناجى شيئاً فى روحك، وربما يربت عليها أيضاً. أما على مستوى التقنية أو المعالجة السردية فثمة رؤى تخلط الواقع بالأوهام، وهى الأجواء التى أفضلها فى السرد بشكل عام.
ما زلت أذكر، ليس فقط موضع قراءتى للكتاب الذى قرأته دفعة واحدة، بل وحتى الكرسى الذى جلست إليه بينما أقرأ الكتاب، فى الشقة التى استأجرتها عند انتقالى من المنصورة للقاهرة للعمل فى الصحافة، فى منطقة المنيل.
أظننى أدركت آنذاك معنى أن تقرأ «سحراً». أو بالأحرى اكتشفت الأمر ولكنى لم أكن أعرف كيف أصفه. لكنى قلت لنفسى إن المخزنجى امتداد لهذه العذوبة وهذا السحر. ولعلهما يشتركان أيضاً فى رهافة السرد ودقته. مع الأخذ فى الاعتبار أن أعمال المخزنجى فى غالبيتها قصصية مكثفة، بينما أعمال بهاء طاهر الروائية تميل لشكل القصة الطويلة أو النوفيلا.
السحر هنا يعنى التعلق بالشخصيات التى تلاحق الذاكرة، كأنها تنتقل للحياة من الكتاب إلى وعيك، بعدما تنفذ إلى روحك مع القراءة الأولى. والحقيقة أن هذا السحر سيتخذ أشكالاً أخرى متباينة من بينها معالجة بهاء طاهر لحالة الصوفية بأشكال مختلفة، ليس فقط فى الأعمال التى تناولت الأمر بشكل صريح مثل «نقطة النور»، لا، بل فى مجمل أعماله.
كان بهاء طاهر يمنحنى فرصة فهم فكرة شفافية الروح، ومكانة القلب فى عالم العقل، وهو ما سوف أرى أثراً له فى أعمال أخرى مثل «الحب فى المنفى»، أو حتى فى ترجمته البديعة لرواية باولو كويلهو «ساحر الصحراء»، الذى تغير فى ترجمات لاحقة إلى «الخيميائى»، فقد انتبه لها، واختار أن يترجمها، لأنها تتماس مع هذا العالم الروحى الغنى المفعم بالأسئلة العقلية التى تثيرها ألغاز الروح. بدأت بـ«بالأمس حلمت بك»، التى غدت جملة أرددها ليلاً ونهاراً بينى وبين نفسى، كالمهووس. ثم انتقلت إلى عمل قصصى آخر هو «أنا الملك جئت»، ولعلها كانت فى نفس الكتاب. وبطبيعة الحال كنت أيضا أتأمل التجديد فى السرد لدى بهاء طاهر، التقشف اللغوى مقابل شحنه عاطفياً، والجمل التقريرية القصيرة المكثفة والدالة، واستخدام ضمير المتكلم، وهى من بين سمات التحديث السردى التى عرف بها أغلب جيل الستينيات، وكنت أرى فى أسلوبه المكثف تقارباً مع أسلوب صنع الله إبراهيم الذى تعرفت على أعماله فى نفس التوقيت تقريباً. لكن كانت العوالم مختلفة بالتأكيد، إضافة للتقنيات واللغة.
قرأت «قالت ضحى»، ثم «خالتى صفية والدير»،التى كانت صدرت قريباً من تلك الفترة، أظن فى عام 1991. تحكى الرواية عن صفية؛ وهى فتاة قروية جميلة تقيم مع بعض أقاربها وتحب ابن عمها حربى، الذى لم يدرك مدى حبها له، لذلك يخطط لزواجها من البك القنصل الغنى، أحد أبرز الوجهاء فى القرية. وتوافق صفية على الزواج من البك رغم فارق السن الكبير ولكنها لا تغفر لحربى تجاهله لحبها. وتتوالى أحداث الرواية وتنجب صفية الطفل حسان وتحقق حلم البك الذى طال انتظاره، ومع تطور الأحداث يتعرض حسان للاعتداء، فتغتنم صفية الفرصة للانتقام من حربى، وتقنع زوجها أن حربى هو الفاعل، إلى آخر الأحداث.
المهم أن أسباب الاهتمام الإعلامى الكبير بالرواية آنذاك تعود إلى صدورها فى فترة كانت قد شهدت عدة عمليات إرهابية فُجرت فيها مقاهٍ بوسط البلد وحافلات للسياح فى شارع الهرم، وفى خارج القاهرة أيضاً، بالإضافة إلى عمليات اغتيال وزاء ومسئولين، ولذلك ركزت الأقلام الصحفية والنقدية التى تناولت الرواية على فكرة التعايش بين الأقباط والمسلمين التى توحى بها الرواية.
ومن الصفحات الأولى للرواية فعلاً يرى القارئ ما تعكسه المشاهد السردية من مظاهر الترابط بين أهل القرية بكل أطيافهم الدينية: شيخ أزهرى يصطحب ابنه إلى الدير، ليهنئ رهباناً بأعيادهم، وطفل مسلم يحمل الكعك إلى مسيحيين، وقبطى آخر يرشد الفلاحين المسلمين لعملية الزراعة الصحيحة. وتسرى فى القصة مشاعر احترام يكنها مجتمع القرية لرهبان يتعبدون فى صوامعهم، وحتى فى أشد لحظات الغضب.
وأذكر أن عودته من جنيف صادفت النصف الثانى من التسعينيات. وأذكر أن لقائى الأول به كان فى معرض القاهرة للكتاب، ربما فى بداية العام 1998. وكان ثمة حفاوة بعودة الكاتب الذى عاش فى الغرب مطولاً، فى سويسرا تحديداً، ليستقر فى القاهرة.وحياته فى الخارج تجربة لها أثر كبير فى تناوله لهذه العلاقة المعقدة بين الشرق والغرب؛ بعذوبة وحساسية شديدتين.خصوصاً فى روايته البديعة «الحب فى المنفى».
وأظن أن مقهى معرض الكتاب كان مكان لقائنا الأول.كان وجهه يحمل ابتسامة يوحى بها لمن يحدثه لأول مرة أنه يعرفه منذ زمن بعيد. يسأل ويحاول أن يفهم.أظننى طلبت أن أجرى معه حوارا حول «الحب فى المنفى»، وهذه الرواية من بين رواياته الأحب إلى قلبى.
وبدأت بعدها علاقة طويلة، سواء بالصدفة فى مقاهٍ مختلفة وخاصة فى مقهى «الندوة الثقافية»، فى باب اللوق قريباً من مقهى «الحرية»، إذ كانت بين المقاهى المفضلة لنا فى تلك الفترة. أذكر مثلاً أننى كنت أذهب فى بعض الصباحات لتناول القهوة وقراءة الصحف فأجده هناك. نقضى وقتاً ممتعاً، أستمع إليه وهو يتحدث عن كتابته وحياته الشخصية وابنتيه أحياناً.
وفى أحيان أخرى تكون اللقاءات فى حى الزمالك قريباً من بيته. ولذلك فإننى كنت أفاجأ دائماً بقدومه لحضور أى حفل توقيع لكتاب من كتبى فى مكتبة «ديوان» إذ تقع فى مواجهة العمارة التى يقطنها تقريباً. كان حريصاً على قراءة أعمالنا ومناقشتنا حولها أيضاً.
فى إحدى دورات مؤتمر الرواية العربية كنا نترقب فوزه بالجائزة، وإن كنت نسيت الآن أى دورة. ترقبنا الأمر أولاً لأنه يستحق أى جائزة بشكل عام، وثانياً لأن أغلب التوقعات كانت تميل لاختيار كاتب مصرى فى تلك الدورة. ولكنى أذكر من حواراتى مع بعض الزملاء آنذاك أننا كنا نتمنى فوزه لأننا نعرف مدى حساسيته الشديدة، وكنا نشعر أنه يترقب الجائزة أيضاً بشكل ما. كانت هناك حالة تقدير كبيرة لبهاء طاهر وعذوبته. ولعل هذا ما كان يمنحنى الإحساس بأنه كاتب يشبه كتابته والعكس، وربما لهذا أيضاً كانت سعادتى بشكل شخصى غامرة حين حصل على جائزة البوكر فى دورتها الأولى عام 2008 عن روايته «واحة الغروب».
بهاء طاهر كاتب كبير وإنسان استثنائى ومعلم، وصديق حقيقى من أولئك الأصدقاء الذين يسعد الإنسان بمجرد رؤيتهم. أضاف لخبراتنا فى الكتابة وفى الحياة وفى التواضع والإنسانية، رحمه الله.