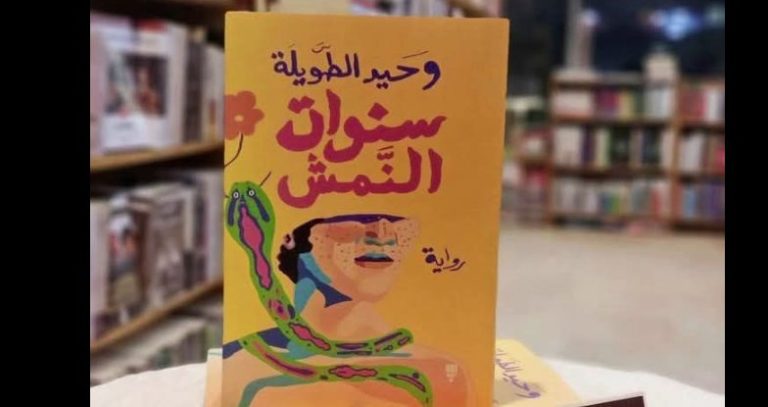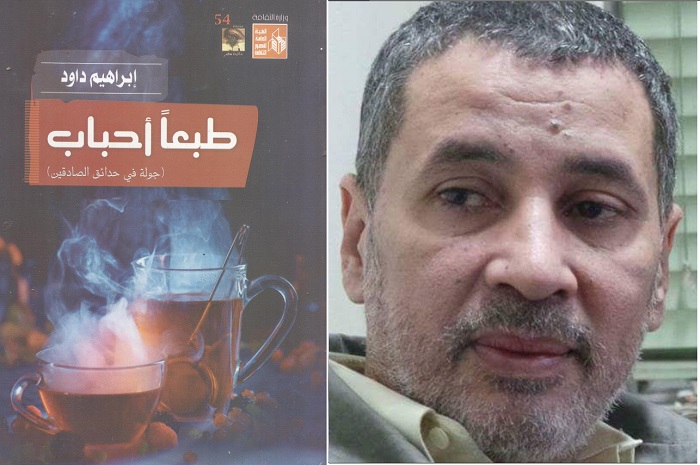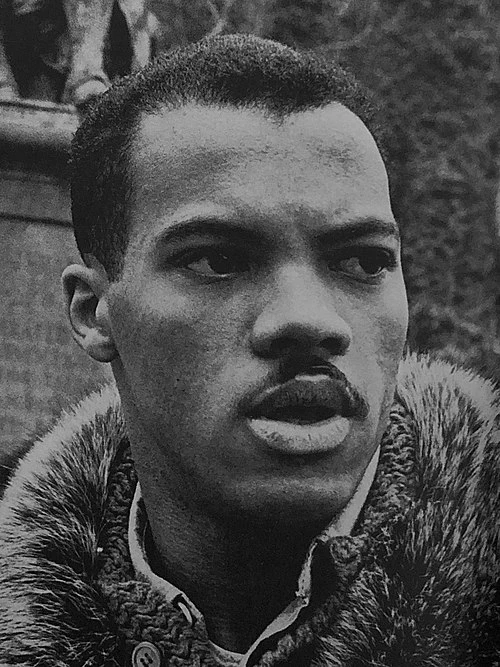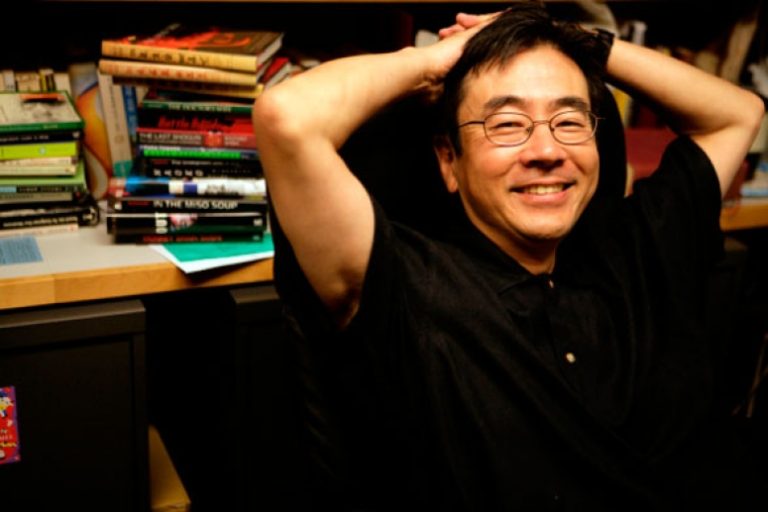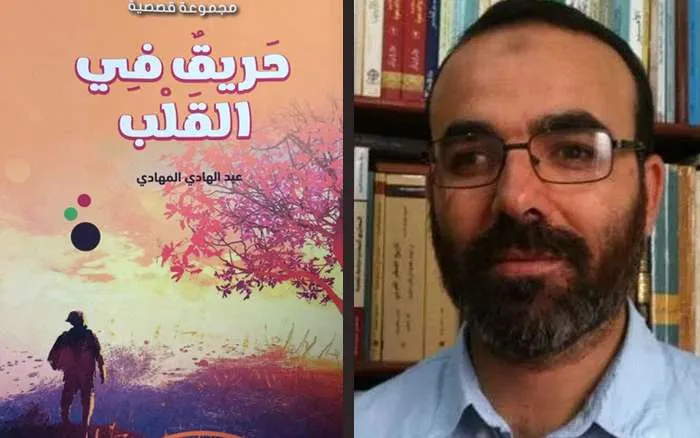د. عزة مازن
تأتي رواية “بريد الليل” (2018)، وهي الرواية السادسة للكاتبة الروائية اللبنانية هدى بركات، أيقونة إبداعية شديدة الخصوصية. استحقت الرواية الجائزة العالمية للرواية العربية – البوكر العربية – (2019) عن جدارة. وجاء في حيثيات الفوز، كما عبر عنها رئيس لجنة التحكيم، الأكاديمي والناقد المغربي شرف الدين ماجدولين، أن الرواية “تعبر عن تجربة في الكتابة الروائية شديدة الخصوصية بتكثيفها واقتصادها اللغوي وبنائها السردي وقدرتها على تصوير العمق الإنساني، ويتمثل تحديها الكبير بأنها استخدمت وسائل روائية شائعة وأفلحت في أن تبدع داخلها وأن تقنع القارىء بها”. وأضاف ياسر سليمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، أنه “في مجموعة مقننة من الرسائل، تتناول “بريد الليل” موضوعها الرئيس باقتصاد لغوي بالغ، يجعل كل كلمة من كلماتها لبنة محكمة تؤدي دورها في بناء فضاءات من المعاني المتقاربة – المتباعدة في آن واحد…. تسبر الرواية ثيماتها في هذا الفضاء بتمعن ومسائلة، ينمان عن صنعة روائية محكمة”.
وفي حديث خاص لهيئة الجائزة العالمية للرواية العربية، بعد ترشيحها للقائمة القصيرة، تقول هدى بركات عن “بريد الليل”: “إن ما دفعني إلى الشكل الأخير للرواية كان نفاذ مشاهد المهاجرين الهاربين من بلدانهم إلى وساوسي…. آمل أن تكون هذه الرواية قد أسمعت بهذا القدر أو ذاك أصوات حيوات هشة يتم إصدار الأحكام عليها دون فهمها أو استفتاء ما أوصلها إلى ما صارت إليه”. وفي حوار آخر عن روايتها أجرته معها جريدة الشرق الأوسط عام 2018، وقت صدور الرواية، تقول هدى بركات: “لا يقين كاملًا لدى هؤلاء الأشخاص. الاعترافات التي دونوها ليست في الحقيقة اعترافات، أغلبها كذب وغش وخداع، وأخبار عن قصص لم تحدث؛ لأن أحدًا لا يعرف ما هي الحقيقة”. وتضيف: “أساسًا لا يقين في العالم كله، مهاجرون يتركون بلادهم ولا يعرفون أين يذهبون…. ما أردت قوله في هذه الرواية، ما كان ليكتب إلا بهذه الطريقة…. هي رسائل مضمونها لا ينتظر جوابًا، ولا يؤدي إلى يقين”. وترى أن البوسطجي في الرواية “له رمزيته، بحيث إن دوره الوجودي برمته قد انتهى، ولم يعد له وظيفة فعلية لتأمين التواصل بين الناس…. لقد أصبحت الرسالة رمزًا لتواصل قد انقطع”.
“بريد الليل” رواية قصيرة (126 صفحة)، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: “خلف النافذة”، و”في المطار”، و”موت البوسطجي”. يستغرق القسم الأول معظم الرواية (94 صفحة) ويضم خمس رسائل كتبها أشخاص (بلا أسماء)، يعيشون في بلدان أوروبية، هربوا من بلادهم التي تستعر فيها نيران الحروب. يومىء السرد إلى أنهم تجمعوا في باريس وإلى أنهمم ينتمون إلى بلدان عربية. تبدو الرسائل الخمس، التي كتبها أصحابها في الليل، محاولين التغلب على وحدتهم ووحشتهم ببوح واعترافات غاب عنها اليقين، منفصلة، ولكنها متداخلة في متاهة حلزونية، فهي لا تصل إلى المرسل إليهم ، إنما إلى بعضهم البعض، حيث تتشابك المصائر ويلتقون في فضاءات الوحشة والغربة والإنكسار. تصل تيمة الليل بين الرسائل الخمسة، وتغلف السرد؛ ففي الليل تشتد وطأة الوحدة والإحساس بالعزلة وتشتد الرغبة في التواصل والبوح حتى لو كان اليقين المتزعزع يتخلل ثنايا كل الاعترافات. الرسالة الأولى يكتبها مهاجر، يلمح السرد إلى أنه هجر بلده العربي الذي تتقاذفه الحروب، إلى ذلك البلد الأوروبي. يتوجه السارد برسالته إلى عشيقة أوروبية، وهو ربما يكتبها لكسر العزلة والوحشة التي تزداد وطأتها في الليل. في السطور الأولى من الرسالة تلقي الكاتبة بخيوط السرد متشابكة ومتداخلة، على أن تنفرج متشظية في الرسائل التالية، وتزداد انفراجة في القسمين التاليين. في نبرة ساخرة يُستهل السرد في الرسالة الأولى: “عزيزتي، بما أنه هكذا يجب أن تبدأ الرسائل، إذن “عزيزتي”…”. تلقي الحروب ومشاعر الغربة والوحشة والوحدة بظلالها على الرسالة: “… علمت بأن القرية بكاملها أصبحت تحت الماء حين انهار السد عليها. لا أعرف إلى أين انتقلوا، أو نقلوهم…. كنت أنوي أن أكتب إلى أمي عن تلك اللحظة التي وضعتني فيها في القطار، وحدي، وأنا في الثامنة أو التاسعة من عمري. أعطتني رغيفًا وبيضتين مسلوقتين. قالت إن عمي ينتظرني في العاصمة، وإن علىَ أن أتعلم لأني أذكى إخوتي، وقالت لا تخف. لا تبك”. يكتب السارد رسالته ليبدد وحشته وعزلته في يوم يضطره فيه سقوط الثلج الذي لا ينقطع إلى البقاء في المنزل: “ولأنك رومنطيقية وتكتئبين ساعة المغيب، ولأنك تحبين الرسائل المكتوبة على ورق، يحملها إلى العلبة الصغيرة ساعي البريد في جعبة جلدية يعلقها بكتفه، سأكتب إليك رسالة. ربما تكون الرسالة الوحيدة في حياتي كلها، إرسالًا وإستلامًا. ولأن الثلج، من النوع اللئيم الممزوج بالمطر، لم ينقطع منذ الفجر، فسأبقى في البيت. لن أخرج في هذا الطقس، وسأكتب لك رسالة. الآن يجب أن أجد ما أعبئ به السطور والورق الأبيض”. يحكي السارد عن هروبه من بلده البعيد إلى ذلك البلد الأوروبي وما وجده من الذل والمهانة، لأنه لا يحمل أوراقًا رسمية، ومعاملته السادية لتلك الحبيبة، والتي كانت تعود إليه دائمًا رغم قسوته وسوء معاملته. يخبرها السارد بأنه يشعر بأن هناك من يراقبه من شرفة بالمبنى المجاور: ” حتى حين أطفئ النور وأتلصص عليه أجده مازال هناك ينظر ناحيتي، وابتسامة لئيمة ترفع شاربيه الكثين. كأنه يراني في مخبئي. كيف تفسرين ذلك؟ هل ستقولين إنها هذياناتي، وإنها البارانويا التي تصيب متعاطي الكوكايين؟ هل تعتقدين فعلًا أني مدمن”؟ وقت الحروب والمجاعات تضيع المشاعر، حتى عواطف الأمومة تموت. عن أمه يقول: “تلك المرأة قصفت عمري وشردتني في بلاد الله؛ البلاد التي كل سكانها غرباء؛ غرباء ويتامى. لم يصلني أنها بحثت عني يومًا…. كانت تعنى بالدجاجة المريضة…. تصلي للنعجة التي تتعثر ولادتها…. إلا أنا…. أنا لم يكن لي فائدة؛ لا بيض ولا حليب ولا لحم. كنت مجرد بطن فاغر فاه. ثم أبعدتني إلى مكان هي لا تعرف عنه شيئًا”. مغالبة وحشة الوحدة والشعور بالقهر وحدهما دافع السارد لكتابة رسالته التي يغيب اليقين عن كل ما يدلي بها من اعترافات: “انسي ما كتبته في هذه الرسالة. أردت فقط أن أكلمك وأطيل انشغالي بك لأني مشتاق إليك. تختلط أموري علىَّ حتى إني أشك في أني، في بعض ما كتبت، قصدت امرأة أخرى غيرك، أو ربما رجلًا آخر تخيلته توأمًا لي، أو شيئًا من هذا القبيل. انسي ما كتبت لأني أنا نفسي نسيته… هو الكوكايين”. لا شىء سوى الليل يغلف حياة السارد ويتغلغل إلى نفسه: “لو تأتين الآن لنسينا كل شىء معًا: قفي قربي وراء النافذة ولننظر معًا عبر الزجاج إلى هذا الليل الجميل…. فأنت لن تري سوى هذا الليل، لا شىء خلفه أو فوقه أو تحته”. تتوقف الرسالة في نهاية مبتورة تحبس أنفاس القارىء: “هذا الرجل قبالة نافذتي يراقبني. منذ مدة يراقبني. هو ليس شبيهًا بصاحب الشاربين الكثين. إنه هو نفسه! إنه أحد رجال المخابرات. هو رجل مخابرات أرسله من رفض تجديد جواز سفري في القنصلية. هذا مضحك؛ مضحك ومخيف في الوقت نفسه. ربما هي مناسبة لأشرح له الوضع ونتفاهم وجهًا لوجه… سأعود إليك”.
الرسالة الثانية تكتبها سيدة مسنة تنتظر حبيبًا قديما تعرفت إليه في صباها، تواعدا على اللقاء في فندق صغير في ذلك البلد أوروبي. تغلف الوحدة والوحشة ساعات انتظار المرأة الوحيدة في غرفة الفندق في الليل، فتعاين أغراض الغرفة وتتأملها. وفي تكثيف بالغ يلمح السرد إلى أن المرأة آتية من بلد مزقته الحروب: “كأني أعرفها، أو أن لها عندي مكانًا أو حكاية. أقول، مثلًا، إن مسكة باب الخزانة تشبه ما كنت رأيته عند عمتي، في شقتها القديمة التي تركتها أيام الحرب”. تعثر المرأة على رسالة في دليل الفندق، يفطن القارىء إلى أنها الرسالة السابقة، دون أن يعرف كيف وصلت إلى هناك. في قلب الليل، ورغبة في التغلب على الوحدة ووحشة الإنتظار تترك المرأة لخيالها العنان، تتأمل المسكوت عنه فيما يخص الرجل ورسالته وكيف وصلت إلى هناك. “إنه الفراغ، سيد الخيال والمعاني”. يجمع الليل ومشاعر الوحشة والغربة الرجل والمرأة، رغم أن لا شىء يربط بينهما سوى المدينة التي أتت إليها ورسالة “في دليل الفندق… تتحدث عن شاب كان كتبها في غرفة مفروشة رخيصة الإيجار في شارع شعبي قريب”. في رسالتها تكتب المرأة إلى حبيبها: “… كنت، وأنا أقرأ الرسالة، أكاد أسمع صوته؛ أكاد أرى ذلك الرجل المستوحش واقفًا وراء نافذته، ينظر إلى فراغ الليل وحيدًا…. لماذا أخبرك بهذا كله؟ كي أتسلى قليلًا وأنا أنتظر، ولأن وحشة ذلك الرجل، كاتب الرسالة، تشبه وحشتي كثيرًا… ولو أن حكايته لا تشبه حياتي في شىء. لكني أحسست بشكواه كأني صديقة قديمة، أو كأني أنا نفسي المرأة التي يتكلم إليها… “. تسيطر الحيرة واللايقين على رسالة المرأة أيضًا: “أنا دائمًا هكذا، أتأرجح بسهولة بين خيالي الخصب، أعني أوهامي، والواقع. أخلط كثيرًا بين ما هو وهم وما هو حقيقة، لكن ذلك لا يقلقني. إنه في الحقيقة يسليني كثيرًا”. تعترف المرأة أن رسالة الرجل حفزتها أن تفتح صندوق حكاياتها في رسالة إلى حبيبها: “أعتقد أن رسالة ذلك الرجل جرتني إلى هذه الحكايات ال… كنت أكتب إليك لأملأ انتظاري”. تتماهى المرأة مع الشاب كاتب الرسالة: “… رحت أتحرك في الغرفة كما كان يفعل في غرفته، بيته. فأذهب إلى النافذة كأننا نذهب إليها معًا. وأرفع الستارة لنتفرج على المطر. حتى إني كدت أكلمه بالصوت المسموع قبل أن أعي أنه لم يعد ينقصني سوى أن أكلم الأشباح”!. المرأة أيضًا آتية من بلد مزقته الحروب، ربما هو نفس بلد صاحب الرسالة. تحكي كيف التقت حبيبها في الماضي وسط جمال الطبيعة في قريتها، ولكن سرعان ما تستدرك: “لستُ هنا في هذه الغرفة كي أعود إلى الوراء، ولا كي أراك وأرى معك كيف كنتُ أنا صبية، وكيف كان الربيع جميلًا وقويًا في البلاد. البلاد التي انقضت، وقعت وتشظت كآنية كبيرة من زجاج”. في رسالة المرأة أيضًا يؤكد السرد على تزعزع اليقين: “تروي ذكريات لنا معًا، في رسالتك الأخيرة. أجهدت رأسي في الرجوع إلى ذلك الماضي ولم أجد شيئًا…. هل أنت من يخترع؟ أم أنا من يمحو؟ هل تخلط بيني وبين فتاة أخرى كنتَ التقيتها في البلاد ثم نسيت؟ ما ترويه عني لا يشبهني بالمرة”. لا تنهي المرأة رسالتها، بل ينقطع السرد فجأة، بعد أن ينتابها اليأس من حضور الحبيب وتقرر البقاء أملا في لقاء صاحب الرسالة: “أفكر الآن في إرجاء حجزي يومين أو ثلاثة أيام، لا لأعطيك مهلة أطول، فأنا أعرف أنك لن تأتي…. بل لأن شيئًا ما يقول لي إن كاتب الرسالة التي وجدتُها هنا سيعود…. صحيح أن الرسالة تبدو قديمة من أوراقها وهي لا تحمل أي إشارة تصلح للبحث عن كاتبها… وعلى الرغم من هذا سأحاول. ربما أعثر عليه في باريس؛ في أحد المقاهي التي تجمع الشبان العرب التائهين، الهاربين من شىء ما…. لا تختفي الناس هكذا، كالملح في الماء. وحين ألتقيه سوف…”.
في “بريد الليل” تتداخل مصائر بشر غرباء وتتماهى تجاربهم الإنسانية في بلاد عانت التمزق والحروب، فوجدوا أنفسهم يعانون الغربة والخوف والمهانة في بلاد أجنبية. تتحول الرسائل التي يكتبونها إلى جسور تربت على أرواحهم المتعبة، وتحاول رتق حبل تواصل إنساني انقطع بين البشر. يعثر كل منهم مصادفة على رسالة الآخر المبتورة والتي لا تصل إلى المرسل إليه، فتحفزه أن يكتب رسالته، وفي صدى كلماته يَسمع همس روحه المتعبة. يكتب رجل رسالته إلى حبيبته الأوروبية، فتعثر عليها المرأة المنتظرة حبيب صباها في غرفة بفندق صغير في نفس البلد الأوروبي. فتحفزها أن تكتب رسالة إلى حبيبها. وفيٍ المطار، ذلك “البرزخ” بين عالمين، يكتب شاب، هارب من الأمن رسالة إلى أمه، رغم شكه في أن تصل إليها. يحكي الشاب كيف عثر على رسالة المرأة في صندوق النفايات، وغلبه الفضول لقرائتها بعد أن رآها تشق الورق نصفين وتلقيه في الصندوق، فأوحت إليه بأن يكتب رسالته، ربما رغبة في التواصل والشعور بأن هناك من يسمعه ويسامحه، رغم أن لا يقين لديه في وصول الرسالة إلى أمه، فبلده أيضًا مزقته الحروب وضاعت العناوين. تحمل اعترافاته في الرسالة سلسلة من جرائم توصله إلى حبل المشنقة، آخرها قتله لسيدة مسنة أوته في منزلها وكان يعيش معها، ولكنه لم يحتمل شبقها، فاضطر لقتلها ومحاولة الهرب بشراء تذكرة عودة إلى بلده مدعيًا أنه لم ينجح في الحصول على إقامة. بعد أن حكى الرجل كل ما رتكبه من فظائع وقتل وتعذيب تنتابه الحيرة في أمر الرسالة التي تحمل دلائل إدانته: “أعتقد أني سأفكر في أمر الاحتفاظ برسالتي هذه لأرسلها إليك، أو أسلمها إليك، أم علىَ أن أتلفها لأنها اعترافات صريحة وتودي بي إلى المشنقة أو السجن المؤبد… غدًا”. ويمعن السرد في السخرية والمفارقة، فذلك الذي ارتكب كل ما يمكن من فظائع يخشى أن يبكيه صوت فيروز، فهل تجتمع كل هذه القسوة مع رقة المشاعر؟! “سأضع صوت فيروز على خيارات هاتفي الخلوي وأنام. سأحاول ألا أبكي من جمال صوتها وحنانه”.
أنزل الأمن الرجل من على متن الطائرة بعد أن طارت في الجو، وبعد إنزال الركاب والتفتيش، وقعت رسالته في يد عاملة نظافة، بينما كانت تعيد ترتيب مقاعد الطائرة، فتكتب رسالتها إلى أخيها بما تحمله من اعترافات، تتماهى مع ما فعله الرجل من قتل وخداع، وإن اختلفت التفاصيل. تكتب الفتاة، هي الأخرى، رسالتها رغبة في أن تجد من يستمع ويسامح: “أقول في نفسي إن الرجل كاتب الرسالة مازال يأمل في لقاء أمه وغفرانها بعد كل اعترافاته لها بتاريخ الإجرام الذي صنعته يداه. في رسالته، أعرف أن ليس له غيرها، وأنه يقف بين يديها كمن يقف بين يدي الخالق، راضيًا بقضائه، عاريًا من كل كذب… أتمنى أن تسمعيني من الآخرة، وأن تغفري لي. أنا أم أيضًا وأعرف أنك تحبينني، وأنك أحببتني حين كنت طفلة… ثم قست عليك الدنيا” . كانت الفتاة اضطرت إلى الهجرة إلى ذلك البلد الأوروبي بعد أن طردتها أمها بعد طلاقها، وهناك عملت في أحقر المهن وأكثرها امتهانًا. تُزور الفتاة أوراق بيع منزل أمها لنفسها وتترك أمها ومخدومتها القاسية تموتان بعد سرقتهما. في رسالتها تبرر الفتاة جرائمها بأنها نوع من الدفاع عن النفس “أنا قتيلة أمي وأيضًا ضحية تلك المرأة. هكذا أفكر. أنا لم أعتد على أحد. أنا فقط رفعت يدي لرد الصفعات. هذا ليس قتلًا”. هل يقتل الفقر الرحمة وتُحجر الحروب القلوب. تخاطب الفتاة أمها في رسالتها: “لماذا تغيرت هكذا بعد أن كبرتِ…. لماذا صرت قاسية مع العمر؟ معي ومع ابنتي أيضًا… تلك التي تلقفتها من بطني إلى قلبك” . ربما تلتقي هذه الفكرة مع الشاب الذي ارتكب شتى أنماط الإجرام ثم يخشى على نفسه من البكاء لصوت فيروز!!
ومثل الرسائل السابقة تأتي تيمة الليل لتلقي بظلالها: “… أقف خلف النافذة أتفرج على الليل. أتفرج على ليل من هواء غريب لا بلاد له. ليل سميك من القطران اللزج يلتصق بالجفون وباليدين. هذه ليست حياتي، لا أدري كيف انزلقت فيها، ولا من دفعني لأتسربل بمصيري هذا وأقفل كل الأبواب ورائي”. ومثل الرسائل السابقة تترك الفتاة رسالتها مبتورة دون أن تقرر ما إذا كانت سترسلها أم لا.
وبالفعل لا تصل الرسالة إلى المرسل إليه، إنما يعثر عليها شاب في خزانة صغيرة في بار كان يعمل به، فتحفزه على الكتابة إلى أبيه. هو أيضًا يكتب رسالته بعد أن وجد في نفسه “تلك الحاجة إلى أن يستمع إلينا إنسان، ثم يقرر أن يسامحنا مهما فعلنا”. في الرسالة الخامسة يفصح السرد عن توحد مصائر أولئك البشر الذين يفصلهم الزمان والمكان، فهم يكتبون رسائلهم ليجدوا أصواتهم الضائعة وليوهموا أنفسهم بأن هناك من يستمع ويغفر. يقول الشاب عن رسالة المرأة التي لم تصل: “هذه الرسالة التي لم تصل، كأنها الصوت الذي لم يسمعه أحد منذ البداية… شعرتُ، وأنا أقرأ الرسالة، بقرب قدر المرأة من قدري، وبتشابه… مساري حياتينا. وتساءلت… عن جدوى أي مقاومة إن كانت مرسومة لنا أقدارنا منذ اللحظة الأولى لخروج أجسادنا الصغيرة من بطون الأمهات”. تنتهي الرسالة الخامسة بأن يطلب الشاب من أبيه، إن سامحه وقبل عودته إلى بلده، أن يرسل إليه “ثمن التذكرة – أو برقية – إلى مركز بريد المطار” حيث يرسل رسالته وينتظر الرد. ويختم: “أرجو ألا تتأخر في الرد. سلام”. وبذلك تكون تلك هي الرسالة الوحيدة التي يتم إرسالها.
في القسم الثاني من الرواية “في المطار” يواصل السرد متاهته في محاولة مبتورة لكشف الجانب الآخر المظلل من الصورة، وهو أيضًا ينقسم إلى خمس فقرات، ولكنها أكثر إيجازًا وتكثيفًا. في الفقرة الأولى تذهب الفتاة، صديقة الشاب كاتب الرسالة الأولى، لتلحق به في المطار. وفي منولوج داخلي تكشف عن صورة الرجل، كما تراها من منظورها الغربي، الذي ربما يغلق مداركه دون الفهم الحقيقي للآخر وأبعاده النفسية: “كان هذ الرجل مؤذيًا في طبعه، معدمًا ومتعجرفًا ومتشاوفًا؛ متخلفًا ومدعيًا؛ عنيفًا وسريع البكاء. حالما حسب أنه أوقعني في غرامه، أو في سريره، بدأ تعذيبه لي؛ تعذيبًا مبرمجًا ومنهجيًا. كان يسعى، على الأرجح، لأن أتعلق به أكثر، بمنطقه المريض…”. وصار الانتقام محركها الأول للبحث عنه: “انتهى الأمر بأن كرهته وكرهت عُقده الكثيرة؛ تلك التي يبدو أنه حملها من طفولته البائسة في بلده المعتل…. صار الانتقام منه هدفًا، لأعود إلى الحياة التي أوقفني عنها”.
الفقرة الثانية، منولوج داخلي لحبيب السيدة التي انتظرت في الفندق. يتأكد منه، كما تقول الكاتبة، في حوار معها، الذي أجرته جريدة الشرق الأوسط (2018)، إن “هؤلاء المشردين في الأرض… لا يريد العالم النظر إليهم إلا ككتلة غير مرغوب فيها أو كفيروس يهدد الحضارة، في حين رحنا نكتشف تراجع البعد الإنساني لتلك الحضارة وتحصن القوميات بإقفال الأبواب”. يصل الرجل من كندا إلى مطار البلد الأوروبي، وتضيع حقيبته، فيتعكر مزاجه ويقف ليتسائل: “لماذا أنا هنا؟ وما الذي أخرجني من بيتي في ليل العواصف؟ لمجرد دعابة؟ مزحة؟ لأرى امرأة عرفتها حين كانت فتاة يافعة”؟ وتلح عليه التساؤلات: “ما الذي أعرفه عن هذه المرأة؟ لماذا لا تكون هاربة من فعلة ما؟ لماذا لا يكون لقائي إياها كحبة الرمل التي ستعطل دوران حياتي كلها….” ويواصل الرجل في نفسه: “الآن حين أتفرج على الصور الأبوكاليبتية الآتية من هناك، في نشرات الأخبار أو في أفلام وثائقية، أشعر بأني لم أزر تلك البلاد يومًا…. كي تفهم ما يجري هناك، عليك أن تكرس جهدًا ووقتًا لا يملك أيًا منهما إنسان عادي. ومن يفعل يكن مدفوعًا بشعور بالذنب لا يفيد في شىء، ولا يؤدي إلى نتيجة، سوى اختراع قضية لمن ليس لديه قضية من الفتيان الرومانسيين. هؤلاء الذين، لو خطر لأحدهم التعرف “عن قرب” إلى ذلك العالم المبهم، لعاد إلى أهله أشلاء في صندوق صغير، أو لم يعد بالمرة”. ويتأكد ذلك الجهل بالآخر: “لم أعرف في السابق شيئًا، ولا أعرف شيئًا الآن. وها أنا في مدينة بعيدة بغية لقاء امرأة من ذلك العالم…. ماذا نعرف عن بشر عاشوا حروبًا أهلية؟ عنفًا ودمارًا وخسارات وخيبات؟ وخوفًا مريعًا، بلا شك؟ كيف يتحولون، وما الذي يتغير فيهم ويقسو؟ في المربع الأخير من الحياة، ذلك الذي يغدو الموت فيه قريبًا ومحتملًا بشدة، لا يعود القلب سوى مضخة للاستعمال المفيد. دم ساخن يتدفق بقوة في الأعضاء من أجل الهرب؛ لا من أجل أي شىء آخر سوى الهرب…. مم تريد الهرب تلك المرأة؟” وبعد العثور على حقيبته يقرر العودة إلى بلده في أول طائرة: “اشتقت إلى رائحة رقبة زوجتي”.
يأتي أخو الفتاة، التي قتلت أمها ومخدومتها وسرقت وزورت، إلى البلد الأوروبي الذي يعرف أنها تقيم فيه، فلا يعثر لها على أثر. تنتابه الحيرة في المطار وهو يروي قصته، وكيف تحول إلى الإجرام ليحميها. تأخذه تأملاته إلى مدى تأثير الحرب على البشر وأخلاقهم، كيف يتحول الناس: “كانت أختي الجميلة الحنونة حين كنا صغارًا. تطعمني من حصتها، وتخرج إلى الصبيان في الشارع إن سمعت صوت بكائي…. يا إلهي، قل لي أين ذهبت هذه الفتاة الصغيرة؟ أين ذهبت أختي”؟ وفي المطار أيضًا يقف الفتى صاحب الرسالة الوحيدة التي تم إرسالها يستفسر عن البرقية أو تذكرة السفر التي ينتظرها من أبيه. ولكن يبدو أن عنوان بيته، الذي يعرفه وأرسلها إليه، لم يعد موجودًا!
تنتهي الرواية بالجزء الثالث “الخاتمة” وتحمل عنوان “موت البوسطجي”. وفيها يكتب البوسطجي رسالته في في مركز البريد، خشية أن يموت قبل أن يصل أحد إلى المركز. يضم السرد فقرة وحيدة يرويها السارد، البوسطجي، الذي صار مقيمًا في مكتب البريد، بعد أن تعذر الخروج منه بسبب الحرب. يتذكر عمله قبل الحرب وكيف كان الناس في القرى يتلهفون لمجيئه ويكرمونه عند حضوره، وكان سعيدًا بذلك التواصل مع البشر. ولكنه، بسبب الحرب صار “موظفًا في مكتب البريد، لا يجول ولا يوزع شيئًا”. تشغله “الرسائل التي لا تصل إلى أصحابها، والتي تتكدس كالأوراق الميتة في زوايا الشوارع الفارغة”. ومع ذلك يأمل البوسطجي أن تنتهي الحرب ويأتي الناس للسؤال عن رسائلهم. فقرأ كل الرسائل التي وجدها وصنفها، وجمعها في ملفات بعناوين واضحة، ثم كتب رسالته آملًا أن يصل أحد إلى المركز بعد موته: “الآن أكتب رسالتي إلى من قد يأتي إلى هنا، وأضعها على بينة واضحة للعيان قرب فهرس الرسائل… فقد أموت قبل أن يصل أحد إلى هذا المركز. من يدري؟”.
لازال البوسطجي يأمل، وتأمل معه الكاتبة، أن تنتهي الحروب ويعود ذلك التواصل الذي انقطع بين البشر. رغم أصداء الوحشة والغربة التي ترددت في ثنايا الرواية، يلوح بصيص من الأمل في نهاية تلك المتاهة السردية.