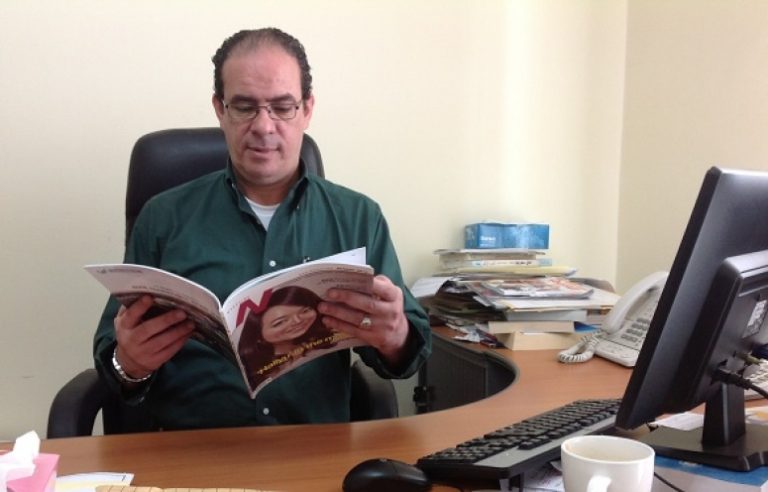حتى لو ظلت المطالبة بالـ ( حكاية ) تحاصر الروائي …
في حوارها مع ( جوسلين بارتكفيزيس ) والذي ترجمه ( حسين عيد ) تحدثت الكاتبة الأمريكية ( جوديث أورتيزكوفر ) عن كتابها ( طعام لاتيني جاهز ) الذي اصطدم برغبة بائعي الكتب في معرفة ما إذا كان الكتاب نثرا أم شعرا أم قصة الأمر الذي أدى إلى قلة عدد المراجعات له .. كان من الواضح أنها لم تحدد ( الجنس الأدبي ) لهذا الكتاب وكان من الواضح أيضا أنه كان هناك ثمن لهذا .. ( الكتابة هي الكتابة ) هكذا لخصت رؤيتها للموضوع ولكنها على جانب آخر كانت تستوعب تماما صعوبة أن يجذب اهتمام الناس كتاب يحتوي أجناسا أدبية مختلفة .. ما يحدث في أمريكا إذن هو نفسه ما يحدث في مصر وهو نفس ما يمكن أن يحدث في أي بلد آخر .. الرغبة في حماية نظام عبر إخضاع الكتابة لشروط مسبقة .. نظام لا يتعلق بالأدب أو بالفن فحسب بل هو أولا وقبل أي شيء يتعلق بالحياة نفسها التي ينبغي أن نسعى دائما وبقدر ما نستطيع للتأكيد على كونها واضحة ومحددة ومحسومة وألا نستجيب أبدا لأي تهديد يريد تحريضنا على التصديق أو الاعتراف بأنها يستحيل أن تكون كذلك .. هذا ما جعل أغلب ما كُتب عن كتابي ( السييء في الأمر ) يتوقف بشكل أو بآخر عند قضية ( التصنيف ) وهذا ما جعل أغلب أسئلة الحوار الصحفي الذي أجراه معي الشاعر والصحفي الجزائري ( مصطفى ربيع ) في صحيفة ( الوسط اليوم ) تناقش هذه القضية وهذا ما جعلني أؤكد في نفس الحوار على أن ( التصنيف ) بالنسبة لي ليس أكثر من لعبة سلطة يريد الآخرون أن يمنحهم الكاتب مفاتيح الفوز بها ، وهذا ما جعلني أبدأ كتابي التالي ( بعد كل إغماءة ناقصة ) بكلمات الشاعر الكندي ( لويس دوديك ) :
( وبينما كنت أحتضر
أنزف حتى الموت
كانوا يقولون
” لكن هذه قصيدة نثر
هذا ليس شعرا ، هذا نثر “
وهكذا مت أنا )
هناك أمر آخر أرى أنه يرتبط بقضية الصنيف هذه ارتباطا وثيقا وهو الجدل المثار منذ فترة طويلة عن ما يسمى بـ ( زمن الرواية ) .. ليس من الصعب في ظني التعرف على نبرة الإدانة لدى كثير ممن يتعرضون لحالة ( الرواج الروائي ) التي تشهدها مصر منذ سنوات باعتبارها دليلا دامغا على أن هذا النوع من الأدب أصبح منتهكا ومستسهلا ومتاحا لكل ( مبتديء ) كي يمارس ( طيشه ) دون ضابط ولا رابط وأن الرواية تحولت ـ بفضل فضائها المتسع ـ إلى فرصة يستغلها الجهلة الغير ملمين بـ ( قواعد ) الكتابة كي ينتجوا أعمالا ( هلامية ) لا قيمة لها .
في مقالي ( الشعر .. قصيدة النثر .. الكتابة ) والذي نشرته صحيفة ( الجمهورية ) اليمنية على جزأين في 11 ، 12 مارس 2009 تحدثت عن التنظير وعن غريزة تنظيم العلاقة بين الكاتب والمتلقي وعن الانتصار لأشكال ومباديء معينة في الفن وعن الكتابة كقرار إنساني في مواجهة الألم وعن تحرير ( قصيدة النثر ) للـ ( شعر ) و( النثر ) من المفاهيم والقوانين التي التصقت بهما على مدار التاريخ وعن تراجع الممارسات التنظيرية عن الحكمة واستبدالها بالأفكار التجريبية مستشهدا بـ ( سارتر ) و( كونديرا ) و( سبندر ) ولكنني لم أتحدث عن علاقة كل هذا بالرواية باعتبار أنه حديث يستحق مقالا خاصا .. هل ازدهار الرواية يحدث في مصر فحسب ؟ .. فلنعتبر إجابة هذا السؤال مجرد عتبة ينبغي تجاوزها نحو التفكير ـ عند التخلص من الإدانة ـ في أن الكتابة التي تسعى للانفلات من الأحكام النوعية ـ الأثريات الغريبة التي لم تعد تخدع أحدا بتعبير ” لوكليزيو ” ـ وجدت في ( الفضاء المتسع ) للرواية ملاذا آمنا بدرجة .. ما الذي يمنع من أن نعتبر ذلك نوعا من الاختباء كرد فعل تلقائي على الرفض أو عدم الثقة في ( النص ) كعنوان للكتابة وكبديل للقصة القصيرة أو للقصيدة مثلا ؟ .. في الرواية لا أحد يطلب منك تحديد هل ما كتبته هذا شعر أم قصة ـ هل علينا أن نتذكر كلمات ” جوديث أورتيزكوفر ” وما كُتب عن مجموعتي ” السييء في الأمر ” الآن ؟! ـ حتى لو ظلت المطالبة بالـ ( حكاية ) تحاصر الروائي لنفي ( الهلامية ) عنه فعلى الأقل تظل فرص القاريء ( للتعايش ) مع هذه الكتابة الغير مأطرة تظل فرصا قوية بفضل ( الفضاء المتسع ) للرواية بعكس نوع أدبي آخر قد لا تتوفر لديه ـ بسبب طبيعته المكثفة ـ فرص كهذه مما يجعله معرضا دائما لأن يؤخذ ضده موقفا عدائيا فوريا .. لم يكن مستغربا إذن أن تتأسس جماليات الرواية الحديثة على إلغاء الحدود الفاصلة بين القصة القصيرة والشعر والتدوين واليوميات والسيرة الذاتية بحيث تصبح أي محاولة لتحديد أين يبدأ هذا النوع أو ذاك وأين ينتهي تصبح عبئا لن يفيد سوى في التأكيد على أن الرواية ليست ساحة لتداخل الأنواع بل لهدم أي فكرة ماضوية عنها .
إحذر حتى لا تصبح مثل عمو ( علاء الأسواني ) …
البطولة خارج النص ضرورة حتمية من ضروريات الحياة .. قد تكون الضرورة الأكبر بالفعل .. اللعبة اللاواعية أحيانا واللازمة لجعل الحياة نفسها نصا هائلا .. بشكل أو بآخر يمكن للبطولة تبرير حدوثها ـ الذي لا يحتاج للتبرير ـ وعليها إذن أن تعتبر تشريح ظواهرها جانبا هاما من جوانب هذه اللعبة …
فيما يتعلق بالشعر على سبيل المثال كان من الطبيعي جدا لأسباب سياسية وثقافية خاصة أن يخرج أحد شعراء القرن الماضي ليخبر الدنيا بأنه الوحيد ـ أو من القلائل إذا ما أراد التواضع قليلا ـ الذي يعرف ما هو الشعر وأن يطلق بزهو إلهي صفات متعددة على نفسه كـ ( مفجر لغة ) أو أشياء من هذا القبيل .. لكن أن يحدث نفس الأمر مع قصيدة النثر ؟!!!
تسمع مثلا واحدا من الشعراء المصريين المقيمين في أوروبا مهووس بذاته وهو يصرخ ويسب ويلعن ( المتشاعرين ) الذين يسيئون لقصيدة النثر المصرية في نفس اللحظة التي يقوم فيها أحد النقاد العرب بفضح سرقات هذا ( الشاعر ) الممتدة من الشعر القديم إلى الحديث .. يأتي شاعر عربي آخر ويقرر على طريقة شيوخ التكفير بأن قصيدة النثر العربية ( متخلفة ) وأن أغلب الشعراء العرب لا يكتبون قصيدة نثر ( حقيقية ) ورغم اتفاقي معه كثيرا في فهمه للعلاقة بين الشعر والنثر والذي شكّل الأسباب التي يقف وراءها هذا الكلام إلا أنه لا أحد يملك هذا الحق الكوميدي في أن يقيم بحسب مزاجه قيامة لقصيدة النثر كي يدخل البعض الجنة ويلقي بالبعض الآخر في النار .. لا يزال شبح شاعر القرن الماضي يتجول حائرا وهو يحمل أصنامه القديمة التي لم يعد لها مكانا في الشعر الحديث فأدرك أنه لم يعد أمامه سوى أن يحاول إعادة تشييدها خارج النص وأن يأمر الآخرين بعبادتها.
بالنسبة للرواية فأنت روائي ( حقيقي ) بقدر ما تشتم ( علاء الأسواني ) الذي تحول إلى ( ملطشة ) لا تقل شهرتها عن شهرة ( عمارة يعقوبيان ) .. ( نموذج ” علاء الأسواني ” يدل على تدني الذوق العام ) هكذا يمكن لروائي شاب أن ينظّر للأدب ( في المطلق ) من خلال نفسه أكثر مما يرصد ظاهرة بالموضوعية والحياد اللازمين ـ أتذكر الآن الروائي الذي ذكر بأننا نعيش في أزمة نتيجة ظهور كتّاب لا يعرفون ما هي الكتابة ” لم يوضح طبعا هل يقصد الكتابة عامة أم الكتابة كما يفهمها هو لأنه لا يرى فرقا بين الاثنتين ” مؤكدا بأن ” كل واحد معدي في الشارع الآن يقول أنه كاتب ” وهذا يستدعي ـ صدقا ـ الشعور بالشفقة من أجله والتفكير جديا في إطلاق حملة قومية لمنع المارين في الشارع من الكتابة قبل موافقته حرصا على أعصابه المقدسة ونحن نعرف جيدا أن أعصاب الأنبياء لا تتحمل كثيرا .. بهذه الطريقة ( السهلة ) يمكن أن يوجه الكاتب ( المتقزز ) من تورط الأدب في ( قضايا الواقع ومشكلاته ) يمكن أن يوجه رسالة ضمنية إلى كل كاتب من ( الكتّاب الأطفال ) : إحذر حتى لا تصبح مثل عمو ( علاء الأسواني ) .. ( علاء الأسواني ) كاتب محدود القيمة وتتوفر في كتاباته بامتياز كافة عيوب الكتابة التقليدية المباشرة للدرجة التي يمكن معها أن تدرّس ولكنني في نفس الوقت مع حقه ـ البديهي ـ في أن يفكر في العالم كيفما يريد وأن يكتب عنه كيفما يريد وضد أن يتعامل معه أحد بطريقة ( كيف تجرؤ على التفكير والكتابة بهذا الشكل ؟ ) بالضبط مثلما أستوعب أن ( تدني الذوق ) ليس جريمة القراء المصريين وأن أسبابه ودلائله أكبر وأعمق بكثير من قراءة ( علاء الأسواني ) .
من بين المهازل الكثيرة المضحكة التي أعقبت ( بيروت 39 ) يمكنني اختيار أبرز نكتتين قرأتهما وكانتا على لساني اثنين من الخاسرين في المسابقة : الأول ـ الذي لو كان فائزا ما فتح فمه بالطبع وما كان فكر أساسا في أي شيء له علاقة بعدم النزاهة والمجاملة والمحسوبية وما كان ذكر ( جابر عصفور ) و( صموئيل شمعون ) إلا بكل الخير .. هذا الكاتب قال ـ من ضمن ما قال ـ أن هناك بعض من الفائزين تم اختيارهم لكونهم ( يكتبون كتابة جنسية بعيدة تماما عن الثقافة المصرية ) .. من الواضح بالتأكيد في أي كلمة من كلمات هذه الجملة يكمن مركز الإضحاك .
الثاني ـ والذي ينطبق عليه بالضبط ما ينطبق على الأول ـ راح يتباكى في مقالتين متعاقبتين على ( الأسماء الهامة الأخرى ) التي كانت تستحق الفوز ـ بخلافه طبعا ـ ولكن نتيجة الحسابات المتحيزة للجنة التحكيم لم يتمكنوا من الفوز .. من هي ( الأسماء الهامة الأخرى ) ؟ .. إنهم ببساطة وباختصار نفس الأسماء التي من العادي جدا أن تقابلها في كل ندوة ومؤتمر وملتقى عن السرد الجديد أو عن قصيدة النثر .. هل كان يحتمي الخاسر في الأسماء المعروفة حتى لا يتورط في دفاع معلن عن أحقيته في الفوز ؟ .. ربما ولكن ما يعنيني هي فكرة ( الأسماء الهامة الأخرى ) .. لم يكن مطلوبا من هذا الكاتب أن يتحدث عن أحد لا يعرفه ولكن بالفعل لا أحد يتحدث ـ ولو بشكل عام ـ عن أحقية الأسماء الغير معروفة التي قد لا تقل أهمية أو تفوق الأسماء التي تستحوذ دائما على كل شيء دون وجه حق في كثير من الأحيان لا أحد يتحدث عن أحقيتها في الحصول على التقدير الذي تستحقه .. حدث زائف ومسرحية سمجة كـ ( بيروت 39 ) كانت مناسبة أو فرصة لتقاسم المكسب بين ( نجوم ) الساحة الأدبية : الفائزون يحصلون على التقدير والخاسرون يحصلون على شرف هزيمة غير مستحقة .. ( بيروت 39 ) كان ينبغي على أحد ما .. أي أحد أن يستغلها في تناول الكتّاب الآخرين الذين لا يسلط الضوء على أعمالهم بالقدر الكافي سواء الذين تقدموا للمسابقة أم لا والذين لا يسمح لأي منهم بالانتشار اللائق إلا عبر اكتساب الخبرة اللازمة التي تؤهله لإجادة التعامل مع الحياة الأدبية في مصر وفقا للمتطلبات التي يحتاجها أي سرير واسع .
سرير … ؟!
أن تتحول شاعرة كـ ( كإيمان مرسال ) ـ التي ربما تكره إسرائيل أكثر من كراهية ” شعبان عبد الرحيم ” لها ـ أن تتحول فجأة إلى ( زبونة ) ينبغي استغلال ( ترجمة ديوان ) لها إلى العبرية من أجل إسقاطها تحت سكاكين ( المطبعين مع الكيان المصري ) فإن هذا لا يحدث حقا إلا فوق سرير واسع .
وأنا أتحدث عن البطولة خارج النص لا ينبغي أن أنسى الفيس بوك .. يدخل البطل على الإنترنت وهو في حالة من ثلاث : إما أنه يعرف ما هي الجملة ( الظريفة ) التي سيضعها في ( الاستاتوس ) أو أنه لازال في حاجة لمزيد من التفكير حتى يتوصل إليها أو أنه سيبقي على الجملة الظريفة الموجودة بالفعل كما هي ولن يحذفها .. كل إنسان ظريف بالنسبة لنفسه .. قد تكون هذه هي الحقيقة لكنني في نفس الوقت لا أستطيع أن أمنع نفسي من الشعور بأن الفيس بوك قد تحول إلى ( عشة فراخ ) متخمة بـ ( البيض ) .. لماذا ؟ .. ليس لأنني لا أتصور مثلا أن هناك كائن في العالم يضحك على جملة مثل : ( الفيس بوك بيتقدم بينا ) .. صدقوني ليس هذا هو السبب .. بل لأنني وسط إسهال الظُرف هذا غير متأكد من أن هناك من يحاسب نفسه ويخوض نقاشا جادا مع الآخرين ويتأمل طويلا في الأسئلة الضرورية المتعلقة بالموضوع والتي كتبت عنها في مقالي ( أنا لا أتهكم ) المنشور بالعدد الأول من مجلة ( إنزياحات ) في يناير 2010 .. ليس هناك من يطرح رؤيته أو تصوره الشخصي عن ( الدعابة ) مع أن هذا الإجراء ـ كقيمة معرفية ـ مهم جدا للـ ( ظريف ) نفسه حيث يتدخل لإحداث نوع من التوازن ـ أو التشويش ـ عند تحوله من منتج للدعابة إلى مجرد بيضة ( تستخف دمها ) .. من منا يضمن أن يظل ( ظريفا ) في جميع حالاته ؟! .
أين يبدأ ( الإبداع ) داخل الخطاب وأين ينتهي وهل يمكن تجريده منه ؟ …
( غايتنا هي ما لا يقوله النص أو ما يقوله في غفلة من الكلمات ونواياها الصريحة ) .. كان ( سعيد بنكراد ) يتحدث هنا عن ( أمبرتو إيكو ) أما عن التساؤل الذي يشغلني وأرى أنه يستحق أن ينشغل به ويعمل عليه المتورطون في المشهد الثقافي المصري تحديدا فهو على أي خطاب ينبغي تطبيق جملة كهذه ؟ .. بدقة أكثر أتحدث عن الخطابين السياسي والديني في حضورهما الشفاهي والمكتوب ولكن ليس بوصفهما ( سياسة ) و( دين ) بل بوصفهما كتابة .. موقف شخص من العالم موثق بالكلمات في لحظة معينة ويتم طرحه باعتباره حاملا أمينا لحقيقة صادقة تنتمي لصاحبه .. طبعا هذا التساؤل من الضروري أن يحفز علاقته بالمزيد من التساؤلات الأخرى حول المعاني والوظائف المتغيرة للكتابة من شخص لآخر ومن زمن لآخر مع استعادة مطلوبة للكتابات الأدبية الأشبه بالمنشورات السياسية أو بالخطب الدينية ليس على مستوى التاريخ العربي أو الإسلامي فحسب وإنما على مستوى تاريخ الغرب أيضا والتي لا تزال حاضرة وتحقق نفسها بتجليات وصور وأساليب مختلفة وغير مباشرة أحيانا وتحتاج لتجاوز طبقاتها السطحية التي تحمل ( نواياها الصريحة ) .. إعادة مستمرة لطرح الأسئلة القديمة بصيغ مختلفة : ما هو الأدب ؟ .. ما هي الكتابة ؟ .. ما هي الفروق اليقينية بين النص
الأدبي وبين أي نص آخر ؟ .. أين يبدأ ( الإبداع ) داخل الخطاب وأين ينتهي وهل يمكن تجريده منه ؟ .. هل هناك عناصر ثابتة يمكنها تحديد ( المشترك الجمالي ) بين النصوص المختلفة لو تعاملنا معها على أنها ـ جميعها بشكل أو بآخر ـ رسائل متبادلة بين البشر ؟ .
نقطة أخرى لها اتصال بالموضوع .. مقارنة بالماضي لا توجد في مصر الحياة النقدية والفلسفية التي تتناسب مع الكتابة الأدبية الآن .. علينا أن نسترجع كيف كانت النقاشات والمعارك المحتدمة عن ( الواقعية الاشتراكية ) و( التحليل النفسي ) و( النقد الماركسي ) و( أدب المقاومة ) و( نظريات ما بعد الحداثة ) … إلخ .. أنا أتحدث عن مصر بالذات لأن بلدا كالمغرب مثلا بالنسبة لي تتفوق كثيرا في هذه النقطة .. طبعا الأسباب تحتاج إلى مقال خاص ولكن بشكل عابر عندي قناعة بأن الكتّاب أنفسهم هم الجديرون بممارسة هذا الدور النقدي أكثر من النقاد ومن الأكاديميين وبالطبع من محرري الصفحات الأدبية بالجرائد والمجلات .. الكتابة الآن تتطلب أكثر من أي وقت سابق الإيمان بعدم قابليتها للخضوع لأي قالب نظري جاهز وأن على من يقاربها تحرير نفسه أولا من أي ثوابت فلسفية وقد صادفت من التجارب ومن الدلائل ما يجعلني أصدق بأنه ليس هناك من يتوفر لديه هذا الإيمان ويمتلك هذه القدرة على تحرير عقله أكثر من الكاتب نفسه .
أعرف أنني أكتب دائما القصة القصيرة ليس كشكلوإنما كبصيرة …
لو أردت أن أكتب شيئا عن عملي الآن فلن أذكر أكثر من أنني بعد سبعة كتب لازلت أشعر بأنني أكتب عن أشياء ثابتة ومحددة لم تتغير منذ النص الأول ولكنني أكتب عنها كل مرة بطريقة مختلفة ، وفي كل مرة أكتشف عنها أسئلة جديدة .. بعد روايتي ( سوبر ماريو ) وأثناء عملي في روايتي الجديدة تعاملت مع ( أورهان باموق ) بكثير من الفهم والتقدير حين كتب في ( ألوان أخرى ) بأن الأدب هو قصة الرحلة التي لم تصل أبدا إلى الحقيقة وأننا أصبحنا تحت وطأة الخوف والاضطراب والفوضى نقلل من السرد وندفع مراكز قصصنا من المركز إلى الهامش فبدلا من السفر إلى أعماق العالم المخبأة نستكشف اتساعه مشيرا أنه هو شخصيا يستمتع بالخروج بحثا عن المزيد من الشذرات والقصاصات .. بحثا عن قصص لم ترو بعد .
في كتابة الشعر والرواية وحتى المقالات النقدية أعرف أنني أكتب دائما القصة القصيرة ليس كشكل وإنما كبصيرة .. الروح التي أجرب بها الحياة والموت مثلما فعل أحبائي شركائي الطيبون في جميع اللحظات والأماكن : ( تشيكوف ) ، ( همنجواي ) ، ( وليم تريفور ) ، ( فولفجانج بورشرت ) ، ( يوسف إدريس ) ، ( كورتاثر ) ، ( كافكا ) ، ( بورخيس ) ، ( هيرمان هسّه ) ، ( فرانك أوكونور ) وغيرهم .. طريقة تسجيل الأهداف الرائعة في العالم بالطريقة التي ليس هناك أبلغ وصف لها من عبارة المعلق التونسي الشهير ( رؤوف بن خليف ) حينما يصف هدفا صعبا ودقيقا : ( بالمليمتر ياحبيبي بالمليمتر ) .
خاص الكتابة