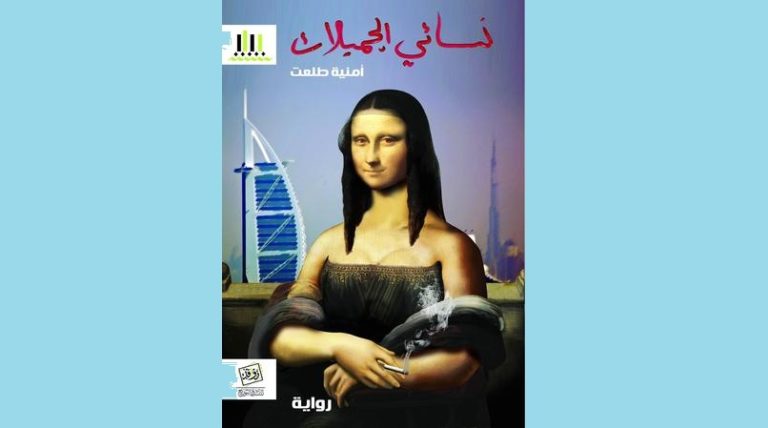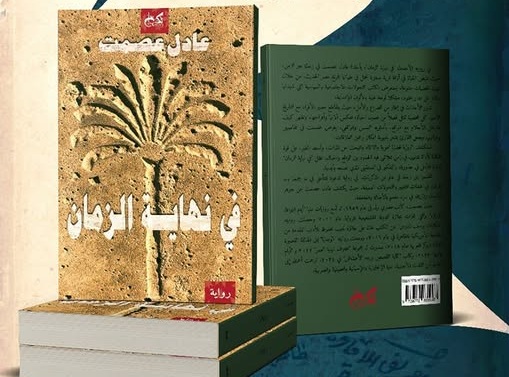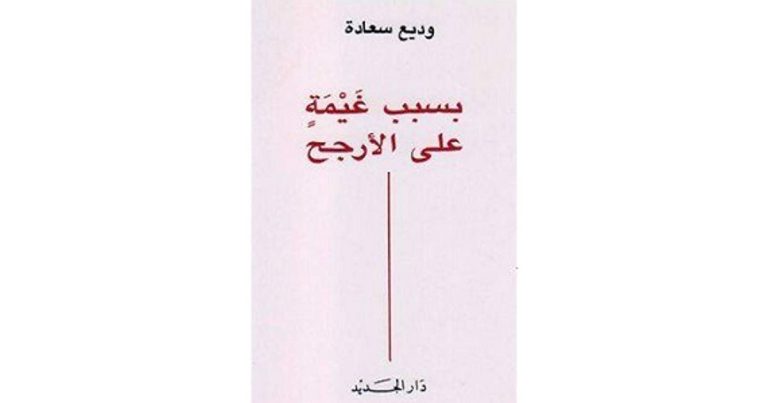طارق إمام
يعجز فردٌ عن ألا يبالي، فيتبع سرابَ بحثٍ عن أبٍ في الواقع، لم يره يوماً إلا طيفاً في فرجات الأبواب المواربة للمنام. هكذا تنطلق “باب الوادي”، الرواية الأحدث للروائي الجزائري أحمد طيباوي (دار الشروق، القاهرة)، متتبعةً “كمال”، إذ يخوض رحلةً على حبلٍ رفيع، مشدودٍ إلى طرفين؛ العاصمة الجزائرية_ الحاضنة لحي باب الوادي الذي حمل النصُ اسمه _ ومدينة ليون الفرنسية. حبلٌ يُشرف على هاوية، يقطعه شخصٌ هو، بتعبير السارد: “ثمرة لتاريخ مزيف” من جهة، و”مسخ وجودي” من جهة أخرى.
في السادسة والثلاثين، يغادر كمال _ الماثل روائياً باسمه المفرد فقط، ترميزاً لوجوده المنبت_ إلى فرنسا، أملاً في العثور على الأب. إنها رمزيةٌ مبكرة، أن يتموضع أصلُك، منبتك، منبعُ نسبك، في أرضٍ غريبة، كانت للمفارقة محتلاً.
يبحث كمال، مجبراً، عن صلبه خارج صلبه، ناهضاً بانعكاسٍ عميق للشخصية الجزائرية اليوم، في واقعٍ يرزح تحت الأسئلة التي خلّفها ماضٍ لم تذب أشباحُه، بين فلول جبهة تحرير أغرقوا وطناً في الفساد، وفلول جبهة إنقاذ أغرقوه في الدم.
فردٌ بين واقعين
حبكةٌ يتولاها ساردٌ عليم، مديراً عناصرها في أحد عشر فصلاً، مُراوِحاً بين رصدٍ مشهدي لبؤرة الحدث الآني واسترجاعات لا تنقطع لماضٍ بذر الحاضر الروائي، بحيث يلتئم أكثر من زمن في نهر رواية طريق، بطلها التحري، متقدمةً للأمام، تتبع اضطراداً خطياً من منبعٍ لمصب؛ نهر تكسر تهاديه استعاداتٌ مزدوجة في موقع وجهة النظر: فالسارد يسترجع تاريخ الشخصيات من خلال رؤيةٍ أمامية تكشفهم بمعرفةٍ كُلِّية، فيما يسترجع تاريخ كمال بالتحديد متحولاً إلى راوٍ مصاحب (رؤية مع) عبر تبئيرٍ لوعي الشخصية نفسها لكن منعكساً على صوت السارد الخارجي.
يخلق كمال ثغرة هروبه بطريقةٍ مختلفة، إذ كلما ضاق عليه واقعُه، ذكَّر نفسه بــ”روائية” هذا الواقع، بانتمائه للتخييل، باحتمالية أن يكون بطلاً روائياً، محض شخصيةٍ من ورق. كأنه شخصية مراوحة بين تعينها كذات وتعينها كدور أو وظيفة فنية، تعي تموقعها الفني في مرويةٍ تُحاكي الواقع لكن تظل اختلاقاً. وفي سبيله لذلك، يؤسس، في موقعٍ مبكرٍ نسبياً من الرواية، لهويته العالقة، محاوراً سارده مباشرةً، ليمنح النص بعده الميتاروائي، حيث يُقَض مضجع الإيهام كلما استحكمت حلقاته ليُعري النص نفسه.
بدوره، يحيل السارد إلى الكاتب، كاشفاً المخطط الذهني للمروية كلها: “لا يتوقع أن يكون الكاتبُ غبياً، وخياله أضعف من خيال بطله، ولن يؤول اختراعه إياه وتعذيبه كل هذا العذاب إلى تلك النهاية الباردة والمكررة في حكايات أخرى حد الغباء. لو يتاح له هامش تفاوض مع السارد، فيتفق معه على مصير يرضيه قليلاً.. لكن سارده قد يتحجج بأن الجمالية والقيمة في استعراض التجربة الإنسانية وتفاصيلها، وتتبُّع حياة يحيى وآسيا والبقية، وليس بالضرورة في نهايةٍ لا يتوقعها القارئ وتدهشه، أو تُرضي هذه الشخصية أو تلك داخل الرواية”. إن مقطعاً كهذا، بقوامه النظري الفادح، إنما يزيح المروية كلها، بإيهاميتها المغلقة، إلى حقيقة كونها خطاباً أدبياً، يُعلن عن نفسه داخل نفسه، وليتجسد كمال، العالق بين مدينتين، وزمنين، ولغتين، عالقاً بالقوة نفسها بين واقعين: واقع فني يوهم بأنه حقيقي، والواقع الفني نفسه وهو يزيح عن نفسه غطاء الإيهام.
ضوءٌ عالقٌ في ثقب الباب
جزائر ما بعد العشرية، هذا هو المكان، بتبئيرٍ لحي في العاصمة “أصبح مشوهاً ولم يبق منه إلا اسمه، اختفى الوادي والباب صار مخلوعاً، والمدينة أصبحت بكاملها شاهدةً على كل الممكنات والبشر”. إنه تأسيسٌ يغور في تقاطع المكان مع قاطنه، الذي لم يبق له، من هويته المموهة، سوى اسمه الأول. حتى القِبلة المتموضعة على الجانب الآخر من البحر، يتم وصفها كـ”مدينةٍ منشطرة، يربط جسرٌ بين ما تباعد من ضفتيها”.
“الباب” ليس فقط مفردة في اسم الحي، لكنه علامة دائمة الاقتران بكمال، فالرواية تُستهل به: “وجد كمال الباب موارباً ففتحه، وكان الآخر بانتظاره”. وسند حيازة البيت، “يقفل عليه باباً داخلياً صغيراً في خزانة”، الباب الذي بفتحه، سيباع البيت ليبدأ الخال حياته، وليفقد كمال جغرافيته بعد أن فقد تاريخه.
يغادر كمال مخفوراً بذواتٍ تتنازع وجدانه: “فتيحة”، الأم التي عوضاً عن أن تترك له وصيةً خلّفت له قنبلة، والتي ربما بذرت فيه جوهر ذاته كـ”شخصية دنيوية”، إذ، حتى في المراحل المتأخرة من مرضها، “أدركت أن حياتها توشك على الانتهاء، وكلام الأطباء عن ضرورة الأمل في الله لن ينفع معها تحديداً،فتلك بضاعة تعرفها جيداً”. “فطيمة”، الخالة التي تعتبره عماد حياتها فيما تفتقر حياته لكل الأعمدة، والتي تقف على الضفة الأخرى بالضبط من أختها: “ترى نبوءات كثيرة، تحب الله وأولياءه الصالحين، وتوقن أن الله سوف يعوضها عن الزوج الهارب بأن يدخلها الجنة، وتكون إحدى حورياتها، ويتزوجها صحابي أو عبدٌ صالح”. ثمة “آسيا” الحبيبة العالقة في قرارٍ مرجأ لا يتخذه أبداً، و”نبيل” الصديق، المتأرجح، كالبلاد، في خمودٍ معبأ بالبارود، المصر على الانتقام لامرأة تعرضت للاغتصاب قبل أن تختفي، فيمحى ذكورة الفاعل بالخصاء، والضالع، في الوقت ذاته، في العمل بالتجسس. وبقدر ما رغب نبيل، دون جدوى، أن يكون “شيخاً من العارفين”، مدعوماً بحفظ القرآن واستظهار المتون، فإن كمال يظل راغباً في الاحتفاظ بجهله، حتى أن الحقيقة التي تبث من فم أم محتضرة، لتنقلها الخالة، تبدو كما لو كانت تؤرقه لأنه عرف، مدركاً أن المعرفة ليست الخلاص، بل النهاية. كمال مسكونٌ أيضاً، للمفارقة، بـ”يحيى”، الخال، نقيضه التام، ابن الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الذي فقد للأبد دوره، مع انتهاء ما يُعرف بالعشرية السوداء، فصار متبطلاً، مقيماً بالبيت، كنسائه، لا يغادره إلا للمسجد، يحاول عبثاً ترويض ابن الأخت الذي شبَّ على عكس ما ناضل من أجله؛ يشرب الخمر ويلاقي النساء ويدير وجهه للسماء. سوط يحيى، الذي لم تستقبله أجساد أعدائه، أصاب ظهر كمال وحده، معاقِباً، حتى تلذذ الأخير بالعقاب، حد أن كاد يتحول إلى لا مبالٍ بأي شيء.
شخصياتٌ هي تمثيلٌ متنوع للتوليفة الإنسانية التي خلفتها حقبةٌ دموية، تركت شخوصها مثل حفناتٍ من رماد.
يودِّع كمال لبيت المتنازع عليه (ربما كالبلد) بين رغبةٍ في البيع من طرف وصد من طرف، مثلما يودِّع “المرقد” الذي حصل من فرجاته على هواءٍ سري من الفن والمتعة والحب، ليقابل شخصاً مجهولاً في أرضٍ لا يعرفها؛ “رسول”، كما يشار برمزيةٍ فادحة إلى “عبد القادر بن صابر”، الرجل الذي سيوصل اليتيم إلى أبيه الحي، أو ربما إلى الوجود المطلق الذي أنكره.
رحيلٌ سبقه رحيل أول، إلى تركيا، بدافعٍ من الأم، كي لا يراقب احتضارها، أو، ربما، كي لا يتلقى القنبلة من فمها الحي. مفارقة جديدة إذ لا يكون كمال حاضراً أبداً لحظة غياب من أوجدوه، وإن كان في حالة الأم عاد مشرفاً على جثمانها، فإنه في حالة الأب سيراه بالكاد جثماناً مرجأً، باتت أمنيته الأخيرة أن يُوارى ثرى وطنه.
“الأقدارُ تحكم مصائر الناس ولا يبدو لإرادة الفرد معها أي أثر”، هكذا يؤكد السارد، في واحدةٍ من العبارات المفتاحية لهذه المروية. إنه تأكيدٌ على العجز، على الفعل المحكوم بالإخفاق، وكأنها توطئة لنضال كمال اليائس، كمال الذي ما إن يعثر على أبيه حتى يعود من دونه.
تبذر الرحلة اقتراباً متنامياً، لا من الأب، بل من جيلٍ كامل، بعضه من “المجاهدين”، خلَّف قبيلةً من اليتامى، حيث لا فارق كبير بين “نادية”، المنفية هناك، و”كمال”، المنفي هنا، واللذين يلتقيان طيلة الوقت على شرف فيلم أو أغنية، ليتسرب الواقع والتاريخ من شقوق غرقهما في جنة التخييل.
تترى المحكيات عن “عبد القادر بن صابر”، كاترين دافو، عيسى أو رحال العيد، وغيرهم، جميعهم مغدورون. كأن كمال سافر ليرى وطنه المنفي في مهد من جابههم، وكأن الهدف الحقيقي من الرحلة هو الإبقاء على محكياتٍ ستزول بزوال الأفواه الشائخة التي ما تزال قادرةً على ترديدها، ربما لمرةٍ أخيرةٍ، كزفرةٍ نهائية وقد أشرفت على الغياب، محكيات خرجت من التاريخ المدون، أقصيت ونُفي بعضُها من الرجل نفسه الذي يطالع كمال اسمه في مطار الجزائر، ذهاباً وعودة.