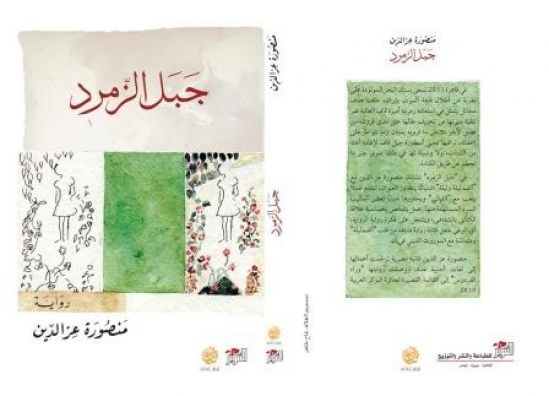ولكن هل عمد الروائى هنا إلى تغليف حدثه الروائى بالإيروتيكا؟!
أعتقد أنه مع التأمل الطويل لعالم الرواية نستطيع الجزم أن هذا العالم لم يكن من الممكن له أن ينبنى بمثل هذا الشكل الروائى إلا من خلال هذا القالب الذى اختاره وحيد الطويلة شكلاً لروايته؛ حتى إننا إذا ما حاولنا أن نوجد لها شكلاً آخر وجدنا أنفسنا أمام لا رواية حقيقية؛ وهنا نتأكد أنه الشكل الأمثل لها، كما أن الروائى هنا يفهم جيدًا ما معنى آليات السرد الروائى من خلال شخصياته الذين هم بقايا بشر كل شخص منهم يحمل داخله حكايته المأساوية؛ ولذلك نرى أن كل شخصية من شخصياته تريد أن (تطرد حكايتها بحكايات الآخرين)، أو تتسلى بحكايات الآخرين كى تستطيع الهرب من حكايتها الشخصية التى تحملها على ظهرها كعبء قاتل؛ إنه العالم المؤلم الذى يقدم لنا شخصيات ماتت أرواحها منذ زمن طويل؛ ومن ثم تعيش كبقايا بشر ليس لها من الحياة سوى محاولة يائسة لمقاومة هذا الموت الذين هم على يقين تام من أنه خرّب أرواحهم تمامًا؛ ولذلك فهم يحاولون التمسك اليائس بأهداب الحياة من خلال الجنس الذى هو المقابل الوحيد للموت الذى يعيشون فيه، وكأنهم يحاولون مقاومة موتهم بخلق حياة جديدة فى الجنس، ولكن على الرغم من هذا الجو المشبع بالجنس، إلا أننا نلاحظ أنه جو شديد الجفاف والقسوة، خالٍ تمامًا من المشاعر الحقيقية فى كل تجلياتها: (هذا اللعب كله من أجل النقود، واحد يدفع ويركب، وواحدة ترقد وتقبض، التعادل نتيجة مرضية للطرفين فى مباراة لا يفوز فيها أحد، وحتى إن حدث ففى الغالب تفوز البنات، جنس سريع مثل الوجبات الخفيفة ولكن بفاتورة مرتفعة، لا واحدة تأتى إلى هنا من أجل المتعة.. كله من أجل النقود)، الجميع هنا يتحرك من أجل المادة ومحاولة الهروب من ذاته الجريحة، المشوهة، سواء كان هذا التشوه بسبب قضية وطنية كبرى مثل مجيد اللبنانى، وأبو شندى الفلسطينى، وأبو جعفر المناضل فى العراق من أجل القضية الفلسطينية، أو كان هذا التشوه بسبب قسوة الحياة ذاتها مثل مهدى التونسى، ونعيمة، ورحمة، وغيرهم، الكل هنا يحمل تشوهه داخله ويحاول أن يتناساه أو يصب بعضًا من قسوة الحياة على الآخرين، إنهم أناس على الرغم من الجرح الغائر فى نفوسهم جميعًا، إلا أنهم يمعنون أحيانًا فى جرح بعضهم البعض بمزيد من القسوة؛ فتأخذ أخت نعيمة عشيقها منها- والذى كان الأمل الوحيد لها فى هذه الحياة- كى تتركها على حافة الجنون لتظل تتساءل: (لماذا غدرت بها أختها، لحمها ودمها وفلوسها، لماذا خطفته منها؟ يحدث ذلك بين البنات أحيانًا، أما أختها فلا.. تكاد تُشل. لم نشلته وهى التى تملك فرصًا أخرى كبيرة)، ولكن على الرغم من هذه القسوة التى قد يجابه بها بعضهم البعض أحيانًا نلاحظ قدرًا كبيرًا من التسامح الإنسانى بينهم؛ ولذلك نرى نعيمة فى نهاية المطاف تُسلم بالأمر (أختك وأخذته، أحسن من أن يذهب لواحدة غريبة!!).
حرص الروائى وحيد الطويلة هنا منذ بداية روايته على الحس التسجيلى الذى يتبدى لنا من أسلوب السرد؛ فهو كسارد حريص على عدم التورط مع الحدث تمامًا، بل هو دائمًا على الحياد كعين الكاميرا التى تسجل بحيادية من دون تورط، ولعل هذا الأسلوب الروائى كان أهم ما يميز هذه الرواية التى لا يتورط فيها راويها مع شخصياته، بل هو يشاهد فقط كى ينقل لك الحدث؛ فنراه يقول فى مفتتح روايته: (كل شيء يحدث فى الحمام، حمام المقهى بالطبع، تتحرك البنات صوبه، واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين، فى الغالب اثنتين، خلفهن بمسافة معقولة رجل أو اثنان)، هذا الحس التسجيلى غير المتورط حرص عليه الروائى على طول روايته فأكسبها شكلاً موضوعيًّا فى جميع الحكايات التى يحكيها، والتى جاءت على شكل أبواب؛ فالرواية عبارة عن خمسة عشر بابًا، كل باب منهم يحمل حكاية واحدة لشخصية ما- وأحيانًا يحمل حكايتين لشخصيتين متشابهتين- وكل باب له عنوان يخصه مثل باب البنات، أو باب الفتح، إلا أن الأبواب كلها تتجمع تحت عنوان باب الليل الذى هو عنوان الرواية، ربما لتُعبر عن الليل الطويل الذى تعيشه جميع شخصيات الرواية، كما أنه على الرغم من أن كل باب يحكى حكاية شخصية بعينها، إلا أن جميع هذه الشخصيات والحكايات تتواشج وتتلاقى مع بعضها البعض داخل المقهى الذى يجمعهم جميعًا، والذى كان مسرحًا لحياتهم الآنية، ولكن هل معنى ذلك أن الرواية من الممكن النظر لها باعتبارها عالمًا روائيًا ينبنى أساسًا على التراتب؟ بمعنى أن كل باب من هذه الأبواب لابد أن يُفضى إلى الباب التالى له؟
علّ التأمل فى رواية وحيد الطويلة يؤكد لنا أنه بالرغم من اختلاط هذه الشخصيات جميعها ببعضها البعض، وعلى الرغم من تداخل حكاياتهم مع بعضها البعض، إلا أنه كان من الذكاء ما جعله يترك مساحة للقارئ المحترف أن يُعيد ترتيب الأبواب كيفما يحلو له فيما بعد، بمعنى أننا نستطيع أن نُعيد ترتيب هذه الأبواب بالشكل الذى نراه نحن- وكأننا نلعب لعبة البازل- وعلى الرغم من ذلك تظل الرواية على بناءها واستقامتها وتتداخل حكاياتها دون أن يحدث بها أى صدع مشابه لشخصياتها، إذن فنحن نستطيع أن نُطلق عليها تجاوزًا: أنها الرواية المرنة، التى نستطيع اللعب معها بسهولة فى إمكانية إعادة بناءها دون الإخلال بها، ولعل تلك ميزة فى البناء السردى لدى وحيد الطويلة اختص به نفسه فى هذه الرواية، من خلال لغة سردية قوية ومفردات موحية ومُحملة بالكثير من الإيحاءات والمعانى؛ ولذلك من السهل جدًّا أن يجد القارئ نفسه متوقفًا أمام الكثير من الجمل ليُعيد قراءتها مرة تلو الأخرى نتيجة جمالها، فنرى: (أجساد أفريقية، سيقان طويلة متماسكة تسند بجسارة عجيزات جسورات، وافرة واعدة، مندفعة بحساب.)، أو (هى تريد بنكًا وهو بنك بخيل، هى تريد رجلاً، وهو رجل بالصدفة)، أو (يصمت كدهر، ثم ينطق كلحظة)، وغيرها الكثير من الجمل والعبارات على طول الرواية، لاسيما الباب المُسمى بباب النحل الذى قد يجعلك تقرؤه غير مرة نتيجة لغته المُوحية الجميلة من خلال البيان الافتتاحى أو دستور “باربى” الصحفية التى هى فى بداية الثلاثينيات، وتحاول دائمًا اصطياد الشباب الذين هم فى بداية العشرينيات، كى تلقى عليهم وتوجههم من خلال دستورها الذى يخصها وحدها كأنثى، هذا الباب كان من أكثر الأبواب ثراء لغويًا ليجعلك تتوقف أمامه طويلاً.
ربما كانت رواية وحيد الطويلة “باب الليل” على الرغم من إيروتيكيتها الخادعة، رواية سياسية فى المقام الأول، أى أنها من الروايات القليلة التى تتحدث بصدق وعمق عن الوجع الفلسطينى، ونضال الفلسطينيين مع جماعتهم التى كفر بها المناضلون؛ نتيجة كثرة تنازلاتها وتخليها عنهم بعد أن قدموا لها عمرهم وأرواحهم التى ماتت؛ فتركتهم فى النهاية مشردين بلا مأوى أو أى اهتمام حقيقى بهم، تركتهم فى العراء حيثما اتفق، بلا أى مال أو أى رعاية، ولذلك نرى شادى المناضل السورى الذى عبر الحدود إلى لبنان كى يناضل مع الثورة الفلسطينية يقول كافرًا بالثورة والنضال:( فى أى شىء يمكن أن تناضل الآن؟ فى الوطن؟ أى وطن!! لقد تغير طعمه بعد مائة اتفاق ردىء، بين أرجل جماعتنا وتحت أقدامهم، نظرهم قصير جدًا، لكن لا تلمهم، الأيدى قصيرة أيضًا، والأيدى الطويلة التى تعبث فى مؤخراتهم لا حصر لها، وكفى الوطن أن يبقى فى توهة الحلم إلى أن يستيقظ الأخير من سباته)، ولذلك يقول وكأنه يقرر الحقيقة الخالدة التى توصل إليها بعد سنوات طويلة من النضال:(اسمع، ليس هناك غير الجسد لنناضل فيه، لم يعد لدينا غيره، هو الذى يستحق، تعلو كركرته ويطرق كفك بكفه، يمد سبابة حازمة متراقصة: ولا أريد لأحد، أى أحد أن ينغص كفاحى فيه) بل نراه فى موقف آخر يقول بشكل أكثر قسوة وحدة:( لن أدفع لأى امرأة لتنام معى، أدفع لها لأى سبب آخر، أو سأدفع لها لأنها لا تكذب علىّ- يصمت قليلاً- أو لأنها تكذب وأنا أعرف، يربت على كتف “أبو شندى”، ينظر عميقًا فى عينيه، يدير رأسه ناحية أبى جعفر المتخندق خلفه: خُدعنا فى الثورة، لا يجب أن نُخدع فى النساء)، ربما كانت شخصيات المناضلين الفلسطينيين والذين قدموا الكثير جدًّا للثورة الفلسطينية تبدو من أهم شخصيات الرواية وأكثرها ثراء ووجعًا يدعو للتأمل المبتئس لما يلاقونه من موت حقيقى، ولعل هذه الشخصيات لاسيما شخصية أبى شندى- التى نراها أهم شخصيات الرواية- من الثراء والوحشة والتشوه ما يجعلك تتأمله كثيرًا حتى أنك تشعر بنفسك قد وقعت فى ذات الجرح والخواء والوحدة الدائمة التى يعانيها، ولعل هذه الشخصية المهمة تذكرنا للوهلة الأولى بالفيلم القاسى الذى قدمه المخرج العالمى ستيفن سبيلبيرج Munich ميونيخ عن القضية الفلسطينية ولكن من وجهة نظر يهودية، والذى لم يأخذ فيه جانب فلسطين ولا جانب إسرائيل بقدر ما حاول أن يقول: بأن ما يحدث على الجبهتين من تقتيل ودمار ومذابح للجميع هو قتل حقيقى لروح من يظن فى نفسه مجاهدًا، قد يأخذ بروحه إلى الموت الحقيقى؛ فلا يستطيع الاستمتاع بحياته لحظة واحدة؛ ومن ثم يكفر بنضاله الذى كان يفعله من قبل فى سبيل قضيته التى توهم أنها حقيقية، ويكفر بجماعته التى تتخلى عنه فى نهاية الأمر لتتركه على شفا الجنون غير قادر على الوصول إلى حقيقة: هل كان صائبًا فيما يفعله أم لا، بل تتركه معذبًا طوال الوقت غير قادر على الاستمرار فى حياته، إنها مسيرة تؤدى بأصحابها من الطرفين إلى الجحيم الحقيقى على الأرض.
أقول إن شخصية أبى شندى بثرائها العميق كانت من أهم الشخصيات التى مثلت هذا الكابوس الذى لا ينتهى، فهو المناضل الذى نذر حياته كلها وأوقفها من أجل النضال مع الثورة الفلسطينية، ومن أجل ذلك توجه إلى أوروبا حيث مسرح العمليات والاغتيالات؛ ليشترى بنقود المخدرات التى وفرت لهم المال ملهى ليليًّا لممارسة الدعارة من خلال اثنتى عشرة مومسًا مناضلات معه من أجل القضية، وليكون الملهى ستارًا على عملياتهم فى الاغتيالات التى يقومون بها، وعلى الرغم من خسارته الفادحة لزوجته اللبنانية/ أم زينة التى ماتت بدلاً منه بعد تفخيخ سيارته وماتت معها ابنته، وعلى الرغم من أنه قدم كل ما يمكن أن يقدمه للثورة الفلسطينية، إلا أنه لم يستطع العودة إلى فلسطين مرة أخرى بعد اتفاق أوسلو الذى وقعه ياسر عرفات، بل تناسته الثورة تمامًا وتركته مشردًا فى تونس بلا أى مال يستطيع أن يعيش منه، فكأن عمره الماضى بأكمله كان مجرد سراب لم يقدم فيه شيئًا؛ ليظل دائمًا يحمل داخله همومه وشروخ الروح التى لا تنتهى نتيجة اجترارها الدائم، لذلك فهو يؤكد دائمًا بجدية مغلفة بالسخرية: ( كل شىء يحتاج لبائعات الهوى)، إنه الرجل الذى تراه (وجه محايد دون تعبير واضح، يبدو كأنه قضى وطره من الدنيا، كأنه لا يأمل فى شىء بعد الآن، ينفث سيجارة تلو الأخرى بعجلة، غالبًا ينساها مشتعلة ليدخل فى غيرها)؛ وربما لذلك تشعر بالأسى الشديد حين تقرأ هذه العبارة الموغلة فى القسوة واليأس حينما ينظر أبو شندى إلى صديقه أبى جعفر المناضل مثله من أجل الثورة والذى يعيش نفس المأساة: (حين تفقد أهلك ووطنك، وأنت صبى أو شاب ستبحث عنهما فى ثقب الإبرة، ستجد لك أهلاً آخرين ووطنًا مؤقتًا، وحين تفقدهما وأنت على مشارف الستين لا يتبقى لك سوى بائعات الحب، دون أن تشعر تكوِّن جيشًًا منهن، يصبحن وطنًا احتياطيًا، يلاعبنك، يهتممن بك كسائح ليبى أو من الهنود الحمر ويغنين لك النشيد الوطنى الذى يعوضك عن نشيدك الأصلى، وحين تفقد أوطانك الأصلية، ولم تعد قادرًا على اللعب فى الأوطان والأحضان الاحتياطية لا يتبقى لك سوى الجنون، حتى الجنون أحيانًا يخونك ويخلف موعده لتبدو أضحوكة أمام نفسك.)، إنها المأساة الحقيقية التى قدمها لنا على الشاشة ستيفن سبيلبيرج فى فيلمه ميونيخ، ليأتى اليوم وحيد الطويلة كى يقدمها فى شكل أكثر قسوة من خلال أبى شندى، وشادى السورى، وأبى جعفر المناضل الذى ساند الثورة الفلسطينية بكل ما يملك من خلال وجوده فى العراق، إلا أنه بعد إعدام صدام اضطر إلى الهروب ولم يجد سوى تونس ملجأ له (حط هاربًا فى لحظة لم تخطر على بال رسام أو مؤرخ، يقولون إنه مشى أيامًا حتى وصل إلى الأردن، لا يعى ماذا حدث بالضبط، الذين رأوه فى اليوم الأول قالوا أنهم شاهدوا رجلا يمشى بدون رأس، بحقيبة واحدة على ظهره، الذين رأوه فى اليوم الثانى قالوا إنهم شاهدوا رأسًا على الأرض يتدحرج بسرعة وحده باحثًا عن جسده، بشارة موت معلقة فى أذنه اليسرى، آخرون قالوا: إنه كان يطير فى الهواء وينبح.. ينبح بلا توقف ككلاب الجحيم: أمريكا احتلتنى وحدى، حبستنى وحدى)، وهناك دار فى نفس الدائرة التى يحياها أبو شندى، إلا أنه لم يستطع تحمل خواءه ووحدته القاسية فكان دائمًا ما يدعى المرض كى يلتف حوله كل رواد مقهى “لمة الأحباب” من المومسات والرجال كى يشعرونه بالدفء والاهتمام( أعجبته حكاية المرض، وجد فيها من يهتم به ويسأل عنه)، وربما لذلك أجرى غير عملية جراحية بالرغم من أنه لم يكن مريضًا، ولكنه دائمًا فى حاجة للاهتمام به بعد أن فقد كل شىء، فكان الحل السحرى بالنسبة له هو تمارضه الدائم الذى كان يجعله محاطًا بالجميع، إنها أرواح شديدة الاهتراء قتلتها الثورة بعد أن امتصتهم عن آخرهم.
حتى جميع الشخصيات النسائية/ المومسات داخل الرواية لها حكاياتها القاسية المؤلمة التى دفعتها إلى مثل هذه الطريق، وهذه الحياة التى رأوا فيها هروبًا من مآسيهن وشكلاً من أشكال الانتقام من الحياة التى فعلت بهن ما فعلته؛ وربما لذلك نرى الجميع فى رغبة دائمة للاكتمال والشعور بالأمان والاهتمام من قبل الآخرين، على الرغم من أن الجميع يدور فى نفس الفلك والوحشة الدائمة؛ ولهذا نرى جميع الشخصيات تحاول التقارب فى النهاية، وربما كان هذا هو السبب الذى جعل نعيمة تحاول أن تجذب أبا شندى- الذى هو بقايا إنسان- إليها بكل الطرق (هو يحتاج لوطن دائم، وهى تحتاج لواحد دائم، لم يبقَ من حلمها القديم إلا أن يكون أجنبيًّا، وأبو شندى أجنبى وقريب فى الوقت نفسه)، وفى موضع آخر (هو يحتاج لمن تضعه على بطنها ليهدأ ظهره، يحتاج لمن تضع ساقها على كتفه ليشعر أنه قادر، وهى تحتاج لمن يضع يده على كتفها طويلاً لتشعر أنها إنسانة، يلمس شعرها، ثم ينزل على خصرها لتشعر أنها أنثى، محبوبة قبل أن تكون مرغوبة)، إذن فهى محاولة التعويض الدائمة من قبل الجميع للجميع، محاولة معالجة الجروح والتشوهات التى هى فى أعماق أرواحهم، حتى لكأنهم يتدثرون ببعضهم البعض على الرغم من معاناتهم جميعًا نفس المعاناة وإن اختلف شكلها.
ربما كانت رواية وحيد الطويلة تذكرنا فى إحدى جوانبها ببعض روايات النضال الكبرى والخالدة فى الذاكرة الأدبية مثل رواية زهر الليمون للروائى علاء الديب، ورواية وليمة لأعشاب البحر للروائى السورى حيدر حيدر، لكنه استطاع بذكاء ومن خلال عالم يخصه وحده أن يعجن حكايته بخلطته المختلفة عن الجميع؛ كى تعتبرها رواية مغرقة فى الإيروتيكية إذا رغبت ذلك، أو أنها من روايات النضال الكبرى لو رغبت هذا أيضًا، أو إنها رواية تحمل كل هموم وتصدعات الروح وخرابها من خلال مقهى “لمة الأحباب” ومومساته الكثيرات اللاتى لابد أن تتعاطف معهن وتشعر بوجعهن، بل قد يصل بك الأمر لأن تناضل معهن من أجل الوصول إلى ما يرغبنه للتخلص من آلام البؤس الروحى اللاتى يشعرن بها، مثل حلومة التى كانت البنت الثالثة لأب لا يرغب فى الإناث؛ ولذلك رفض أن يسجلها باسمه أو أن يرعاها، فتم تسجيلها باسم خالها وعاشت فى أحضان خالاتها، وحين صادقت واحدة وحاولت أن تكون بجانبها دائمًا نصبت هذه الصديقة على الآخرين بشيكات لا رصيد لها وهربت هى وعشيقها لتتورط حلومة فى الأمر وتقضى عشر سنوات فى السجن (حلمت مرة واحدة أن تتزوج وأن تخلف بنتًا تسرح لها شعرها، تغنى لها حتى تنام ثم تفتح قلبها، تشقه نصفين، تدخلها فيه وتنامان معًا.. وأن تختار لها أبًا يفخر أنه كتبها باسمه، لم تسمح لنفسها أن تحلم بالولد حتى لا يزداد جرحها)، ولكن إلام أدت بها الحياة والأحلام؟
(سرّحت لزميلاتها فى السجن شعورهن، نهشت أجسادهن الجائعة بأصابع عطشى، وهى التى كانت تحلم بمن يمسد بيد طرية جسدها، واختلطت الخطوط فى بعضها، وتسللت الأصابع، واشتعل عنبر السجن بآهات مكبوتة تحت وطأة الليل والظلام والحاجة، تمدد سقفه، وما لم تفعله الأصابع فعله اللسان، تكلمت بلسانها كثيرًا، رماها أبوها بنتًا فذهبت للبنات)، ولذلك تقول: (السجن إصلاح وتعذيب وسحاق أيضًا، تعلمت فيه حرفة تنفعها فى المستقبل)، إذن فجميع الشخصيات لديها وجعها الخاص الذى يدفعها إلى طريقها الذى ترى فيه تعويضًا عما حدث لها أو انتقامًا مما حدث معها، الكل هنا له مبرراته، وله وجعه الذى لابد من مداواته بأى وسيلة أيًّا كانت.
ربما كانت الإيروتيكية التى غلف بها وحيد الطويلة روايته، والإيهام بالحياة وصخبها وضجيجها ودفئها وشبقها على الرغم من خوائها فى الحقيقة هى أهم ما يميز روايته؛ ولذا من الممكن جدًّا أن أرى فى تلك الإيروتيكية المتعمدة فضيلة كبرى استطاعت أن تجعلنا نحتمل كل هذه الأوجاع الإنسانية سواء التى تحدثنا عنها أو تلك الأخرى التى سكتنا عنها؛ كى نخرج فى النهاية برواية مهمة فى السرد العربى، لابد من التوقف أمامها طويلاً لتأمل جماليات البناء الروائى، وجماليات السرد واللغة.