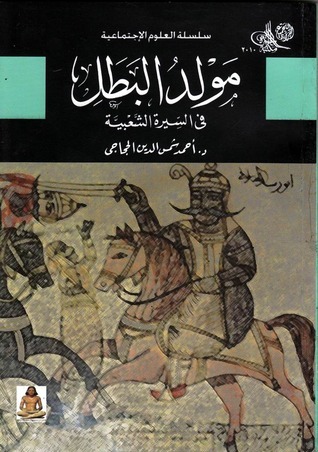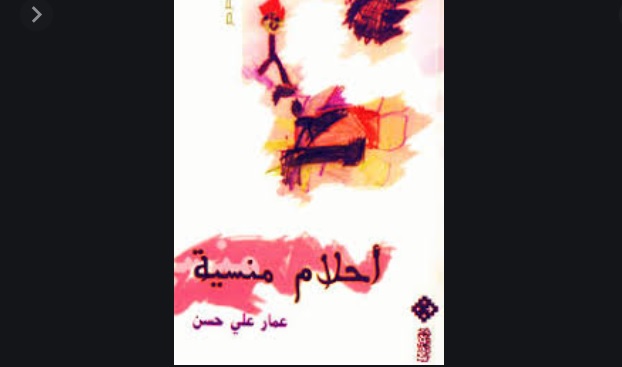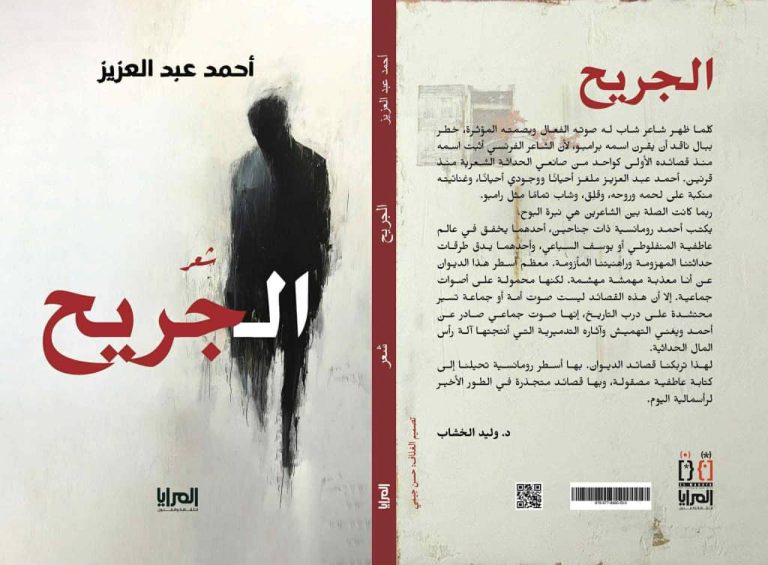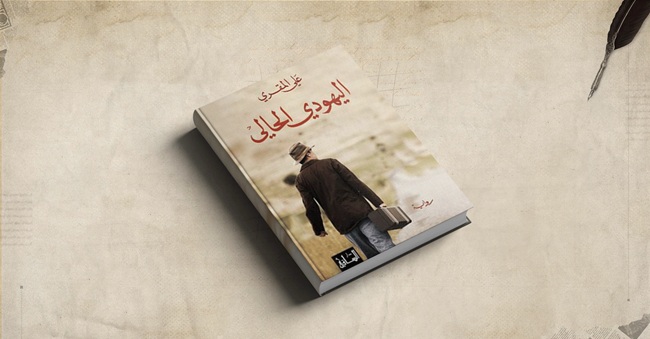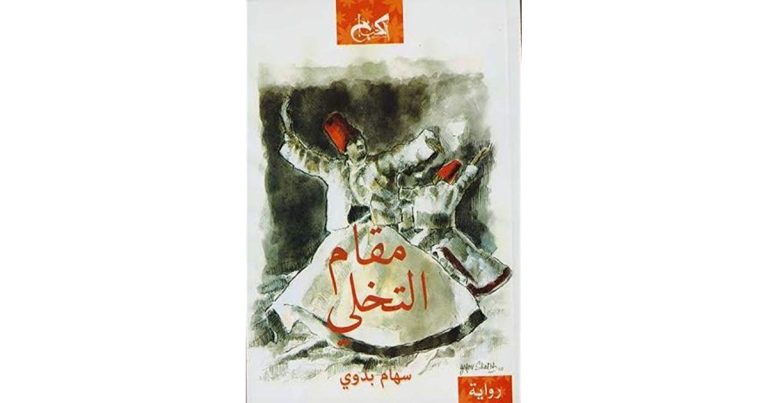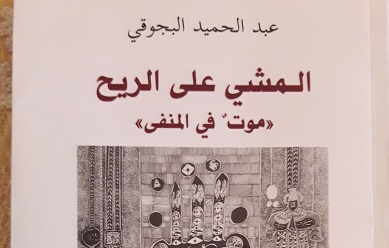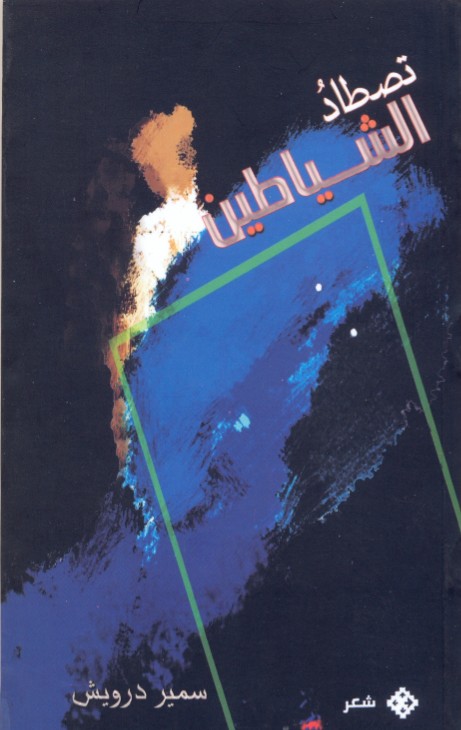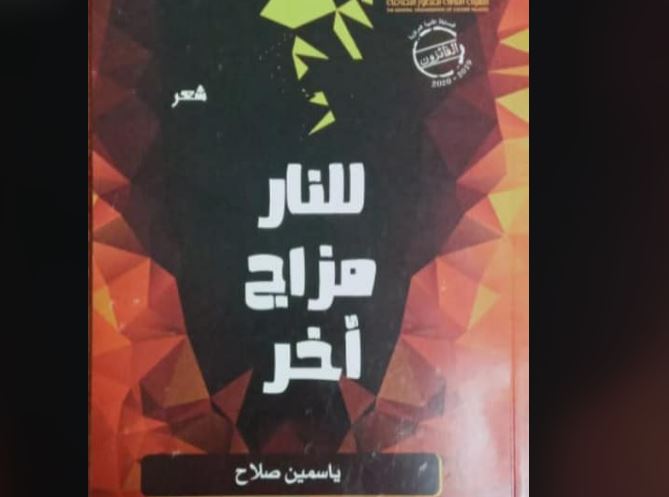ممدوح فرّاج النَّابي
سمير درويش واحدٌ من جيل الثمانينيات في مصر، يسعى جاهدًا مع زملائه من أبناء جيله إلى أن يصنعوا علامة فارقة في مسيرة الشعر بعدما وقعوا ضحية لجيلي الستينيات والسبعينيات، فمع رحيل معظم شعراء الجيل الأوّل، ونضوب قرائح الشعرية للباقي ممَّن هم على قيد الحياة، ومشاغبات جيل السبعينيات ومحاولاتهم للظفر بإنجاز تجاوز مرحلتهم، فظفر البعض منهم باعتراف بما يكتبون في مرحلة لاحقة مع أعمالهم التي لاقت قبولًا حتى وجدت طريقها للدرس الأكاديمي، وما بين جيل الستينيات حامل القضايا الكبري وجيل السبعينيات الساعى للتمرد على سلفه بكتابة قصيدة لها ملامح مُستقلة، وإن كانت لا تختلف كثيرًا عن جيل الستينيات في إلحاحها على التركيز على القضايا المصيرية والكبرى، وإن تميّز بعضها بالتركيز على الخطاب اللغوي الذي لاقى احتفاءً كبيرًا عند اثنين منهم محمد عفيفي مطر وحسن طلب، وإن كان البعض يعد تجربة عبد المنعم رمضان مميَّزة، ماعدا ذلك فلا تجد ملمحًا مائزًا يكاد يفرقهم عن سابقيهم أو لاحقيهم، أو حتى قدموا إضافة حقيقية تميزهم عن غيرهم سوى اختصاصهم بمجلتين جمعت الكثير من الشعراء تحت لوائها، هما إضاءة 77 وأصوات.
في ظل هذه الأجواء والسياقات التي خلت من المشاريع الكبرى التي يلتف حولها الشعراء كما حدث مع سابقه، جاء جيل الثمانينيات فلاذ كثيرٌ من أبنائه بقصيدة النثر، يعرض من خلالها لواقعه المشوَّه وراصدًا للهامشي منه، كتأكيد لمسعى جمالي يجعل من الواقعي شعري ويلبسه بلبوس الخيال، الشيء اللافت في نتاج هذا الجيل هو إندياح الحدود النوعية، داخل كتاباتهم والتي اتَّسمت عند كثير منهم بالتعدُّد والتنوُّع ما بين النثر والشعر، بل وصل إلى أن القصيدة ذاتها تحمل هذا الهجين والثراء. ونموذج سمير درويش دال على هذا، فإلى جانب كونه واحدًا من شعراء الجيل وأكثرهم نتاجًا فقد أصدر أحد عشر ديوانًا غير هذا الديوان، إلا أن له محاولات نثرية متمثلة في كتابة الرواية علاوة على المحاولات النقدية التي يكتبها هنا وهناك. والدواوين هي كالآتي: قطوفها وسيوفي 1991، موسيقى لعينيها خريف لعيني 1993/ النوارس والكهرباء والدم 1998/ الزجاج 1999/ كأعمدة الصواري 2002/ يوميات قائد الأوركسترا 2008/ من أجل امرأة عابرة 2009/ تصطاد الشياطين 2011/ سأكون ليوناردو دافنشي 2012/ غرام افتراضي 2012، وديوان الرصيف الذي يحاذي البحر/ 2013، بالإضافة إلى روايتين: خمس سنوات رملية 2004، وطائر خفيف 2006.
-1-
ديوان “من أجل امرأة عابرة” الصَّادر عن سلسلة أصوات أدبية التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، يمثِّلُ امتدادًا للتجربة التي بدأها الشاعر بديوانه الأوَّل وتوالت عبر أعماله المختلفة وصولًا إلى آخر دواوينه “الرصيف الذي يحاذي البحر”، وهي تجربة تنتصرُ للتفاصيل والحياة، فالشَّاعر مولعٌ برصد الواقع العياني وحالات الإحباط التي تعتري إنسانه، لذا دائمًا نرى إنسانه عبر عدسته الراصدة في صوره المتعدِّدة؛ الشارد واللامبالي والخائف، وأيضًا العاشق. المتابع لتجربة الشاعر على امتدادها الأفقي وأيضًا العرضي يجد ثمة ولع بالتجريب يُمارسه الشاعر في كل تجربة من تجاربة الشعرية، فالمتأمِّل لآخر دواوينه الصادرة بعنوان “الرصيف الذي يحاذي البحر” يكتشف امتداد حالاته الشعرية وتقنياته وإن كانت في تطور يُحسب للتجربة الأخيرة، وهذا التطور ناتج عن وعي الشاعر وإلمامه من خلال المتابعة للتجارب الشعرية المختلفة والمتنوعة وأيضًا العابرة للحدود حيث استحضار تجربة شعر الهايكو الياباني ذي المقاطع القصيرة. كما تتداخل في نصوصه أنواع أدبية متعدِّدة وهو ما يُوحي بسعيه إلى مفهوم يتجاوز مفهوم بدايات قصيدة النثر التي ينشغل عليها، حيث تتجاوز الإجراءات البلاغية المُتعارف عليها، إلى إجراءات بلاغية/ واقعية خاضعة للتجربة الشعرية وللحالة الشعرية المنتجة؛ وعدم قصرها على المألوف وإنما يطوِّرها، وفق ما يتواءم مع تجربته الشعرية، بالارتكاز على مجاز الواقع، وهو مجاز مغاير لمجاز البلاغة ومنحرف عن مفاهميه البلاغية النظرية القارة؛ حيث يستمد أشكاله المجازية التعبيرية من مواقف حياتية واقعية وصور واقعية”؛ مما يعطِّل فاعلية الإجراءات البلاغية التي تُصبح في سياق التجربة شكلية لا بنائية.
-2-
ثمة ملاحظة لافتة في أعمال سمير درويش عامَّة، هي اختراقها لحدود النوع الشعري، ومن ثمَّ فهي تتمثَّل للحداثة في أبسط صورها، حيث اقترابها من السَّرد باعتمادها على تقنياته، إضافة إلى تراسلها مع نصوص أخرى فيستحضر تمثُّلات ثقافية يأتي حضورها ليعطي المعني الشعري دلالته التي تتجاوز واقعيتها الصرفة فنرى حضورًا لندوة لمناقشة مجموعة سيد البحراوي “صيف وشتاء” وأغاني عبد الوهاب وأغنية سيلين ديون بترجمته، وكذلك نصوص قرآنية، كما تحضر لقاءات مع أصدقاء ورحلات، فتقترب عوالم الشعرية لديه بالعوالم السردية، بل تكاد تكون تيمة أساسية في معظم نتاجه الشعري، ليس فقط في اعتماده على سرد التجربة الشعرية، وفقط، بل باستعارة عناصر السردية، فيستحضر الراوي الغائب الذي بمثابة عين الكاميرا في التقاط الجزئيات/ المشاهد السردية، وتجميعها أمام بؤرة الكاميرا التي هي عين السادر. في قصيدة الأقصر وهي تبدو أشبة بسرد ذاتي عن رحلة قام بها الشاعر مع مجموعة من أصدقائه إلى مدينة الأقصر، يسجل الراوي الغائب ما تلتقطه عينه هكذا:
“فى هذه الساعة المبكرة
لا يشغل ميدان المحطة سوى:
سيارات الأجرة التى يتثائب سائقوها،
الدكاكين الصغيرة،
بائع الصحف،
سيارة الشرطة التى تغطيها حبات الندى،
الضابط بنجمته الصفراء،
وهؤلاء
الذين يلبسون جلاليب واسعة
يفترشون الأرصفة بأدواتهم البدائية
شاخصين أبصارهم نحو الغيب”. (الديوان، ص 73)
يستمر الشَّاعر في وصف -والوصف تقنية مستوحاة من السَّرد- ما تقع عليه عيناه من مناظر ومزارات داخل المدينة الأثرية، بل يدخل في حوارية مع ذاته أشبه بديولوج عن تساؤلات تشغل ذات الشاعر، كما يتبدى في صراعه بين حالات الانفتاح التي تبدو عليها السائحات وحالة الرغبة التي تعتري الذات التي تشاهد الأجساد العارية، ويلخص إحجامه عن الفعل لقوانين التحضُّر، ومن ثم يلعنها، وتمتد التساؤلات لتشغل صِراعًا فكريًّا حول وعيه المعرفي عن هذه الحضارة وما هو يرتأيه في الواقع العياني.
-3-
طغيان السردية يميل بنصوص الديوان إلى شعرية الحالة، فرغم استقلالية قصائد الديوان ظاهريًّا/ شكليًّا بوجود عتبات رئيسية متمثِّلة في العناوين المستقلة، إلا أن على مستوى الشعرية ثمة حالة واحدة ممتدة عبر قصائد الديوان تتمثَّل في تأملات الذات الشاعرة ورصدها للواقعي الذي لا يسبب الدهشة بنقله بصورة مجازية أو خيالية بقدر ما يحقق الدهشة في نقله كحالة إلى النص الشعري كما هو ظاهر في القصيدة الأولى “ميتة عابرة”. في قصيدة “المترو” تبدو القصيدة وكأنها حكاية سردية مروية بضمير المتكلم، تصوغ للذات الشاعرة عبر هذا الضمير تأملاتها منذ لحظة ركوبها المترو، في رحلتها حيث اللِّقاء المُرتقب في محطة الجيزة، وما يقابلها من تداخلات مع وعي الذات الشاعرة ومدى تعارضها أو توافقها مع الحالة الخارجية، فتصبح القصيدة كمشهدين خارجي/ رصد للعالم المحيط، وداخلي ذاتي من خلال وعي الشاعر/ تأملاته، ويتداخل المشهدان حيث الحالة الشعرية التي تغلب وتسيطر، فتصاب الذات الشاعرة بحالة من الشرود والتشتت، وهو ما انعكس عليها منذ تماهيها مع العالم الخارجي الذي هو منفصل عن واقعه، ومصاب بحالة من التوهان وعدم المبالاة (بما كان يدندن به)، وهو ما يعكس أن هذا العالم غير المتجانس الذي اجتمع في هذه البؤرة المكانية/ المترو، بالمصادفة فصله عن واقعه نظرًا لتناقضه وتنافرهما بين الشاب الأندونيسي الذي يبيع المصاحف الصغيرة داخل عربات المترو والفتيات الثلاث.
العالم في المترو متناقضٌ مع الأغنية المُستدعاة، فأفراد هذا العالم منفصلون عن واقعهم، كل شخص على حدة، جميعهم يتوحدون في أنَّهم لا يأبهون للناظرين وهو الشيء الوحيد الذي يجمعهم رغم تواجدهم في حيز واحد/ المترو الذي يَعْبُرُ بهم من محطة إلى أخرى، ومع تبدُّل الركاب إلا أن حالة اللامبالاة مستمرة وما يوازيها من التشتت والضياع للذات الشاعرة التي تتوَّزع ذاتها على الذوات المحيطة بها، فلا تتذكر أية أغنية لعبد الوهاب كانت تدندن، أو يستحضر لقاءً تمَّ في ندوة لا علاقة لها بالعالم المُحْتَشِد سوى إطلالها ليؤكِّد عبثية المشهد.
-4-
يستحضر الشَّاعر في تجربته أسماء شخصيات لها حضورها على المستوى الإبداعيِّ وكذلك على مستوى تبني قضايا وطنية والتعبير عنها، وهو ما تبدى في إهداء الديوان لاسم صبري موسى “شاعر الرواية العربية” كما يصفه، وهو ما يعضد من قيمة الوفاء التي يتسم به الشَّاعر، ويكنُّها لأشخاص لهم تأثيراتهم على مستوى مسيرته الإبداعية، كما هو ظاهر في علاقته بحلمي سالم الذي يتخذ مقطعًا من نصه “يوجد هنا عميان” ليصدِّر به نصه، في مفارقة لحالة الإبصار التي تظهر بها الذات الشاعرة في التقاطها للتفاصيل وللهامش التي لا ترصدهما إلا عين الخبير. وفي إطار حالة الاستحضار لا يرد اسم الشاعر أمل دنقل كمُهدى إليه النص في قصيدة “البدروم” وفقط، وإنما يتجاوز حضور أمل الاسم والإهداء إلى استعارة الموقف الأيديولوجي منه المُعبِّر عن الشموخ، ومن ثمَّ فالتناقض الذي يشير إليه عنوان القصيدة الذي يوحي بالهبوط والانحدار علاوة على اقتباس الايقاع في قصيدة من كلمات سبارتاكوس والتي هي أشبه برسالة من ذات الشاعر الرافض لشعب مصر، حتى أنه يبدأ المقطع الأول مترادفًا مع أمل فيقول درويش: تقوَّسوا/ تقوَّسوا/ تقوَّسوا (رسالة لأهل مصر) مرادفًا لمقولة أمل “علِّموه الانحناء”، ليست هذه هي الاستعارة الوحيدة بل إن النص وحالة السخرية والتمرد على الواقع بمثابة استلهام لنص أمل أو بمعنى أدق نصوص أمل الأخيرة التي تمثِّلها في ديوان المرض (أوراق الغرفة 8)، فالقصيدة عن رجل الأمن المتربص والذي يتحايل عليه الشاعر بانتظاره لا بالهروب منه فهو يجلس بعد أنهى طقوسه اليومية منتظرًا أن يفاجأه ولكن فِعْل المُفاجأة غير متحقِّق في ذات الشاعر الذي أعدَّ كل شيء لاستقباله وإنما متحقق في الشرطي.
وقد يتكرَّر حضور أمل لكن هذه المرة عبر الشكل الذي انتهجه أمل في ديوانه الأخير وخاصة في قصيدة الموت في لوحات، وإن كان ثمة تماسات في بعض حالاته الشعرية في قصيدة الطريق السريع/ لوحات مع حالات قصيدة الجنوبي. ومع دخول هذه التراسلات والتماسات في باب التناص أو التداخل النصي -كما يسميه البعض- فإن هذا أولًا لا يقلِّل من أهمية النص الذي نهض على تخوم نصوص أخرى، وثانيًا لا يلغي خصوصيته الإبداعية بل على العكس يؤكد سماته المتميزة بوصفه نصًّا قائمًا بذاته تجاوز غيره أو تخطاه، وعملية التناص لا ينفيها الشاعر بل يؤكِّد عليها في إشارته القصدية في التصدير بأن “هذه القصيدة مشغولة بالآخر”، ثم رَاحَ يُعدِّد الآخر إلى؛ الحبيبات الحاليات والمفترضات والأصدقاء، زوجتى وأخواتها، وصديقاتهن،.. إلخ، إضافة إلى تقسيمه القصيدة إلى مقاطع أو لوحات يصل عددها إلى ستة عشر مقطعًا (وهو يتجاوز عدد مقاطع قصيدة أمل التي تصل إلى خمسة مقاطع). تتنوَّع المقاطع ما بين الذاتي الذي يشكِّل صورة جديدة تسعى من خلالها الذات الشاعرة إلى استعادة سيرتها، وبين الانشغال بالعام الذي هو هاجس الشاعر في الأساس، فتراه يُظهر حالة المتاهة التي يعيشها منذ أن انقضت ثماني سنوات “مسجونًا في لحظة جاثمة” دون أن يعثر على ذاته، ليرتد مُباشرة إلى تلخيص لمسيرته الحياتيه: كنت طفلًا في الخامسة/ حين ملأتُ رأسي بخيالات فتاة تتمدَّد وحيدة/ خلف شباكها المقفول، وصولًا إلى مرحلة النضج دون أن يعثر على ما يبتغيه فمرّت: أربعون سنة كاملة/ قرأ فيها مئات الكتب وقطع خلالها آلاف الأميال، ومع هذا: ما زالت الخيالات تسكنني والمرأة التي تتأوه خلف الشبابيك المقفلة. ورغم ثمة مؤكدات أو دلالات فيزيقية تؤكد حضور ذاته خاصة بعد أن “غرسوا شمعة وسط تورتة صغيرة/ ولصقوا قبلهم على خدي وشفتي” كما يقول. لكن في النهاية مع حضور كل المؤكِّدات يفاجئنا بأنه “لم يكن هناك/ حيث ثوبك الكاكاوي من القطيفة الذي التصق بي من الخلف” (68: 69)، الشيء المهم الذي يخرج به في هذه التجربة بعد إمعان التدقيق والرصد والمتابعة هو “أن الطريق السربع/ الذي يتوازى مع العمر ليس: سوى جسر بين شاطئين/ غير أنه لا يصلح لممارسة الحب، اللهم إلا في تلك السيارات الغالية/.. التي تتسكعُ في أقصى اليمين/ أو على المقاعد الخلفية/ في سيارات الأجرة)، الشيء الآخر الذي يُدركه هو أن (عمر المرأة يصير أطول/ كلما مات الرجل من أجلها)، وهي معاني خبرها الشاعر من تدقيقه وتأملاته التي تمزج الخاص بالعام.
رغم أن كثيرًا من حالات الشاعر تميل إلى الذاتية فإن هذا لا يعني انفصال الذاتي عن الشأن العام، فنرى الذات الشاعرة تتفاعل مع حالة الاستنفار الأمنى عقب الحوادث الإرهابية ومعاناة الشاعر التي تعكس تمثلًا حقيقيًّا لمعنى المثقف الفاعل/ الغضوب في المجتمع بتعبير جرامشي، لذا يحيل ما يقع عليه على غيره الآخر الملتبس في ذاته/ الإنسان المهمش الذي قد تضعه ظروفه ليخضع لعملية التفتيش فالشاعر اعتمد على المخزون المتشكِّل في اللاوعي لإكمال الصورة الناقصة التي لم يحضر طرفها النقيض إلا عبر الخيال، ومن خلال محازاة نفس حالة الالتباس في الصورة بين حالة الأمن غير المتحقِّقة التي تجعل الضباط يقفون على مدخل كنسية “ماريو حنا” وبين الفتيات اللاتي يفترض أنهنّ يحظينّ بالأمن في حضور الضابط الشَّاب، وبدلًا من توفير الأمن وعلى مستوييه لهن يخترق بسلطته المحتمي بها أمنهن الداخلي وهو ينظر إلى مؤاخراتهن، فالشاعر يرصد لحالة التناقض بين حالة الأمن التي يجب أن يحققها هذا الضابط وبين انتهاكه لها وهو يحتمي بسلطته: يحمل جهازًا لا سلكيًّا، وهو ما يضطرهن إلى اللوذ بالأمن الداخلي، والأعجب أنهن يقابلن ما أحدثه من فزع وتحرش بلامبالاة فـ: يتعلقن بأذرع فتيان في مثل أعمارهن/ ويرسمن حقول البهجة. (الديوان، 73)
– 5-
تستقي قصائد الديوان مجازاتها ليس من البلاغة وإنما من الواقع، فالصور الشعرية التي يحتوى عليها الديوان خالية من المجازات والصور المفرطة في الدلالات والمعاني التي تتجاوز السياق المعجمي، وهو ما يعطي للمفردة شعرية الحالة. فمنذ القصيدة الأولى التي يكاد يكون عنوانها نشازًا عن بقية عناوين الديوان التي احتل فيها المكون المكاني حيزًا طاغيًا غلب على الديوان بعامة. يهيئ الشاعر أفق المتلقي بأن ثمة سلبية أو بمعنى أدق ثمة اعتياد على نمط حياتي سريع عصري لا وجود فيه للمشاعر لدرجة أن الشاعر يعلن (في خضم محاولاتنا الدءوب/ لم نجد وقتًا لنبكي!) (ص 6)، وقد كان لرغبة الشاعر في تسجيل الصورة الواقعية أن جعلته يتغاضى عن مجازاتها فتأتي الصورة خالية من أية بلاغات تتولد عن الصور المركبة، وإنما الصورة عادية، وواقعية ولا نغالي إذا قلنا إنها مفرطة في الواقعية حسب ما يقول في تصويره لمشهد الموت في تطوراته (جسدها يتحوَّل تدريجيًّا منذ أيام/ وجهها يستطيلُ ويشحب وبطنها يتضخم/ وقلَّتْ رغبتها في الكلام/ بالضبط كما هي الآن، الفرق/ أنها للمرة الأولى تنام على صدري) (ص 12)
كما تحيل الحالة الشعرية إلى الغرائبية في ذات الشاعر، فالجثة التي هي فعل سكون تتحول إلى فعل إيجابي يتجاوز حالتها السكونية إلى حركية وفاعلة فتفسد مهمة المحيطين بها بالنبش في الذاكرة واستحضار حالتنا السيئة التي هي نتاج واقعنا المفرط في القسوة والأنانية، فلا نجد وقتًا لنبكي على أحبتنا أثناء وداعهم، ومن ثم فتتمرد الجثة على سكونيتها للتذكير بحقها الذي غاب في سياق مشاغلنا. الشاعر ليس منشغلًا إلا برصد ما هو واقع مباشرة على عينيه، وكأن التجربة التي خبرها جعلته لا يبحث عن أوجاع آلام، فقط يرصد ويتعقب ما هو ماثل أمامه.
-6-
ثمة شعرية تتوازى مع هذا الواقع المحبط تتمثل في شعرية اللامبالاة، حالة الواقع التي يرصدها الشاعر تنعكس على حالة مواقف الشخصيات، فثمة لامبالاة في ردِّ فعلهم إزاء هذا الواقع، وكذلك بالآخرين منذ عدم الاعتناء بـ(العيون التي تختبئ خلف خصائص الشبابيك)، وفي قصيدة “الزَّغب”، تتجلى اللامبالاة، فعندما يقول لنجوى لقد تأخَّرتِ بعد أن نَقَرَ أرنبة أنفها بسبابته (فتضحك غير عابئة بعيون المارة/ ولا المتطفلين في الشرفات المواجهة/ ولا بانفعالات أمين الشرطة) (ص 32)، وفي قصيدة “التحرير” حيث العاشقان لا يباليان بالناس في عشقهما، فهما مشغولان (بكفٍّ ملهوفةٍ على ظهرِهِ،/ وبرغبةٍ طافحةٍ التهمتْ شفتَاهَا شفتيْه../ دونَ أن تلحظَ العيونَ الجاحظةَ من محاجرِها،/ الخارجةَ من صهدِ المقهَى../ حيثُ يجلسُ أربابُ المعاشاتِ/ يلعبونَ النردِ ويدخنونَ الشيشةْ)، وقد تتحوَّل اللامبالاة إلى فعل يصدر من ضباط الشرطة على شكل ابتسامة عندما يضطرون إلى تفتيش حقيبة الشاعر (الملآنة بالكتب/ والجرائد اليومية …/ بعد كل عملية انتحارية) (ص52)
-7-
ثمة وعي من قبل الشاعر بإمكانيات قصيدة النثر وتجاوزها الإطار النظري الذي حُصرت فيها منذ محاولات التأسيس لدى روادها أو ما أعقبها من تقليد لنماذج الرواد، بتطويع قصيدة النثر للتفاعل والتحاور مع حالات شعورية رومانسية يتقاطع فيها الشاعر مع شعراء الرومانس إبان عصر النهضة واستحضار صورهم الشعرية القائمة على مفردات الشاطئ، والصخور، والرمال، والمياه، والمحبوبة، والأمواج، وفي هذه الاستعادة التي تأتي لتثبت وعي الشاعر وقدرته على إحضاع نصه للتجارب الشعرية المتعددة وعدم قصره على إطار ثابت قار، وفي كل هذا هو حالة متطلعة (إلى بئر ثانية وخل لن يجيء) (13، 14)
حالة الوعي بامكانيات قصيدة النثر ممتدة في النص الثالث حيث يطوِِّع القصيدة لغرض شعري قديم هو الغزل، وهو يؤكِّد عدم ثبات الشاعر على بنيات مغلقة، أو قوالب جاهزة يجاري بها أسلافه، بل يخلق لذاته بنيات وحالات شعرية يُعبِّر بها عمَّا يعتريه دون أن يعبأ بالقوالب الثابتة والمكرَّرة التي أصابت قصيدة النثر عند كثير من الشعراء إلا لوحات جوفاء خالية مِن الشِّعرية، بل تكاد تكون تكرارًا لحالات مُشابهة سابقة عليها، وهو ما أدى إلى نفور جماعي وعدم اعتراف من قبل بعض الشعراء بنماذجها وتجاربها. وهو هنا يوسِّع من دائرة شعريتها وامتلاكها رحابة تتجاوز المألوف السائد. وهو ما يحسب للشاعر. وفي قصيدة “ميدان التحرير” لا يأتي التحرير ليستحضر زمن الثورة. فالديوان سابق لها، وإنما يستحضر الجانب الرومانسي له، حيث هو مكان يتواعد العشاق فيه، وبين أشجاره يسرقون قبلاتهم كما في صورة العاشق الأسمر وفتاته اللذين يراقبهما ويرصد أطوار رغباتهما بدءًا من دخول الميدان إلى التأجج وتبادل القبل دون مبالاة بالعيون الجاحظة من محاجرها، وهي حالة من تلصص ذات الشاعر التي تشعر بالوحدة ومن ثم تنشغل بالذين يكتشفون الحب ويثبتانه على جدران أعمدته الرخامية أو بين ظلال أشجاره. في النهاية نكتشف أن ذات الشاعر المتلصِّصة لحالة الحب وحيدة. وقد تتحاور الذات الشاعرة مع الآخر على نحو تحاوره مع مشهد من “تايتانيك”، فيرفض أن يغرق مثل “دي كابريو” من أجل امرأة عابرة.
كما يبدو اهتمام الشاعر بتوزيع الحالة النفسية على توزيع قصائد الديوان وترتيبها داخله، فبعد حالة اللامبالاة المسيطرة على القصيدتين الأولين نراه في قصيدة “رأس البر” تقفُ الذات الشاعرة لتستعيد ذاتها، فالقصيدة أشبة باستراحة واستعادة للذات التي غيَّبتها التفاصيل والمشاهد البائسة السابقة في استراحة مع المحبوبة، فهنا يبدو الشاعر رومانسيًّا يستعيد قصائد شعراء الرومانس في الخلوة واستحضار الماء والضوء فنرى هنا هدوءًا، وهو واضح في اختيار المعجم الشعري وأيضًا في الحالات الشعرية التي قدمها، وحالة الهدوء المستقاة من المكان حيث أحجار البازلت “لا تتكوم على الشاطئ” (ص 12)، وفي ذات الوقت “الشتاء ليس في عنفوانه” وفي أشخاصة “المصطافون لم يهربوا إلى المدن الساحلية” تختلف نظرة الذات الشاعرة إلى المحبوبة.
على الجملة نحن مع حالة شعرية واعية بما تكتب من خلال سعي حثيث للتجريب الذي يمرره داخل القصائد، وأيضًا باستفادته من التراث الثقافي وهضمه وتضمينه داخل نصوصه، وأيضًا باهتمامه بالواقع والهامشي منه، ونقله إلى مجاز الواقع الذي يخالف قوالب النظرية، ليقول إن الشعرية مرنة ومتطورة، وقابلة لاستيعاب أنواع مغايرة عنها في المَنْحى الجمالي.