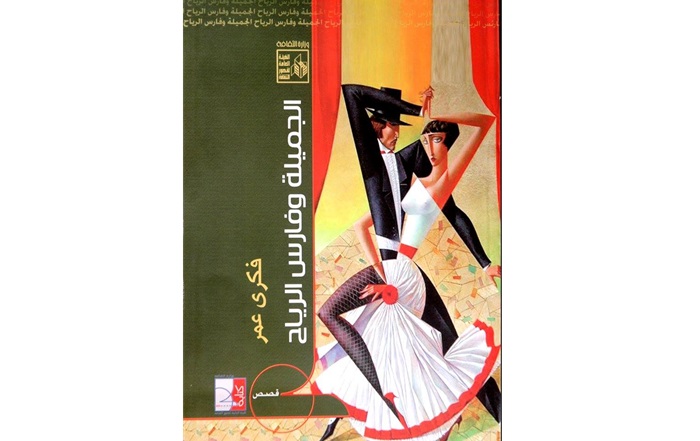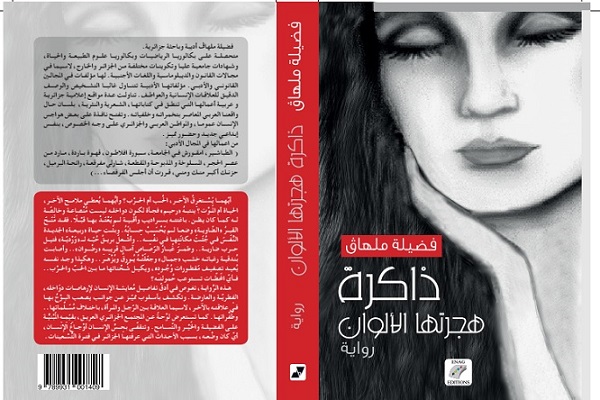محمد صفوت
حين سقط “وحيد” بجوار الطاولة لم يهتم أحد منا بذلك، واصلنا اللعب دون انقطاع، كـُنا فقط في الفواصل السريعة بين دور الدومينو وما يليه نخطف نظرات إلى جسده المُمدد تحت أرجلنِا، فقط حاول أحدنا أن ينبهه إلى برودة بلاط المقهى، ثم تناسيناه، لم يلفتْ هذا أيضا انتباه رواد المقهى وهم يغادرون تباعا، باستثناء أن أحدهم طلب منا أن نلملم ساقيه بعيدا عن الطريق، فكلـُنا اعتدنا على تلك المشاهد السينمائية التي يؤديها وحيد في كل الأوقات وكافة الظروف، لم يكن وحيد يعيش حياته قدر ما كان يؤديها كممثل محترف، حتى تحولتْ حياته إلى مجرد حياة مقتبسة من حيوات عديدة شاهدها، حياة تمتد كشريط طويل من السيلولويد بها مئات الكادرات السينمائية وآلاف الشخوص والوجوه التي تاه وحيد داخلها، حد أنه ذاب بينها، وفي كل المواقف وطيلة كل وقت كان وحيد يتصرف بما يـُمليه عليه هذا البطل الذي قفز إلى رأسه في هذا الوقت، حتى إنه صدم زوجته في ليلة زفافه مـُعلنا أنه سوف ينام في حجرة حفيظة، عندما استفسرتْ زوجته عن ذلك، ظل طيلة الليلة يروي لها قصة فيلم الزوجة الثانية مصحوبا بأداء تمثيلي يتنقل خلاله بين أبطال الفيلم إلى أن وصل إلى مشهد العمدة حافظ وهو مـُستلقي على ظهره كفيل فوق سرير حفيظة، وحين مات خاله المـُقرب منه، فاجأ كل من في سرادق العزاء بالانفجار في الضحك وهو يفتح أزارا قميصه كما فعل يحيى الفخراني في فيلم الكيف، لذا كان يصعب أن تتوقع ردود أفعاله، أو تتنبأ بما يمكن أن يفاجئك به في أي موقف، فهذا يتوقف على ما سيلمع ساعتئذ في ذاكرته المـُشبعة بمئات الأفلام، ربما سيضحك مثل إسماعيل يس إذا نقلت له خبرا ما وبعد دقائق سيبكي بكاء أمينة رزق تجاه نفس هذا الخبر إذا كررته على مسامعه، وفي المرة الثالثة قد ينطحك في رأسك كبروس لي.
عاش وحيد حياته حتى مشهده الأخير حين سقط بيننا دون أن نعرف له صوتا محددا ولا طريقة معينة في الكلام ولا نمطا ثابتا في الملبس، لم تعرف زوجته له طعاما مفضلا، ولم يفلح نادل المقهى حتى سقوط وحيد الأخير في معرفة إن كان يفضل الشاي سادة أو مظبوط أو سكر زيادة أو أنه لا يشرب الشاي من الأساس.وبالتالي كـُنا نتعامل مع وحيد على أنه ليس شخصا واحدا، فهو مجموع كل هذه الشخوص التي شاهدها والتي ترمح داخله بشحمها ولحمها، هو ذات مرة قال إنه كلما نظر في المرآة يرى وجها جديدا لم يطالعه من قبل.
ورث وحيد مهنة والده كعامل تشغيل آلة العرض السينمائي داخل سينما الجمهورية وهي السينما الوحيدة في مديتنا، كان يعرف كل شىء عن هذا العمل الغامض، فمنذ صغره كان يرافق والده إلى تلك الحجرة الصغيرة التي تخرج من كوتها تلك الأشعة الساحرة التي حين يستقبلها الحائط الأبيض تتحول إلى حياة متدفقة تنبض بالحركات والقبلات الساخنة والمعارك والصرخات والبكاء والضحك، قضى وحيد معظم حياته خلف هذه الآلة، كان يزعجه كثيرا أن رواد السينما وهم في طريقهم إلى الخارج يتبادلون الحديث عن أحداث الفيلم وأداء هذا الممثل ورقصة تلك الممثلة دون أن يذكره أحد، وكان كل ما يظفر به من جمهور الصالة سيلا طويلا من السـُباب واللعنات إذا توقفتْ الآلة لأي سبب عن البث، لذا كان على وحيد أن يخرج من الظل إلى عمق الكادر، بدأ في هذا حين كان يُوقف عرض الفيلم ليُفاجىء رواد السينما بأنه يقف أمامهم على المسرح وظهره للشاشة المظلمة ليـُعيد هو تمثيل المشهد بطريقته، كان هذا يـُثير غضب البعض واستهجانهم، لكنهم حين تعودوا على ذلك كانوا كلما لم يرق لهم أداء ممثل في أحد المشاهد يطلقون الصفارات ويطالبون وحيد بالنزول وأداء المشهد من جديد وكما ينغي، بل أنه تمادى أكثر فكان أحيانا يضع بكرة فيلم قبل الأخرى ليس لسبب سوى أنه كان يرى أن تلك البداية تجعل الفيلم أكثر تشويقا، ظل هذا ممتعا لوحيد ومـُشبعا لغريزة السينمائي الكامنة داخله، حتى تعرضتْ سينما المدينة الوحيدة إلى حريق كبير على يد بعض الجماعات السـُنية مطلع الثمانيات، فقد وحيد وظيفته، لكن الأهم أنه فقد معها تصفيق جمهور الصالة، لم يتحمل وحيد أن يعود ثانية إلى الظل بعد أن تعود أن يكون في بؤرة الكادر وبريقه، راح يؤدي تلك المشاهد التي يحفظها عن ظهر قلب والمقتبسة من أفلام قديمة وجديدة، عربية وأجنبية في كل مكان في المدينة، حتى ظل مألوفا في مديتنا أن ترى تجمعا كبيرا من الناس حيث يؤدي وحيد مشهدا من فيلم كذا، أو أنه يقوم بتقليد الممثل فلان في موتته الشهيرة أو ضحكته الساخرة، ثم نسى وحيد في ظل كل ذلك أنه وحيد، فهو زكي رستم أو فريد شوقي، بروسلي مرة وأميتاب باتشان أحيانا، وحتى تناسينا نحن أصحابه بمرور الزمن صورة وحيد القديمة، كـُنا نتعامل معه في ضوء ما يحدده هذا المشخصاتي المجنون بداخله، يضحك فنعرف أن هذه ليست ضحكته، يصرخ فنتذكر أنها صرخة هذا الممثل، مات وحيد أمامنا عشرات المرات، مات بعدد كل الممثلين الذين شاهدهم يموتون، لكنه ظل حتى النهاية ممتنعا عن أداء ميتة أحمد زكي في فيلم زوجة رجل مهم، وحين حاولنا إيقاظه في تلك الليلة حيث سقط داخل المقهى وبعد أن اكتفينا من اللعب، لم يستجب لتصفيقنا كما كل مرة، ثم ونحن نحمله إلى بيته رحنا نستعيد هذا المشهد حيث سقط وهو يهتز عدة هزات مـُبحلقا بعينه حتى سقط على بطنه تماما كما فعل أحمد زكي.