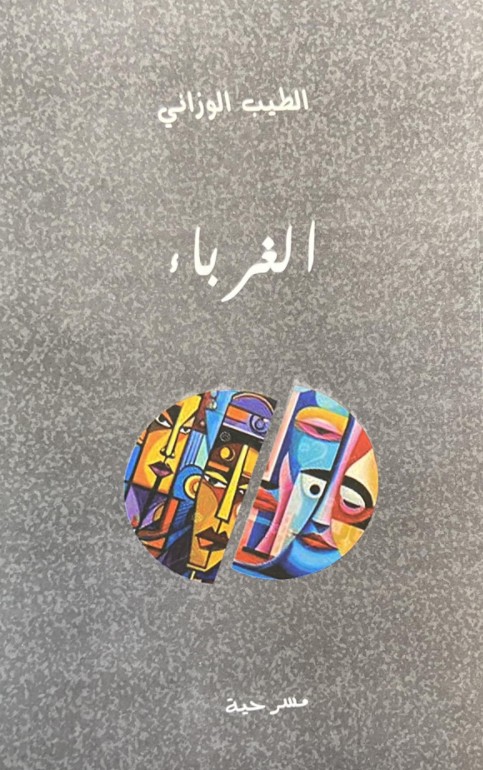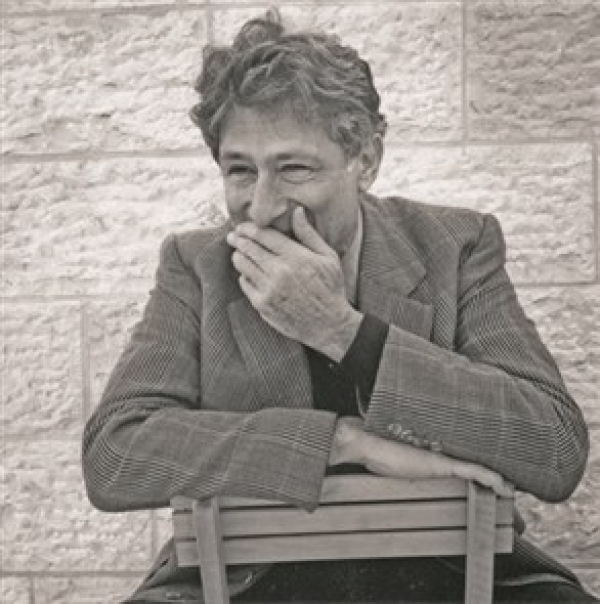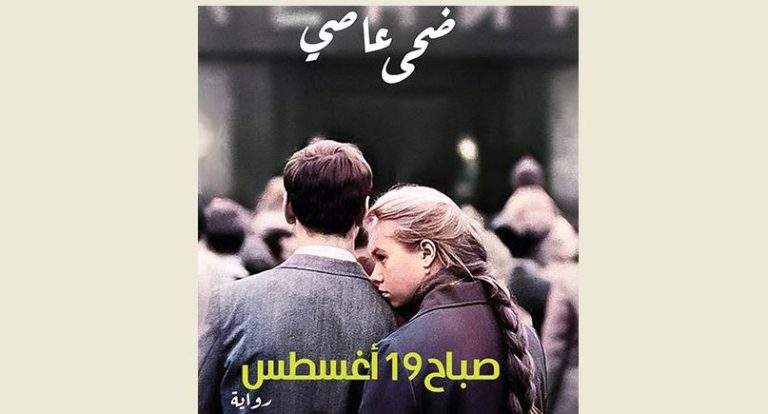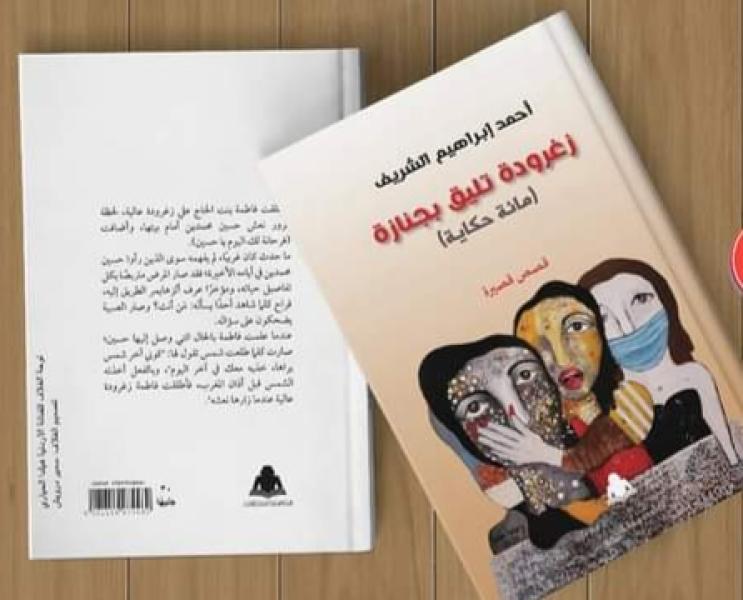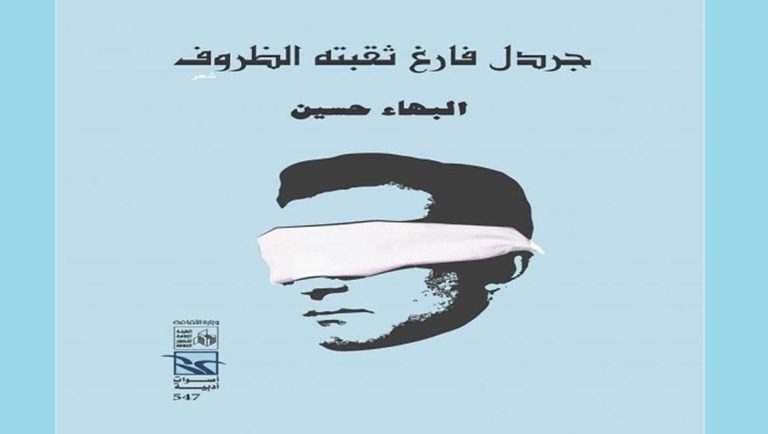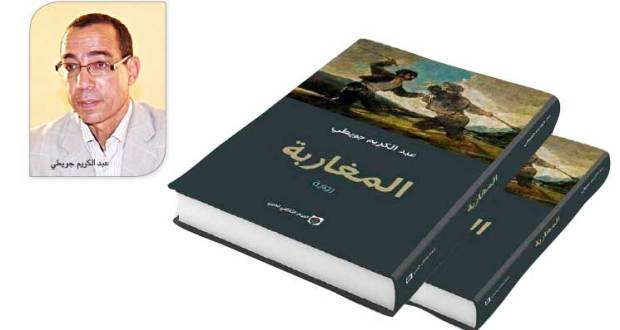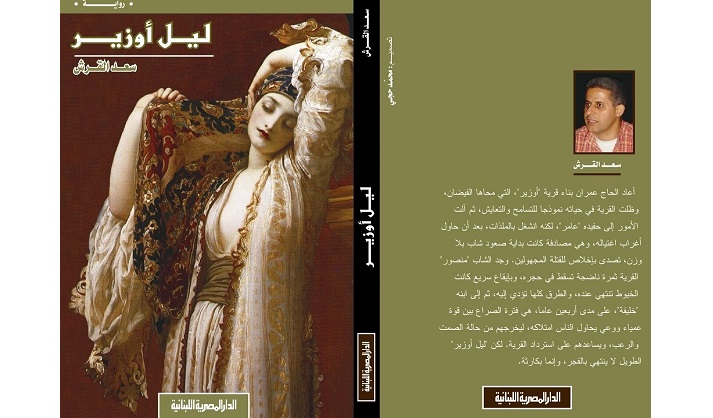د. رضا عبدالرحيم
على الرغم من تزايد الاهتمام بقضية اغتراب الإنسان داخل وطنه، فإن مفهوم الاغتراب ما يزال غامضًا، ونادرًا ما يتفق الباحثون على تحديده. وقد توصّل عالم الاجتماع الأمريكي “ملفين سيمان” عام 1959 إلى تحديد خمسة مفاهيم مختلفة للاغتراب، أطلق عليها تسميات: العجز، وفقدان المعايير، وغياب المعاني، واللاانتماء، وما يسمى الاغتراب الذاتي. وقبل ذلك بأربعة أعوام أجرى باحث أمريكي آخر هو “أنتوني ديفيدز” بحثًا ميدانيًا في جامعة هارفارد، توصل من خلاله إلى أن مفهوم الاغتراب يتألف من خمسة توجهات متشابكة هي: التركيز على الذاتية، وعدم الثقة، والتشاؤم، والقلق، والاستياء.
ويتضح من مقارنة النتائج التي توصل إليها كلٌّ من سيمان وديفيدز أنه ليس بينهما أي عناصر مشتركة، ما يدل على غموض مفهوم الاغتراب، ويثبت مرة أخرى أن هذا المصطلح ليس في واقع الأمر سوى مجموعة متفرقة من المعاني التي ليس من الواضح تمامًا ما طبيعة العلاقة فيما بينها.
أما الاغتراب كما صوّره الكاتب الطيب الوزاني، فهو أقرب إلى مفهوم هيجل (1770–1831)، ويطرحه في عمله المسرحي الجديد “الغرباء”. فهو حالة اللاقدرة أو العجز التي يعانيها الإنسان عندما يفقد سيطرته على مخلوقاته (ما كان سببًا في وجوده مثل أولاده) ومنتجاته وممتلكاته، فتُوظَّف لصالح غيره، بدل أن يسطو هو عليها لصالحه الخاص. وبهذا يفقد الفرد القدرة على تقرير مصيره والتأثير في مجرى الأحداث التاريخية، بما فيها التي تهمه وتسهم في تحقيق ذاته وطموحاته.
فيأخذنا الطيب الوزاني من خلال عمله المسرحي “الغرباء” إلى حياة أبطاله، ويطرح مشكلاتهم الشخصية مع ذواتهم، تلك التي تتقاسمها مع الآخرين، بادئًا عمله بما يعرف بالبرولوج. وهو كمصطلح درامي: الجزء الأول من الأجزاء الكمية في التراجيديا والكوميديا اليونانية والرومانية، وهو عبارة عن افتتاحية قد تتخذ صورة المونولوج أو صورة الديالوج. يحاول الشاعر الدرامي في البرولوج أن يهيئ أذهان المشاهدين (النظارة)، ويقدم بعض الخطوط الأولية في رسم الحوادث والشخصيات على الصعيدين الماضي والحاضر.
وإذا كان هذا دور البرولوج قديمًا: الإعلان عن الأحداث لمستمعيه مقدمًا أو حتى التعليق على تلك الأحداث، والدخول أحيانًا في جدال مع الجمهور، فإنه في عمل “الغرباء” يشارك في الأحداث، بل مع نهاية العمل نجد أن معظم الأبطال قد تحولوا إلى هذا النوع من الدراما، لتكون صرخة الجميع إعلانًا عن المرض الذي يعاني منه الجميع في الواقع (المعاش).
فها هو ملقي البرولوج يخاطب الجمهور في بداية العمل:
أيها السادة الحاضرون، أيتها السيدات الحاضرات، أقدم لكم نفسي. أنا الراوي، الشاهد على عصره، الحامل للناس أجمل الحكايا، وأيضًا أتعس الحكايا. جئت لأروي لكم، فانصتوا جميعًا.. عفوًا، لقد نسيت أن أقول لكنّ ولكم، قبل أن ينطلق السفر، السلام عليكم. ستكون رحلة لا أغبطكم عليها. أسمعتم؟ أنا الراوي أزرع البسمة وأفجر الدمعة.
وإذا كان الفصل الأول من العمل يقدم لنا مشاهد حياتية معاصرة لأسرة يعيش فيها رجل البيت (الزوج سعد) اغترابًا من خلال علاقته بزوجته وابنه وابنته، في مواقف حياتية يومية، تذكرك بما يحدث معك يوميًا؛ من تسلط سيدة البيت (الزوجة فامة)، وفقد الرجل لهيبته من خلال حوار رشيق لم يخلُ من طرافة مريرة.
سعد: عليكم السلام ورحمة الله.
فامة: كفى من تلميحاتك الشخصية، وأخبرني ماذا تريد؟ أو ماذا جلبت معك؟
سعد: (متهكمًا) جئتك أنا، وأريد مجالسة زوجتي، حبيبتي وأم عيالي. ألا يكفيك هذا؟
فامة: (تزغرد بسخرية) جميل، هذا يسعدني عزيزي روميو. لقد اعترت أحشائي رعشة من شدة فرحي بقدوم طلعتك البهية!
سعد: طبعًا من حقك أن تسخري.. يبدو أن الأسد أصبح هِرًّا وديعًا لا يُخشى جانبه.
فامة: (بحدة) عن أي أسد، أو هر، أو حتى فأر تتحدث؟ إذا لم يكن لديك جديد تقوله، فدعني أنصرف لأشغالي.
سعد: ……………………..
فامة: ……………………..
سعد: الحقيقة أنك استحوذت على أمور البيت، وأصبحتِ تقررين وتنفذين حسب رأيك ومزاجك. فلم تعد به سلطة إلا سلطتك، ولا رأي أو مشورة إلا برأيك، رأيك وقراراتك. فمالت البنت كما الولد إليك، وانحازا لصفك.
وإذا كنا في الفصل الأول قد شاهدنا رجلًا تقهره امرأة هي زوجته، فسنجد في الفصل الذي يليه امرأة يقهرها رجل هو أخوها (فالرجل والمرأة سواء في الاستبداد). وهذا من خلال حوار ثلاثي بين الغريبة (سها)، والكاتب المسرحي الشهير حسن الطنجي، وسعد (الغريب)، لنكتشف قصة حب من طرف واحد كانت بين سها الممثلة الشابة وقتئذ والكاتب المسرحي. ثم تأخذنا سها في رحلة غربتها عن الوطن وزواجها ثم عودتها إلى الوطن بعد فقد الزوج، لتواجه غربة أخرى في وطنها (غربة بين الأهل):
حسن: مرحبًا بك دائمًا. والآن؟ ماذا تفعلين في حياتك؟
سها: (بهدوء وكبرياء وكأنها تحكي حكاية عادية) لما رجعت إلى وطني، نزلت ضيفة على أخي في بيت أسرتنا العتيق.
سعد: جميل أن تكون للمرء أسرة تحتضنه وقت الشدة.
سها: ولما طالبته بحقي في الميراث، تنكر لي وقذف بي إلى الشارع.
حسن: هكذا ببساطة؟
سها: كان ذلك منذ شهر. (بحسرة) نعم، منذ شهر وأنا أتجول في شوارع المدينة.
حسن: ……………………..؟
سها: (بهدوء صاخب) لقد خبا الانفعال بداخلي، وسطحت أمامي معاني الأشياء والأحداث. وكل ما يمكن أن يفرح أو يحزن الآخرين، لم تعد له قيمة أو معنى لدي. لهذا أنا هادئة. بل ـ إن صح التعبير ـ أنا هادئة لأنني أدركت قمة الإحباط والعجز. أنا داخليًا محطمة. أمشي مرفوعة الرأس كديك مذبوح بغتة بسكين حادة المدية.
ويبدع حقًّا الطيب الوزاني ـ كما ذكرت آنفًا ـ في هذا الديالوج الذي يحمل الكثير من العتاب بين سعد وأمه، وهو يشي أيضًا بالغربة بين الأهل. يقوم فيه الراوي نفسه بدور الأم (أم سعد). وعبر الهاتف التقليدي (هنا اتهام صريح لدور التكنولوجيا في الإسهام في إحساسنا بالاغتراب):
الراوي (أم سعد): توحشتك أو ولدي.. فينك؟
سعد: حتى أنا أ الوالدة.. توحشتك بزاف.
أم سعد: شحال هادي ما جيتي زرتيني!!
سعد: ماشي بزاف.. واحد الشهرين؟!
أم سعد: وكان وكان.. الباب حدا الباب!!
سعد: يكون خير.. هاد المرة ما نبقاش نتأخر عليك.
أم سعد: ما تنساش باللي أنا كبرت وبقيت بوحدي، ما عندي اللي يونسني.
سعد: معاك ومعان الله أ الوالدة. (ينهى المكالمة)
ويأتي الفصل الثالث بعيدًا عن البيت والمقهى، وقد اختار الكاتب المكان بعناية (مأوى المسنين) لعرض أنماط مختلفة من البشر، وبالتالي أنواعًا متباينة من الاغتراب (موضوع النص). فالعم علي (المُسنّ القعيد المصاب بمرض الزهايمر ـ نوع من الاغتراب بفعل السن) وسؤاله المتكرر: “كم الساعة؟ أخبروني كم الساعة؟”
والخالة بركة (التي تلوذ بالصمت دائمًا ـ نوع من الاغتراب والهروب من النفس)، وسها (الغريبة)، وحاتم (نجم سينمائي سابق يعيش حاضره بحسرة)، وخالد (فنان تشكيلي وموسيقي، بوهيمي الطباع، مقبل على الحياة). فالاغتراب هنا ربما كان اختيارًا للفرد بكامل حريته، مثل حالة خالد الذي اختار الوحدة جزيرة خاصة يعيش فيها ويبدع ويحقق النجاح والشهرة:
خالد: وحدي! أتقاسم أفراحي ونجاحاتي مع نفسي! أو مع أناس عابرين لا روابط ثقيلة تربطني بهم. أنا كنت أبدع أعمالي الفنية في وحدتي، ولم أكن أحتاج لغيري في ذلك، فلم لا أتقاسم أفراحي بنجاحاتي مع نفسي، بنفسي، ولنفسِي؟! ألم آتِ إلى هذا العالم وحيدًا، عاريًا؟
وإن كنت أختلف مع وجهة نظر “سها” في وصف وحدة خالد بأنها “عظمة وهمية” لا يراها إلا صاحبها، خاصة أن الحوار بينها وبين خالد يوضح أنه يعاني من النسيان، نسيان ما بعد أفول النجومية: لا معجبين، ولا أضواء، ولا ما يسمّيه “حب الجماهير”. وحدها الغربة تصبح الحقيقة الوحيدة التي تستمد حضورها من ماضٍ انتهى.
وأتفق مع وجهة نظر “حاتم” في أن كل ساكن في وحدته يعيش صهدها ولهيبها في دواخله بطريقته.
وهناك الاغتراب القدري متجسدًا في شخصية الأعمى، الذي يعبر عن هذا العالم المظلم بلغة شفافة. فهل الاغتراب نوع من العمى (غربة مدى الحياة)؟ سواء كان هذا العمى عضويًا أو نفسيًا. ومن الواضح أننا أمام سؤال صعب، نظرًا لحاجة الموضوع إلى المزيد من الدراسات الاجتماعية والنفسية.
الأعمى: استكانتي ولدت معي لما ولدت أعمى. نشأت وترعرعت بجانبي. لم أشعر بها تجتاحني. لكن لما تفتحت أحاسيسي ومشاعري ونمت مداركي، أدركت أن لعالمي حدودًا غير حدود الآخرين. رسمت حينها بداخلي أبعاد حدود عالمي، حددت مداها لنفسي واستكنت إليها. وحاولت تطوير نفسي داخل مجالها. هكذا اتقدت حواسي الأخرى: سمعي، ذوقي، لمسي، حاسة الشم لدي، وخصوصًا بصيرتي.