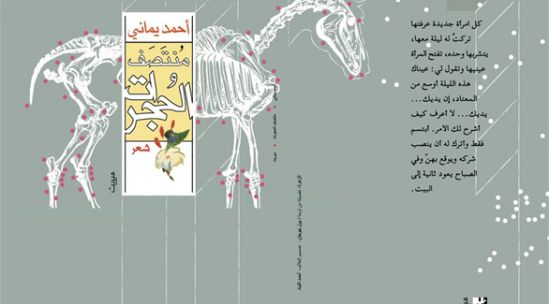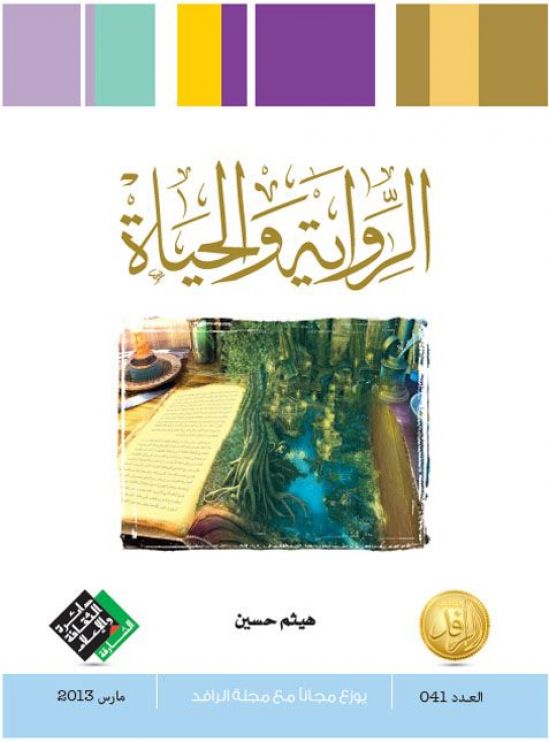قلولي بن ساعد
حين أتأمل دعوات بعض النقاد الحداثيين لإحداث قطيعة معرفية صادمة ولا رجعة فيها مع مكونات النقد الأدبي الجزائري السياقي الذي تشكل في أفق الوعي الثوري الجزائري بتأثير من لوازم الفكر التحرري الذي ساد بلدان العالم الثالث والعالم العربي سنوات المد التحرري، أجد أن هذه القطيعة غير ممكنة فما قدمه أبو القاسم سعد الله وعبد الله ركيبي ومحمد مصايف وعبد المالك مرتاض وعبد الله حمادي ومحمد ناصر وعبد الحميد بورايو ومخلوف عامر للأدب الجزائري المكتوب باللغة العربية لا يستهان به.
ويكفيهم شرفا أنهم أماطوا اللثام عن الفتوحات الإبداعية والممكنات التعبيرية لأدب جزائري عربي اللسان وقدموا بعض نماذجه للقارئ المشرقي الذي كان في ستينيات القرن المنصرم لا يعرف من الأدب الجزائري سوى ما كتبه محمد ديب وكاتب ياسين ومالك حداد باللغة الفرنسية وأسسوا بذاك لبدايات تشكل نقد أدبي جزائري عربي اللسان وهو الآن يحفر عميقا في مجرى التاريخ والمعرفة النقدية.
فلا يصح أبدا أن نؤاخذهم على مافاتهم في زمنهم بالنظر لظروف الدراسة الصعبة التي كانت تعترضهم من مناهج القراءة وآليات النقد والتحليل فنحن نحترم كل المواقف النقدية السابقة وما أنتجته في زمنها وبيئتها من منظومات معرفية.
ومن باب الوفاء لهم والتكريس لثقافة التواصل أجد أنه من الضروري إعادة قراءة هذا المنجز النقدي ومساءلته بروح تجمع بين الإختلاف والتواصل والدعوة إلى إحياء هذا التراث النقدي الغزير من خلال إعادة نشر أعمالهم النقدية ولفت نظر الأجيال الجديدة من الطلبة والكتاب والباحثين لهم.
وما يقال هنا وهناك بشأن عدم راهنية النقد الأدبي الجزائري السياقي الذي تشكل في أفق الوعي الثوري الجزائري بتأثير من لوازم الفكر التحرري الذي ساد بلدان العالم الثالث والعالم العربي سنوات المد التحرري بالنسبة لأجيال ما بعد الإنفتاح الديمقراطي ولو في مظهره الواجهاتي الذي عرفته الجزائر بعد أحداث أكتوبر 1988 مجرد أحكام جاهزة لا تصمد أمام أبسط الوقائع الحية.
ولا أعتقد أن هناك علاقة بين النقد الأدبي وبين الأحكام المجانية الجاهزة.
الناقد لا يصدر أحكاما لأنها ليست من إختصاصه الأحكام مجالها المحاكم ولا علاقة للنقد الأدبي بها النقد يثير أسئلة فقط في أبعاد النص المختلفة الجمالية والبنائية والموضوعاتية والشكلية والنسقية فيما هو يحاول إضاءة الجوانب الداجية في النص الإبداعي ويتجنب الإجابات القطعية والوثوقية العمياء والأحكام المجانية الأخلاقية إلى حد الخروج عن الإملاءات المرجعية.
فاللجوء إلى الأحكام القيمية المسبقة في المافضلة بين النصوص النقدية مفاضلة معيارية تستقي أهميتها من ثقافة القطائع غير المكتملة ذات الوقع الردعي لم تشكل أبدا في يوم ما قيمة إبداعية أو منطلقا نظريا أو مفهوميا طالما أنها لا تتجاوز ثنائتي الإستحسان أو الإستهجان والذم أو المدح التي لا ترضي سوى غرور قارئ نمطي لا يريد أن يذهب بعيدا في الكشف عن الأسئلة العميقة التي يختزنها النص النقدي في باطنه وفي بنياته المتعددة وليس العامل التاريخي سوى بعد واحد أو مكون واحد من مكونات بعض تجارب النقد الأدبي الجزائري في إرهاصاته الأولى.
وهي غالبا أقرب إلى ثقافة الإستعراض المجاني. إستعراض العناوين والنصوص والمفاهيم بشكل سطحي ومن دون وعي بها وبسياقات تشكلها في الفضاء المعرفي الناشئة عنه.
وهي أشبه ما يسميه المفكر الفرنسي جي ديبور ( الإنفصال المكتمل ) وهو عنوان الفصل الأول من كتابه ( مجتمع الإستعراض ) وليس يخفى على أحد من الذين قرأوا هذا الكتاب أن جي ديبور يفتتح الفصل الأول من كتابه ( مجتمع الإستعراض ) بفصل يسميه ( الإنفصال المكتمل ) وهو بالطبع غير راض على هذا الإنفصال الأمر الذي قاده إلى أن يتوكأ على فقرات لفيورباخ وردت في مقدمة الطبعة الثانية من كتاب فيورباخ ( جوهر المسيحية ) ما نصه :
” لا شك أن عصرنا يفضل النسخة على الأصل التمثيل على الواقع المظهر على الوجود بحيث ان أعلى درجات الوهم تصبح أعلى درجات المقدس “.
هذا هو ( مجتمع الإستعراض ) الذي ادانه ناقد آخر هو رولان بارت عندما أهدى كتابه الرائع ( الغرفة المضيئة / تأملات في الفوتوغرافيا ) تكريما لخيال سارتر ولما سئل
لماذا أهديت الكتاب لساتر.. ؟
رد قائلا :
قتل الأب فكرة سخيفة.
والذي يراد له أن يكون بديلا عن مجتمع القراءة أو (مجتمعات القراءة ) بل ( مجتمعات المعرفة )
لكن هل إكتمل حقا هذا الإنفصال.. ؟
وهو لن يكتمل بالطبع في السياقين العربي والكوني وإذ ما إفترضنا أنه إكتمل ألا يعني هذا أننا أمام فجوة من جهة وأمام عدوى هي عدوى الإلغاء.. ؟.
فأما الفجوة فلم نعد نبحث عنها في الفجوات القائمة بين الحاكم والمحكوم ولا بين المبدع والمتلقي بل يتعين علينا البحث في هذه الفجوات أولا بين المثقف الناقد وقناعاته وفلسفة الإنسجام مع الذات / لديه الحلقة المفقودة المتوارية خلف ” المسكوت عنه ” في خطابه النقدي الذي يريد أن يطرح هذه القطيعة الجذرية بين المحمول النقدي السابق عليه وبين الوعي لديه بأهمية وجدوى الكتابة النقدية في تماسها بالمجتمع والتاريخ والوجود والمحيط الثقافي الذي يشكل ” هويته النصية ” بتعبير بول ريكور في أبعادها التاريخية والأنترروبولوجية والنفسية كرافد مهم وأساسي.
بما أن هذا الخطاب لم يعد يتعدى مثلما يرى بول ديمان ” تلك المساحة البينية أو نقطة العمى” بالمعنى النفسي العميق وهو عمليا لا يدشن قطيعة جذرية.
وربما كان الأمر يطال اللاشعور النقدي لديه الذي يتجاورفيه الخطابان ومختلف الخطابات الأخرى من دون أن يشعر فلا أحد من النقاد مهما بلغ من الموهبة والعبقرية يمكن له الإنطلاق من الصفر لأنه دائما هناك في النقد وفي شتى حقول المعرفة النقدية والفلسفية نوع من السلالية الثقافية او الحلقية التي لا إنفصال فيها بين كل حلقة وأخرى.
وأما عدوى الألغاء فمضمونها يقول :
أن الإبن يشكو من الإقصاء المتعمد عليه / الأب يتمسك بما يراه حقا مشروعا وبأن هذا الإبن قاصر ولا يمكن تسليمه تركة ثقيلة عليه.
والمسألة لاتتوقف عند هذا الحد وسيرث الإبن بكل تأكيد عن أبيه ثقافة الإقصاء والإلغاء والسطوة وكافة قيم القتل الرمزي المستشرية في المخيال الجمعي للمجتمعات النامية أو الأبوية أو ( الأبوية المستحدثة ) بتعبير هشام شرابي والتي تسكن كما يرى هشام شرابي ” نظام الأبوية المحافظة ونظام الأبوية المستحدثة على السواء “.
والنتيجة هو هذه العدوى / عدوى الإلغاء التي تدمر أجيالا بكاملها وتحول دون التأسيس لقيم الحوار والتعدد والديمقراطية والإختلاف في المخيال الجمعي السائد بما يعني من غياب وإنعدام التمثل الفاعل في السلوك والممارسة لثقافة التعدد والتداول الجذري السليم لمختلف قيم التراتب الإجتماعي والثقافي والسياسي بعيدا عن كل أشكال التعدد الصوري الواجهاتي القائم على أسس شكلية وأداتية هي نتاج إملاءات فوقية لديكور ظرفي سيزول أثره بزوال معطياته والنمط الزبائني الذي إستلزم وجوده.
وهنا لابد أن نسلم بالأمر الواقع فهذا ما وجدنا عليه آباءنا عاكفون وأننا مثلهم فشلنا في التأسيس لثقافة الإختلاف والتعدد والتنوع لأننا خارج النص وخارج التاريخ .
ولأن “العقلانية الأداتية للدولة الوطنية” بتعبير الزواوي بغورة رسخت فينا هذا المرض / مرض الإقصاء وأنه لا أمل فينا للعلاج بسبب ” القصور العقلي” بتعبير إيمانويل كانت الذي يميزنا عن باقي المجنمعات ذات التقاليد الديموقراطية التي قطعت أشواطا مهمة على هذا المنوال.
وعندئذ لا نملك سوى أن نردد مع المفكر المغربي عبد الله العروي “هذا خطأ وذاك خطأ وهل كتب علينا أن نعالج خطأ بخطأ”
وإني لأسمع صوت أحد رموز التصوف العربي وهو النفري يحذر “فلا يزال وجود يحطم وجودا حتى لا يبقى وجودا” .