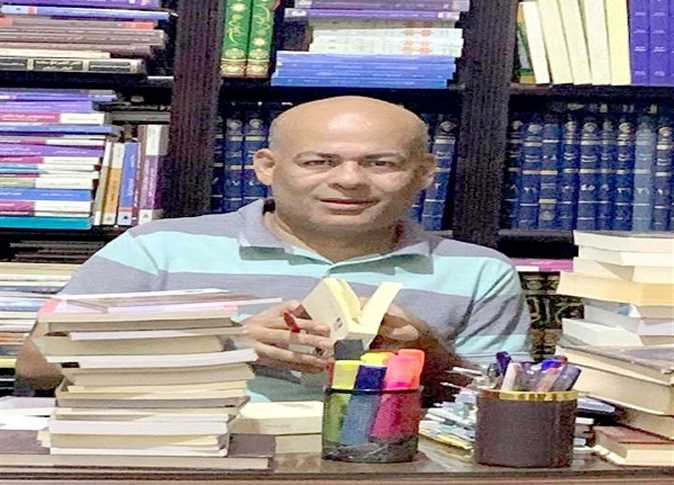عبد الرحمن أقريش
كنا صغارا لا نفهم الكثير من أمور الحياة، ولكننا سرعان ما انتبهنا لحجم الخوف الذي يسكن أرواحنا بسبب سلطة غامضة، سلطة تنتشر في كل مكان مثل الوباء، في البيت، في المدرسة، في الشارع وفي كل مكان، سلطة الآباء، سلطة الكبار، سلطة المدرسين، سلطة السلطة…
عندما يعاقبنا الكبار نشعر بالألم، فالعقاب عادة يكون قاسيا ولا يتناسب مع حجم الأخطاء، كان أسوأ ما في الأمر هو شعورنا بالذنب، فالكبار يصرون أننا أخطأنا وأننا نستحق العقاب، تمر الأيام، يتبخر الألم ولكن الشعور بالذنب والخطيئة ينغرس عميقا في أرواحنا مثل جرح غائر.
في ذلك الزمن البعيد كانت القسوة نظرية في التربية وفلسفة للعقاب، فالجميع متفقون ومتواطئون عندما يتعلق الأمر بفضائل القسوة وجدوى العقاب، وحدهن الأمهات يرفضن هذه التربية العوجاء والتهذيب القاسي، ولكن رفضهن لم يكن يغير الكثير.
نكبر قليلا ونكتشف تدريجيا الوجه الآخر للمفارقة، نكتشف أن الكبار رغم مظاهر السلطة والتحكم يسكنهم خوف غامض، يبدون غرباء، ملامحهم حزينة، تعيسة وخائفة، خطواتهم متوجسة، يذهبون إلى العمل، يعودون من العمل، يتفرجون على الواجهات التجارية، يقتنون حاجياتهم اليومية، يجلسون في المقاهي والحانات، يقرأون الجرائد، يدخنون، يشربون، يحتفلون، ينتشون، يضحكون، ولكنهم ليسوا سعداء.
بعيوننا نحن الصغار يبدو الأمر غامضا ومستعصيا.
كان ينبغي أن تمر سنوات لنفهم لم يكره آبائنا الذهاب إلى الادارات العمومية.
كان ينبغي أن تمر سنوات لكي نفهم لم يفقد الرجال سلطتهم وشجاعتهم كلما تعلق الأمر بالإدارة وسلطة الدولة.
كان ينبغي أن تمر سنوات ونعبر إلى الجامعة لنفهم أن البلد تعيش تحت التأثير النفسي لسنوات الرصاص.
وكان ينبغي أن تمر سنوات لنفهم أن الأمر كان مدروسا بعناية.
العمالات عبارة عن بنايات ضخمة يشعر الناس أمامها بالضآلة، بوابات عملاقة، أسوار عالية، حدائق أنيقة، أشجار، ورود، وأسطول سيارات فخمة شديدة السواد…
البلديات والمقاطعات والمستوصفات عبارة عن بنايات مهملة، وقليلة الإضاءة، مكاتب متهالكة تعج بالأوراق والملفات، كراسي خشبية رخيصة، وجيش من الموظفين يدخلون ويخرجون، يدخنون، يتناولون وجبات الفطور، قهوة، شاي، فطائر، ثم ببطء ينطلق العمل.
ينظرون للمواطنين بعجرفة.
– خاصك ورقة…
– خاصك زوج أوراق…
– سير حتى لغذا…
– خاصك زوج تنابر (طوابع)
– الملف ديالك ناقص…
في الطريق إلى المدرسة، نمر أمام الكوميسارية القديمة، قصر الشرطة، هكذا تسميها اللائحة النحاسية الصدئة المثبتة في أعلى البناية، نعبر الطريق خفافا، بسبب الخوف نمر للرصيف الآخر ولا نمر أبدا أمام بوابة البناية الضخمة، أقواس من الأجور الأصفر، نوافذ عالية بشبابيك حديدية صلبة، مكاتب بتفاصيل كافكاوية تفوح منها رائحة الرطوبة.
هناك يقف الناس منذ الساعات الأولى للصباح، يمسكون بأيديهم أغلفة صفراء تضم وثائق وطوابع إدارية وأوراقا نقدية.
يخرج الشرطي الخمسيني، ينظر الناس خفية إلى وجهه الذي حفره الجذام، تنتابهم مشاعر متناقضة، خليط من الخوف والكراهية والغضب، ينظر هو إلى وجوههم الشاحبة، يتأمل جلابيبهم البسيطة، وعندما يتأكد أن ليس بينهم شخص مهم، يخاطبهم باحتقار.
– ديروا الصف الحمير…
– ديروا الصف البقر…
هي أيام فقط ويحل العيد الوطني، توقفت الدراسة منذ أسبوع، فالمعلمون والتلاميذ الكسالى تفرغوا كليا للحفلات والتهييء للعيد القادم، أغاني، أناشيد، مسرحيات، أشعار، والكثير من الرايات…
نقف في رأس الدرب، نتحدث عن الكرة والمدرسة والكتب والسينما، يمر المقدم، يجول ببصره في تفاصيل الحي، يتفحصها، ينظر للبنايات، يتحسس بحدسه المخالفات بحثا عن آثار للبناء وعمليات إصلاح غير مرخصة، يلقي إلينا نظرة متشككة ثم يمضي.
يتوقف (عمر البراح) عند مدخل الحي، ينفخ في بوق نحاسي صغير.
– أيها الناس، يا سكان المدينة قال لكم القايد صبغوا ديوركم وعلقوا الرايات.
لم تكن الأعياد الوطنية سيئة كلها، كانت عنوانا لمفارقات غريبة، فمصائب قوم عند قوم فوائد، تزدهر أعمال وتجارة موسمية وعابرة، فواكه جافة، وجبات سريعة ورخيصة وسجائر بالتقسيط…
الأعياد الوطنية فرصة يتسع فيها فجأة هامش الحرية وتنفتح أبواب للتسيب والانفلات، خمور، مخدرات، دعارة، أعمال وصفقات مشبوهة…
أما نحن الصغار فلم تكن تلك الأعياد تعني لنا الشيء الكثير، فضيلتها الوحيدة هي التحرر لأيام من قيود المدرسة والتسكع في ليل المدينة بحثا عن فرجة مجانية.
هيمن الليل على الحي عندما أنتهى (النعماني) من طلاء الواجهة الأمامية لبيته المتواضع، شعر ببعض الرضا، صحيح أن الصباغة كانت رخيصة ومنتهية الصلاحية ولكنها تفي بالغرض، فقد أخفت عيوب البناء وبعض الرسوم والخربشات التي خطها المراهقون بالفحم والمسامير…
أما الراية فأمرها يسير، حفنة من مسحوق التنظيف، وبضع قطرات من ماء جافيل وتكون جاهزة ومعلقة في مكانها المعلوم.
تتسرب خيوط رفيعة من الضوء عبر زجاج النافدة، المذياع المكسور يبث أغاني وأهازيج وطنية بمناسبة العيد، تمدد (النعماني) على السداري يستريح من عمل يوم شاق ومتعب، فكر أن يضيء الغرفة، ولكنه فضل الإنصات لهواجسه في صمت، أشعل سيجارته وراح يدخن، يدفع الدخان بعيدا ويتأمل الفراغ.
(النعماني) رجل بسيط، يعمل مياوما في أوراش البناء، لا يفهم في السياسة، ولا يهمه كثيرا الكلام الذي يقال عن الوطن والوطنية، ولكنه يشعر في قرارة نفسه أنه يحب البلد، يحب الحقول والغابة والبحر والأفق ومغيب الشمس في قريته الصغيرة، يحب الناس البسطاء، وتجتاحه انفعالات قوية عندما يشاهد صورا وأشرطة وثائقية لرجال المقاومة وجيش التحرير، ينظر إليهم بإعجاب، جلابيهم، عماماتهم، أسلحتهم، وتستوقفه كثيرا وجوههم السمراء وملامحهم القاسية، فيغمره شعور غريب، مزيج من الحماس والفخر والكبرياء.
يود (النعماني) أن يحتفل بالعيد الوطني مثل الآخرين ولا يريد أن يبدو مختلفا…أحس ببعض السعادة، فغذا تبدأ عطلة العيد ومن حقه أن يستمتع ببعض الكسل والتحرر من ضغط العمل ليوم واحد أو يومين.
في الخارج تغير الجو فجأة، يغرق الحي في صمت رهيب، يسمع صوت المطر ينزل مدرارا، يضرب الأرض والجدران بقوة، يخفت قليلا، تنفخ فيه الريح، ثم يعود فيضرب بقوة أكبر، استحضر (النعماني) بداخله قضية الصباغة والراية، استيقظت هواجسه، أشعل سيجارة أخرى، امتص منها نفسا عميقا، طرد الدخان من فمه وأنفه بالتناوب، أرسله بعيدا، أحس ببعض العزاء، استعاد هدوءه واستسلم لصوت المطر.
الصباح، يوم جديد، مشرق ودافئ.
كان ذلك اليوم يوما مشهودا.
عند مدخل الحي وقف المقدم بعيدا يرقب الموقف، توقفت سيارة الشرطة على بعد خطوات من بيت (النعماني)، ترجل منها رجال أشداء، أخذوا مواقعهم فيما يشبه انحناءة قوس، رئيسهم يتحدث في هاتفه المحمول، ويمرر التعليمات بصمت، أحدهم يوجه آلة التصوير جهة البيت ويلتقط الصور.
تجمهر الفضوليون.
وقفنا نحن الصغار ننظر ونحاول أن نفهم.
بدا أن أمرا غريبا وخطيرا قد حدث.
مرت لحظات، انكسر جدار الصمت تدريجيا وبدأ الناس يتهامسون.
– أنظروا هناك…
– أهو المطر؟
– نعم، إنه المطر…
– أمر غريب…
– أيعقل ذلك؟
– هو أمر غريب فعلا ولكنه المطر…
– يبدو الأمر كما لو كان بفعل فاعل…
– ربما…من يدري…
– يبدو أنه المطر…
كانت الواجهة الأمامية لبيت (النعماني) قد تحولت إلى لوحة فنية، نحث فيها المطر تفاصيل لجدارية ثورية، حقل ممتد، أفق أحمر، سنابل، نجوم، شهب، وجوه غاضبة، أجساد مندفعة إلى الأمام لرجال أقوياء، وفي مقدمة الجدارية تقف سيدة جميلة بصدر نصف عار، تبتسم وتشير بسبابتها إلى مكان ما حيث تنغرس الراية…
تتواصل الهمهمات بصوت خفيض.
– أكاد لا أصدق..
– فعلا، إنه أمر لا يصدق…
– تصور حتى الراية تلاعب بها المطر…
كانت النجمة الخضراء قد اختفت، ذابت الألوان، امتزجت، وكأنها تشير إلى بلد بعيد.
توارى المقدم، غادر رجال الشرطة، حملوا معهم (النعماني) مقيدا، وقف رجال الحي خاضعين، مستسلمين، ينظرون بعيون مهزومة، عيون يسكنها الخوف، نفس الخوف، نفس العجز، نفس الغضب الصامت…
كانت تلك المرة الأخيرة التي رأينا فيها (النعماني).
لم يرجع أبدا.
المستلبة
عبد الرحمن أقريش الزمن، صيف...