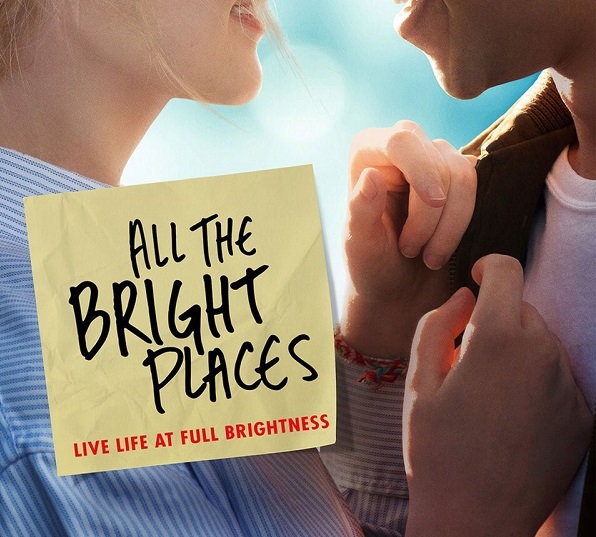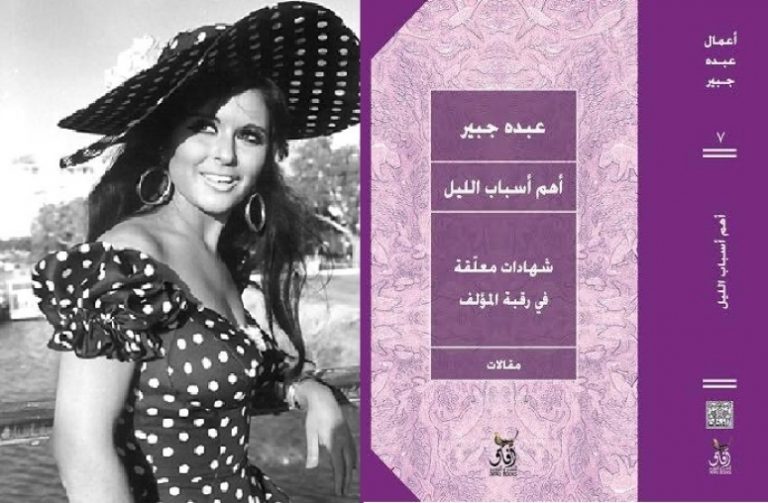آمال فلاح
عام 1975 قدم معهد التشييد والبناء –آنذاك- طلبية لانجاز فيلم عن مشكل السكن في مصر حرص فيها على إبراز دور الحكومة في العمل على إيجاد حل جذري للمشكل، لكن المخرج الذي اختير لإنجاز الفيلم راح يصور الناس في الشوارع ويتحاشى التحدث مع المسئولين عن القطاع ويترصد الأحداث بطريقة ساخرة جعلت كل من شاهد الفيلم يحلف بأغلظ الأيمان أن مشكلة الإسكان لن تحل أبدا، فلا إرادة سياسية متوفرة ولا رغبة في تغيير الأمور. وطبعا غضب مدير المعهد الذي أصبح وزيرا للإسكان ورفض استلام الفيلم مطالبا بدفع تكاليفه.. إلى أن تدخل شادي عبد السلام وحل النزاع بطريقة سلمية. لكن الفيلم/ القضية لم ير النور قط واختفى في الأدراج.
كان اسم الفيلم “القاهرة كما لم يرها أحد” ودفع صاحبه إبراهيم الموجي ثمن هامش الحرية الكبير الذي منحه لنفسه غاليا. فالسينما بالنسبة إليه هي الحياة. فلماذا لا ننظر للحياة بعيون ساخرة تنفذ بعمق إلى الحقيقة؟
وأي شكل أفضل لتحقيق ذلك من السينما التسجيلية التي جاء إليها الموجي من مهنته كسيناريست للأفلام الروائية وكمخرج لها فيما بعد (المرشد وعيون الصقر): “أنا حالة خاصة. عندي تقدير كبير للأساطير السينمائية. فعندما عملت مع محمود المليجي كنت في قمة السعادة وكذلك مع شادي عبد السلام وأزعل جدا لو حد جاب سيرة أم كلثوم أو انتقدها.”
يؤكد الموجي قبل أن يضيف: “وجدت الوسط السينمائي ساحرا لأني لا أبحث عن النقائص عند الناس، فنقائص العظماء هي سلوى الفاشلين.” فمن يكون هذا الرجل المجد/الساخر، المحب للسينما حد الجنون؟ كان والد إبراهيم الموجي قاضيا شرعيا، ينتقل بين محافظات مختلفة لممارسة القضاء. كل أخ من أخواته السبع ولد في مدينة بعينها وكان حظه أن يولد في سوهاج بصعيد مصر.
أول صورة احتفظت بها ذاكرته في مدينة قوص هي صورة الحريق الذي أشعله وخرج من الغرفة دون أن يبلغ أحد ثم غرق في اللعب إلى أن جاء الجيران يدقون باب المنزل، لكن لم يكن هناك من يفتحه. فالأب في المحكمة والأم والأخت ليس مسموحا لهما بفتح الباب. حكت له الأم فيما بعد كيف تدخل الجيران لإخماد النيران وكيف خمنت أنه هو الذي أخذ الكبريت وأشعل النار في غرفته:” ظلت أمي لسنوات طويلة تعرف الكثير عني حتى وأنا خارج البيت. وظللت مؤمنا بأنها ليست مجرد أم. أنها نصف إله.”
ثاني صورة علقت في ذاكرته كانت عن مجنونة محبوسة في بيت الجيران، لا يراها أحد إلا لما تطلع إلى السطوح مع النساء لتطلق الشتائم وتقدم “صور بلاغية” عن الجنس. وبما أن الطفل –الذي لم يبلغ بعد سن الذهاب إلى المدرسة- لم يكن مشتركا في أحاديث أمه مع الجيران، فقد كان متفرغا للتفرج، خاصة على المرأة المجنونة.
بعدها انتقلت الأسرة إلى القاهرة، وكان آخر مشهد يراه إبراهيم في السطوح- حيث سارعت الجارات في توديع الأم- هو منظر المجنونة وهي تقدم –إضافة إلى مشهد الشتائم المعتاد- وصلة رقص.
في القاهرة كانت أول صورة يذكرها هي صورة امرأة تحمل على كتفها راديو. فقد غادرت فلسطين بعد أحداث 1948 وكانت تحكي كيف أنقذت الراديو، وكيف أخذته وكيف حرصت على ألا يضيع منها. كانت أصوات عبد المطلب وشكوكو تطلع من الراديو يومها. أصوات لم يسمعها الطفل من قبل: “كان والدي لا يفتح راديو البيت إلا لسماع القرآن ثم يغلقه للتو ويضعه على رف عالي لا تطاله قامتي الصغيرة”. بعدها تحول الراديو إلى تسليته الوحيدة إلى أن اكتشف السينما.
حدث ذلك لما بدأ إبراهيم يرتاد المدرسة. وكان جنب المدرسة قاعة سينما. فجأة أصبحت الأفيشات هي عالمه الجديد: “كنت أقف أمامها لساعات محاولا تأليف قصص تختلف عن قصص الأفلام التي أراها يوم الخميس.”
وعندما انتقلت الأسرة من القلعة- حيث دار عرض يوسف وهبي و”إيزيس”- إلى حي شبرا اكتشف الطفل دار عرض “بلازا” التي كانت تقدم الفيلم بعد أسبوع من عرضه في “سينما كايرو”. سابقة فتحت أمامه عوالم جديدة دفعته، وهو يرتاد كلية التجارة، للبحث عن متنفس آخر، إذ وجد ضالته في افتتاح معهد للسينما في الخمسينيات.
في المعهد تأثر الموجي بأستاذ فرنسي شاب، اتهم بالعمالة فطرد من المعهد، لكنه: “فتح في مخي صمام الثقافة”. فظل محتفظا بهذه الصداقة سنوات من بعد. هذا الأستاذ الذي اسمه كلود بورهين وسوف يصادفه الموجي لاحقا بصحبة شادي عبد السلام أثناء مشروع إنجاز مجموعة من الأفلام التسجيلية في أسوان. هناك ناقش الأستاذ الفرنسي تلميذه السابق طويلا حول مشروع تخرجه عام 1968. مشروع التخرج الذي أشرفت عليه رحمة منتصر زوجة صلاح مرعي. فيلم قصير من 10 دقائق اسمه”المرآة”.
بعدها أخرج الموجي أفلاما تسجيلية قصيرة هي”ملامح شرقية” و”الترحيلة”. أفلام أعجب بها شادي عبد السلام، وكان مسئولا آنذاك عن المركز التجريبي، فأخذه معه لتصوير العبورعام 73 .
لحظة العبور أثناء حرب أكتوبر لم يصورها أحد لأن السرية الكاملة أحاطت بالعملية، ولم يسمح بالتصوير إلا في لحظة الانتصار مما ما طرح إشكاليات فنية لبعض المخرجين النزهاء :”كانت التجربة بالنسبة لي ثرية لكنها بالنسبة لشادي كانت مختلفة “
لم يحضر شادي المعركة لذلك شرع في انجاز فيلمه”جيوش الشمس”بالاعتماد على صور مراسلي الحرب وصور لتدريبات الجيش وتسجيل شهادات الجنود : “حل يتفق مع صدقه الشديد وعدم ادعائه.”
ابتداء من عام 73 بدا إبراهيم الموجي يشتغل في السينما الروائية لغاية 98 كسيناريست، ومن بعد كمخرج ليتحول إلى تأليف المسرحيات وإعداد الدراسات ومن ثم المسلسلات التلفزيونية وهو الآن يبحث عن تمويل لآخر مشروع سينمائي له عن فلاحة تنزل إلى القاهرة وتدرس خريطة مصر بطريقة جيدة لتنتهي إلى حقيقة نفسها ولتكتشف وجودها.
مسار فني متعثر ربما كان انعكاسا للحساسية الزائدة لهذا الرجل الذي حرص دائما على الاحتفاظ بنظرته اللاذعة وبصدقه اللانهائي، أم أنه كان ببساطة مرآة لمسار السينما المصرية نفسها؟
لعل الكثيرين لا يذكرون عن إبراهيم الموجي سوى أنه من أهم كتاب السيناريو في مصر الذين ساهموا في صنع أفلام مثل “شوارع من نار”، دائرة الانتقام”، “حب في الزنزانة” و”عفوا أيها القانون” أو”المتوحشة”، ويجهلون سجله الهام في إرساء قواعد الفيلم التسجيلي في العالم العربي.ثم أنهم ربما لا يعرفون أن أحد أعماله التسجيلية ارتبط بأهم مؤسسة ثقافية في مصر وهي متحف “أم كلثوم” حيث يعرض فيلمه منذ عام 2002 على جميع الزائرين. لكن قلة من الناس تعرف في الموجي روحه الساخرة وترفعه عن ركوب أية موجة، وإن أدى ذلك إلى وقوفه على الهامش، وان ظل أحد أهم ركائز السينما المصرية الحديثة :
“إلى جانب إنتاج الأفلام هناك حياة في الوسط السينمائي. هناك “معارك” لم أملك إلا أن أشترك فيها. لقد وجدت نفسي في مواجهة مدرسة نقد الستينات التي كانت مرحلة حشد وتجنيد. في تقدير النقاد كان هناك فقط “الصح والغلط.” كان هناك النزوع لتحقيق قيم الخير والجمال في الأعمال السينمائية .و كنت أعاني دائما من سؤال الدارسين والنقاد ( ما القصد مما فعلته وماذا أردت قوله) . كان المنهج الوحيد المسموح به هو الواقعية الاشتراكية والالتزام. فلو صورت مشكلة في الشارع يقولون لي لماذا لم تصور جهود الدولة في حلها. وقد أخذت هذه المسائل وقتا كبيرا ومعارك لا حصر لها لأني كنت أتخيل انه بمقدرتي تغيير وجهة نظر الناس. أنا الآن مهتم فقط بعملي وليس بالاستماع إلى آراء الآخرين.”
والآن؟ أسأل الموجي. ما الذي يحدث؟ “الناس على دين ملوكها “يجيب : “الفلسفة السائدة هي فلسفة بائع السمك، والجيل الذي أشتغل معه يتسرب إلى التلفزيون.”
بدون تعليق..