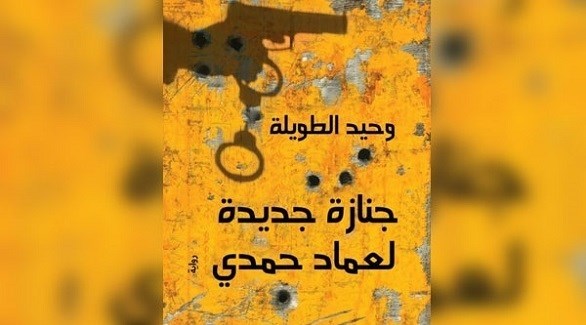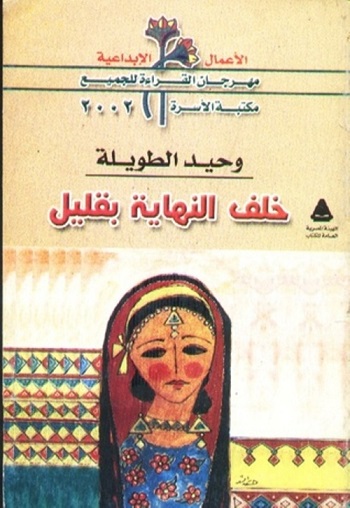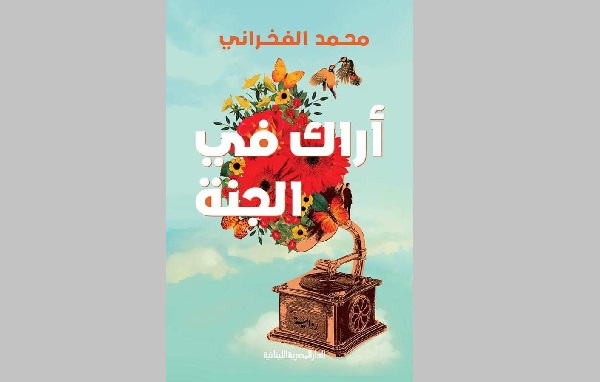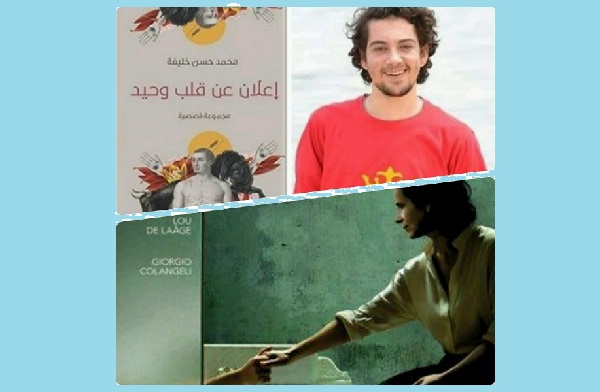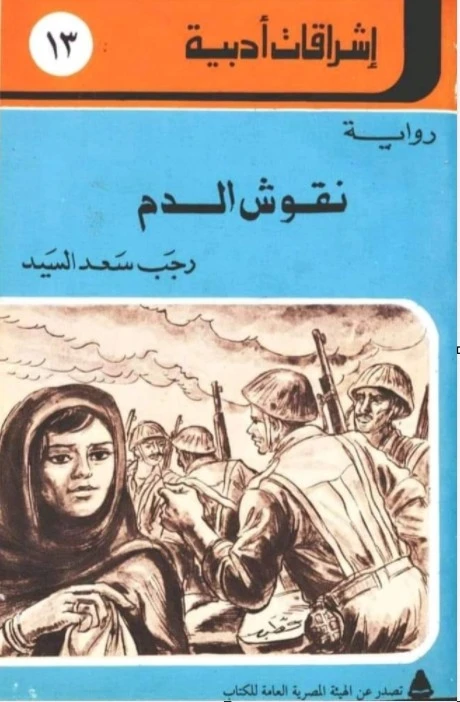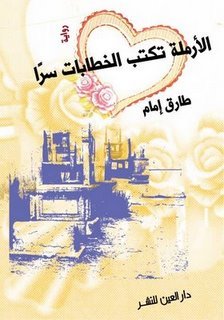سيد الوكيل
عندما نتحدث عن القص الجديد هنا ، فإنما نعني تلك الملامح التي تكونت علي أرضية واحدة من الوعي بالظرف التاريخي وتداعياته الثقافية والوجدانية ، والتي في تصورنا أنها بدأت في تكوين معالمها ، علي نحو واضح في منتصف الثمانينيات.ويجدر بنا هنا ، أن نتحفظ قليلاً علي استخدامنا لظاهرة التقسيمات الجيلية ، التي يعترض عليها الكثيرون ، إذ يبدو ، من غير المعقول إننا بإزاء تغيرات واضحة المعالم كل عشر سنوات ، فالأدب كمنتج ثقافي ، له طبيعة تراكمية ، لا تعرف القطيعة التامة مع السابق أو اللاحق ، كما لا يمكن أن يقوم بمعزل عن الظواهر الثقافية كافة، تلك التي تؤثر في بعضها البعض تأثيراً كبيراً ، إلي درجة يصعب فك الاشتباك بينها .
إن هذا الكلام عن آليات التطور الأدبي ، أو بمعني أدق ، آليات العمل داخل السياق الثقافي كله ، يكاد يرقي في تصورنا إلي مستوي الحقيقة العلمية ، وفي المقابل ، فإن هذه الحقيقة ، تستدعي حقائق أخري صغيرة أو كبيرة لكن لا يمكن تجاهلها، ومن ذلك ، إن الموضوع السياسي ، أصبح أقوي الروافد المعرفية التي تغذي ثقافة القرن العشرين ، حتي يكاد يكون إنسان هذا القرن هو حيوان سياسي بالدرجة الأولي ، ومن ثم،لا مبالغة علي الإطلاق ، أن يرتهن الحراك الأدبي بالحراك السياسي .
إن هذا الارتهان يبدو ظاهرة عالمية ، وهو متزامن مع بزوغ فن القصة تحديداً، ولكنه في منطقتنا العربية ، وفي مصر علي وجه الخصوص ،يحتدم بشكل لافت بل مرهق للذات العربية ، التي أصبحت بطريقة ما ، أسيرة الموضوع السياسي .
حقيقة ، أن أكثر من ثلث دول العالم خضع للاستعماريات الأوروبية بدرجة ما، لكن تلك الدول التي نالت حريتها ، تراجعت فيها أهمية الموضوع السياسي ، وبدأت في ترتيب البيت من الداخل ، فعملت علي قضاياها الداخلية ، كقضايا المرأة وحقوق الإنسان ، والتنمية البشرية والديموقراطية ، أما عندنا ، ونتيجة لاستمرار الصراع العربي الإسرائيلي واحتدامه المستمر ، ولأسباب أخري تتعلق بالشأن العربي نفسه، فالأمر يبدو مختلفاً، لقد ظل الموضوع السياسي أكثر الموضوعات حضوراً ، حتي تضاءل أمامه كل موضوع آخر ، علي نحو ما عبر عنه الشعار المعروف (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة)
وهكذا ، فعندما نقول إن الحراك الأدبي في مصر كان منهمكاً في الحراك السياسي فنحن نقرر واقعاً ملموساً .لكن الحراك السياسي في مصر ، وفي النصف الثاني من القرن الماضي ولم يزل، كان متسارعاً بدرجة لم تسمح بالاستقرار في أي لحظة ، وكان متراوحاً بضراوة بين انتصارات قليلة ، وانكسارات كثيرة ، وفي واقع يعاني كل هذه الارتجاجات العنيفة ، لا نتوقع الاستقرار الثقافي ، أو النمو الطبيعي و التدريجي ، ولكن نتوقع نقلات حادة عصبية في مجملها ومتطرفة ، بين علمانية غير مؤهلة، واشتراكية مترهلة غير جديرة ، ورأسمالية غير منصفة ، وأصولية غير واعية ، ولكل منهم يقينه البازغ الذي يدعي القدرة علي الحل .
وعلي المستوي التاريخي تتجسد هذه النقلات في أحداث جسيمة تبدو كمرتكزات مفصلية للوعي ، هذه النقلات تأتي في بداية الخمسينات مع ثورة يوليو وانفجار الوعي القومي وما صاحبه من أحلام كبري ، ثم يخمد كل هذا فجأة وبطريقة دراماتيكية في 67 ، لتبدأ مرحلة قاسية من جلد الذات واهتزاز اليقين، ولأسباب معقدة لم تنجح حرب 73 في عبور تلك المرحلة ، بل علي العكس، لقد بدأت كل الثوابت القديمة تتداعي فجأة ، وكأنها لم تكن تتماسك طوال ست سنوات إلا ذراً للرماد في عين العدو ، أعتقد أن كل شيء في السبعينيات كان مؤهلاً للتداعي ، فلا يمكن أن أصدق ، بأن تغير السياسة الاقتصادية إلي الانفتاح ، أو اتفاقية للسلام مع عدو تقليدي سبق لنا محاربته ومهادنته من قبل، يمكنهما ، أن يحدثا كل هذا التغير العاصف ، ما لم يكن كل شيء أصبح مؤهلاً للتغيير ، حتي أن كثيراً من الرموز الثقافية التي كانت بمثابة ضمير الأمة ، مارست انفتاحاً مثيراً علي وعيها بمسئوليتها ، ودورها التاريخي الذي تخلت عنه بسهولة مدهشة باستمرار الإحباط والعزلة واجترار الذات وربما قوبلت عزلتهم لدي الجيل الجديد بشيء من الارتياح وكأنهم تخلصوا من بعض الأشياء الفائضة عن الحاجة .
ألا يعقب هذا شيء من الفراغ الثقافي؟وهو الأمر الذي سمح بالاجتياح الأصولي القادم من الخلف، لقد تعلم الأصوليون شيئاً من الماضي القريب ،فوجهوا خطابهم إلي هؤلاء البسطاء الذين يصنعون الحياة اليومية بشكل مباشر ، متجاهلين تماماً تلك الطغمة من المثقفين الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة.
إن هذا العرض الهذلي مهم للتذكير بطبيعة الحراك الثقافي المتسارع والعصبي القلق ، وعلي ضوء هذا يمكننا أن نتصور الفكرة التي مازلنا نتحفظ عليها لأسباب فنية أخري ، ونعني فكرة أن يكون لدينا كل عقد أو ما يزيد قليلاً جيل له ملامحه المختلفة.
كانت اتفاقية السلام مع العدو التقليدي بمثابة صدمة للمثقفين ، وفي ظني أن لهذه الصدمة أبعاداً عديدة ، فهي فضلاً عن أبعادها السياسية والأيديولوجية، كانت بمثابة تحد لوعي المثقفين في درجات قبولهم بالواقع الجديد وكيفيات هذا القبول.
كان الحراك الثقافي ولسنوات عديدة قد ارتبط مع فكرتين رئيستين ، الأولي تتمثل في وجود عدو دائم يجسد نمطاً (استعماريا كلاسيكيا ) يذكرنا بالتاريخ القريب ، والثانية تتمثل في حلم قومي ـ يذكرنا بالتاريخ البعيد ـ يمكنه مواجهة هذا العدو ، أما وقد انتهي علي المستوي الرسمي هذا العدو بإعلان التصالح معه ” رغم أنف أمل دنقل” ، وعلي المستوي النفسي أجهض هذا الحلم العربي ، فإن المثقف الذي تغذي علي هاتين الفكرتين ، سيواجه بحالة مخيفة من الفراغ الموضوعي ، ولم يكن من السهل تقبل هذا الواقع الجديد ، ومن ثم دخل المثقف في مواجهة عنيفة مع هذا الواقع الذي فرضته المرحلة بكل تداعياتها، السياسية والاقتصادية المتمثلة في الانفتاح الاقتصادي، ولاشك أن هذه المواجهة استغرقت قطاعاً كبيراً من الحراك الإبداعي طوال هذه الفترة ولم تزل تداعياتها ماثلة إلي اليوم ، لكن هذا لم يمنع أن واقعاً جديداً قد بدأ يتشكل بالفعل ، ففي منتصف الثمانينات كان لدينا جيل من المبدعين أقل اصطداماً بالموضوع السياسي ، وأقل اشتباكاً مع الذاكرة التاريخية لهذا الصدام ، بل أقل إيماناً بإمكانية تحقق الحلم القومي ، وكان علي هذا الجيل أن تواجه ذاته فراغاً علي مستوي الموضوعات العامة ذات الصبغة القومية ، وكان ثمة ضرورة لإعادة تشكيل هذا الفراغ ، وهكذا وجد هذا الجيل نفسه في مفترق طرق ، بلا علامات إرشادية واضحة في وقت يتطلب منهم القيام بمهمة أولي تبدو أخلاقية أكثر من أي شيء، وهي ( حماية وإحباط محاولة تغييب الماضي ) (1)
سيعاني هذا الجيل كثيرا ً من الارتباك ، وسيتعين عليه البحث عن مفهوم جديد للذات غير ذلك المنشأ علي الذاكرة الرسمية ، ويصلح للتعامل مع فراغ الواقع ، سيتطلب هذا البحث عن موضوعات جديدة لخلق واقع بديل وذاكرة بديلة ، سيكون الاحتفاء بالخصوصيات المحلية ـ مثلاً ـ بديلاً عن الموضوع القومي العام ، علي نحو ما نجد عند ( إبراهيم فهمي ) وسوف تطل لغة غنائية ذات طابع احتفالي جزل بدلاً عن تلك النبرة النضالية الجادة التي ميزت الخطاب الستيني. واستمرت بقوة الدفع الذاتي إلي ما بعد ذلك.وعموما سيوصف هذا الجيل بأنه جيل الجزر المعزولة والخصوصيات الضيقة ، والهويات الضائعة ، والفرص المحدودة ، وسيتحول نضاله من نضال ضد عدو متعين واضح إلي نضال ضد عدو غامض ومتعدد، ليأخذ هذا الصراع طابعًا ( دون كيشوتي) قد يتوجه إلي الذات أكثر من أي شيء آخر ، ومن ثم تبدلت صياغة السؤال الوجودي الكبير، نكون أو لا نكون ، ليصبح ( كيف أكون؟)
إن وجود ( الكيف) في صيغة السؤال ، وتحولها من الجمع إلي المفرد تفتح الباب لاحتمالات التعدد والقبول بالحلول الوسطية ، واحترام التجارب والخبرات الخاصة والشخصية مهما كانت محدودة ، ومراجعة الثوابت وخلخلة اليقينيات ،إن معني الذات الجمعية يبدأ في التخلخل متيحاً الفرصة لذوات أخري صغيرة تأخذ فرصتها في إعادة صياغة الواقع الجديد أو علي نحو ما يقول إدوارد سعيد أصبح (دور المثقف أولاً طرح رواية بديلة ومنظور آخر للتاريخ بدلاً من تلك التي يقدمها المحاربون باسم ذاكرة رسمية وهوية قومية ) (2) .
وبطريق غير مباشر يتعرض مفهوم الهوية لاختبارات قاسية ومتطرفة من خلال النص الأدبي ، بين إبداع يغالي في تأكيد الخصوصيات الثقافية ومتاخمة حدود الأنثربولجي بدعوي أن المحلية أول طريق العالمية ، دون إدراك كبير لفخاخ التصدير والشروط التي يضعها سوق الثقافة الغربية علي نصوص الإبداع المنتجـة عندنا ، وبين رغبة في استيلاد نصوص مهجنة بشعر أشقر وعيون زرقاء (3) .
ولا نستطيع القول بأن كتاب الثمانينات قد أمسكوا بكل هذه المتحصلات دفعة واحدة ، بل علي الأرجح أنهم عانوا كثيراً من الارتباك والتشوش،ومشاعر التشظي والتجزيء،غير أنهم أدركوا علي نحو ما أن المقترح المتاح لا يمكن صياغته في صورة كلية علي نحو يقيني يماثل الأفكار الكبري التي شاهدوا تفككها.
إن وعياً علي هذا النحو لا يمكن ضبطه وفق تصورات محددة بحيث ينطبق عليها معني الجيل بكل تداعياته السلطوية والنمطية ، فنحن في الحقيقة أمام تيارات واتجاهات تتفاوت في طبيعتها وحجمها ، إن الأمر أشبه ما يكون بالروافد الصغيرة التي تغذي مساحات شاسعة ومتنوعة من الأرض .وفق وضع كهذا ، فإن ما نسميه بجيل الثمانينات قد بدأ في تحطيم ذاته الجمعية منذ اللحظة الأولي ، أو بمعني أدق في تفكيك هذه الذات ، وإحلال بدلاً عنها تصورات مختلفة عن ذوات صغيرة وهشة ، ومن ثم لم يعد لدينا ما يمكن تسميته بالجيل إلا في سياق قبولنا لمفهوم جديد للذات قائم علي التعدد ، وهو المأزق نفسه الذي نجد فيه مفهوم الهوية كما سبقت الإشارة .
إن هذا الحكم المغامر ينطلق من تصور أن فكرة الجيل لا تنشأ إلا تحت غطاء ثقافي كبير وعام يبلغ مستوي القومية ، كتلك التي نجدها في الستينيات مثلاً ، حيث كانت تشمل جوانب الحياة كافة ، ثقافياً وسياسياً واجتماعياً، بل شعباً وحكومة ، حيث توحد الجميع توحداً رومانسياً في أحلامه الكبري ، أو في هزائمه المروعة.
لقد حدث هذا من قبل فيما يشبه المشروع النهضوي للثقافة بمفهومها الواسع ، وحيث يكون الأدب أحد تجليات هذا المشروع ، قصاً وشعرًا.. إلخ ، غير أن الواقع قد بدأ في التغير فعلاً مع بداية الثمانينات، ومن ثم أصبح من قبيل المفارقة الساخرة، أن نظل نتحدث عن جيل التسعينيات وكأن شيئاً لم يحدث ، أو وكأن المجايلة قدر محتوم وممتد ، وثابت من الثوابت الثقافية التي لا يأتيها الباطل من خلفها أو من بين يديها .
وظني أنه من الأفضل التحدث عن تيارات واتجاهات وخصوصيات تعكس معني التعدد والتجاور ، بدلاً من الحديث عن (الجيل) الذي يحمل في تداعياته أبعاداً أيديولوجية ، وجمعية لم تعد متاحة الآن .ورغم ذلك ، تجدر الإشارة إلي أن المتحصلات والرؤي التي كانت مشوشة ، ومرتبكة وضبابية في نهاية الثمانينيات ، بدأت في التبلور سريعاً ، فلم نكد نتجاوز بداية التسعينات حتي كان إنتاج هؤلاء المبدعين قد فرض وجوده ، وبدأ في طرح إشكالياته وأسئلته الجمالية ، كاشفاً عن مناطق جديدة ومختلفة من الوعي ، وقد شمل ذلك الشعر والقصة علي وجه العموم ، ثم الرواية علي وجه الخصوص .
ولأن القصة القصيرة هي تمثيل أدبي لظاهرة ثقافية فقد كانت أكثر فنون الأدب استجابة لهذا المتغير الذي أنتج وعياً جديداً بالذات ، إن أول ملامح هذا الوعي في القصة الجديدة ، هو الرغبة في تحطيم الثوابت والمطلقات والمفاهيم اليقينية التي تحكم الإبداع الأدبي .وقد تحقق هذا تقنيا في صورة اشتباك عنيف مع (النوع ) ، حيث بدا النوع تمثيلاً تقنياً للذات الجمعية التي لم يعد لها وجود فعلي ،هكذا تظهر محاولات جادة لكسره وتجاوزه علي نحو ما رصدها إدوار الخراط في (الكتابة عبر النوعية ) ومثل لها بنماذج عديدة من أبرزها (منتصر القفاش ) .وعلي مستوي آخر تظهر محاولات أكثر احتراما ًللمدركات الحسية بعد أن طال الشك العقل ، وأصبح النص أقرب إلي المشهد البصري علي نحو مانجد عند هناء عطية ، كما تبدو اللغة أكثر احتفاء بالحواس وحالات تفتحها الأولي ، وعلي مستوي الموضوع تصبح الخبرات الحميمة واللصيقة بالذات موضوعا قصصياً فيقترب النص كثيراً من مناطق الشعور لدي المتلقي كما عند عبد الحكيم حيدر وعبد المنعم الباز ، ويتخذ خيري عبد الجواد من الموروث الشفهي والمكتوب أفقاً لخصوصية لغوية وتقنية بل وموضوعية ، وكان إبراهيم فهمي في وقت باكر قد علق خصوصيته علي سردات غنائية احتفالية تحتفي بخصوصيات البيئة النوبية ولغتها ، ويعلق ناصر الحلواني تجربته علي التشكيل اللغوي المعلق في أفق شعري، وتراهن نعمات البحيري علي التاريخ الشخصي فتقترب من السيرة الذاتية ، وتقترب صفاء عبد المنعم فتلمس مناطق محظورة في الوعي النسوي ،وينشغل فؤاد مرسي بصور الذات في حالات تشظيها وتبرز بشكل خاص أسماء أخري تحضر بوعي كتابي مهتم بالبحث عن صيغ جمالية جديدة علي نحو ما نجد عند السيد نجم وسمير عبد الفتاح وسيد عبد الخالق وربيع السبروت وأحمد زغلول الشيطي وآخرين ..وغني عن الذكر ، أن هذه الأسماء علي سبيل المثال لا الحصر ، فقد اتسع المشهد القصصي ، وبلغ حداً من التنوع غير مسبوق ، بحيث تكاد كل تجربة تتحول إلي اتجاه فردي ، لا يجمعه مع الآخر سوي الرغبة في الخروج عن السياق العام والبحث عن خصوصية ما ، ونتيجة لهذا ، ومع اقتراب نهاية عقد التسعينات ، أن حدث الانفجار المثير لهذا الوعي الجديد ، وأصبح لدينا مفهوم مرن وواسع للقص ، يتزامن مع مقولات ما بعد الحداثة ، التي طرحت نفسها علي نحو جريء ، وهي تقتحم مناطق كان ينظر إليها كمحظورات فنية ، وموضوعية ، كتلك التي ترتبط باستبدال العادي بالمقدس ، واليومي بالتاريخي ، والحقيقي بالمجازي والشخصي بالعام ، فتقترب لغة القص من لغة الحياة اليومية ، وتتمكن من الخوض في موضوعات شديدة الخصوصية حتي لتشبه الاعترافات والبوح والثرثرة الفنية كما نجد عند ( نجلاء علام ، منال السيد ، هويدا صالح ) ، واتخذت اللغة طابعاً وصفياً مباشراً لا تختبئ وراء المجاز ـ الذي كان يمثل غطاء للقول العميق ـ بقدر ما تعلن عن قدرتها علي تحدي القارئ وخدش وعيه بقوة ،إنها لغة تصل إلي حد الابتذال والحوشية ، تستهين بالمحذورات وتخترق المحرمات ، لا تنافق الذائقة التقليدية للمتلقي بقدر ما تهزها بعنف وبشكل صادم علي نحو ما نجد في كتابات ( ياسر إبراهيم ، محمود حامد ، عفاف السيد ، مني البرنس ، مي التلمساني، نورا أمين)
ويبدو أن هذا الوعي بتفكيك الكليات والسلطات الثقافية ، صادف هوي خاصاً لدي الكاتبات ، متزامنا مع نشاط واسع للحركات النسوية في العالم ، التي نجحت إلي حد كبير في أن تؤسس لنفسها اتجاها نقديا جديداً وقادراً علي إنتاج أدبياتة اللغوية والموضوعية الخاصة ، ويلقي دعما واسعاً من كبار النقاد والمفكرين أمثال (رولان بارت ، دريدا،لاكان جان فرانسوا ليوتار،هيلين ساكسوس) ،لقد كان لهذا الحضور النسوي انعكاساته في ثقافتنا ، إذ اتسمت نهاية التسعينيات بسطوع نسوي علي المشهد القصصي ، بحيث يمكن القول أنهن أسسن لأنفسهن جمالياتهن الخاصة ، بل وموضوعاتهن التي جعلت من الجسد محوراً لتأكيد مغزي التميز بدلاً من التماهي الذي يعكسه معني “الروح ” الغامض والحيادي / المخنث .وظني أن هذا الانفجار القصصي المثير من الممكن أن يصيب المشهد كله بفوضي (كله ماشي ) ، ومن ثم تحتاج المرحلة إلي كثير من الجهد للرصد والتأريخ ، والكشف عن معطياتها الجمالية بعيداً عن أحكام القيمة العمياء،التي تهدر قيم الاختلاف والتعدد .
وهو جهد نظنه مضن ، نظراً لعمليات التسارع الثقافي والتنوع الجمالي ، مما يجعل الذاكرة النقدية محتشدة ومرتبكة ، بل لا مبالغة لو قلنا إننا نتابع حراكنا الإبداعي بنقد بلا ذاكرة يتشظي علي صفحات الجرائد اليومية والمنتديات الصغيرة، ويتأكد إحساسنا هذا كلما خرج إلي الوجود عمل ، يحتفي به علي نحو إعلامي واسع تدعمه وسائل الانتشار الحديثة ، ثم يظهر عمل آخر يلقي نفس الاحتفاء، وسرعان ما ننسي العمل الأول.
دونما حراك نقدي عميق ومتأمل ، مواكب لحركة النشر الواسع التي توفرها (ميديا الألفية الثالثة ) .
وسوف يكون من المفيد أكثر ، ضبط هذا الفضاء وهو في لحظات تشكله ، وقبل أن يصبح جثمانا ً في ذمة التاريخ ، والحقيقة إن الملاحقات النقدية الموقوفة لرصد هذا التغير قليلة بل نادرة ، ربما لأن نقادنا الأجلاء مازالوا منشغلين بالأسئلة التي طرحتها الحداثة الأوروبية في سياقات نظريات الأدب ، والتي ارتبطت بقضايا الواقع من قبيل البحث عن تعريفات لدور الأدب، وعلاقته بالواقع ، والأيديولوجيا ، ومعني الحرية والالتزام …إلخ ، وهي جميعاً أسئلة تأتي من مرجعيات سياسية أكثر منها إستاطيقية .الآن ثمة مساءلات جديدة ربما تبدو أكثر هامشية وأقل رسوخاً ، بمعني أنها ليست محملة بتاريخ نظري عريق ، ولا مدعومة بمنظومات فلسفية مقدسة ، ولا مشغولة بهواجس سياسية مخاتلة ، بل حتي لاتطرح نفسها كأيقونات ، أو وثائق تعلق علي أستار مقاهي المثقفين ، أسئلة أكثر اتصالاً بجماليات النص الأدبي وطرائق إنتاجه أي أكثر إستاطيقية ، أسئلة عن اللغة ، النوع ، القارئ ، الذاكرة ، كل منها لا يقدم كسؤال مصيري ومستقل ، بل يمكننا ملاحظة أن كلا منها يشتبك بالآخر ويؤثر فيه .لقد كشف لنا مجدي توفيق في كتابه ” الذاكرة الجديدة (4) أن الذاكرة الملتصقة بالواقع هي الذاكرة السائدة في الذهنية العربية ، فذاكرة الواقع ” كانت دائماً جوهر البلاغة وأساس الموقف الاتصالي ( بين المبدع والمتلقي ) الذي تقوم عليه البلاغة ، متخذة صورة ذاكرة لغوية تمد الأديب بتراكيب وهياكل وبنيات يتحرك وسطها لايكاد يعدوها “.
من الاقتباس السابق ( بتصرف ) يمكننا ملاحظة كيف يشتبك مفهوم الذاكرة بالقارئ واللغة علي نحو يجعل الفصل بينها ضرباً من التعسف .
هل يمكن القول إن النص الجديد يأتي من ذاكرة جديدة ؟وهل يمكن القول إن وعياً جديداً لا يقوم إلا متكئاً علي ذاكرة جديدة؟هذا ما سوف تجيب عنه القراءة التحليلية لنصوص الإبداع الجديد ، وسيتعين علينا أن نبحث فيها عن مفهوم جديد للذات غير ذلك المنشأ علي الذاكرة الرسمية.
…………………
الهوامش
:1- إدوارد سعيد: لدور العام للكتاب والمثقفين ..مجلة الكرمل ..العدد 68 صيف 1002 . 2= نفسه.
(3) لمزيد من العلومات ، يمكن مراجعة بحثنا ” الأنا والآخر ـ تأملات في الهوية والخصوصية الثقافية ” ـ كتاب أبحاث المؤتمر الأدبي الخامس لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد ، ثقافة البيئة ..ثقافة النص ـ الفيوم ـ 2005 .
(4) مجدي أحمد توفيق : الذاكرة الجديدة ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ 2004