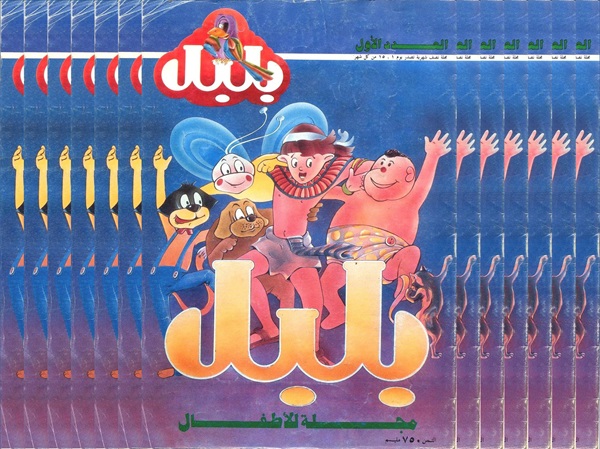خالد النجار
“ليس الاستعمار مجرد مسألة قهر، إنه بطبيعته مسألة إبادة ثقافية. فلا يمكن للاستعمار ان يأخذ مجراه بدون تصفية سمات المجتمع الأصلي”
(جون بول سارتر)
سال حبرٌ كثيرٌ حول بورتريه المثقف الكولونيالي، وملامحه النفسية التي يحكمها إحساس عميق بالدونية.. وحول التشوهات الناتجة عن كل ذلك ولعل كتابات الدكتور فرانز فانون وعالم الاجتماع اليهودي التونسي ألبرت ممي أفصح من حدّد سمات وملامح هذه الشخصية المستلبة ثقافياً وبخاصة في كتابه “صورة المستعمَر” بفتح الميم (Le portrait du colonisé) وهو كتاب، كما هو عنوانه، صورة المستعمر بفتح الميم أي أن الكاتب وضع صورة وصف فيها ملامح هذه الشخصية الكولونيالية المستلبة في علاقتها مع السيد المستعمِر بكسر الميم الثانية، ولكنها في الآن نفسه تعمل على تقليده وتقمص دوره… هذا التقمص سبق إلى توصيفه بدقة ابن خلدون في المقدمة حيث كتب في * الفصل الثالث والعشرين:
المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. والسّبب في ذلك أنّ النّفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها، وانقادت إليه، إمّا لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه، أو لما تغالط به (نفسها) من أنّ انقيادها ليس لغلب طبيعي وإنّما هو لكمال الغالب.
فترى الفرنكوفوني العربي يتقمص دور المستعمر ويقوم بالأدوار الثقافية نفسها التي يقوم بها المستعمر فتراه يتعالي ويتعالم على زملائه العرب من المثقفين أحادي اللغة، أو حتى المتأثرين بالثقافة الأنجلوسكسونية، أي الذين تلقوا ثقافتهم وعلومهم باللغة الانكليزية خارج العالم الثقافي الفرنسي المغلق والمتعالي هو أيضاً على بقية الثقافات الغربية الأخرى. فما بالك بثقافات الحضارات والشعوب غير الغربية. وكيف لا؟! وقد اعتمد الفرنسيون نفس سياسة التبشير المسيحية في نشر لغتهم وثقافتهم ومبادئ ثورتهم لدى مثقفي أوروبا أواخر القرن التاسع عشر.. بل إن حروب نابليون بونابرت وغزواته داخل القارة العجوز كثيراً ما تخفت وراء مبدأ أخلاقي، وهو نشر بل التبشير بمبادئ الثورة الفرنسية التي حدّدت نفسها كمبادئ عالمية (universelles). ملزمة لبقية الشعوب. وهكذا كان نابليون الأوروبي الوحيد المفرد من غزا بلدان أوروبا الغربية، ودفع بجيوشه إلى استعمار إيطاليا واسبانيا وبلجيكا وهولندا. هو استعمار لا يقتصر على احتلال الأراضي وإنما يتعداها إلى احتلال العقول، وإلغاء ثقافة ولغة الآخر. وكل هذا لا يتم سوى بالعنف المادي والمعنوي.
إنّ المثقف الفرنكوفوني المتخرج من المدرسة الاستعمارية، الذي أُنسي لغته وثقافته، وتحوّل إلى مجرد انسان منزوع الهوية، تراه يُعيد لا شعورياً تقمص دور السيد المستعمر التبشيري، فيتعالى على بقية مواطنيه ويتعامل معهم بفوقية واحتقار ويُنصّب نفسه مبشراً بحداثة هي في جوهرها عملية قص لصق (راجع خطب الحبيب بورقيبة في ستينيات القرن الماضي، كلها سب، وشتم، واحتقار للعرب). وهكذا كان موقف طاهر بن جلون من حركة حماس التي تُعبّر في رأيه عن بربرية، والصاق صفة البربرية والتوحش قديم في أدبيات الاستعمار، وهي اللفظ/ الصفة نفسها التي جاءت في خطاب الرئيس الفرنسي جول فيري (JULES FERRY) أمام البرلمان الفرنسي في ربيع 1881، إبّان الحملة الفرنسية على تونس، عندما قال “ذهبنا لأداء مهمة تحضير هذه الشعوب المتبربرة”. كما أنّه (بن جلون) يتحدث في حوار أخير بكثير من الاحتقار عن ناقلي كتبه إلى اللغة العربية، وأنهم لم يفهموا مقاصده، وأنهم كثيراً ما يقعون في أخطاء تدل على عدم فهمهم للغة الفرنسية. وهذا يُذكّرني بالكثير من مواقف المثقفين التونسيين والجزائريين والمغاربة المعادية للعروبيين، ومعركة بورقيبة في محاربة الزيتونة والزيتونيين التي عرفت أوجها في الستينيات حيث مُنِعَ خريجو الزيتونة من التوظيف في الإدارة وعوملوا كمثقفين من الدرجة الثانية.
التقيت أثناء أسفاري في فرنسا وفي كندا بمثقفين فرنكوفونيين من بلاد مختلفة، من تونسيين وجزائريين ومغاربة ولبنانيين وأفارقة، ووجدت كثيراً من التشابه ومن القواسم المشتركة في اضطراب الهوية، وفي موقفهم النفسي، وفي احساسهم اللاواعي بالدونية إزاء المستعمر، وفي تعاطيهم المرضي مع الأنا ومع الآخر؛ ذاك التعاطي المبني على مفارقة هي كالتالي: إحساس قوي بالدونية وباحتقار الذات إزاء الثقافة الفرنسية والغربية اجمالاً، وفي الوقت نفسه، إحساس لا يقل عنه قوة بالتعالي إزاء شعوبهم. يسري ذلك على حالة مثقفي الفرنكوفونية المغاربة (من تونسيين وجزائريين ومغاربة) إزاء بقية العرب. وهذا يفسر لك الكراهية التي كان يحملها حبيب بورقيبة ضد كل التيارات العروبية من ناصريين وبعثيين ونهضويين اسلاميين. نفس هذا الموقف النفسي الثقافي تلقاه في لبنان، حيث تجد كثيراً من المثقفين الفرنكوفونيين اللبنانيين يُعاملون بقية النخب ذات اللسان العربي بحس من التفوق والتعالي الكولونيالي. وقد لاحظ علماء النفس لدى هؤلاء الفرنكوفونيين موقفاً ينطوي على مفارقة كبرى هي كالتالي: فرنسا بالنسبة للفرنكوفونيين هي المثال والعدوّ في الآن! سألت يوماً هشام جعيط وهو من أساتذة التاريخ، عاش تجربة الثقافة والفكر والكتابة في إطار اللغة الفرنسية، ولم تتشكل تجربته الثقافية في إطار اللغة العربية. سألته: أنت، كيف تُحدّد نفسك؟ أجاب بكل شجاعة: في فرنسا أعتبر نفسي تونسياً عربياً، وفي تونس شيئاً آخر. أي أن هويته تتحدد كرد فعل، وليست كهي هي، أي لا يعرفها بذاتها. وموقف القبول والرفض هذا للثقافة الفرنسية لدى الفرنكوفونيين عبّر عنه كاتب ياسين بما دعاه تراجيديته اللغوية والنفسية في احساسه بالذنب الذي حاول التخفيف منه بقوله كانت اللغة الفرنسية غنيمة حرب لدينا والحال أن الفرنسية وبكل بساطة كان قد فرضها عليه الاستعمار، ولم يغنمها اقتدارا. وفي الحقيقة كان هو غنيمتها.
التقيت في فرنسا وفي كندا بمثقفين فرنكوفونيين من بلاد مختلفة، من تونسيين وجزائريين ومغاربة ولبنانيين وأفارقة، ووجدت كثيراً من التشابه بينهم، ومن القواسم المشتركة في موقفهم النفسي وفي احساسهم اللاواعي بالدونية؛ ذاك التعاطي المبني على مفارقة هي كالتالي: إحساس قوي بالدونية وباحتقار الذات إزاء الثقافة الفرنسية والغربية اجمالاً، وفي الوقت نفسه، إحساس لا يقل عنه قوة بالتعالي إزاء شعوبهم وباستثناء مثقفي وكتاب مقاطعة كيبيك الذين تختلف طبيعة علاقتهم بفرنسا؛ فهم ليسوا أبناء مستعمرات ذوي ثقافة مغايرة، ممن ضارَّه الاستعمار الثقافي في هويته ولغته وحمل في أعماقه جروح التاريخ. وإنما هم فرنسيون هاجروا منذ القرن السابع والثامن والتاسع عشر إلى العالم الجديد، وهم يتكلمون لغة فرنسية قديمة شبيهة بلغة فولتير كما يقولون عن أنفسهم، وهي اللغة التي كانوا يتكلمونها لحظة وصولهم للعالم الجديد. وهكذا تطوّرت لغة عصر فولتير الفرنسية في كيبيك مستقلة وبعيداً عن المركز الباريسي. وحافظت بالتالي على كثير من خصائص لغة القرن الثامن عشر. وبرغم ذلك، هم في صراع مستمر مع المركز الباريسي، كما أعلمني الشاعر الكندي فرنند واليت في حوار أجريته معه ذات سنة في مونتريال؛ وكذلك الشاعر الكندي الآخر غاستون ميرون، وهو أحد زعماء الحركة الاستقلالية وقد ظلّ ذات ظهيرة في شقته الباريسية في شارع فوجيرار على مرمى حجر من ساحة السوربون يشرح لي الفروق بين اللغة الفرنسية في فرنسا، أي في المركز، وبين فرنسية مقاطعة كيبيك المستقلة بخصائصها الصوتية والدلالية عن اللغة الفرنسية كما هي اليوم في فرنسا، وظلّ يُخرج لي من رفوف مكتبته القواميس والموسوعات اللغوية الكيبيكية التي تشرح وتُدعّم موقفه، فقد كان غاستون ميرون مناضلاً، من أشد المدافعين عن قومية وهوية كيبيك، في مواجهة التبشير الفرنسي كما هو الاسم الرسمي (La mission française). الموقف نفسه يتكرر تقريباً في مصر إذ كان هناك شبه صراع بين الثقافة الفرنسية ممثلة في طه حسين وتوفيق الحكيم وبين جماعة العقاد الانكلوسكسونيين.
أنت في لندن تتعلم اللغة الإنكليزية من دون أن يمس ذلك هويتك؛ تتعلمها وأنت حياديا إزاء الثقافة التي تحملها/ وأنت تجد المثقف الأنجلوسكسوني، وأحسن مثال على ذلك ادوارد سعيد لا يتنكر أو يحارب ثقافته وهويته وبخاصة لا يحارب لغته، وعقائد مواطنيه، وذلك لأن الاستعمار الإنكليزي يقتصر على الاستراتيجي و”البزنس”، (ما ترجمته اليوم: البترول والكيان الصهيوني) هذا كل ما يهم الاستعمار؛ وليس للإنكليزي أي مؤسسة تبشيرية كما هو شأن الفرنسيين. وليس للإنكليزي أي رسالة ثقافية يحملها لأبناء المستعمرات.. في المقابل، اللغة الفرنسية حاملة لثقافة وايديولوجيا تبشيرية لا تعترف بالاختلاف، وهدفها تحويل أبناء المستعمرات وجعلهم على صورتها أي فرنستهم. وأنت إذ تتعلم اللغة الفرنسية فإنك تتعلم في الآن أن تصير فرنسياً، تعلم اللغة ينطوي على التبشير. فأنت تجد الطفل العربي الجزائري، والسينغالي أول ما يتهجّأ في المدرسة الكولونيالية التي كانت شائعة في المستعمرات جملة تقول:
Nos ancêtres les goullois
ما ترجمتها: أجدادنا الغاليون، من البدء يتم حذف هويته الاصلية ويبدا تقمص الهوية الفرنسية
في حين ان أجداد هذا الطفل قد يكونون من قبائل الشلوح الجزائريين أم من أحد قبائل غامبيا أو فيتنامي من أعماق آسيا.
هذا العدوان على الهوية يدفع الكثير من أبناء المهاجرين الذين تربوا في البيت على أنهم عرب مسلمين ويعاملون في الشارع كفرنسيين مما يدفعهم إلى حالة من الازدواج الثقافي كثيرا ما تصل بهم حدّ الشيزوفرينيا. واليوم هناك مرضى نفسيون يقبعون في العيادات النفسية الفرنسية هم ضحايا هذا الازدواج الثقافي؛ ضحايا هذا الارتجاج الذي تحدثه الثقافة الفرنسية في أعماق أبناء المهاجرين، مما يدفعهم إلى الناحية الأخرى، إلى تبني تيارات إسلامية متطرفة كرد فعل للعدوان على هويتهم.
عمل الاستعمار الفرنسي على فرنسة من يسمونهم “الانديجان” (Les indigènes) وهو الاسم الذي تطلقه فرنسا على سكان المستعمرات من الوطنيين مثل سكان المارتنيك و الجزائريين وغيرهما من المستعمرات.. لذلك لا تتعجب من طاهر بن جلون اذ يصم مجاهدي حركة حماس بالإرهاب، وكذلك التونسي عبد الوهاب المؤدب الذي كتب مقالات كثيرة في هجاء حماس، وأيضا رهط كثير من الفرنكوفونيين التوانسة والجزائريين والمغاربة الواقعين تحت تأثيرات الثقافة الكولونيالية.. من أمثال محمد صنصال، ياسمينة خضراء، وكمال داود. وكثير منهم يتبنون السردية الصهيونية؛ إذ كثيراً ما تتسرب الصهينة عبر الثقافة الفرنسية. وكتب كمال داود عن “طوفان الأقصى” أنه هجوم إرهابي بربري. ووصل الأمر بمحمد صنصال إلى الحج إلى حائط المبكى.. ولا ننسى في الآن أن هذه الثقافة الفرنسية برغم ادعاءات اللايكية هي ثقافة ذات جذور وتلوين كاثوليكي. وقد لاحظ ألبرت كامي ALBERT CAMUS في كتابه “الانسان المتمرد” أن شعار الثورة الفرنسية: “حرية، مساواة، أخوة”، ليس سوى إعادة انتاج لا واعية للثالوث المسيحي الكاثوليكي، وقد تحوّل من صيغة “الآب والابن والروح القدس” إلى “حرية، مساواة، أخوة”، كما لو أنهم علمنوا المحتوى وحافظوا على الصيغة في بنيتها الثلاثية. أي أن الكاثوليكية حاضرة بعمق في الثقافة الفرنسية؛ بل إن مملكة فرنسا تأسست في أحضان الكاثوليكية من أيام كلوفيس. وقد أطلقوا على مملكة فرنسا ومنذ القرن السادس ميلادي إلى اليوم صفة البنت الكبرى للكنيسة فقالوا:
« La France, fille aînée de l’Église :
وهذا ما عبّر عنه جون بول سارتر في كتابه الكلمات وهو سيرة طفولته إذ قال إنه ينتمي لثقافة كاثوليكية. ومن ملامح
هذا المثقف الفرنكوفوني الذي عادة لا يعرف اللغة العربية على الاطلاق (باستثناء عدد قليل) احتقار الذات من خلال هجومه الدائم والحاد على لغته وتراثه العربي الإسلامي، وهو في حقيقته هجوم على تلك الهوية الدفينة في أعماقه الغائبة الحاضرة، والتي من المستحيل محوها، ويسمون هذا الصنف من ناكري هويتهم كارهي أنفسهم. والناس ما تزال تتذكر في تونس الصراع الذي اتخذ أشكالاً دموية بين النخب السياسية العروبية الزيتونية وبين النخب المتفرنسة، أو ما اصطلح عليهم بـ”المدرسيين”، أي الصراع الذي وقع بين خريجي جامع الزيتونة الأعظم وخريجي المدرسة الصادقية.
في لقاء لي مع الشاعر الفرنسي برنار نويل، وكنت أيامها أعمل على ترجمة مجموعته قصيدة انتظار، شبّه عملية تلقين الفرنسية لأبناء المستعمرات بالاغتصاب الجنسي الذي يُدمّر روح الضحية. فلا هو يعود إلى هويته الأصلية، ولا هو يستطيع أن يتحول إلى فرنسي.
كان بورقيبة وهو نموذج صارخ للشخصية الكولونيالية المستلبة، كثيراً ما يهاجم في خطبه الزيتونيين والعروبيين، والإسلاميين، ويصمهم بالرجعية والتخلف ويسميهم (Les archaïques) متماهياً مع الموقف الثقافي الاستعماري في تحقيره لثقافة الأهالي، بل خلق مدرسة متنكرة للهوية وللتراث ما يزال لها ممثلون اليوم وإن كان عددهم قليل. وكان قمة الاجرام الثقافي غلق جامع الزيتونة المؤسسة التعليمية العريقة التي يمتد تاريخها إلى أكثر من ألف ومائتي سنة، وغلق فروعه التي كانت منتشرة في الأرياف التونسية، وإحالة مشيخته وأساتذته على التقاعد، وذهب شيخ الجامع محمد طاهر بن عاشور إلى بيته، ونقلوا كثيرا من مخطوطات الجامع وفي الأثناء حسب رواية الشيخ المحقق عبد الحفيظ منصور تعرض بعضها للسرقة والتلف…
أتذكر الصديقة إيلز ماري، الملحقة الثقافية الألمانية سابقاً، ومديرة معهد غوته في تونس. كانت تنتقد الفرنكوفونيين من مثقفي المغرب العربي الذين ينظرون إلى أنفسهم بكثير من الدونية، فتراهم نماذج صارخة للشخصية الكولونيالية المستلبة. وتضع البرنامج الثقافي باللغتين الألمانية والعربية وحاربوها لأجل ذلك، إذ كانت البرامج توضع باللغة الفرنسية قبل أن تستلم هي إدارة فرع المعهد في تونس. قالت لي “عشت في كثير من البلاد الإفريقية وشاهدت نفس الموقف الفرنكوفوني في إفريقيا السوداء”، وذكرت لي بلداً إفريقياً نصفه مستعمرة فرنسية والنصف الآخر مستعمرة إنكليزية، وقالت إن أبناء القسم المستعمَر من فرنسا وهم بالطبع فرنكوفونيون يحتقرون بقية شعبهم الذي يتكلم الانكليزية! قلت لها إن نفس الموقف عشناه ونعيشه في تونس حيث وصل الأمر أن الجامعة التونسية أقصت كاتبا ومثقفا كبيرا مثل طاهر الخميري لأنه متخرج من الجامعات الإنكليزية والألمانية، وكان أستاذا بالجامعة الأميركية بالقاهرة كما درس سبعة عشرة سنة في جامعة هامبور بألمانية، كان طاهر الخميري يقول لم يغفروا لي السنوات القليلة التي التحقت فيها طالبا بالزيتونة.
أدركت بعض هذه الفروق عندما ذهبت للمرة الأولى إلى نيويورك وواشنطن وتواصلت مع المثقفين العرب الأنجلوسكسون في الجامعات الأميركية وخارجها الذين اختلطت بهم وتحدّثت إليهم، ولم ألمس لديهم ذاك الزهو وذاك التعالي الذي لدى مثقفي الفرنكوفونية لدينا. تعالي على شعوبهم، وتذللا للمستعمر.
……………………………………………
* راجع ابن خلدون أول من رسم صورة نفسية للشخصية المغلوبة التي نسميها اليوم الشخصية الكولونيالية في المقدمة:
(الفصل الثالث والعشرون في أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده)
والسّبب في ذلك أنّ النّفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها، وانقادت إليه إمّا لنظره بالكمال بما وقر [١] عندها من تعظيمه أو لما تغالط به (نفسها) من أنّ انقيادها ليس لغلب طبيعيّ؛ إنّما هو لكمال الغالب. فإذا غالطت بذلك واتّصل لها اعتقادا فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبّهت به وذلك هو الاقتداء أو لما تراه _ والله أعلم _ من أنّ غلب الغالب لها ليس بعصبيّة ولا قوّة بأس وإنّما هو بما انتحلته من العوائد والمذاهب تغالط أيضا بذلك عن الغلب وهذا راجع للأوّل ولذلك ترى المغلوب يتشبّه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتّخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبّهين بهم دائما وما ذلك إلّا لاعتقادهم الكمال فيهم وانظر إلى كلّ قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله زيّ الحامية وجند السّلطان في الأكثر لأنّهم الغالبون لهم حتّى أنّه إذا كانت أمّة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التّشبّه والاقتداء حظّ كبير كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة فإنّك تجدهم يتشبّهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتّى في رسم التّماثيل في الجدران والمصانع والبيوت حتّى لقد يستشعر من ذلك النّاظر بعين الحكمة أنّه من علامات الاستيلاء والأمر للَّه. وتأمّل في هذا سرّ قولهم العامّة على دين الملك.