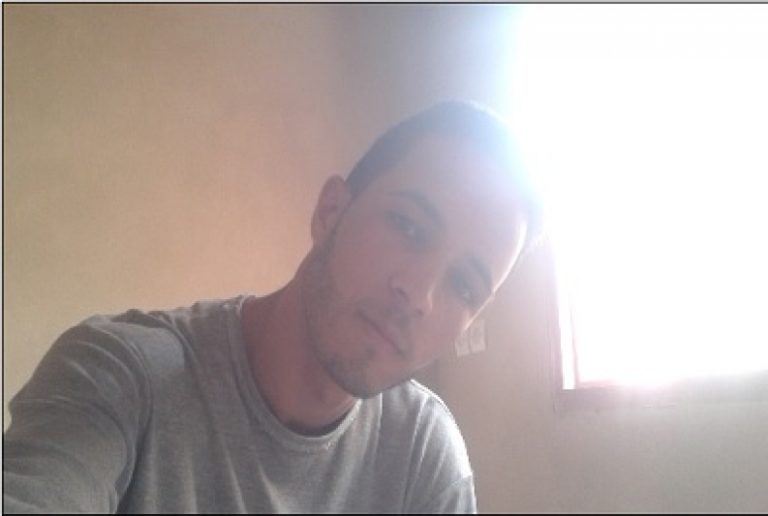حسني حسن
(1)
لم يكن زميل العمل معنياً لا بالثقافة، ولا بالمثقفين. لكن، وبما أنه يعمل بمجال الإعلام، فقد سمع، ذات مرة، وبمصادفة غير سعيدة، عن رجل يُدعى “جوبلز”. وعن “جوبلز” ذاك، كان يعرف ثلاثة أشياء بالعدد:
أولها أنه زعيم نازي، وربما ساعد “هتلر” الأيمن.
ثانيها أنه كان يعرج، ربما بتأثير مرض شلل الأطفال القديم.
أما ثالثها فكونه واحداً من أشد الكارهين للثقافة، وللمثقفين، على مدار التاريخ البشري.
– كلما سمعت كلمة ثقافة، أتحسس مسدسي.
يقهقه زميلي، ويغمز لي بطرف عينه، ويؤكد برضا منتشٍ:
– كلام “جوبلز”. رجل عاقل، أليس كذلك؟
– كلام مجرم حرب وفاشي عتيد.
أرد بعناد على الزميل المشاكس، والذي يتشاغل عني الآن عمداً. في الحقيقة، لم أستطع أن أتبين، أبداً، علة مشاطرة زميلي “جوبلز” رأيه، القاسي الصادم، هذا في الثقافة والمثقفين. لم أتعرف على نبرات الكراهية لهما في صوته، بل الشفقة والاحتقار، وظل ذلك يعذبني، ويؤرقني بالسؤال: من أي نبعٍ مسمومٍ تمتح هذه الاستهانة، يتفجر ذاك التعالي، على الثقافة وناسها؟.
كنا في أواسط عقد التسعينيات، الأخير، بالقرن العشرين. ورحنا نتابع، بصدمة ثقيلة باتت اعتيادية، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في يوغسلافيا السابقة ورواندا وبوروندي، وغيرها. كانت القلوب موجوعة والنفوس مجزوعة. لكن، وبمرور الوقت، وتتالي مشاهد الفظائع وتناسلها، راحت المشاعر تتبلد شيئاً فشيئاً، وأخذت الأسئلة، المعجونة بزيت الحرقة والألم، تستبدل زيتها ماءً فاتراً، بل وعاودنا الضحك والتندر على ذلك القرد، الذكي الماهر، الحالم ببلوغ مرتبة الإلوهية، والوالغ في حمأة الدم الرخيص بما تخجل من اقترافه الذئاب في البرية.
– ما أخبار مذابح “التوتو” و”الهوتسي”؟
يسأل الزميل، بلا مبالاة، وهو يقلب بالأوراق والملفات المكدسة فوق مكتبه الحكومي العتيق.
– اسمهما “الهوتو” و”التوتسي” لا “التوتو” و”الهوتسي”.
أزفر بضيق، فيتنازل برفع عينيه عن ملفاته، ثم يقول بسخرية:
– طبعاً مثقف، والتدقيق أهم شئ بالنسبة لك، لكنك، وبرغم خطأي وجهلي، فهمت عمَن أتحدث، وهذا هو الأهم، أليس كذلك؟
يوقعني سؤاله، المنطقي، في فخ الحيرة. أليست اللغة، أية لغة كانت، مجرد نظام إشاري للتفاهم والتواصل بين البشر وبعضهم البعض؟ فما الضير، إذاً، أخطأنا، أو حتى عكسنا، النظام الإشاري المتفق عليه فيما بيننا، طالما أن التواصل قد تم بنجاح؟ أو لا يغدو الإصرار على تصحيح المسار الإشاري، والحال هكذا، نوعاً من التنطع العقلي، بل والنفسي، ذي طبيعة ثقافية أرثوذوكسية؟ ألا يمكن أن يكون ذلك، وبالتحديد، سبب احتقار زميلي للمثقفين ولثقافتهم، أو بالأحرى لنطاعتهم الثقافية؟.
– تعرف؟ نحتاج إلى شِوالٍ ضخم يسع قرابة نصف مليار شخص.
– ماذا؟
أسأله، مستغرباً، مصدوماً قليلاً، وجاهدا في سعيي لملاحقة مخيلته الجامحة.
– نعبئ فيه كل العرب، من الخليج إلى المحيط، ونُحكم ربطه علينا، ثم نُلقي به إلى أعمق نقطة في المحيط.
– ثُم؟
– من غير ثُم، صدقني هذا أفضل جداً للعالم، للبشرية.
ولم أصدقه. لكني بكيته، بحرقة، لما رجعت من سنين سفري، الطويلة، لأعرف أنه مات، حزناً وكمداً، عقب فقده ولده الوحيد، المتخرج في كلية الفنون الجميلة، باعتصام “محمد محمود”.
(2)
لسنتين متصلتين، عكفت على العمل، بكل جدية وصرامة، في كتابي الأول “يقين الكتابة.. إدوار الخراط ومراياه المتكسرة” لأربعة أيامٍ متتاليةٍ بالأسبوع بين القراءة والكتابة والمراجعة والتصحيح، وفي اليوم الخامس أقعد لأكتب خطابي الأسبوعي، الأول، لزوجتي المُعارة بالخليج، أصف لها فيه مقدار ما حققته من تقدم، خلال تلك الأيام الأخيرة، بالكتابة، وكذا ما أجابهه من مشكلات وصعوبات. طقس أسبوعي مقدس، ومهمة غدت كالوفاء، الذي يستحيل التحلل منه، بالنذر. أجل، كنت قد نذرت العامين لإنجاز الكتاب، ربما في محاولةٍ، بائسة شقية، لتعويضها عن جزءٍ، تافهٍ ضئيل، من نذرها هي الأشد دموية، لأجل توأمينا الوليدين وأسرتنا الصغيرة؛ أمَا هي فقد وضعت أمومتها، شغفها وسعادتها، كأضحية على مذبح الحاجة والعوز، وأمَا أنا فقد كانت تقدُمتي لإله الكلام.
أبتعث هذا كله من آبار النسيان والأحزان المطمورة بصحراوات العمر، وأهز رأسي بأسى. حقيقة الأمر أننا لا نعيش لا هنا ولا هناك؛ أعني أنه لا مكان في حياتنا لأي مكان، بل في الماضي والآن، أو بالأحرى في آنية الماضي المُستدَامة، أمَا الامتدادات المكانية فليست أكثر من زاوئد وفضلات الزمان. ليس الامتداد واقعة جغرافية، بل محض طيف للذاكرة، وما السعي لاسترجاع ما جرى، لاسترداد ما امتصه الأثير الكوني، بأكثر من هرجة تافهة، مسعى عشقي خائب، كي نكسو عظام الزمن، المنشورية البلورية، لحم كثافة مكانية متوهمة: شمال/جنوب، شرق/غرب، أو اسكندرية/خليج.
خلال إحدى جلساتي الطويلة معه، لقراءة ما أنجزه من فصول ومناقشتها سويةً، سألت الأستاذ “الخراط” عمَا إذا كانت لفظة “حال” تأتي على صيغة المذكر أم المؤنث. لسبب ما، اخترت دوماً إيرادها مؤنثة، غير أني لم أتيقن من صوابية اختياري، ولا لمرة واحدة. ابتسم لي الأستاذ، بسماحته المعهودة، وقال:
– لنرَ.
راح يقلب في واحدٍ من المجلدات العشرة “للسان العرب”، بعد تجريد المزيد وإرجاع حروف العلة لأصلها المعجمي، حتى وصل للصفحة المنشودة. قرأ:
– الحال هي كِينة الشئ، وتأتي على صيغتي المؤنث والمذكر معاً.
أضاءت عيناه لمعة غريبة، من تحت نظارتيه السميكتين، وهو يهتف، مغتبطاً، كطفلٍ:
– انظر إلى كلمة “كِينة” هذه! من اللحظة صارت “خراطية”.
تبادلنا أنخاب الظفر، كنتُ قد قعَدتُ وشرعنتُ لأنثوية الحال، كما هجستها دائماً بغموض، وكان الأستاذ قد أخرجت سنارته، من بطن بحر “لسان العرب” اللجب، وعلى غير انتظار ولا توقع، كِينته.
الليلة أتساءل:
ماذا لو لم تكن “الحال” تأتي في “لسان العرب” على صيغة المؤنث؟ هل كانت الحال تصبح غير الحال؟ أم أن ذلك ضربٌ من المُحال؟.
(3)
أوصانا “بول فاليري” بالتزام الدقة، لا الوضوح. من جهتي، وفيما يتعلق بوصيته المشددة عن الدقة، فقد عهدت نفسي ملتزما بتحقيقها، أو بالأقل بالسعي لتحقيقها، ما استطعت لذلك سبيلاً، إلى حد أني كنت أخاف من صرامتي وانضباطي شبه العسكريين. لا إنجاز مع مخاصمة الدقة، هذا مؤكد. غير أن المحير لي ظل يتمثل في ذلك التعارض الذي أقامته عبارة “فاليري” ما بين الدقة والوضوح:
فهل يقصد “فاليري” أن الدقة والوضوح نقيضان في الجوهر؟ أم أن طبيعة الشعر تنفر من الوضوح، وتحتفي، بنفس الوقت، بالدقة والتفصيل؟
الأقرب للتصور أن الاحتمال الثاني هو المرجح، ومع ذلك تبقى العبارة محيرة، حيث كل دقة تنزع، بكيفية ما، بقصدية أو من غير قصدية، لإماطة غموض، وإنارة درب معرفة، أي لبلوغ وضوح. الدقة، والقابلية للقياس الكمي أو التوصيف التفصيلي المحدد، والصلاحية للتعميم والكليانية إنطلاقاً من الإحصاء الجزئي، هي كلها خصائص علمية يستعيرها الفن الحديث من فلسفة العلوم، هذه العلوم نفسها، وفلسفتها ذاتها، التي تخاصم الغموض وتسعى للجلاء الحسي/الرياضي الكامل، للوضوح المطلق. صحيحٌ أن ذلك يظل دوماً في طور الشروع، لا الامتلاك النهائي، لكن هذا لا يغير شيئاً، لا من حقيقة المسعى وغاياته، ولا من مناهجه وأدواته، ولا طبعاً من استبصارات وحدوس، بل ومباهج، رواده وصناعه وعلاماته.
الحقيقة أن المشكلة ليست بهؤلاء الأخيرين، أو أنها لم تكن يوماَ بهؤلاء الأخيرين.
نعم، المشكلة في السابقين إلى الإيمان، العائشين به، لا في الساعين المتأخرين باتجاهه.
يكتب “تولستوي”:
” نقول إن الوقت يمضي. هذا غير صحيح. نحن الذين نمضي، لا الوقت”.
هي على ذاك النحو بالضبط؛ كل شئ رهن بزاوية النظر. الجالس في عربة القطار السريع يرى البلدات تمر، والحقول تُنهب، والمسافات تُطوى. واقع الحال أنه هو من يمر ويُطوى، عبر الزمن، بفعالية الحركة. من هذه الازدواجية المثيرة ينبثق الإيمان، أو بالأحرى التوق للإيمان، في السحر والفن والدين. إنه المسعى، المشتط وإن الخاسر، لمجابهة الحتم؛ أعني الموت، التناهي، وأزلية الغياب. لكن، ولمَا كنا الآن على الحافة، لمَا كنا نخاصر، مغمضي الأعين على اتساعها، ريحاً كونية نتوهمها أبدية الرخاء، فإن التحديق بالقاع يلوح خياراً غير مُستحب، بل وهناك من يغامر بوصفه كخيارٍ جبان. وهكذا تنقلب الأحوال، والمقامات، رأساً على عقب، ويتفرق دم الحقيقة بين القبائل. أمَا قبيلة العلماء فهم قتلة الأنبياء، وأمَا قبيلة الأنبياء فهم راية الدهماء، وما بين أولئك وهؤلاء يقبع الشعراء؛ عشيرة الادعاء والاجتراء.
عنهم أتحدث عمَا قريب.
(4)
لم يوفروا لنا لحظة لنستريح فيها؛ أولئك الشعراء!.
منذ عقودٍ عديدة، جرؤ “أندريه بريتون” على القول، وبكل أريحية:
“إن أبسط شئ يمكن أن يفعله السوريالي هو نزوله إلى الشارع، في كامل زينته وأناقته، قابضاً على مسدسه بيمناه، ومطلقاً النار، عشوائياً، على الجموع، بأقصى ما يستطيعه من قوة وسرعة”.
مهلاً مهلاً، رجاء. لا تعجلوا علي بظنكم أن هذا أقصى ما يعدكم الشاعر به من رعبٍ، فلا يزال الأنكى بالانتظار. نعم، فالشاعر لن يرضى بعد ذلك بأقل من أن نشكره، بل ونبجله، ولم لا؟ لقد حررنا. ممَ؟ من وهم الوجود.
كان لي، دائماً، الكثيرُ من الأصدقاء الشعراء. حقيقةً، عشت منكوباً بالعديد منهم. أغلبهم طالما أشعروني، وكل الآخرين معي، أنهم إنما يتنزلون من علياء سماواتهم ليرأفوا بأحوالنا. عادةً، كنت أفضل ألا أشتبك معهم في نقاش، لا لشيء إلا لأني لم أكتسب، أبداً، ما يكفي من مهارات تفكيرهم “المحلق” لأفهم بدقة، ولا بوضوح طبعاً، ما يتفجر بألسنتهم من رؤى وأفكار وأحلام ما بعد حداثية. في البدء واصلت اتهام نفسي بأني تخلفت عن مواكبة جنوحهم الشعري، وأن سخريتهم من قراءاتي “القديمة” ولغتي “القديمة” وبلاغتي ” القديمة” ربما كان لها ما يبررها. كنت قد تربيت، أدبيا،ً على الكلاسيكيات العربية والعالمية، وفلسفياً، على الفلسفات المادية والمثالية، ورأيتهم يقرأون في البنيوية والتفكيكية وما بعد الحداثة، ويتحدثون عن “فوكو” و”شتراوس”و”دريدا”، بينما لا زلت أنا أقرأ “سارتر” و”كامو” و”ماركس” و”تروتسكي”. أقبلت على الأسماء التي يذكرونها بتقدير واهتمام، خاصة الشعراء “أراجون” و”بريفير” و”لوتريامون” و”بيسوا”. وبرغم العسر الذي كنت أجده في الترجمات، الفلسفية بالذات، فقد أدركت مبكراً أني قادر على تمثل أفكار مفضليهم، ومناقشتها، بجدية وتعقل، باعتبارها أفرعاً وأغصاناً، جديدة مضافة، لشجرة إبداع العقل الغربي، الكبيرة الوارفة، بالتضاد مع ما يتوهمونه هم من أنها نتاج نوعٍ من القطيعة المعرفية مع كل ما سبقها. كنت أحاججهم بالقول إنه لا الحياة، ولا الثقافة باعتبارها طريقة التفكير بالحياة، تقدران على إحداث تلك القطيعة المعرفية، التي يزعمون، مع كل ما سبق، فيردون بالقول إن كلامي هو كلام الإيديولوجيين وأصحاب العقائد الجامدة، من الماركسيين خصوصاً، فأرد بدوري إنه حتى الزعم بموت الإيدولوجيا هو نوع من الإيديولوجيا، فيقولون إن العالم قد تغير فيما بقي الإيديولوجيين متحجرين… وهكذا.
المهم، أني تيقنت، وبعد أشواط من معاناة محن حوارات الطرشان تلك، أنهم بالكاد يقدرون على هضم الأفكار والرؤى، الغامضة المشوشة، التي يقرأونها في ترجمات بالغة السوء والركاكة، ترجمات تفتقر إلى الحدود الدنيا من الفهم والضبط والدقة، وأن غاية ما يبلغون هو إعادة إنتاج تشوشهم الذاتي بعد ترصيعه ببضع جملٍ براقة، غير متماسكة السبك، مقتطعة، بشكل تعسفي، من سياقٍ ما، وأن ذلك الهجين المسخ يلوكونه، قولاً وكتابة، شعراً ونثراً، همساً وصُراخاً، باعتباره منتوجاً فكرياً وجمالياً بالغ الجدة والأصالة، وأنه، من ثم، يبيت لزاماً على العالم أن يصغي إليهم، وأن يرفعهم على الأعناق، وأن يعقد لهم الندوات والمهرجانات والمؤتمرات، بالداخل والخارج، ويمنحهم الجوائز، ويبرزهم على صفحات الجرائد والمجلات والقنوات التلفزية، بينما يواصلون هم “تبولهم الشعري” في أدمغتنا وأرواحنا المُستباحة.
في عصرنا هذا، ببلادنا هذه، صرنا نعيش كأننا. صار المسيسون كما لو كانوا ساسة، والمتعالمون كما لو أنهم علماء، والمتشاعرون كما لو أصبحوا شعراء، والرعية كما لو أنهم مواطنون. لكن الحقيقة، كل الحقيقة، أن ما يوهب للمرء من فسحة للعيش، لهو أضيق، بكثير، مما يسمحون له به عند موته.
(5)
قالت له:
– أشد ما يعجبني في “شوبنهاور” هو إيمانه، الوطيد، بجدارته الذاتية، وثقته، المطلقة، بأن ما يكتبه سيعيش، طويلاً طويلاً، من بعده.
يعرف أنها تحرضه وتعضده حتى لا يقع فريسة في شرك عنكبوت اليأس. يقول:
– في روايته القصيرة الرائعة المعنونة “ذوبان الثلوج”، كتب “إيليا إهرنبورج” عن اثنين من الفنانين التشكيليين الروس اللذين عاشا خلال الحقبة الستالينية. كانا صديقي صبا وشباب. وعاشا يحلمان بتكريس نفسيهما وموهبتهما للجمال وللإنسان، لكن الصديق الأشد وسامة وتطلعاً عرف أن ثمة أشياء أخرى يمكن للفنان الموهوب أن يحلم بها ويحصل عليها؛ المجد، الأضواء، النفوذ، المال، والحظوة لدى النساء الفاتنات. أمَا صديقه، الأقل وسامة والأكثر موهبة، فقد كانت خياراته أضيق بكثير، ولم يختر غير الفن والحب.
– وماذا حدث لهما؟
تسأل باهتمام وقد بدأت الحكاية تشغفها.
– ماذا تتوقعين أن يحدث؟ قولي أنتِ لي.
– أتوقع أُمثولة عن تفوق حلم الفن والحب، على أحلام النفوذ والثروة والشهرة والفاتنات الحسان.
ابتسم لها بحب. أخذ بضعة أنفاس من سيجارته، ثم همس:
– تتوقعين أُمثولة في عصر “ستالين”؟
زاغت بعينيها، اللوزيتين البنيتين، بعيداً عن نظراته المحدقة فيها. رغبت بأن تجيب عن سؤاله بنعم، لكنها لم تجرؤ. أشفق عليها، فقال:
– تعرفين؟ لن تصدقي أبداً، حتى في عهد “ستالين” يمكن لأحلام الحب والفن أن تنتصر، وهكذا فإن الصديق الفقير الضعيف غدا محسوداً من صديقه القديم النجم.
– أنت لا تلفق تلك النهاية شفقة بي.
قام يحتضن رأسها الصغيرة بين كفيه، قبل أن يطبع قبلة عاشقة خفيفة على جبهتها. زفر بتعب:
– لا، لستُ أنا، بل “اهرنبورج” نفسه من لفقها، ربما شفقة بنفسه.
حرر رأسها من بين يديه، وراح يشخص للبعيد وهو يفكر في النهاية، متسائلاً عمَن يستطيع المجازفة بالإدعاء أنه في نهاية الأمر ثمة نهاية لأي أمر.