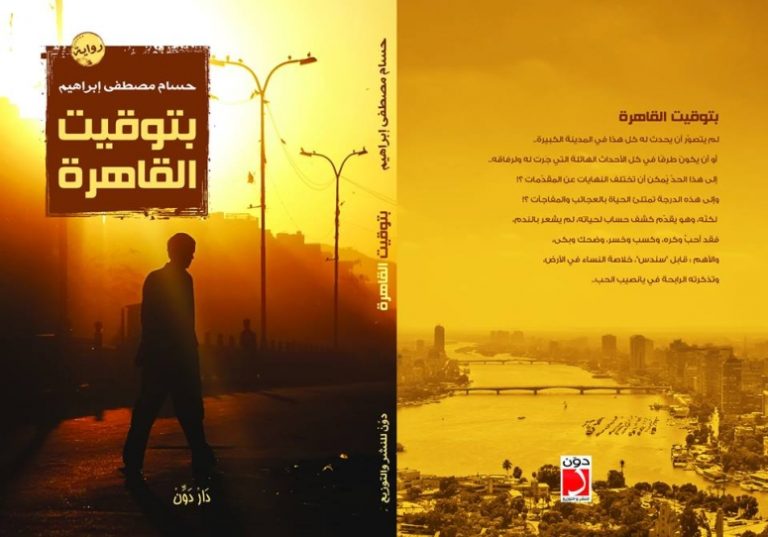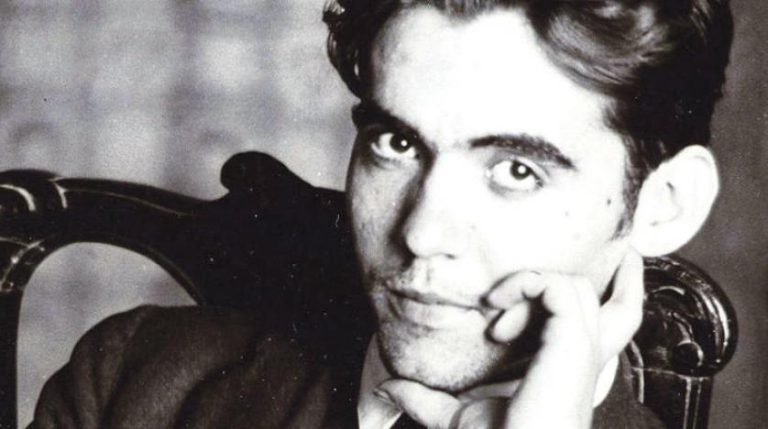هنا المفتاح لتأويل رواية أحمد كامل” العهد القديم”، الصادرة عن دار روافد 2017، والتي جعلت من بطلها “يوسف المدهش” حاملا لعبء الزمن وصليب الذكورة المنسحقة والمسحوقة فوق كاهله، والذي باستعارته صوت الأنثى الشاكي، يستعيد حقه في البوح، ولا أمل في بوح الذكر إلا إن صار أنثى.
تبدأ الرواية بيوسف يحمل وردة، كأنوثة مكتملة بذاتها تسقط ذكرها، وتصير مفتاحه لعالم من الرعب، والأمل أيضا في اكتفائه هو نفسه بذاته، بعيدا عن سطوة الصراع المتوهمة، ربما هي رغبة في التخلص من القضيب بحثا عن طيف حريته، متخلصا من طاووس ذكورته، وأسطورته الكبرى التي نال عبرها حقوقا وهمية، ثم رزح تحت كاهلها في مقابل شديد الهشاشة: احتكار عفة الأنثى. والتخلص من أعباء لم يعد أهلا لها، كاحتكار العنف، قدرته على القتال، جلب الزرق، وتحوله من ” المدهش” إلى ” المقيد”. الآن يدرك أن الثمن بخس: حياته كلها.
فتصير عفاف، الزوجة، في ذهنية المختل، وحشا كاسرا، لفرجها سلطة ابتلاعه. رمز العفة ليس إلا رمزا لمنظومة أخلاق اخترعها أسلافه الذكور أصلا لحمايته، وورثها عنهم اشتهاء لتلك الحماية المزيفة، فيكتشف ضآلة أسطورة قضيبه بجانب أسطورة الوحش الذي اخترعه فنهشه، ويخترع لها كائنا شبحيا مجهولا ومطلقا، وحده يملك قضيبا خرافيا يستطيع إشباعها، متهما إياها بخيانتها معه. بينما نراه مشغولا بالسيطرة على ذكره العاجز وحماية مؤخرته من ” ألاعيب العيال” مصدر ثقته هو مصدر هزيمته في آن.
مشهد البداية في الرواية، هو مشهد قيامة، يمهد لسيولة العالم في عيني يوسف المدهش وانهياره، هو في الأساس كزمن الرواية، فالرواية لا تتقدم خطيا إلى المستقبل، بل تدفع دفعا من المستقبل إلى الماضي في رحلته كمختل إلى جذر المشكلة، رحم ما قبل المعاناة، وكشفا مستحيلا عن أسبابها. يأتي ذلك ضمن تقاطعات زمنية، تحول الزمن إلى عبء ثقيل فوق كاهل بطل الحكاية.
وتصبح”المعرفة” هي سبب الخلل، فهي” تهز الواحد يا مدهش، تكشف عريه لعينيها، تفقأ روحه بالحقيقة“. هي فعل التحطيم، لكن كأن تحطيم الأصنام التي تكبل الكائن، بفأس المعرفة، لا يتحطم معها إلا ذات حاملها. فتصير لعنته أنه أدرك، فلا ينجيه إدراكه، فلا يحصل إلا على خذلان في خذلان وعجز فوق عجز، فيتوهم أن انسحاقه ليس سوى أضحية من أجل المستقبل خطوة للوصول إلى الإنسان الكامل، وفقا لرسالة الأصوات الفوقية (ملوك الزمان) التي تأتيه: “الخلاص في المستقبل”.
بطل الرواية، يتم تحذيره من كل شيء، من الحياة كلها، ففي كل موضع فخ، وففي فراشه عقارب وحيات، وفي كل موطيء قدم مسامير، ومن السماء تنقذف الحجارة إذا غفل. سلطة الدين والأسرة المتدينة والعفة المتوهمة متحجرة القلب.
يتحول حق الإنسان في المتعة ، إلى طريق للهروب في مقهى “سعادة”، حيث المتعة- في مجتمع يرزح تحت أساطيره- تتحول إلى أفعال ضد القانون، كمخدر لا كغاية، مقيدة بقيد الذنب الهائل، ومبتذلة حد احتقار المرء لذاته إذا ما نالها. ميدان تتتشابك فيه أساطير الذكورة عن نفسها، وانسحاقها في الوقت عينه”، ففي مشهد المقهى، حيث ينال الذكور متعة الفرجة على الأفلام الجنسية المختلسة، ينتهي من يدافع عن عفة أمه/ علامة ذكورته ضد النعت بالانفلات الجنسي، إلى مهزوم معلق كذبيحة على باب جزار، والعصا تخترق دبره/شرفه على يد قسم الشرطة التي قاومها.
الأب مورث العادات لم يكن إلا مسحوق مثله، حتى ولو لم تتجل هزيمته في اختلاله، ولا يورث له سوى نصيحة الواعي بهزيمته والقنوط من كل أمل إلا ذريته التي ستسحق بدورها” يايوسف، تشبث بذاكرتك فقط، لا تسمح لهم باللعب فيك”.
الذاكرة هنا، قد تكون حافظة الوعي الجمعي وفطرته، أو بداهة الأشياء وأصلها قبل اختلاط الحقائق وحجب المعرفة، لكنها من المؤكد، قشة نجاة أخيرة. عندما يتشبث بها البطل أكثر فيعرف أن ذاكرته هي سلسلة من الهزائم، هزائمه وهزائم سلفه.
قد يحدد يوسف المدهش منبع الهزائم في حيرة، فتارة يشير إلى فقاعة العفة المخترعة والتي تجعل الجسد خصما للروح التي “تحتاج إلى ثقوب” الجسد، ثم تقوده الفقاعة إلى التدين السلفي، المتطرف، القادم من “شارع الخليج” الذي يتدخل في أصغر تفاصيل الإنسان. لكن منظومة العفة، الممثلة في الزواج والزوجة، تظل هي القاتل الرئيسي من وجهة نظره، وبخلاصه منها قد يتخلص من أسباب كل الهزائم، فيحملها أسباب مآساته بالكامل وأسباب خلاصه أيضا.
ينشئ يوسف صراعا متخيلا بين أطياف الأنوثة: الأنس من أنيسة (الحبيبة الأولى)، سلوى من السلوى (العشيقة المشتهاة)، العفة من عفاف (الزوجة)، هناء، سلمى، كلهن مجازات لأنثى واحدة، أطيافها المتعددة التي تضيء وتقبض على وحشة البطل العارمة، يظل الأنس مشتهى ومطلب، كأنه حل مثالي، لكن العفة واحدة أيضا من أسباب الصراع بين الذكورة والأنوثة، هي حجاب الأنوثة ورمز سيطرته عليها، لكنها أيضا المسؤولة عن حجابه هو وعزلته وانسحاقه. الرغبة في الجنس والأنس معا هي الفخ إلى قيد عفاف المهول التي ترغب في احتكار كل أطياف الأنثى ومجازاتها في جبروت، فتصير هي الأنس والسلوى والهناءة والسلام، دون أن تقدمها حقا، هكذا نراها من زاوية الذكر الذي يفقد حريته وطموحه، لكن أليس هذا ما يسلبه الزواج/ منظومة الأخلاق من الأنثى أصلا، تسليم بفقد طموح أن تتورد الزهرة، واستسلام لحال الذبول، في مقابل ايناع آخر؟ ماذا لو لم يحطما بعضهما البعض، ولماذا لا ينموا مع بعضهما البعض؟ عفاف بصوتها المكتوم، كما كتم من قبل صوت شارل في مدام بوفاري، مسحوقة مثله، دون شكوى، فتستحيل كلما نجحت وفق معايير الذكورة، إلى وحش قبيح من وجهة نظر المختل، كما رأينا شارل من وجهة نظر مدام بوفاري.
حتى في الرواية ينكشف خداع اندفاع الزمن من المستقبل إلى الماضي، فلا زمن بل دائرة، تبدأ من عفاف وتنتهي إليها، مقتولة كي تكف عن انجاب المزيد من القيود، قتلها ليس إلا كشفا لروح الحب الأصلي” الأنس”. فالأنوثة هي أصل الحياة ومنبعها. ورعب البطل يأتي من ادراكه قدرتها على الاكتفاء بذاتها، وعجزه الأصيل عن الاكتفاء بذاته، وانكشاف هشاشة أساطيره التي حمته طيلة قرون.