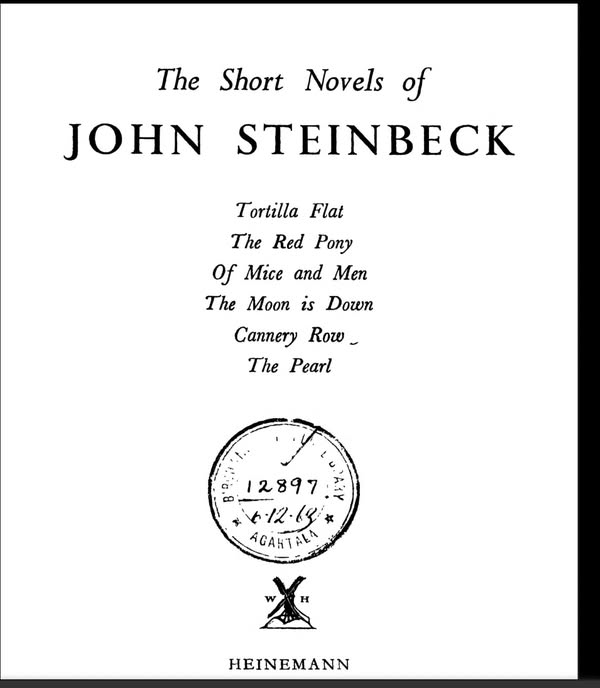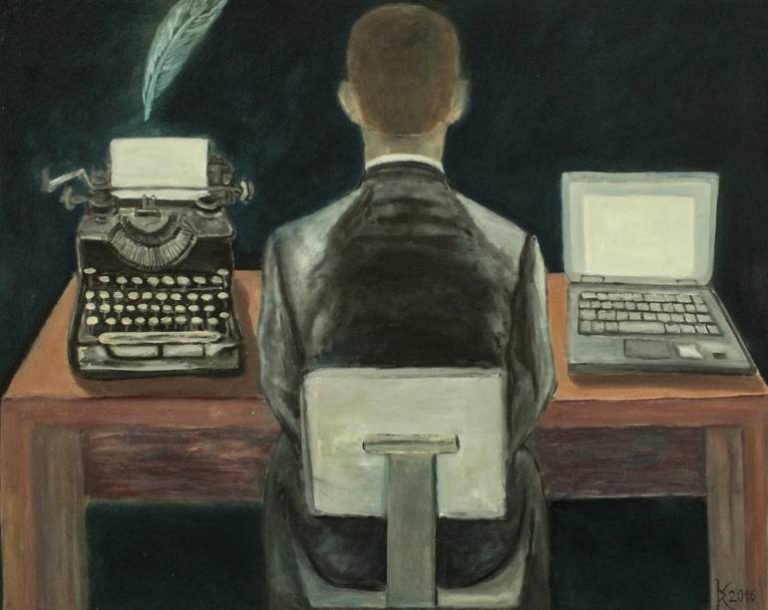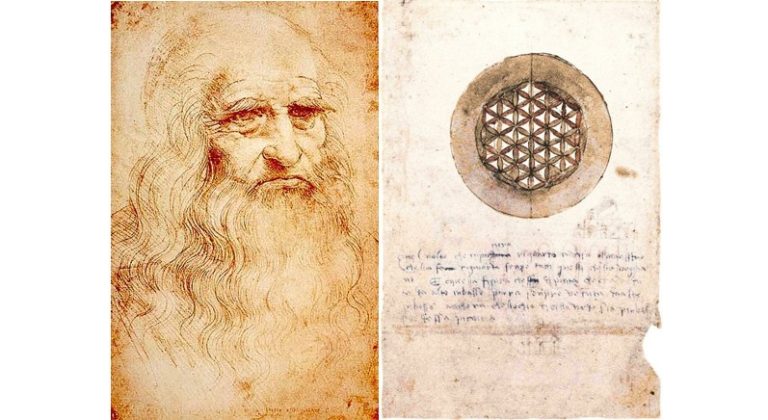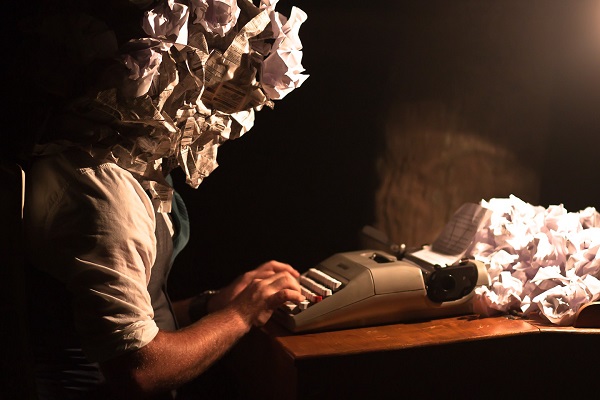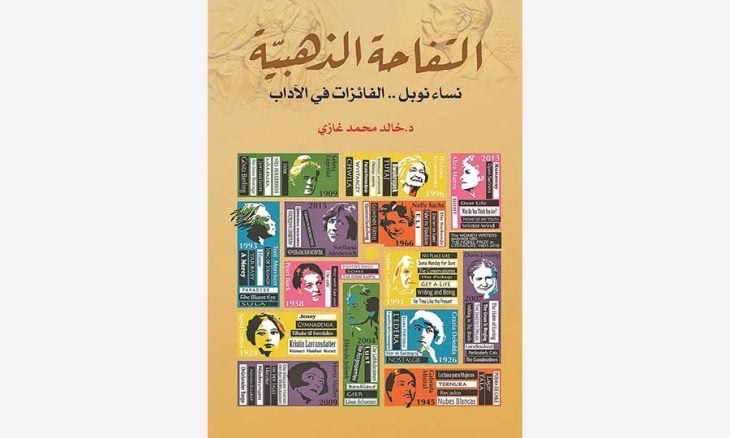مرزوق الحلبي
*الثقافة العربية قادرة بما تُنتجه في كلّ حقولها على الخروج من ظلال الثقافة الغربيّة والظهور مكشوفة في الشمس والريح، فلديها ما يحميها وما تقترحه من جماليّ ومعنى*
علاقة الثقافة العربيّة بجائزة نوبل للأدب لا تختلف عن علاقة ثقافات الأطراف غير العربية بالجائزة بوصفها حُكمًا ما ومؤسّسة تمنح الشرعيّة وتكافئ وتضع النتاج الأدبيّ في مصاف “الرائع” و”العالميّ”، والمُبدع الحائز عليها في قائمة “الخالدين” (وإن كانت صيغة النص بالمذكّر إلّا أنها تقصد المبدعات، أيضًا). إنها علاقة تابع لمتبوع أو واقف على البوّابة ينتظر أن يفتحوا له فيدخل “الجنّة”، إذا فتحوا! أقول هذا في ضوء الخطاب العربيّ المتّصل بهذه المسألة عشيّة كلّ موسم نوبل وغداته. ربّما أن الأديب نجيب محفوظ الحائز على نوبل أصدق مَن عبّر عن هذه الأفكار في الكلمة التي ألقيت باسمه في مراسم فوزه بها (1988). صحيح أن خطابه اشتمل على محاور هامّة كالإشارة إلى مسألة فلسطين ومعاناة شعوب العالم الثالث إلّا أنها كتبت بأسلوب الرجاء “أن افتحوا لنا البوّابة!”. ليس هذا فحسب، بل كان محفوظ بحاجة إلى الاستعانة بالحضارة الفرعونيّة كي يدلّل على شخصه وسموّ أدبه أو كونه سليل حضارتيْن جديريتيْن أسهمتا في الحضارة البشريّة، الفرعونيّة والإسلاميّة. كُتب جلّ الخطاب بلغة التابع الذي يتحدّث إلى المتبوع، ابن الجنوب الذي يرجو الشمال صاحب الرأي والحلّ والربط، ابن العالم الثالث الذي يطلب حنوّ العالم الأوّل ليرأف بحاله ويخلّصه.
في كلّ موسم لجائزة نوبل يقف العرب مع غيرهم على البوابة ذاتها ويقولون الكلام ذاته. وهو ما يستدعي أن نتوقّف عنده وعند نوبل كحُكم على الأدب وكبوابة دخول أو حظر دخول إلى الأدب العالمي. ولا يقلّ أهمّيّة عن ذلك هو التوقّف عند صورة الأدب العربي في عينيّ نفسه ومنتجيه. إنها مناسبة سخيّة لرؤية العربيّ ناظرًا ومنظورًا إليه (كما في كتاب الطاهر لبيب). يصير هذا ضرورة في ظلّ حقيقة أننا في حقبة ما بعد الاستعمار من حيث العلاقات بين القوى والثقافات واللغات. على الأقلّ من حيث التنظير لهذا الموضوع. وهو ما يفترض أن ننشئ كعرب خطابًا ثقافيًّا مغايرًا لا ينتظر عند البوابة ولا يستجدي العبور إلى “الجنّة” ويكفر فيها أو يقترح “جنّته” البديلة.
أدرك النزعة الطبيعيّة لدى الثقافة العربيّة أن تصير جزءًا لا يتجزّا من الثقافة العالمية، ولدى الأدباء العرب أن يصيروا جزءًا من “الأدب العالمي” بلغة دمروش الرائجة الآن أو غوته من قبل، أو من “الجمهورية العالميّة للآداب” بلغة باسكال كازانوفا. وهي نزعة مشروعة ومفهومة يعبّر عنها بعض مبدعينا على نحو يُبقى على احترامهم لأنفسهم ولأدبهم وثقافتهم. ومع هذا، فإن كازانوفا في كتابها المفتاح من العام 1999، كانت صريحة صراحة متناهية في نقدها وكشفها لعلاقات القوّة بين اللغات والثقافات والآداب بما ينفي وجود أدب عالمي بالمعنى الذي تحدّث عنه برومانسية يوهان غوته الألماني في العام 1827، حين اعترف لمساعده إيكرمن برفضه لفكرة الأدب الألمانيّ المتفوّق وبإعجابه بالأدب الصينيّ وأمله أن يرى آداب اللغات الأخرى في حفلة راقصة تجوب الكرة الأرضية على ثقافاتها وشعوبها. لقد أوضحت كازانوفا وجود لغات مُسيطِرَة تسبح في فلكها لغات خاضعة لسلطتها. وقد كان مثقّفو ما بعد الاستعمار ونظريّات التفكيك النقديّة معها وقبلها أشاروا إلى هيمنة ثقافات و”إمبراطوريات” قُيّض أن تكون كلّها غربيّة داعين الشعوب التي تتوق إلى رفعتها واستقلالها وعزّتها الثقافيّة أن تنحو منحى مغايرًا في علاقتها بـ”المراكز” على اختلافها وأن تنظر إلى نفسها ـ ولغاتها وثقافاتها وأدبها ـ باحترام واعتزاز. فوفق هذه النظريّات لم يعد هناك مكان لأدب أطراف وهوامش أدنى قيمة مقابل أدب مراكز هو الأدب الذي تُقاس الإبداعات به ووفق معاييره.
شيء ما ينبغي أن يحصل في مساحة رؤية العرب لذاتهم الأدبيّة المُبدعة وللجائزة ومانحيها (مؤسّسة نوبل). في أثناء دراستي للحقوق درست مساقًا في الاقتصاد ونظريّاته. ولا زلت أذكر المادة عن نظام المكافآت في الاقتصاد، فرضياته ومآلاته. وأراني على طريق كازانوفا أستعمل الاقتصاد ونظرياته في تحليل العلاقات الأدبيّة. أذكر جيّدا من ذلك المساق أن كلّ نظام مكافأة في الاقتصاد ينتهي إلى عكس ما بدأ لأجله. فالمكافأة لأجل التحفيز والتشجيع تنتهي إلى تربية الكسل والركود. وهكذا جائزة نوبل للأدب ـ وسواه ـ لم تعد تحفّز على الأدب بقدر ما تحفّز على غيره من فنون العلاقات العامة والتسويق وإنشاء اللوبيات. فهي في رأينا المتواضع تآكلت كأيّ نظام مكافأة ولم تعد بوابة للعالميّة أكثر من أيّ أستاذة جامعيّة يفتنها الأدب العربي وتقرّر أن تنقل كلّ ما كتبه إبراهيم الكوني إلى اللغة الألمانية مثلًا. وليس أهمّ من تدريس درويش في مساقات جامعيّة عبر العالم، ولا من دار نشر تقرّر أخيرًا أن تترجم كل نتاج عبد الرحمن منيف إلى الفرنسيّة، وهكذا.
أشار المهتمّون بنظريّة “الأدب العالميّ” الرومانسيون منهم والنقديّون إلى أهمّية الترجمة بين اللغات وإلى مبدأ أن الآداب متساوية وأن هيمنة لغة ما ينبغي ألّا يُشتقّ منها سموّ أدب وانحطاط آخر. وافترض معظمهم أن الترجمة هي المفتاح إلى أدب عالمي تعيش فيها الآداب على قدم المساواة. هذا علمًا بأن القائلين بهذا الرأي يقولون، أيضًا، بفرضيّة أن الترجمة كانت ولا زالت خاضعة لعلاقات القوّة بين اللغات وأن أكثرية الترجمات تتمّ من اللغات “القويّة” إلى اللغات “الأضعف”. وكانت كازانوفا في كتابها وحواراتها أشارت إلى أن مثل هذا الوضع سيتوقّف حين لا نعتبر اللغة الأقوى أقوى فعلًا وأن قيمة أدبها ليس أكثر من قيمة أدبنا. بمعنى، هناك أهمّية لنزع “الأسطورة” عن اللغات “القويّة” وإدراك أنها لا تتميّز عن سواها في شيء، وأنه قد يُصادف أن تفقد هيمنتها تمامًا. مع كلّ هذا الخطاب التحريريّ الذي نُقل إلى ثقافتنا العربيّة وتمّ إدراجه ضمن المساقات الأكاديميّة في الدراسات الثقافيّة لا نزال فيما يتعلّق بجائزة نوبل ننتظر على البوّابة أن ندخل ومعنا توصية من نجيب محفوظ. يبدأ التغيير في رأينا عندما يردّ الأدب العربيّ اعتباره لنفسه من خلال تبنّي نظريّات تفكيكية نقديّة لا تحابي المركز الغربي ومؤسّساته بما فيها “نوبل” ولا “تُقدّسه” وتتوسّل دخول هيكله، فتثق بنفسها وبزرقة المتوسّط وعلوّ النخيل وجماله. فيصير عبد الرحمن منيف مثلًا الأديب الأهم عالميًّا حصل على نوبل أم لم يحصل، ويصير درويش الشاعر الأعظم في العقود الأخيرة، حصل على جائزة أو لم يحصل. من هنا أهمّية تغيير اتّجاه الترجمة، فنعكف على ترجمة درويش ومنيف إلى لغات العالم قبل أن نعكف على ترجمة أمبرتو إيكو وتوماس مان إلى العربيّة. ومن هنا أيضًا، أهمّية أن تنشئ الثقافة العربيّة جوائزها لا أن تنقلها عن البوكر العالميّة. وأنا من المؤمنين أن الثقافة العربية قادرة بما تُنتجه في كل مجالاتها على الخروج من ظلال الثقافة الغربية والظهور مكشوفة في الشمس والريح، فلديها ما يحميها وما تقترحه من جماليّ.
(تشرين الأول ـ 2025/ برلين)