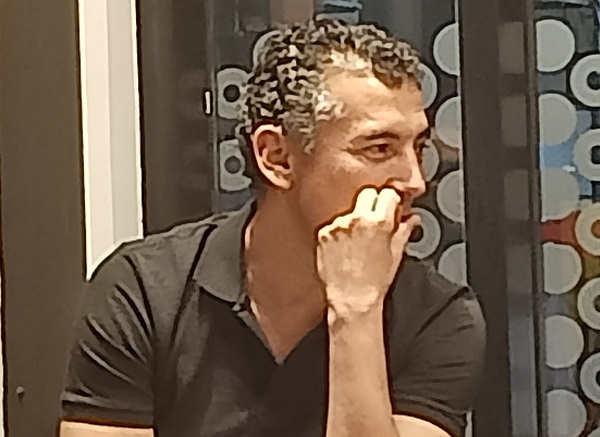أسامة كمال أبو زيد
لماذا يخفق القلب لوقع سطورٍ من الشعر؟ ولماذا تضيء العتمة فجأةً من داخلنا دون أن ندري؟ أهو الشعر، أم هو الاسم السرّي للحياة حين تنادينا من سدرة منتهى المعنى؟ لم يكن السؤال يومًا: هل نتحدث عن الشعر أم نتركه يتكلم وحده، بل كان: كيف نقترب من ذلك النبع الذي لا نرى منبعه، ونسمع ارتجافته رغم كل الصمت أو الضجيج الكامن حولنا؟ الشعر ليس ترفًا، ولا حرفةً تُتقن، بل ضرورة كالنور في الحدقة؛ لذلك همس شارل بودلير بأن يكون الشعر قريبًا من ومضات الروح، قريبًا من الحقيقة حدَّ الألم، ومن الجمال حدَّ الدهشة، كامنًا في المسافة السحرية والسرية بين المطلق والإنسان، لا ينحاز إلا للضوء البعيد.
لا أحد يعرف من أين ينبع الشعر؛ نحن فقط نفاجأ باندفاع الماء، لكن الاندفاع لا يعني الاكتمال. كم من نبعٍ وُلد فدفنته الرمال، وكم من صوتٍ علا ثم خمد قبل أن يدرك معناه. هكذا القصيدة: ليست كل رعشةٍ نصًّا، وليست كل قافيةٍ حياة. الأشكال تتبدّل مثل زجاجات العطر؛ فالخلود ليس للإناء أو الزجاجة، بل لما يتوهج داخله من رائحةٍ بلورية غير مرئية. لذلك تغيّرت الزجاجات وتبدّلت البيوت، وبقي الجوهر يبحث عن مسكنٍ يليق بضوئه. فلا أبو الطيب المتنبي كان وزنًا فحسب، ولا محمود درويش كان قضيةً فقط، ولا دانتي كان شكلًا معلّقًا في كتب البلاغة؛ كانوا لحظة صدقٍ عبرت اللغة، فصارت اللغة أثرها.
ومن هنا يجيء السؤال الآخر: هل يحتاج الشاعر أن يتحدث عن نفسه، عن مخزونه، عن تصوّره للجمال، أم تكفي القصيدة دليلًا إلى بيتها السحري؟ أتصور أن الشعر والنقد يخرجان من غرفةٍ واحدة في الروح، غير أن الناقد يقف غالبًا أمام البيت، يصف نوافذه، وربما تصل يده إلى عتبته وأسراره؛ لكن الشاعر هو الساكن، هو الذي يشعر بالظل المختبئ بين الممرات، ويتنسم رائحة المطر القابعة في الجدران. ومع ذلك لا يحيط بالبيت كله، لأنه بيتٌ يتجدد بساكنه، ويتسع كلما ظن أنه اكتمل. القصيدة أكبر من كل تصور نقدي عنها، لا لأنها ترفض العلم، بل لأنها تفيض عنه؛ تظل قابلةً لتأويلات لا تنتهي، وتتجدد كلما تجدد قارئها. فالمبدع يرى من قلب البيت، من نقطةٍ تتجاوز الحدود المألوفة إلى الزمن المستحيل. ومع ذلك تبقى المسافة قائمة بين التجربة واللغة، بين ما يُراد قوله وما يُقال؛ ثمة صراعٌ خفي وهو يكتب: حذفٌ وإضافة، وإعادة بناء. والشاعر الجيد هو من يُحسن الإصغاء لذلك الصوت الغامض فيحرره، لا يخنقه، فيخرج الكائن حيًّا متألقًا؛ بينما الرديء يقمعه حتى يموت ويغيب.
أن تمرّ بكل الدروب، أن تشرب من كل الينابيع، أن تتعرّض للشمس كما للريح، ليس لتدخل التيه بل لتعرف أيُّ ضوءٍ يخصك؛ فكل الأنهار تصب في البحر، لكن البحر لا يصير نهرًا. وحين تعود وقد دخلتك الحياة صلصالًا أعمى، وخرجت ممهورًا باسمك، بلغتك، بلون دمك، هناك يبدأ الشعر، وهناك يصبح التوقيع سؤالًا مريرًا: أهذا أقصى ما أستطيع؟ الشعر لا وظيفة له كما لا وظيفة للشمس، ولا يزهر في أغلال الشعارات البراقة. لم يكن بابلو نيرودا لافتةً، ولا والت ويتمان نشيدًا معزولًا عن جسده؛ كانوا حياةً كاملة، ففاضت الكلمات عن حدودها. وإذا لم يوقفك سطرٌ في الطريق، ولم يهزك جمالٌ عابر، ولم ترتبك أمام وجهٍ من بين الوجوه، فما جدوى الكتابة؟ التجاوز ليس صخبًا، بل وفاءٌ للمعنى؛ أن تخرق السائد لتفتح نافذةً للريح، فالجمال وحده ما لا يذهب جفاء.
والشعراء حين يضعون أيدينا على مفاتيح بيوتهم، لا يفعلون ذلك ترفًا، بل يفتحون نافذة أخرى على النبع، يقرّبون المسافة بين القارئ والقصيدة، ويفتحون أفق الحوار بين الأجيال والاتجاهات في زمنٍ تتكاثر فيه دعاوى التهميش وتعلو فيه الضوضاء. إنهم حين يتكلمون لا يبررون، بل يضيئون؛ يكشفون عمق صلتهم بالتراث، ويبرهنون أن الاختلاف ليس قطيعة، بل امتدادٌ آخر للنهر. قد ينال شاعرٌ لقبًا كما ناله أحمد شوقي، وقد يعبر آخرون المنافي والخيبات مثل بدر شاكر السياب، أو يقفون عند حافة الحلم كما فعل خليل حاوي؛ لكن ما يبقى بعد الضجيج هو الإخلاص، وحده الإخلاص.
مرت أعوامٌ وأعوام وأنا أكتب وأقول: ليس بعد؛ كأن الاستحالة شرطُ المواصلة، وكأن الشعر سؤالٌ لا يريد جوابًا، لأنه هو الجواب حين تعجز اللغة عن تفسير لماذا نحيا، ولماذا نحتمل، ولماذا نواصل السير في هذا الضوء المراوغ؛ الضوء الذي إن لم نمسكه بالكلمات انطفأنا، وإن لمسناه لحظةً عرفنا أن الحياة كانت هنا، قريبةً من الروح، دانيةً من القلب، وأن البيت السحري لم يكن سوى اسمٍ آخر لذلك القلب الذي يخفق كلما لامسته سطورٌ من الشعر.