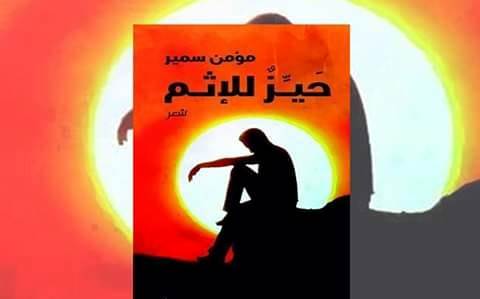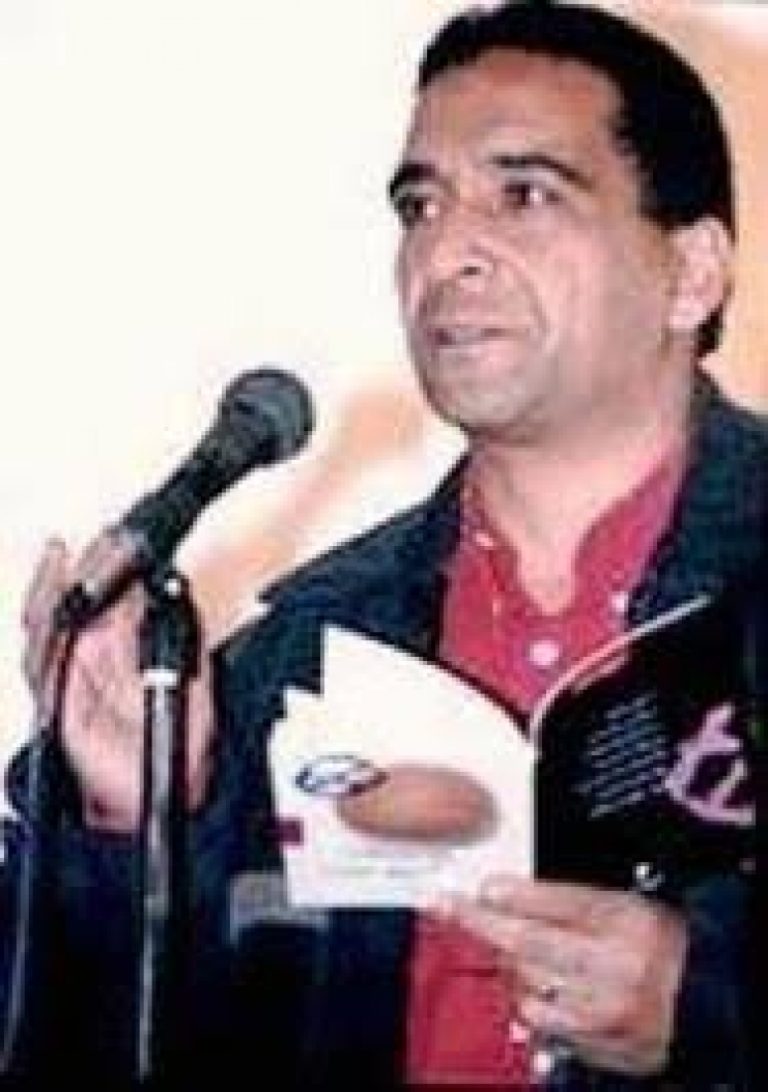يمثل أشرف الصباغ تجربة مميزة في عالم القصة القصيرة، حكمت عليه بها نشأته المصرية، وتواجده في أرض تشيكوف الذى يعتبر أحد أهم مؤسسى فن القصة القصيرة في العالم، فاحتشدت قصص الصباغ القصيرة، وتلونت، بما يجمع بين التجربتين، والأسلوبين. فكانت الهموم المصرية، مصاغة بالصيغة الروسية، وبالتحديد التشيكوفية، التي اهتمت بالتفاصيل، وبالسخرية والفكاهة المريرة، كما ابتعدت لغته عن الكليشيهات، أو الصيغ المعلبة، بل تميزت بلغة الشارع، فيقرأ القارئ وكأنه يستمع إلى من يحدثه، حديث الصداقة، والألفة، التي يخفى وراءها عمق التجربة، التي لا يستطيع القارئ الوصول إليها إلا بإعمال الفكر والتأمل.
فإذا ما تأملنا أول قصة في المجموعة وهى قصة “اللكمة” التى يستدعى العنوان فيها بهاء طاهر فى أولى مجموعاته “الخطوبة” فى العام 1972، والتى لا تبتعد كثيرا عن قصة “اللكمة” للمبدع أشرف الصباغ، وإن كانت قصة بهاء طاهر تتناول واقعة محددة، وهى نكسة 67، بينما لكمة أشرف الصباغ تتناول الشأن العربى عامة، وفى القلب منه “القضية الفلسطينية”. حيث تتناول الشأن المصرى بعد معاهدة كامب ديفيد، وكيف استقبلها العرب، والفلسطينيين في القلب منهم فكلتاهما تتناولان الشأن السياسى، فى أمتنا العربية كما أنه ومن النشر فى الحالتين مختلف، فكان الاختلاف أيضا فى التناول، حيث نرى أشرف الصباغ، قد تناول مسائل عديدة، حتى ليظن القارئ- غير المتمرس- أنها متباعدة، إلا أن التدقيق فيها، سيثبت أنها لم تغادر القضية الأساسية، ولكنه يتناول الوصف العام للحالة، عندما يبدأ القصة بالنظرة الأحادية، التى يُصر عليها كل العرب، والفلسطينيين منهم حاصة، عندما تبدأ القصة بما ترسخ فى أذهاننا من أقوال الآباء والأمهات والأخوة الكبار، وكتب الجغرافيا فى المدارس الأولية، بأن البحر المتوسط، ليس له شط آخر غير الذى نراه نحن هنا {لم يكن هناك على الطرف الآخر من البحر المالح أى شئ سوى الفراغ. نحن فقط الذين نطل عليه} ولم تكن الرؤية الجغرافية، فقط، هى ما رمى إليه الكاتب بقدر ما كان يرمى إلى تلك الرؤية الأحادية، التى ترى أننا فقط من على الأرض، وراينا هو الصواب، وكل ما عدانا باطل. خاصة أن هذه الرؤية تم زرعها فى عقول الأطفال ليشبوا مشبعين بها، مؤمنين إيمانا لا يتزحزح، ودونه القتل والموت {ومن أين لوسائل الإعلام والمدرسين والآباء والأمهات بذلك اليقين وزرعها مثل الصدى فى النفس وضربات القلب وانقباض المعدة وانبساطها فى الوعى والذاكرة؟!}. فقد جعل الكاتب من تلك الرؤية، هى القاعدة التى منها ينطلق، وكانت السبب فى تلك اللكمة التى هاجمه بها الشاب العشرينى، بينما –السارد- عائد فى رحلة الطائرة من موسكو إلى بيروت، ليوسع القاعدة، ويُثبت أن منها تنطلق تلك الاندفاعة الحمقاء، لتشمل العالم العربى كله، بل والعالم الإفريقى. حيث يصف الكاتب ركاب الطائرة ومن بينهم{ عدد قليل من الركاب اللبنانيين مع زوجاتهم الروسيات … وربما راكبين أو ثلاثة ينتمون لجنسيات أوروبية وإفريقية}. وقد صاحب اللكمة {الخائن ابن الخونة}. حيث يتبين أن الشاب ضمن مجموعة من الفلسطينيين تعودت الذهاب إلى “موسكو” للتدريب هناك لمدة ثلاثة أشهر كل عام، ومنهم من يعود، ومنهم من يظل هناك فليس له من يعود إليه فى لبنان. ولم يكن إختيار الكاتب لموسكو تحديدا، إعتباطيا، وإنما قصده، حيث يقول أن الفلسطينى كان كالمستعين بالرمضاء بالنار. فلم تكن موسكو تختلف كثيرا عن تلك الرؤية الأحادية التى نشأ عليها العربى. فيصيح أحد الشباب بأن معه مصرى، فيقول آخر {خريا عليك وعلى المصرى} واقترب آخر ليسأل عن هذا المصرى، فيبتسم له السارد، فيناوله الشاب لكمة فى وجهه، ويبدا وصلة سباب لم يتبين منها – السارد-غير “يا خائن يا ابن الخونة.. انتم الذين تصالحتم مع إسرائيل يا ….}. فيحاول آحد الشباب أن يعتذر، ويمتدح موسكو و{يؤكد أن روسيا هى الأكبر والأعظم وأن لا جغرافيا ولا تاريخ إلا جغرافية وتاريخ روسيا… واكد لى أن الاتحاد السوفيتى لم يسقط أو يتفكك كما يشيعون، وإنما هى لعبة حاذقة لتضليل الصهيونية والرأسمالية العالمية من أجل مفاجأتهما والانقضاض عليهما فى الوقت المناسب} ثم يشير الشاب إلى أن روسيا هى الدولة الوحيدة التى تقف ضد إسرائيل، وأن بريطانيا وأمريكا هما اللتان أسستا إسرائل ومنحتاها الشرعية. وابتلع السارد لسانه حتى لا يتعرض لما لا تحسب عقباه مع مثل هذا الشباب المُضلل، ولم يقل له {إن روسيا تحديدا هى التى أقامت دولة إسرائيل بشكل قانونى واعترفت بها قبل أى دولة أخرى من دول العالم}. وقبل أن تصل الطائرة وتستعد للهبوط وجد السارد المضيفة التى تقف أمامه مباشرة تبتسم، ولم يعرف لماذا تبتسم، حيث كان {رأس جارى الثلاثينى مائلا على كتفى بشكل لافت، ويده تقريبا على عضوى الذكرى. لحظتها فقط أدركت لماذا كانت المضيفة تبتسم}.
وتقترب قصة “اربات مع قليل كم الفوكا والكائنات الروسية” كثيرا من تلك الرية التي تقوم على دراسة مرحلة مؤثرة من الحياة المصرية، فترة الستينيات التي، انتهجت فيها مصر من التجربة (السوفيتية). والتى على الرغم مما تثيره كتابات أشرف الصباغ من تساؤلات حول النوع الأدبى، وما توحى به من (حكى) وكأنه الحديث الشفوى، الذى يبدو خاليا من العناصر الإبداعية، وبالرغم من السخرية (المبطنة) التى تؤكد أن الكاتب يلعب مع الكتابة، إلا انها تحمل من الشعرية السردية الكثير، حيث صنع الفجوات، وترك الفراغات، التى يدعو قارئه لملئها. كما تؤكد كتباته الثقافة الواسعة التى تجعله يتأمل، الواقع المصرى- بصفته البيئة المنشأ، والثقافة الروسية –باعتبارها البيئة الحاضنة- . فعندما أراد الحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية، بإعتبارها، حرب عبثية، ينفيها التاريخ المشترك، وتتمناها الدول الأوربية، لمساهمتها فى تفتيت القوة المناوئة لها. أقام المقابلة بين اثنين من أوائل المبدعين الروس، وأشهرهما فى العالم أجمع، دوستوفيسكى، وجوجول، لم يذكر منشأهما، أى محل ميلادهما، فى الوقت الذى يؤكد قصدية اختيارهما، حيث ولد دوسستوفيسكى فى موسكو (العاصمة السوفيتية، والروسية فيما بعد) فى العام 1821. ولم يذكر أن جوجول ولد فى (أكرانيا) فى العام 1809. أى أن الفارق فى الميلاد ليس كبيرا، وهو الأمر الذى جعل التشابه بينهما منطقيا، فكتب فى قصته “شارع أربات مع قليل من الفودكا والكائنات الروسية” {وهنا نصل إلى مربط الفرس، حيث جوجول ودوستو فيسكى، طرفى المقص الإبداعى، وطرفى النقيض، اللذين فضحا النظام ليس فقط النظام القيصرى، بل المجتمع الروسى نفسه، وكان كشفهما الروح الروسية وتوغلهما فيها، هما المنهج والأداة اللذين يمكن التعامل بهما أيضا مع الكائن السوفيتى والكائن الروسى ما بعد السوفيتى}، بل يصل إلى أن جوهر الإبداع عندهما يؤكد وحدة الثقافة، ورابط الدولتين {لكن جول الميت أفضل كثيرا من جوجول الحى، واكثر عقلانية وانصياعا وخضوعا. ومع ذلك فقد طالته الحرب أيضا من أجل التأكيد ليس فقط على فكرة وحدة الثقافتين الروسية والأوكرانية، بل وعلى وحدة الأدبين الروسى والأوكرانى، واعتبارهما صوتا واحدا ووحدة واحدة}. ثم تأتى السخرية التى تكشف أنه رغم هذه الوحدة، والتى لا تعنى بالضرورة أن الاتحاد السوفيتى هى الجنة الموعودة، وإنما هى دولة تمارس الخديعة على شعبها {أولئك الروس الذيم يأتون من أقاصى روسيا ومناطقها النائية الغارقة فى الثلج والنسيان، ليروا ولو لمرة واحدة عاصمة بلادهم التى تُصدعهم حكومتهم بها عبر البرامج التليفزيونية الموجهة، بانها أعظم مدينة فى العالم، بالضبط مثل روسيا العظيمة أيضا التى تمتلك أحدث وأعظم وأسرع أسلحة فى التاريخ وتستطيع أن تهزم أمريكا عشرين مرة خلال عشر دقائق}. وهو ما يعود بالذاكرة إلى ذات الفترة الستينية التي تعالت الأصوات المصرية بأن مصر سترمى إسرائيل ومن وراء إسرائيل في البحر، وقبيل حرب 67 كانت النغمة أنها نزهة وساعات قليلة لدخول الجيش العربى إلى تل أبيب.- فلم تكن الخدعة في الحالتين- على شعبها فقط، وإنما على الدول العربية، التى لديها الاستعداد لتبنى تلك السياسة التى تستطيع بها تنويم الشعب، خاصة مصر التى عاشت فترة –ليست بالقليلة- تتبنى هذا الفكر، وهى فترة ستينيات القرن العشرين، حيت استخدم الشعر، والأغانى، لتنويم الشعب بأن تلك السياسة هى من اصل الإسلام، الذى لا يملك له المصرى تعقيبا (الاشتراكيون أنت أمامهم)، فتقول القصة {ثم يأخذ زعماؤهم كل تلك الحكايات ليعيدوا سردها على مسامع زملائهم العرب، بعد أن يجرعوا براميل الفودكا معا، فيطرب كل منهم ويحتفى بالآخر ويرصع وجهه وشفتيه بالقبلات ويرقص معه حتى مطلع الفجر}. {السكيرون الروس خفيفو الظل مثل الحشاشين المصريين}.
وقد استغل –الكاتب- اسم الشارع “أربات” للربط بين الاتحاد السوفيتى، أو روسيا، وبين مصر التى وجدت فى سياسة السوفييت، ما يحقق رغباتها{يقولون إن شارع “أربات” يعنى شارع “عَرَبَات” وهو تسمية عربية تعنى “عَربَات” أى جمع “عَرَبة”} على الرغم من أن الشارع لم تسر به من قبل أى عربة. فيربط الكاتب بسخريته بين البلدين، وكأنهما فى جلسة “سلطنة{لأن الطبيب دائم الحضور فى مثل تلك الجلسات الإنسانية الأسمى، والمهندس موجود مثل الفيلسوف والكاتب والمطرب والعازف، ورجل الفضاء الذين يسبح فى ملكوت الفودكا فى روسيا من أقصاها إلى اقصاها، او يحلق فى فضاء الكون فى مصر من قلعة الكبش إلى الدرب الأحمر والباطنية}. فى حين أن الرابط الحقيقى بينهما، يكمن فى الفقر الذى يؤدى إلى إختيار الرؤساء { ولكى تتفادى الاقتراب من أوجه الشبه التى تجمع بينهما. فمن الممكن أن تكتشف فى لحظة واحدة أن كل هؤلاء ينتمون لجيوش الفقراء الذين يبذلون كل جهودهم فى اختيار الرؤساء والمديرين والوزراء الفاسدين، أو لكتل لزجة من الهوام والوحوش التى تنهش بعضها البعض}. وهكذا استغلت روسيا التاريخ الممتد من آلاف السنين، وزرع فى جذور معتقداتهم هذا الجهل {هذا هو شارع “أربات” الذى يقول عنه الروس، عندما يجلسون مع أصدقائهم العرب أبناء أبى سفيان وأحفاد أبى جهل وأبى لهب، أولئك الذين يعبدون هبل واللات والعزى والرؤساء والأموال والشيوخ، إنه من كلمة “عربات” العربية}. فالوهم والخدعة، هى الحقيقة التى تكشف عنها القصة، والتى تجمع الكذب فى كلا البلدين. استعان الكاتب فيها بواحدة من الروايات الجامعة بين الحب والحرب، وهو “دكتور زيفاجو” وكأنه يقول من داخلها نأتى بالدليل، للاجدوى الحرب، وما تكبده من دمار. داعيا قارئه لأن يبحث ويُعمل ذاكرته وبحثه للربط بين الجزيئات التى تحتويها القصة، ليصل إلى ما أراده منها.
وعندما تقوم ثورة الخامس والعشرين من يناير فى القاهرة، والتى عرفت بأنها ثورة الشباب، يستحضر الكاتب ابنه، الشاب في قصة “جرافيتى”-والذى هو فن احتجاجى متمرد، ويمارس في الشارع، وهى الصورة الواضحة من ثورة 25 يناير-. فيقدم صورة عن تغير صورة الشباب، التى كانت مرسومة فى أذهان الكثيرين، حتى راحت السلطات تنعتهم بالكثير من السوءات، غير أن الصورة الحقيقية، والتى اقتنع بها الغالبية من عموم الشعب. وقد كانت أحد أهم الوسائل التى استخدمها أولئك الشباب، “الجرافيتى” بالرسم عل الحوائط ورأى السارد رسوم جرافيتى، فسأل ابنه عن فك طلاسمها، فأخبره بما يفيد أن هذه الرسوم، تتم أساسا لمهاجمة الحكومة، ولكن الحكومات تقوم بإزالتها، لا بحجة رفض المقاومة، أو الاعتراض، ولكن{ بتهمة تلويث الجدران ومحطات المترو والباصات}. ويتحدث السارد عن ابنه-الجيل الجديد-{فهو يدرس القانون ويخطط للاستمرار بدراسته بعد التخرج ايضا، ولكنه فى هذه اللحظة لا يظهر فقط معرفة عميقة بالفن، وبالذات “الجرافيتى” وإنما يسعى أيضا إلى ربط كل ذلك بمجريات الحياة السياسية والاجتماعية. وكأن الكاتب يعمق المسألة، او يبحث عن الجذور لها، ويسوق الأسباب التى تقود الشعوب للثورة، فيطوف فى العالم الخارجى من الأسبانى للفرنسى للسوفييتى، ليعرض بعضا من تلك الممارسات الديكتاتورية {فى الصباح أخبرنى صديقى الكاتب والمترجم الذى يعيش فى أسبانيا أن الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو الذى مات فى عام 1975، بعد حكم ديكتانورى طال أربعين عاما قتل وشرد وهجَّر خلالها ملايين الأسبان، وورث أولاده قصورا وبنايات وعقارات استولى عليها بدون وجه حق. وأنه كان مغرما ببناء الجسور والكبارى والمدن الأسمنتية، فعطل أسبانيا ما يقرب من خمسين سنة وجعلها قطعة من التخلف والانهيار والهمجية}.
ولا زالت ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلقى بظلالها في قصة “زرائب الحظ”، فتحدث الفُرقة، بين الأفكار والمذاهب والملل، ولم تكن تلك هي حال مصر وحدها، وإنما ما تم في مصر، تم قبلها في تونس، وبعدها في سوريا واليمن وليبيا. فيتجمع في موسكو، وكأنها الكعبة التي يحج إليها العرب، ف {جمعت موسكو بين فرحان السورى أبا عن جد وعابد اللبناني وكاظم العراقى وإيفان الروسى ومحمد المصرى وفرشود الطاجيكى في وقت واحد. وربما تكون قد جمعت بين أمثالهم عبر أجيال متفرقة}. ولم يكن هناك ما يجمعهم سوى المكان، حيث بدأ الحديث عن تطورات الأوضاع في مصر، وماذا يجرى بعد انهيار حكم الإخوان}. وبينما كؤوس الشراب تتداول بين الجميع، كانت كؤوس الأفكار أيضا تدور، خاصة بين العرب، بينما غيرهم ينظر ويراقب وينتظر {انقلب الجلسة إلى حرب بين الجميع تقريبا، حيث بدأ أصحاب الأفكار القومية السورية في جانب، وأصحاب الأفكار الناصرية في جانب آخر، وأصحاب الأفكار الشيوعية السوفيتية في جانب ثالث…. إلا أن الجلسة انتهت بمشادات كلامية أنهاها محمود عزمى بخطبة طويلة تدور حول أن العرب سيستعيدون يوما كل أراضيهم وأملاكهم من الغرب بمساعدة روسيا. فشخر له محمد وعابد، وضحك فرشود الذى كان يجلس صامتا يراقب الحديث من بعيد}. ورغم أن هذا هو الوضع على الطبيعة، غلا أن الصورة الرسمية كانت غير ذلك {ولكن اشتراكية الفقر المحكومة بقبضة المخابرات، كانت مستعدة لتجميل أي شيء وكل شيء وخداع نفسها ورعاياها، وخداع الآخرين، بينما الآلة الدعائية تعمم النماذج الفردية، وتصنع صورا ذهنية من اللاشئ تلصقها بنظامها وتصف به نفسها}.
ويستمر الكاتب فى الحديث عن الديكتاتورية، ورفض السلطات لحرية الرأى فيتحدث عن المخابرات، والنظام البوليسى. فحين التحدث عن مضادات للكورونا {ولكن أيضا فى صالح الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التى ترزح على صدور الشعوب مثل الوباء أو الجائحة، ولا أمصال أو لقاحات حتى الآن يمكنها أن تقاوم توحشها وجبروتها وبلطجيتها}. الأمر الذى تعرض فيه القصة لأحد جوانب الحدث الكبير، فى الخامس والعشرين من يناير 2011.
ثم يخرج الكاتب من التخصيص إلى التعميم في قصة “انتظار” التي تستدعى-أيضا-المثل القائل بأن (وقوع البلاء ولا انتظاره). حيث تعرض حالات الحرب المجانية، والتي يدفع فاتورتها الصغار، دون أن يعلموا لماذا ولا كيف. لمجرد شعار يرفعه الكبار، ولا يعييه الصغار، غير أنهم مسوقون (كالأنعام). فيصرح السارد في وصفه لأحد هؤلاء الجنود: {بعد عام قضاه هنا في الحرب التي لا يعرف حتى الآن لمذا نشبت، ولماذا تدور، ومتى ستنتهي، وكيف ستنتهي. ولا يعرف أيضا بالضبط كان يحارب من. فقد أرسلوه إلى هنا ليحارب الأعداء الذين يشكلون خطرا على الدولة ويهددون أمن الوطن}. وفى القطار الذى يحمله إلى موسكو، نتعرف بأن أباه فضل أن يعمل بالجيش لرعاية ابنه، والأم ذاتها أقسمت أن تدخل الجيش إذا لم يخرج ابنها الوحيد، وبينما هو فى القطار، تنطلق قنبلة، مجهول المصدر، مجهولة الهوية، لتطيح بالجميع أشلاء متناثرة، ولتبقى الأم هناك في البعيد تنتظر عودتهما.
لا شك أن المقارنة، او المواجهة، هى أحد العناصر الأساسية فى بناء العمل الأدبى، خاصة عندما يسافر المبدع، او يعيش خارج بلاده، وإن ظلت بلاده مسكوتا عنها فى قصة “يوم ممطر” وتركها للقارئ الذى لابد يستحضر تلك المواجهة، بين هنا وهناك، من حيث كيفية المعيشة المنبثقة من الثقافة المجتمعية، المتحكمة فى رؤيته للحياة، لتصبح أحد أساليب التنوير التى يسعى إليها المثقف، وتأخذه إلى حيث يعبش العالم.
وقد يتساءل القارئ-بعد القراءة-عن سبب تسمية القصة باسم “يوم ممطر” على الرغم من أن الأمطار لم تكن كثيفة، ولم تؤثر على الأحداث التى حضرت فيها الحرائق أكثر من المطر؟ وأتصور أن الكاتب لم يقصد المعنى المباشر للعنوان، بقدر ما أوحى للقارئ بأن يستحضر الأجواء المصاحبة لذلك العنوان، خاصة للقارئ الشرقى الذى يعى جيدا أن اليوم الممطر لا يأتى إلا فى الشتاء، المعروف فيه التقلب وعدم الاستقرار، وهو ما يوحيه الجدال الذى بين الراوى وذلك الذى قابله فجأة وفى النهاية أخبره أن اسمه “لونيا” حيث يشير الراوى-وكأنها جملة اعتراضية- {بدا كما لو أن الحديث يتجه اتجاها معاكسا للطقس، ويأخذ مسارا غير محمود العواقب}. حيث كان {هذا طقس معتدل يثير الحسد، لا يفسده إلا أخبار الحرب}. فالكاتب هنا يصنع المواجهة، حيث يفرض الإحساس والتداعيات التى يولدها الموقف، وليس الموقف ذاته. وهو ما سار عليه بالقصة، حيث نجد الحرائق التى تسود المجتمعات، بما فيها الأوروبى، والعربى، على حد سواء، وكأن العالم كله قد نشبت فيه الحرائق، والتى وصلت إلى الفرد ذاته. فبدأت القصة ب{ طالعتنا نشرات الأخبار في الأسبوع الأخير بأخبار سيئة عن ارتفاع درجات الحرارة في العالم كله. تركيا تعاني من ارتفاع درجات الحرارة بشكل يقلص أعداد السياح، بينما اليونان وصفت ما يحدث عندها بالحرب الطاحنة، حيث نشبت في عدة جزر منها حرائق واسعة النطاق، وأرسلت مصر طائرات مروحية لإطفاء الحرائق، بينما راحت روسيا كالعادة توجه الحدث في اتجاهات سياسية، وتعلن أنها على استعداد لإرسال قوات الطوارئ والمروحيات الروسية الضخمة المخصصة لإطفاء الحرائق في حال إذا قدمت أثينا طلبا رسميا بذلك. وكانت الجزائر أيضا تتابع العالم بما يجري فيها من حرائق في عدة ولايات، وتتحدث وسائل إعلامها بالإنجازات الجبارة في إخماد الحرائق، وفي الوقت نفسه تبث بيانات غريبة عن استمرارها، وعن الخسائر المروعة.}. ولتنتهى كل تلك الحرائق العامة إلى الحريق الخاص-فى بيت “لونيا” الذي {راح يحكي عن الحريق الذي شب في شقته قبل عدة أشهر، وأن المطبخ مليء بالأثاث والصناديق وأثار الحريق تظهر على الجدران من الخارج وتصل حتى الطابق الرابع أو الخامس} ويمكن هنا فهم الطابق الرابع والخامس بوضعهما الرمزى أيضا.. حيث يمثلان عمق الآثار النفسية التى انتابت (الفرد) جراء تلك النيران المشتعلة فى كل مكان بالعالم. تُحرق كل أوراق السيد “لونيا” الشخصية، وكأن الحريق الخارجى، لم يكن خارجى بقدر ما هو حريق داخل الإنسان ذاته {فسألـه: “ماذا حدث بعد ذلك؟ هل تضررت الشقة بالكامل، وهل احترقت أوراقك وأوراق الشقة؟ “.. قال إن أوراقه الشخصية كانت معه. لكن أوراق الشقة وكل ذكرياته غارقة في مياه الإطفاء، وصوره وصور زوجته تسبح على سطحها. ضاع كل شيء} فالمكان هنا لازال موجودا لكن الإنسان ضاعت هويته. وهكذا انعكست التقلبات (المناخية) التى أحدثتها الحرائق، كانت هى التى أضاعت هوية الإنسان فى العالم أجمع. إلا ان العالم العربى، والشرق أوسطى عامة، كانت تعانى من الجمود والتوقف بالزمن، لتضيع هوية الإنسان فيها-أيضا- { كانت الدول العربية وإيران وتركيا غارقة في قضية حرق القرآن في السويد والدانمارك، وأزمات القمح والمياه، والتركيز على المظالم التي تطولها من الغرب بإهانة مقدساتها، وتقسم بأن الحرب الروسية الأوكرانية هي السبب في نكباتها ومشاكلها الغذائية. وتطالب حكوماتها بمقاطعة البضائع السويدية والدانماركية وطرد السفراء وقطع العلاقات إلى أن تسلم الدولتان مواطنيهم الذين قاموا بهذه الجرائم البشعة. كل ذلك والحرب الروسية الأوكرانية في منتصف عامها الثاني، ولا غالب ولا مغلوب، والأمور تتطور إلى سيناريوهات مخيفة}.
وليست تلك الاهتمامات المختلفة هى فقط التى توضح الفرق بين هنا وهناك، وإنما يأتى ايضا تلك الزيارة لعمل الأشعة والفحص الطبى، حيث نرى هناك، الموعد بالدقيقة، بينما هنا لا ننظر إلى الدقائق ولا حتى الساعات. فقيمة الزمن والإحساس به تختلف هنا عن هناك {وفي الواقع كان لدىَّ موعدان. الأول في الساعة الثانية وعشرين دقيقة بعد الظهر لإجراء أشعة على الصدر. والثاني في الثانية وأربعين دقيقة لإجراء أشعة على الضلوع من الجانب ومن الخلف}.
وعندما أراد –السارد-أن يغير فى ذلك النظام-الدقيق-باعتباره (شرقيا) فيطلب لآخر أن يحل محله، فتكون الإجابة الصارمة {“لا تتدخل فيما لا يعنيك. هذا ليس شأنك}. وملحوظة أخرى-بدت لو أنها أيضا جملة اعتراضية إلا أنها تعنى إسلوب حياة، وإسلوب تربية، ووعى بدور كل فرد فى المجتمع {وكنا بالفعل قد اقتربنا من ساحة لعب الأطفال الخالية تماما منهم في هذا الوقت من المساء}. حيث تنعكس أيضا قيمة الوقت والالتزام بالمواعيد الصارمة.
فضلا عما يستحضره الحوار من استدعاء ومواجهة، ذلك الحديث الذى دار بين السارد والرجل الآخر “لونيا” حول الدين وتأثيره الجذرى هنا، وغيابه هناك وتأثيره على تصرفات الفرد، وعلاقته مع الآخر، بقبوله الزواج من تلك الأرمنية رغم أنه لم يكن يعرف أنها يهودية، ورغم ذلك كان الحب هو الجامع بينهما، ليعيشا زوجين فترة طويلة.
وبعد أن كان الكاتب يقدم قصته، جرعة واحدة، يلجأ في تجربة جديدة، إلى تقديم قصته في مقاطع سردية، وإن كانت تبدو منفصلة، إلا أن رابطا يربطها جميعا. ففي قصة “توابيت الدهشة” تنقسم القصة إلى ثلاث مقاطع سردية، حوى المقطع الأول ما يمكن تسميته بالتمهيد، والمقطع الثانى ما يمكن تسميه بالطواف، والمقطع الثالث بالنتيجة، او ما كان يسمى فى النقد التقليدى ببؤرة التنوير، حيث تصنع القصة -بكاملها- المفارقة، أو المقابلة بين الحرية –المطلقة- والتى يمثلها صاحبتى فرقة الغناء “توتا” والتى تتمثل فى رحلة لأمريكا للفتاتين، واثناء غزو أمريكا للعراق، أعلنتا {رفضهما ليس فقط للعمليات العسكرية فى العراق، بل وللحرب بشكل عام، وظهرتا فى أحد البرامج التليفزيونية الأمريكية الشهيرة بزى حمل عبارة “لا للحرب”}، من جانب، ومن جانب آخر السطة المطلقة والأبدية التى يتمتع بها الجالس على الكرسى، صانعا من تلك الفرقة السخرية التى تعود –مبطنة- إلى الطرف الثانى، والتى تتبدى فى وصفها، ووقعها الساخر بالمرارة {ولم تتوقف شعبية الفتاتين على الغرب فقط، بل شقت طريقها إلى القلوب فى الشرق الأوسط حيث سجلت مبيعاتهما من التسجيلات فى دول الخليج أرقاما قياسية بأغانيهما التى اعتبرها النقاد الجدد أصحاب العالم الجديد والفن الجديد والأعضاء السيلكون وأعضاء البرلمانات، بل وأعضاء مجلس الأمن الدولى عموما، والأعضاء الخمسة الدائمين على وجه الخصوص}. خاصة إذا ما عرفنا أن الطرف الثانى، يصنع الوهم الذى يعيش فيه الطرف الأول {مثل الصواريخ الروسية فرط الصوتية التى يتباهى بها الكرملين). وكذلك إنصراف علماء النفس إلى ما يُفهم أنه ايضا البحث عن الحرية التى يتمتع بها الكلاب، ولايتمتع بها الإنسان الروسى، فامام عدم الاندهاش، الذى وقع فيه علماء النفس الروس {أنهم أصبحوا يلقون بأسئلة غريبة من قبيل: لماذا يمارس الإنسان حتى وقتنا هذا حياته الخاصة فى غرف مغلقة؟ ولماذا تمارس الكلاب، مثلا، كل شئ فى أى مكان؟ هل للمجتمع علاقة بكل ما يحدث، أم السلطة السياسية التى هى الوطن والحب والنضال والأخوة والسلام هى المسئوولة؟ ما هى الأسباب الحقيقية وراء هذه الظواهر التى تتزامن عادة مع الانقلابات الكبرى فى حياة المجتمعات؟}. ومن الأمور الملفتة، أن الإشارة إلى الدول العربية كانت من الجانب السياسى، باعتباره أحد مسببات تخلفهم، فى حين أن الحديث عن زيارة بوش الإبن لأمريكا، ركزت السيدة كونادليزا رايس بتلقينه أن أهم شئ يمكن التحدث معهم فيه هو “دوستوفيسكى، وروايته الشهيرة، الحرب والسلام. وفى الحديث عن اليابان، كان الحديث أيضا ثقافى، حيث {كتبت الصحف الروسية أن اليابان قبل “تاتو” كانوا يعرفون جيدا أن أعلى قيمة فى روسيا هى قيمة الكاتب العظيم “فيدور دوستوفيسكى” الأوسع انتشارا فى اليابان. ولكن بعد ظهور “تاتو” اكتشف اليابانيون أن هناك فى روسيا قيمة أخرى عظيمة، وأصبحت فرقة “تاتو” تنافس دوستوفيسكى على حب المجتمع اليابانى}.
التقنية القصصية
إذا كان في الماضى قد لُقب مسرح توفيق الحكيم بأنه مسرح فكرى، فإننا نستطيع هنا أيضا أن نسمى قصص أشرف الصباغ بأنها قصص فكرية، حيث نجد فيها العقل والمنطق، يغلب على العاطفة، والأحاسيس. فنجد أن القصص كلها –تقريبا- تخلو من وجود التأثير العاطفى، عل الشخوص، وإنما هي المشاهدة، والواقع، التي يستغلهعا الكاتب في صناعة قصصه. فقد جمع الكاتب التجارب الحياتية فى كل من الشارع السوفيتى والعربى، والرؤية المحددة للحياة السياسية، والقراءات الواصلة إلى عمق القراءة، وأضاف إليها السخرية الخارجة من الشارع. ووضع الجميع فى خلاط الموهبة الإبداعية. ليخرج إبداعا نابضا بالحياة، مُشعا بالثقافة، مزخرفا بحلاوة لسان ابن البلد، مصطحبا “لارا” ابنة باسترناك الروسى، ليسير على طريق الحرب، وصولا للسلام والحب.
فعلى نهج يوسف إدريس، الجامع لشتات المواقف، ليصبها فى بؤرة ضيقة.. يسير أشرف الصباغ، فى شوارع السياسة، المليء بالرؤى. فيتنقل بين روسيا، والدول العربية، فيجد من التشابه بينهما، ما يجعلها، جميعا، تسكن ذات الشارع. وقد استمت القصص ببعض الصفات التي لا تُخطئها عين القارئ، مثل السخرية اللفظية، والتي نجدها مجسدة في قصة ” شارع “أربات” مع قليل من الفودكا والكائنات الروسية” فعندما لم يستطع السارد شرب مائتى مليجرام من الفودكا دفعة واحدة{وراح كل منهما يعلمنى كيف أفعل ذلك كرجل روسى ينجز مهمة إنسانية ستدفع بالبشرية إلى درب التبانة} فالسخرية هنا مستمدة من موقف الشراب، {وراح كل منهما يتحدث معى بروسية سليمة لا يأتيها الباطل من أمامها ولا من خلفها}، فتلمس هنا أن السارد، يسخر من أولئك الذين يتشدقون باللغة وكأنهم يتمسكون، لا بالمكان، ولكن بالفكر الذى ينتمون إليه. و{فى عهد العارف بالله يوسف ستالين الذى يعشقه الكثيرون من الشيوعيين والزعماء العرب، ولكنهم اصطلحوا على أن يشتموه ويلعنوا دين أبيه علنا}.
كما نستطيع كذلك ان نجد السخرية المعنوية في قصة “توابيت الدهشة” التى يغلف بها الكاتب اعتراضاته، عندما انتوى الثنائى يوليا ولينا صاحبتى فرقة “تاتو” الترشح للرئاسة، في الوقت الذى لا يسمح للمترشح بأقل من خمسة وثلاثين عاما، فقالتا: لا مشكلة .. سنترشح معا، وبجمع سنيهما سيزيد العمر عن السن المطلوبة بكثير. ثم نجد السخرية اللفظية أيضا فى {تأسست فرقة “تانو” فى عام ألفين على يد إخصائى فى علم النفس ومسئوول إعلان سابق يدعى إيفا شابوفالوف الذى شغل أيضا منصب منتج الفرقة. كان شخصية ذكية وإبداعية، وكان يفهم فى كل شئ، بما فى ذلك القانون والهندسة والأزياء والمخدرات والكوميديا والتدليس والتعريص والسياسة والأمن واليزنس والنساء والسحاق و”تاتو”}
وفى قصة “فرشود” حيث حدثت هزة عنيفة، وتصورا أنها زلزال و{اختلف محمد المصرى وفرشود على اسم مقياس الزلازل. فبينما تمسك فرشود باسم “مقياس كارتر”، أكد محمد أن اسمه “مقياس شرشر” وهنا قال فرحان في حكمة وهدوء : لا يهم كارتر أم شرشر أم بنجر..}
ولا يملك الكاتب ان يتخلى عن السخرية في قصة “جرافيتى” التى بها يستطيع أن يقول ما يشاء، وكأنه يلعب بالاستعارة للإشارة إلى موطن المشكلة التى يتناولها. فبعد موت الديكتاتور، سحبت السلطات الجديدة القصور والعقارات من الأبناء (ومنحتهم شقق إسكان متوسط فى كرموز بالاسكندرية}. حيث نجد أنفسنا في الإسكندرية بيعما كنا نتصور أننا في روسيا.
كذلك تقوم قصة “الذى فعله بائع الحمص مع المدعو دوستويفسكى” على السخرية المريرة، حيث اشتغل فرحان السورى أبا عن جد، ببيع الأشياء العادية من المأكولات التى يتم توزيعها فى أماكن العمل، ولتحسين دخله، التحق للعمل كمحرر للشئون الاقتصادية، ثم بزغت فى ذهنه أن يؤلف، أعملا إبداعية، رغم أنه يكره القراءة من صغره. ومعتمدا على شراء القاعة، اقام حفلا كبيرا لمجموعته القصصية الأولى، فتصور أنه أصبح ديستوفيسكى، وقرر أن يكتب رواية، ويعرضها عل السارد الذى وجد فيها {وجدت أنه قد كتب أشياء لذيذة ومبهجة، وحكايات خفيفة الظل عن أصحابه وأقاربه فى قريتهم النائية}. حيث قام هو بالطباعة والبيع، فباع منها سبع نسخ، وبعدها تبين أنه بذلك قد ساهم فى التوفير للمؤسس، إذ استغنى العاملين بها عن ورق التواليت.
العنوان
وتأتى نهاية قصة ” شارع “أربات” مع قليل من الفودكا والكائنات الروسية”، ليستحضر –الكاتب- روح “دكتور زيفاجو” تلك الرواية الروسية الشائعة لبوريس باسترناك، والتى تعكس تبدل شخصية الإنسان، قبل وبعد السلطة، خاصة أن الرواية (المنشورة 1957) تتناول الفترة من 1903 وتمتد حتى 1929 لتشمل الحرب العالمية الأولى {1914 – 1918) و فترة الثورة البلشفية 1917، والتى فيها تم تغيير الحياة السياسية فى روسيا. حيث تتناول الرواية الكثير من ويلات الحرب، وتُعلى من شأن السلام والحب الذى حمله دكتور زيفاجو للحبيبة “لارا” التى سعى وراءها وهى لا تعلم أنه حبيبها، فيسقط ميتا، لكن الحب .. لايموت. فاستطاعت القصة بالسخرية والجمع بين المتشابهات فى الاتحاد السوفيتى وروسيا من بعده، ومصر. وكأنها تجمع كل الدول التى تصورت أنها بالثورة وبالحروب ستبنى الدول، فى حين أن السلام والحب هو الباقى والممتد. فوضع الكاتب كل قصته بامتداداتها وتنقلاتها فى بؤرة واحدة، تُشع رؤى بعيدة، مخبأة وراء السطور، وحافظ بها على روح القصة القصيرة – رغم الإلتباس فى الفهم.
الزمن
وفى قصة “يوم ممطر” وعلى الرغم من أن القصة-القصيرة- قد تبدو متباعدة، زمانيا ومكانيا- إلا انها تحتفظ بمفهوم القصة القصيرة، إذا ما وعينا أن السرد يتحدث هنا عن زمن ماض، اى أن الراوى يتحدث عن فترة كانت، بدليل أنه عندما تكررت زياراته للبحث عن ذلك الغريب، ولم يجده فى مرات عديدة حتى أتت لحظة النهاية، والتى تضع كل ماسبقها فى الزمن الماضى { توجهتُ مباشرة نحو مدخل البيت، ضغطتُ جرس باب شقته. خرجت امرأة شابة تحمل رضيعا. سألتها عن “لونيا”. فنظرت إلىَّ في دهشة، وقالت: “لا أحد يعيش هنا بهذا الاسم”}. لتضع تلك النهاية بلا توقف حيث لابد أن القارئ يبحث عن سبب وإحتمال سبب عدم الوجود، وما إذا كان قد مات، أو أنه لم يكن له وجود فى الأصل، وما هى إلا تهيؤات فى داخل السارد، وليعود، القارئ ويتأمل كل ما فات، ويتأمل تلك الحياة هناك، وكيف هى هنا، وليعلم أن القصة تربطها وحدة واحدة، تربطها من البداية إلى النهاية، وهى الفرق بين الشرق والغرب.. ولماذا هم هكذا، ونحن فى مكاننا. حتى إذا ما أردنا تصنيف القصة، فنقول أنها قصة تنويرية.
إلا ان الأمر تجاوز حدود القصة القصيرة، في “زرائب الحظ” والتي كتبها في أربعة وحدات سردية، وإن كان الكاتب قد تجاوز السرد الظاهرى، إلى عملية استبطان الإبداع الأدبى، وتحويله إلى حياة البشر على الأرض، أو بين العمارة التي يسكنها الإنسان السوفيتى، وبين هندسة الرواية السوفيتية، والتي تعبر عن حياة السوفيتى {هناك حوار تاريخى وسياسى بين المعمار والأدب، يعكس أبرز نماذج هندسة العقل}.
المعلوماتية
وإذا كانت (المعلوماتية) قد أصبحت عنصرا أساسيا فى الرواية، إلا أن الكاتب قد استحضرها كثيرا فى قصصه القصيرة، فنرى التواريخ الحقيقية التى تسجل وتؤرخ لبعض المواقف، مثل في قصة (فرشود) {هذه لعبة العلاقات الجدلية التي يمكن أن نلمحها عند هيجل وكارل ماركس وفيورباخ في موضوعات فلسفية واجتماعية وتاريخية عميقة. وكثيرا ما تناولها نيتشة بشكل مجازى عابر في بعض مؤلفاته ومحاضراته العابرة. لكنها تشكل أحد المراكز الراسخة في فلسفة كل من هيجل وماركس مع الأخذ بعين الاعتبار اتجاهات وآفاق فكرة الجدل لدى كل منهما. وقد جرى العرف على أن الجدل عند هيجل هو جدل مثالى، وفق آراء الماركسيين الذين يؤكدون أنه مادى علمى لدى ماركس…. وعموما، لا توجد في العلم ثوابت وآراء قاطعة ونتائج نهائية}.
فهناك العلاقة بين فلوبير الفرنسي الذى قلب بروايته “مدام بوفارى” المجتمع الفرنسى، وتولستوى وروايته “أنا كارنينا”، خاصة أن بين كتابتهما واحد وعشرين سنة فقط، أى تشابه الظروف الزمنية، ولكن إختلافا كبيرا بينهما في التأثير على المجتمع. مثل قوله {من الصعب اكتفاء بالجانب المعمارى وإسهاماته في بناء العقل والروح الإنسانية أو العكس. كما ان العلاقة بين دوسوفيسكى وتولستوى من دون ترسيم وتحديد يجعل المعادلة غير متزنة}. فتحول الأمر إلى بحث، مدعوم بالتواريخ. فضلا عن تناولها الحياة السياسية منذ “ستالين” إلى”نكيتا خرشوف”، أي منذ قيام الثورة البلشفية فى أكتوبر 1917، إلى قيام البريستوريكا عام 1990. أو فترة التحول من الإتحاد السوفيتى إلى الدولة الروسية. الأمر الذى يحصر الموضوع في نطاق البحث الذى يمكن عنونته ب”الأدب والمجتمع”. فالتناول هنا عقلى بحت، ولا يتصل بالعاطفة التي هي أحد العناصر الهامة في الإبداع الأدبى.
المباشرة
نظرا لطول القصصى –النسبى- يخشى الكاتب أن تتوه رؤيته، فيلجأ إلى المباشرة، التى يعتمد عليها الإسلوب الأدبى، ففى قصة “جرافيتى” نقرأ عن “”لوسيان” الذى رفض ارتداء بنطلون أحدى الموتى، الملطخ بالدماء، وأدى رفضه إلى إعتبار ذلك عصيان، وعدم إطاعة الأوامر العسكرية، فتد إعدامه، فيتدخل الكاتب، وكأنه يقول، وماذا يفيد التكريم بعد موت الشخص، فيكتب {وفى عام 2014 فقط سُجل اسمه فى قائمة “نصب الشهداء” فى منطقته. لكن زوجته كانت قد ترملت، وابنته تيتمت، وفقد اب والأم ابنهما الوحيد، فيما فقد الإبن نفسه حياته التى كانت فى بداياتها. وعلى الجانب الآخر تمت ترقية الضباط الذين زوروا القانون، والذين حكموا بالإعدام، والذين نفذوا عملية الإعدام، ومنحوهم الأوسمة والقلادات}.
وبصفة عامة نستطيع القول بأن الهم العام كان هو الشغل الشاغل للكاتب في قصص المجموعة،